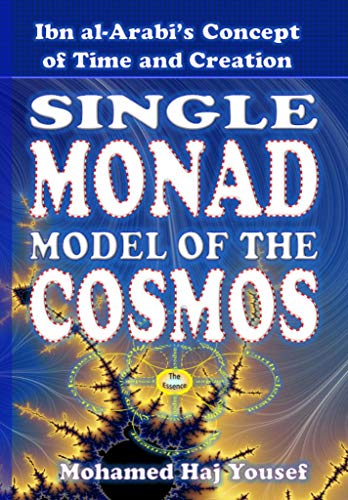المكتبة الأكبرية
*** يرجى الملاحظة أن بعض هذه الكتب غير محققة والنصوص غير مدققة ***
*** حقوق الملكية للكتب المنشورة على هذا الموقع خاضعة للملكية العامة ***

مشرع الخصوص إلى معاني النصوص
للشيخ علاء الدين علي بن أحمد المهائمي
وهو شرح لكتاب النصوص للشيخ أبي المعالي صدر الدين بن إسحق القونوي
النص الثاني والعشرون
 |
 |
ولما فرغ عن تحقيق التوحد ، شرع في كشف ما يحجب عنه غالبا ، فذلك بما قال رضي اللّه عنه :
[ نص شريف ] هو آخر النصوص ؛ لأن كمال إيضاح التوحيد الذي هو أشرف المطالب حاصل به ، والحجب الباقية تيسر انكشافه عند انكشافه وآخريته لأن كمال اتضاح التوحيد في مقام أحدية الجمع والفرق ، وهو آخر المقامات فيما يتعارف .
قال الشيخ رضي اللّه عنه : [ اعلم أن أعظم الشبه والحجب أن التعدّدات الواقعة في الوجود الواحد توجب آثار الأعيان الثابتة فيه ، فتوهم أن الأعيان ظهرت في الوجود وبالوجود ،
.......................................
( 1 ) أي التعددات .
وإنما ظهرت آثارها في الوجود ولم تظهر أبدا ؛ لأنها ذاتها لا تقتضي الظهور ] .
إنما كان هذا أعظم الشبه الحاجبة عن التوحيد ؛ لأن جميع الحجب من النقص والإمكان والتغييرات فرع هذا ، فإذا ارتفع ، فكأنه ارتفع الكل .
يعنى : أن هذه التعددات إنما هي آثار الأعيان الثابتة في الوجود الواحد الظاهر بها ، فتوهم أن الأعيان هي التي ظهرت في الوجود ، فهي المرئية ، وظهرت بوجود خاص لها غير وجود الواجب ، فرد ذلك بأن الظاهر هو الحق فيها وبها ، وإنما ظهرت آثار الأعيان في ذلك الوجود الواحد ، ولم تظهر تلك الأعيان ولا تظهر أبدا ؛ لأنها بالذات لا تقتضي ،
أي : لا تقبل الظهور ؛ لأنها أمور عدمية ولا ظهور للعدم بل الوجود هو الظاهر والباطن .
ومن هنا قال الشيخ محيي الدين في “ إنشاء الدوائر “ : إن الوجود ليس بزائد على الوجود ؛ لأن الوجود هو الظاهر ، ولا ينافي كونه زائدا على الماهية في غير الواجب ، ثم ذكر تأويل ما يخالفه من أقوال المحققين ،
بما قال الشيخ أعلى اللّه مقامه : [ ومتى أخبر محقق بغير هذا أو نسب إليها الوجود والظهور ، فإنما ذلك الإخبار بلسان بعض المراتب والأذواق النسبية ، أي : إنما يثبت صحتها بالنسبة إلى مقام معين ، أو مقامات مخصوصة دون ذوق مقام الكمال ، وأما النص الذي لا ينسخ حكمه ، فهو ما ذكرناه وهكذا كل ما ذكر في هذا الكتاب ، فإنه الحق الصريح الذي هو الأمر عليه ، وما سواه ، فقد يكون صحيحا مطلقا كهذا الذي ذكرنا ، وقد يكون صحيحا بالنسبة والإضافة إلي مقام ما ، كما سبقت الإشارة إليه ] .
أي : ومتى أخبر محقق عن كشفه بغير ما ذكرنا من أن الظهور للوجود ، بأن قال :
الظهور لها والوجود محقق فيها ، أو نسب إليها الوجود والظهور جميعا ، وقال لها : الوجود الإضافي هو ظل الوجود الحق ، وهي الظاهرة بذلك الوجود ، فإنما ذلك الإخبار بلسان بعض مراتب الكشف وبلسان بعض الأذواق النسبية لا بمعنى أن المخبر المكاشف بجميع المقامات يخبر بذلك عن بعضها ، بل بمعنى أن هذا الكلام ، إنما يصح من المخبر بها إذا بلغ مقاما معينا ، أو مقامات مخصوصة وتقيد بها ، ولم يصل إلى مقام الكمال ، فإن الواصل إليه لا يعتد بظهورها ولا وجودها ، بل الظاهر هو الوجود الواحد فيها .
......................................................
( 1 ) انظره في ( ص 140 ) ، طبعة دار الكتب العلمية .
هذا هو النص الذي لا ينسخ بما هو أعلى منه ، بخلاف تلك المقامات فإنها تنسخ بما هي أعلى منها ، ثم ذكر أن جميع نصوصه إنما هي على مقام الكمال وصحتها على الإطلاق ، بخلاف المذكور في غيره من كتبه وكتب غيره ، فإنه قيد يكون كذلك وقد لا يكون ، مع أنه لا بدّ وأن يكون صحيحا ، والإضافة إلى مقام ما سبقت الإشارة في التفريع الثالث من تفاريع النصوص الثلاثة : الأول من أن جميع الكشوف لا بدّ من صحتها بوجه .
فإن قيل : قد مر مرارا أن الأعيان ظاهرة ، قلنا : المراد ظهورها بظهور الحق فيها ، لا بذاتها ، كما أن وجودها كذلك ، وذلك الظهور والوجود عين الحق لا هي ، فهي معدومة أبدا .
فإن قيل : فحينئذ لا يكون ذلك من النصوص .
قلنا : إنما لا يكون من النصوص على تقدير أن يقال : أن الظهور إما بذاتها وإلا فهذا الكلام لا يقبل النسخ ، فافهم .
قال الشيخ : [ ومتى وضح لك ما ذكرته في هذا النص ، علمت أن الظهور في الوجود ؛ لكن بشرط التعدد مع آثار الأعيان فيه ، وأن البطون صفة ذاتية للأعيان ، والوجود أيضا من حيث تعقل وحدته ، والأمر دائر بين الظهور ، وبطون غلبة ومغلوبية ، بمعنى أنه ما نقص من الظاهر ، اندرج في الباطن ، وبالعكس والنسب والإضافات صور أحوال وأحكام تنشأ بين المراتب ، فيظهر بعضها بعضا ، ويخفى بعضها بعضا بحسب الغلبية والمغلوبية المشار إليها آنفا ، فافهم ] .
وصلّ اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم ، أي : وما ظهر لك ما ذكرته من أن الظهور لآثار الأعيان في الوجود ، علمت أن الظهور للوجود ، إذ لا أثر للأعيان من حيث هي ؛ لأنها معدومة ، بل من حيث تعلق الوجود بها فالآثار في الحقيقة آثار الوجود بشرط الأعيان ، فإذا ظهرت آثار الوجود بشرط .
آخره والحمد لله رب العالمين
* * *
....................................................................................
( 1 ) فإن ظهر الوجود على الأعيان اختفى حاله الذاتية وهي بطونها وعدميتها ، وإن ظهر حكمها الذاتي توهم بطون الوجود لعدم غير يعرفه .
النّصوص في تحقيق الطّور المخصوص
لصدر الدّين القونوي قدس اللّه سره
تحقيق الشيخ أحمد فريد المزيدي
.
بسم اللّه الرحمن الرحيم
الحمد للّه الذي أبان بمستقرات الهمم مراتب علم اليقين وعينه وحقه ودرجاته ، وأوضح بسكون قلق الطالبين حال الوصول إلى منتهى شاء نفوسهم بتفاوت درجاتهم في منازل معرفته سبحانه في تقريباته . وميّز خاصته من بين الخلق بأن لم يجعل لهم غاية سوى ذاته من جميع عوالمه ، وحضرات أسمائه وصفاته ، بل جعل منتهى مدى هممهم أشرف متعلقات علمه الذاتي وأعلى مراداته ، حتى صار نهاية مرادهم وغاية مرماهم ما يريده بذاته لذاته . ومن جهة أعلى حيثيات شؤونها الأصلية الأول ، وأرفع تعيناته ، فهو سبحانه عين علمهم اليقيني ، وعينه وحقه في سائر مراتب علمه الذاتي المتعلق به أولا .
ثم بمعلوماته مع استهلاكهم فيه من حيث هم ، وبقاء حكمهم وسرايته في جميع موجوداته وحضراته .
وصلّى اللّه على المتحقق به من حيثية الشهود الأكمل ، والعلم الأتم الأشرف الأشمل ، مع دوام الحضور معه سبحانه في جميع مواطنه وأحواله ومراتبه ونشأته .
سيدنا محمد وآله والصفوة من أمته وإخوانه الحائزين من اللّه ميراثه الأتم المشتمل على علومه وأحواله ومقاماته .
مع تحققهم بنتائج حظوظهم الاختصاصية المميّزة إيّاهم عن التي تميز بها خواص الوسائط وثمرات التبعية ، وأحكام الروابط ، صلاة مستمرة الحكم .
دائمة الإيناع دوام الزمان من حيث حقيقتها الكلية ، وصور أحكامها التفصيلية المعبّر عنها بسنينه وشهوره وأيامه وساعاته .
نصّ شريف هو أول النصوص الواجب تقديمه : اعلم أن الحق من حيث إطلاقه الذاتي لا يصح أن يحكم عليه بحكم ، أو يعرّف بوصف ، أو يضاف إليه نسبة ما من وحدة ، أو وجوب وجود ، أو مبدئية ، أو اقتضاء إيجاد ، أو صدور أثر ، أو تعلق علم منه
بنفسه أو غيره ؛ لأن كل ذلك يقضي بالتعين والتقيد ، ولا ريب في أن تعقل كل تعين يقضي بسبق اللاتعين ، فكل ما ذكرناه ينافي الإطلاق ، بل تصور إطلاق الحق يشترط فيه أن يتعقل بمعنى أنه وصف سلبيّ ، لا بمعنى أنه إطلاق ضد التقييد ، بل هو إطلاق عن الوحدة والكثرة المعلومتين ، وعن الحصر أيضا في الإطلاق والتقييد ، وفي الجمع بين كل ذلك والتنزه عنه ، فيصح في حقه كل ذلك حال تنزّهه عن الجميع ، فنسبة كل ذلك إليه وغيره وسلبه عنه على السواء ، ليس أحد الأمرين بأولى من الآخر ، وإذا وضح هذا علم أن نسبة الوحدة إلى الحق والمبدئية والتأثير والفعل الإيجادي ونحو ذلك إنما يصح وينضاف إلى الحق باعتبار التعين .
وأول التعينات المتعلقة : النسبة العلمية الذاتية ، لكن باعتبار تميزها عن الذات بالامتياز النسبي لا الحقيقي ، وبواسطة النسبة العلمية الذاتية يتعقل وحدة الحق ووجوب وجوده ومبدئيته ، وسيما من حيث أن علمه بنفسه في نفسه في نفسه ، وأن عين علمه بنفسه سبب لعلمه بكل شيء ، وأن الأشياء عبارة عن تعيّنات تعقلاته الكلية والتفصيلية ، وأن الماهيات عبارة عن التعقلات ، وأنها تعقلات منتشئة التعقل بعضها من بعض ، لا بمعنى أنها تحدث في تعقل الحق تعالى ، تعالى اللّه عما لا يليق به .
بل تعقل البعض من متأخر الرتبة عن البعض ، وكلها تعقلات أزلية أبدية على وتيرة واحدة ، تتعقل في العلم ويتعلق بها بحسب ما تقتضيه حقائقها .
ومقتضى حقائقها على نحوين :
أحدهما : تعقلها من حيث استهلاك كثرتها في وحدة الحق ، وهو تعقل المفصل في المجمل ، كمشاهدة العالم العاقل بعين العلم في النواة الواحدة ما فيها بالقوة من الأغصان والأوراق والثمر ، والذي في كل فرد من أفراد ذلك الثمر مثل ما في النواة الأولى ، وهكذا إلى غير النهاية .
والنحو الآخر : تعقّل أحكام الوحدة جملة بعد جملة ، فيتعقل كل جملة بما تشتمل عليه من الماهيات التي هي صورة تلك التعقّلات المتكثرة المعددة للوجود الواحد ، وهكذا عكس الاستهلاك الأول المشار إليه ؛ فإن ذلك عبارة عن استهلاك الكثرة في الوحدة ،
وهذا هو استهلاك الوحدة في الكثرة فليعلم ذلك .
اعلم أن الحق من حيث إطلاقه وإحاطته لا يسمّى باسم ، ولا يضاف إليه حكم ، ولا يتعيّن بوصف ولا رسم ، ليس نسبة الاقتضاء إليه بأولى من نسبة اللا اقتضاء ، فإن الاقتضاء المتعقل إذ ذاك أو المنفي هو حكم متعين ووصف مقيّد .
ثم لتعلم أن الاقتضاء وإن كان ذاتيّا فإن له ثلاث مراتب :
حكمه من حيث المرتبة الأولى هو أنه لا يتوقف على شرط ، ولا موجب يكون سببا لتعيّنه .
وحكمه من حيث المرتبة الثانية هو أن يتوقف تعيّنه على شرط واحد فحسب .
وحكمه من حيث المرتبة الثالثة هو أن ظهور أحكامه يتوقف على شروط وأسباب ووسائط .
فحكم الاقتضاء الأول هو الفيض الذاتي لا لموجب ، ولا يتعقل في مقابلة قابل أو استعداده ، وحكم الاقتضاء الثاني التوقف على شرط واحد وجوديّ فحسب ، وذلك الشرط الوجودي هو العقل الأول الذي هو واسطة بين الحق وبين ما قدّر وجوده من الممكنات إلى يوم القيامة ، وأما حكم الاقتضاء من حيث المرتبة الثالثة فإن ظهور أثره وحكمه موقوف على شروط شتى كباقي الموجودات .
ولست أعني بهذا أن ثمة اقتضاءات ثلاثة مختلفة الحقائق ، بل هو اقتضاء واحد وله ثلاث مراتب ، يظهر ويتعين به من حيثية كل مرتبة منها أثر أو آثار فافهم .
ومن النصوص الإلهية : إن العلم الوحداني الذاتي يضاف إليه التعدّد من حيث تعلّقه بالمعلومات ، ولا يتحقق بإدراكها إلا من تعيّناته وتعلّقاته ، وتعلقه بكل معلوم تابع للمعلوم بحسب ما هو المعلوم عليه في نفسه ، بسيطا كان المعلوم أو مركبا ، زمانيّا أو مكانيّا ، أو غير زماني ولا مكاني ، موقت القبول ، متناهي الحكم والوصف ، أو غير موقت ولا متناه فيما ذكرنا ، فاعلم ذلك .
ومن تفاريع ما ذكرنا من النصوص أيضا أن الحكم من كل حاكم على كل محكوم عليه تابع لحال الحاكم حين الحكم ، وتابع لحال المحكوم عليه حال حكم الحاكم عليه ، فإن
كان المحكوم عليه ما من شأنه التنقل في الأحوال تنوعت أحكام الحاكم عليه في كل حال ، واختلفت بحسب تلبّسه بتلك الأحوال ، وإن كان المحكوم عليه من شأنه الثبات على وتيرة واحدة ثبت حكم الحاكم عليه بحسب التعلق المعين بحكم الحاكم عليه ومقتضاه ، وبقي الأمر بحسب حال الحاكم حين الحكم ، فإن كان الحاكم من مقتضى ذاته التقلّب في الأحوال بحسبها ، أو مقتضى ذاته أنه ثابت والأحوال تنقلب فيكون تبعية حكم الحاكم بحسب أحد الأمرين الحاصرين لمراتب حكم كل حاكم وكل محكوم عليه ؛ إذ لا يخرج عما ذكرته حكم حاكم ولا محكوم عليه .
ومن تفاريع ما ذكرنا من النصوص أيضا أن العلم يتبع الوجود ، بمعنى أنه حيث يكون الوجود يكون العلم دون انفكاك .
وتفاوت العلم بحسب تفاوت قبول الماهية الوجود تماما ونقصانا ، فالقابل للوجود على وجه أتم يكون العلم هناك أتم ، وينقص العلم بقدر القبول الناقص ، وغلبة أحكام الإمكان على أحكام الوجوب عكس ما ذكرنا أولا ، فاعلم ذلك .
ومن تفاريع ما ذكرنا من النصوص المحققة أيضا ، وإن كنت قد ألمعت بطرف منه في بعض المواضع من كتبي في ضمن أمر آخر وبلسانه ، لكن لما أفردت هذا الكتاب لذكر النصوص من الأذواق المختصّة بخصوص مقام الكمال ، دون لسان عمومه من الأذواق المقيّدة الحاصلة لأرباب المقامات المخصوصة والمستندة من حيث الأصالة إلى حضرة اسم أو صفة من الصفات ،
والأسماء الإلهية التي هي محتد ذلك الذوق الخاص ومنبعه ، وجب عليّ أن أفرد وأميز ما يختص بذوق المقام الأكمل الأجمع ، وصحة ثبوته ومطابقته لما يعلمه اللّه تعالى في أعلى درجات علمه وأتمها وأكملها من ذلك الأمر المترجم عنه ، دون تقرير صحته وثبوته بالنسبة والإضافة إلى مقام دون مقام ، وباعتبار حال ووقت دون غيرهما من الأوقات والأحوال وما ذكر .
فنقول بعد تمهيد هذه المقدمة الكلية في بيان هذا النص الذي قصدنا إيضاحه :
إن كل معلوم أدركه الإنسان بنظره أو كشفه أو حسه أو خياله جمعا وفرادى ، ولم ينته نظره أو كشفه لذلك الأمر ، أو إدراكه إيّاه حسّا وخيالا إلى إدراك ما وراءه بعد معرفة
ذاتياته ولوازمه الكلية ، فإنه لم يدرك ذلك الأمر حق الإدراك تماما ، ولم يعرفه حق المعرفة .
وسواء كان متعلق إدراكه ومعرفته العالم من حيث معانيه وأرواحه ، أو من حيث صوره وأعراضه ، أو كان متعلق معرفته الحق ، فإنه متى كشف له عن جلية الأمر وصورة تعين كل معلوم في علم الحق وجد الأمر كذلك ، فإنه ما لم ينته معرفته بالحق إلى إطلاقه وصرافة وحدة ذاته الحقيقية ، التي لا اسم يعيّنها ولا وصف ولا حكم ولا رسم ، ولا تنضبط بشهود ، ولا تعقل ، ولا تنحصر في أمر معين ، لم يعرف أن ليس وراء اللّه مرمى ، وأن الإحاطة به علما وشهودا محال ، وأن ليس بعد الوجود الحق المطلق إلا العدم المتوهم ، هذا وإن كان لمعرفة تعذّر العلم باللّه على نحو ما يعلم نفسه طريق آخر أعلى وأتم وأكشف ، عرفناه ذوقا وشهودا بحمد اللّه ومنّه ، لكن ذلك مما يحرم بيانه وتسطيره وغاية البيان عنه هذا الإلماع المذكور .
هذا وإن كان الذوق والمعرفة الحاصلة لصاحبه والشهود من حيث استناد ذلك الذوق ، والمقام إلى حضرة اسم من الأسماء الإلهية الذي هو قبلة ذلك المقام ، وغاية معرفته من الحق نهايته ، سيما من الوجه الذي يقضي بأن الاسم عين المسمّى ، كما أوضحناه في مواضع من كلامنا ، لكن تلك غايات نسبية ، فإن المبادئ والغايات أعلام الكمالات النسبية ، والأمر من حيث الكمال الحقيقي بخلاف ذلك .
وإليه الإشارة بقوله تعالى لأكمل عبيده :وَأَنَّ إِلى رَبِّكَ الْمُنْتَهى[ النجم : 42 ] ،
وأدرج سبحانه وتعالى في هذه الآية لطيفة أخرى خفية ،
وهو كونه لم يقل : ( وإن إلى ربك منتهاك ) بل نبّه على أن غايته من مطلق الربوبية الغاية التي هي غاية الغايات ، وليس بعدها إلا تفاصيل درجات في الأكملية التي لا تقف عند حدّ وغاية .
وقد أشار صلى اللّه عليه وسلم إلى ما ذكرناه في بعض مناجاته فقال صلى اللّه عليه وسلم : “ أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك ، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك “ : أي لا أبلغ كل ما فيك . فجمع فيه بين التنبيه على تعذر الإحاطة وبين التعريف
...............................................................
( 1 ) رواه مسلم ( 1 / 352 ) .
بانتهائه في معرفة الحق إلى غاية الغايات ، وهذا كالتفسير للآية المذكورة ، وهي قوله :وَأَنَّ إِلى رَبِّكَ الْمُنْتَهى.
وفي الأحاديث النبوية تنبيهات كثيرة تشير إلى ما ذكرنا ، من تتبّعها بعد التيقظ والتفهم لما ذكرت ألفاه واضحا جليّا .
ثم نقول : ولهذا المقام والذوق المنبه عليه ألسنة تترجم عنه بصيغ مختلفة ، فمن ألسنته من القرآن من حيث التسمية الذي أخبر اللّه سبحانه أن رجاله يعرفون كلّا بسيماهم ، وهذا من خاصية الاستشراف على الأطراف بالانتهاء في معرفة الأشياء إلى الغاية التي توجب الاستشراف ، على ما وراءها .
ولسانه في مقام النبوة واسمه المطلع كما قال صلى اللّه عليه وسلم في أم القرآن بل في سر كل آية منه : “ إنّ لها ظهرا وبطنا ، وحدّا ومطلعا إلى سبعة أبطن “ . وفي رواية : “ إلى سبعين بطنا “ .
وقد نبّهت على ذلك في تفسير الفاتحة فلينظر هناك .
واسمه ولسانه في اصطلاح أهل اللّه الموقف الذي هو منتهى كل مقام ، والمستشرف منه على المقام المستقبل .
واسمه ولسانه في ذوق مقام الكمال بالنسبة إلى كل مقامين البرزخ الجامع بينهما ، والنسبة إلى خصوص مقام الكمال برزخ البرازخ .
نصّ شريف عزيز المنال : غيب هوية الحق إشارة إلى إطلاقه باعتبار اللاتعين .
ووحدته الحقيقية الماحية لجميع الاعتبارات والأسماء والصفات .
والنسب والإضافات هي عبارة عن تعقل الحق نفسه ، وإدراكه لها من حيث تعيّنه ، وهذا التعقل والإدراك التعيّني وإن كان يلي الإطلاق المشار إليه فإنه بالنسبة إلى تعين الحق في تعقل كل متعقل في كل تجلّ تعين مطلق ، وإن أوسع التعينات ، وهو شهود الكمّل ، وهو التجلّي الذاتي ، وله مقام التوحيد الأعلى .
ومبدئية الحق تلي هذا التعين ، والمبدئية هي محتد الاعتبارات ، ومنبع النسب
...................................................................
( 1 ) ذكره الشريف الجرجاني في التعريفات ( 1 / 48 ) بنحوه .
والإضافات الظاهرة في الوجود ، والباطنة في عرصة التعقلات والأذهان .
والمقول فيه أنه وجود مطلق واحد واجب ، فهو عبارة عن تعين الوجود في النسبة العلمية الذاتية الإلهية ، والحق من حيث هذه النسبة يسمّى عند المحقق بالمبدأ ، لا من حيث نسبة غيرها ، فافهم هذا وتدبّر ، فقد أدرجت لك هذا النص أصل أصول المعارف الإلهية ، واللّه المرشد .
كل سالك سلك على أي طريق كان غايته الحق ، بشرط فوزه منه سبحانه بسعادة ما ، فإن ذلك السالك صاحب معراج ، وسلوكه عروج فافهم .
نصّ شريف كليّ يحتوي على أسرار جليلة : اعلم أن كل ما يوصف بالمؤثرية في شيء أو في أشياء فإنه لا يصدق إطلاق هذا الوصف عليه تماما ، ما لم يؤثر حقيقية ذلك الشيء من حيث هو دون تعقل انضمام قيد آخر إلى تلك الحقيقية الموصوفة بالتأثير ، أو شرط ما خارجي كان ما كان ، وإنما ذكرت هذه القيود من أجل الآثار المنسوبة إلى الأشياء ، من حيث مراتبها ، أو من حيث اعتبارات هي من لوازم حقائقها ، ومن أجل ما استفاض أيضا عند أهل العقل النظري ، وأكثر أهل الأذواق بأن كل موصوف بالمرآتية سواء كانت مرآته معنوية أو محسوسة ،
فإن لها : أي لتلك المرآة أثرا في المنطبع فيها ؛ لردها صورة المنطبع إليها ، وظهور صورة المنطبع فيها بحسبها . وهذا صحيح من وجه ليس مطلقا ؛ فإن الأثر للمرآة في المنطبع إنما كان يصح أن لو أثرت في حقيقته من حيث هو ،
وذلك غير واقع ، وإنما يثبت الأثر للمرآة في المنطبع من حيث إدراك من لم يعرف حقيقة المنطبع ولم يدركه إلا في المرآة ، وليست المرآة بمحل لحقيقة المنطبع ، بل هي مجلى لمثاله وبعض ظهوراته ، والظهر نسبة تضاف إلى المنطبع من حيث انطباع صورته في المرآة ليس عين حقيقة المنطبع .
ومرادي من قولي ببعض ظهوراته التنبيه على أن التجليات الذاتية الاختصاصية لا تكون في مظهر ولا في مرآة ، ولا بحسب مرتبة ما ، فإن من أدرك الحق من حيث هذه التجليات فقد شهد الحقيقة خارج المرآة من حيث هي لا بحسب مظهر ولا مرتبة كما قلنا ، ولا اسم ولا صفة ولا حال معين ولا غير ذلك ، وهو يعلم ذوقا أن المرآة لا أثر لها في الحقيقة .
وكان شيخنا الإمام قدّس اللّه روحه يسمّي هذه التجليات : “ التجليات الذاتية البرقية “ ، وما كنت أعرف يومئذ سبب هذه التسمية ، ولا مراد الشيخ منها .
ثم إن هذه التجليات الذاتية البرقية لا تحصل إلا لذي فراغ تام من سائر الأوصاف والأحوال والأحكام الوجوبية الأسمائية والإمكانية ، وهذا الفراغ فراغ مطلق ، لا يغاير إطلاق الحق ، غير أنه لا مكث له أكثر من نفس واحد ، ولهذا شبه بالبرق .
وسبب عدم دوامه حكم جمعية الحقيقة الإنسانية ، وكما أن هذه الجمعية لا تقتضي دوامه ، كذلك لو لم يتضمن الجمعية الإنسانية هذا الوصف من الفراغ والإطلاق المستجلب لهذه التجليات ، لم تكن الجمعية الإنسانية مستوعبة كل وصف وحال ، فحكم الجمعية يثبته وينفي دوامه ، ووجدت لهذا التجلّي لما منحنيه اللّه أحكاما غريبة في باطني وظاهري ، من جملتها أنه مع عدم مكثه نفسين ، يبقى في المحل من الأوصاف والعلوم ما لا يحصره إلا اللّه ، وعرفت في ليلة كتابتي هذا الوارد أنه من لم يذق هذا المشهد لم يكن محلّا للورثة ، ولم يعرف سر قوله صلى اللّه عليه وسلم : “ لي مع اللّه وقت لا يسعني فيه غير ربي “ .
ولا سر قوله عليه السّلام : “ كان اللّه ولا شيء معه “ . ولا سر قوله تعالى :وَما أَمْرُنا إِلَّا واحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ[ القمر : 50 ] ،
ولا يعرف سر مبدئية الإيجاد لا في زمان موجود ، كما أنه من ذاق هذا المشهد وقد كان علم أن الأعيان الثابتة هي حقائق الموجودات ، وأنها غير مجعولة ، وحقيقة الحق منزّهة عن الجعل والتأثير ، وما ثم أمر ثالث غير الحق والأعيان فإنه يجب أن يعلم إن صح له ما ذكرنا أن لا أثر لشيء في شيء ، وأن الأشياء هي المؤثرة في أنفسها ،
وأن المسمّاه عللا وأسبابا مؤثرة هي شروط في ظهور آثار الأشياء في أنفسها ،
لا أن ثمة حقيقة تؤثر في حقيقة غيرها وهكذا ، فلتعرف الأمر في المدد ،
فليس ثمة شيء يمد شيئا غيره ، بل المدد يصل من باطن الشيء إلى الظاهر ، والتجلّي النوري الوجودي يظهر ذلك ، فليس الإظهار بتأثير في حقيقة ما أظهره ، فالنسب هي المؤثرة بعضها في البعض ، بمعنى
...............................................................
( 1 ) ذكره القاري في المصنوع ( 1 / 151 ) ، والمناوي في فيض القدير ( 4 / 6 ) .
( 2 ) رواه الحكيم الترمذي في النوادر ( 4 / 104 ) ، وذكره ابن حجر في فتح الباري ( 6 / 289 ) .
أن بعضها سبب لانتشاء البعض ، وظهور حكمه في الحقيقة التي هي محتدها .
ومن جملة ما يعرفه ذائق هذا التجلّي أن لا أثر للأعيان الثابتة من كونها مرائي في التجلّي الوجودي الإلهي ، إلا من حيث ظهور التعدد الكامن في غيب ذلك التجلّي ، فهو أثر في نسبة الظهور الذي هو شرط في الإظهار ، والحق يتعالى عن أن يكون متأثرا من غيره ، وتتعالى حقائق الكائنات أن تكون من حيث هي حقائقها متأثرة ، فإنها من هذا الوجه في ذوق الكمال عين شؤون الحق ، فلا جائز أن يؤثر فيها غيرها ، فلا أثر لمرآة ما من حيث هي مرآة في حقيقته المنطبع فيها لما مرّ بيانه .
فافهم هذا النص وتدبّره ، فقد أدرجت فيه من نفائس العلوم والأسرار ما لا يقدر قدره إلا اللّه ، وهذا هو الحق اليقين ، والنص المبين ، وكل ما تسمعه مما يخالف هذا فإنه وإن كان صوابا فإنه صواب نسبيّ ، وهذا هو الحق الصريح الذي لا مرية فيه ، واللّه المرشد والهادي .
ومن النصوص الكلية نصوص ذكرتها في كتاب مفتاح غيب الجمع وتفصيله ، وفي غيره من الكتب التي أنشأتها لا بكلام أحد من الناس ، فإن ذلك ليس من دأبي ؛ إذ قد عصمني اللّه من ذلك ، وأغناني بهباته الخالصة العلية عن العواري الخارجية السفلية ، غير أنه لما اختصّ هذا الكتاب بذكر هذه النصوص وجب ذكر تلك النصوص أيضا هنا .
فأقول من جملتها أن كل ما هو سبب في وجود كثرة وكثير ، فإنه من حيث هو كذلك لا يمكن أن يتعين بظهور ، ولا يبدو لناظر إلّا في منظوره .
ومنها أن الشيء لا يصدر عنه ، ولا ينمي ما يضاده ، ولا ما يباينه على اختلاف ضروب الإثمار وأنواعه المعنوية والروحانية والمثالية والخيالية والحسية والطبيعية ، وهذا عام في كل ما يسمّى مصدرا لشيء أو أشياء ، أو أصلا مثمرا ، لكن إنما يكون له هذا الوصف باعتبار تعقله من حيث هو هو ، وباعتبار آخر خفي لا يطّلع عليه إلا الندر من المحققين .
ومتى توهم وقوع خلاف ما ذكرنا فليس ذلك إلا بشرط خارج عن ذات الشيء ،
أو شروط وبحسبها وبحسب الهيئة المتعقلة الحاصلة من تلك الجمعية ، أعني جمعية الحقيقة الموصوفة بالمصدرية مع الشروط والاعتبارات الخارجية ، وأحكام المرتبة التي يتعيّن فيها ذلك الاجتماع . قال تعالى : كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ [ الإسراء : 84 ] .
ولا يثمر شيء ، ولا يظهر عنه أيضا عينه ولا ما يشابهه مشابهة تامة ، فإنه يلزم من ذلك أن يكون الوجود قد حصل مرتين ، وظهر في حقيقة واحدة ومرتبة واحدة على وجه ونسق واحد ،
وذلك تحصيل للحاصل ، وأنه محال لخلوه عن الفائدة ، وكونه من قبيل العبث ، ويتعالى الفاعل الحق الحكيم العليم من فعل العبث ، فلا بدّ من اختلاف ما بين الأصول وثمراتها ، فالممكنات غير متناهية ، والفيض من الحق الذي هو أصل الأصول واحد ، فلا تكرار في الوجود عند من عرف ما ذكرنا فافهم .
ولهذا قال المحققون : إن الحق سبحانه وتعالى ما تجلّى في صورة واحدة لشخص واحد مرتين ، ولا لشخصين أيضا في صورة ، فلا بدّ من فارق واختلاف من وجه أو وجوه ، كما أشرت إليه من قبل ، فافهم واللّه المرشد .
نصّ شريف : اعلم أن الحق لما لم يكن أن ينسب إليه من حيث إطلاقه صفة ولا اسم ، أو يحكم عليه بحكم ما سلبيّا كان أو إيجابيّا ، علم أن الصفات والأسماء والأحكام لا يطلق عليه ولا ينسب إليه إلا من حيث التعينات ،
ولما استبان أن كل كثرة وجودية أو متعقلة يجب أن تكون مسبوقة بوحدة ، لزم أن تكون التعينات التي من حيث ما تضاف الأسماء والصفات والأحكام إلى الحق مسبوقة بتعين هو مبدأ جميع التعينات ومحدتها ، بمعنى أن ليس وراءه إلا الإطلاق الصرف ، وأنه أمر سلبيّ يستلزم سلب الأوصاف والأحكام والتعينات والاعتبارات عن كنه ذاته سبحانه ، وعدم التقيد والحصر في وصف أو اسم أو تعين ، أو غير ذلك مما عدّدنا أو أجملنا ذكره .
ثم إن لذوي العقول السليمة وإن عدموا الكشف الصحيح أن يعتبروا الصفات والأسماء التالية ، فإن تعذّر عليهم تعقل أسماء وصفات وراء ما تصورت وانتهت إليه ادراكاتهم العقلية ، فتلك أسماء الذات بالنسبة إليهم ، ويستدل بحقائقها في طور العقل
النظري حال الحجاب ؛ لشمول حكمها ، وتبعية غيرها من الصفات والأسماء لها ، وتوقف تعين ما بعدها عليها ، فالعطايا الإلهية الذاتية والأسمائية تعرف من هذه القاعدة ، بمعنى أن كل عطاء وخير يصل من الحق إلى الخلق ، إما أن يكون عطاء ذاتيّا أو أسمائيّا ، أو أن يكون مجموعا من الذات والأسماء .
فأما العطايا الذاتية فلا حساب عليها ، ولا تنضبط تعيناتها بعدد ولا تنحصر فيه ، وأما العطايا الأسمائية والمنسوبة إلى الذات والأسماء جميعا فلا يخلو إما أن تكون نسبتها إلى حضرة الذات أقوى وأتم من نسبتها إلى حضرة الأسماء والصفات ، أو بالعكس ، فإن غلبت نسبتها إلى الأسماء والصفات على نسبتها إلى الذات وقع الحساب عليها ، إما عسيرا أو يسيرا ، بحسب الغلبة والمغلوبية الواقعة هناك .
وهنا سرّ كبير لا يمكن إفشاؤه ، وإن كانت نتيجة الغلبة والمغلوبية قوة نسبة تلك العطايا إلى حضرة الذات ، فذلك الذي لا حساب عليه ؛ لأن العطايا الذاتية وما قويت نسبتها إليها لا يصدر ولا يقبل إلا بمناسبة ذاتية ، فلا موجب لها غير تلك المناسبة .
ومن لم يعرف هذا الأصل لم يعلم حقيقة :
قوله تعالى :وَتَرْزُقُ مَنْ تَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ[ آل عمران : 27 ] .
ولا سر قوله تعالى :وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ[ النور : 38 ] .
ولا سر قوله تعالى :هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ[ ص : 39 ] .
ونحو ذلك مما تكرّر ذكره في الكتاب العزيز .
وفي الأحاديث النبوية أيضا مثل قوله عليه السلام : " إنه يدخل الجنة من أمته سبعون ألفا بغير حساب ومع كل ألف سبعون ألفا " 1 " . "
هؤلاء أصحاب العطايا الأسمائية ، غير أن نسبتهم إلى حضرة الذات أقوى من نسبتهم إلى حضرة الأسماء والصفات ، ولهذا اتبعوا أصحاب المناسبة الذاتية ، وشاركوهم في أحوالهم ، فاعلم ذلك .
....................................................................
( 1 ) رواه الترمذي ( 4 / 626 ) ، وأحمد ( 5 / 268 ) ، وابن ماجة ( 2 / 1433 ) .
وإذ قد ذكرنا أقسام العطايا وأحكامها فلنذكر أقسام القابلين لها ، فإنهم في أخذهم على طبقات يتعدد بحسب سؤالاتهم الاستعدادية ، أو الحالية ، أو المرتبية ، أو الروحانية ، أو الطبيعية المزاجية ، أو الطبيعية العرضية التي يترجم عنها لسان الطالب القابل .
وعلى الجملة فأعلى مراتب القابلين في قبولهم لما يرد عليهم من فيض الحق وعطاياه رؤية وجه الحق في الشروط والأسباب المسمّاه بالوسائط وسلسلة الترتيب ،
بحيث يعلم الآخذ ، ويشهد أن الوسائط السببية ليست غير تعينات الحق في المراتب الإلهية والكونية على اختلاف ضروبها ، بمعنى أنه ليس بين فيض الحق المقبول وبين القابل إلا نفس تعين الفيض بالقابلية المقيّدة دون انضمام حكم إمكاني يقتضيه ويوجبه أثر مرور الفيض على مراتب الوسائط ، والانصباغ بأحكام إمكاناتها ، ويرى الفيض أنه تجل من تجليات باطن الحق ،
فإن التعددات والتعينات التي لحقته هي أحكام الاسم الظاهر من حيث أن ظاهر الحق مجلى لباطنه ، فأحكام الظهور تعدّد مطلق وحدة البطون ، وتلك الأحكام هي المسمّاة بالقوابل ، وهي صور الشؤون ليس غيرها فافهم . واللّه يقول الحق وهو يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم .
نصّ جليّ وضابط كليّ يفيد معرفة المطاوعة والإجابة الإلهيين وإبائهما :
اعلم أن الميزان التام الصريح والبرهان الذوقي المحقق الصحيح في معرفة : متى يكون العبد من المطيعين لربه ، ومتى تسرع إليه الإجابة الإلهية في عين ما يسأله فيه دون تعويض ولا تأخير ، هو صحة المعرفة وكمال المطاوعة ،
فالأصح معرفة بالحق والأصح تصورا له تكون الإجابة إليه في عين ما سأل فيه أسرع ، والأتم مراقبة لأوامر الحق ومبادرة إليها بكمال المطاوعة يكون مطاوعة الحق له أيضا أتم من مطاوعته سبحانه لغيره من العبيد ،
ولهذا كان مقتضى حال الأكابر من أهل اللّه أن أكثر أدعيتهم مستجابة ؛ لكمال المطاوعة ، وصحة المعرفة باللّه والتصور له ، وإليه الإشارة بقوله سبحانه :ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ[ غافر : 60 ] ،
فالعديم المعرفة الصحيحة الشهودية النسبي التصور ، ليس بداع للحق الذي ضمن له الإجابة بقوله له :ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، وإنما هو متوجه في دعائه إلى الصورة الشخصية في ذهنه ، الناتجة من نظره وخياله ، أو خيال غيره ونظره ، أو
المتحصلة من المجموع المشار إليه ، فلهذا يحرم من هذا شأنه الإجابة في عين ما سأل فيه ، أو يتأخر عنه ، أعني الإجابة .
ومتى أجيب مثل هذا فإنما سببه سر المعية الإلهية المقتضية عدم خلو شيء عن الحق ، أو الجمعية التامة الحاصلة للمضطرين ، الموعود لهم بالإجابة للاستدعاء الاضطراري ، والاستعداد الحاصل به : أي بالاضطرار .
وحال من هذا وصفه مخالف لحال ذي التصور الصحيح والمعرفة المحققة ، فإنه مستحضر الحق ، ومتوجّه إليه استحضارا وتوجها محققا ، وإن لم يكن ذلك من جميع الوجوه لكن يكفيه كونه متصورا ومستحضرا للحقّ في توجهه ، ولو في بعض المراتب ، ومن حيثية بعض الأسماء والصفات ، وهذا حال المتوسطين من أهل اللّه ، والحال إلى المقدّم ذكره حال المحجوبين .
وأما الكمّل والأفراد فإن توجّههم إلى الحق تابع للتجلّي الذاتي المشار إليه ، الحاصل لهم ، والموقوف تحققهم بمقام الكمال على الفوز به ، فإنه مثمر لهم معرفة تامة جامعة لحيثيات جميع الأسماء والصفات والمراتب والاعتبارات ، مع صحة تصور الحق من حيث تجليه الذاتي المشار إليه ، الحاصل لهم بالشهود الأتم ، فلهذا لا يتأخر عنهم الإجابة .
وأيضا فإنهم أعني الكمّل ومن شاء اللّه من الأفراد أهل الاطّلاع على اللوح المحفوظ ، بل وعلى المقام القلمي ، بل وعلى حضرة العلم الإلهي ، فيشعرون بالمقدّر كونه لسبق العلم بوقوعه ، ولا بدّ فيسألون لا في مستحيل غير مقدر الوجود ، ولا تنبعث هممهم إلى طلب ذلك والإرادة له .
وإنما قلت : ( والإرادة له ) من أجل أن ثمة من يتوقف وقوع الأشياء على إرادته ، وإن لم يدع ولم يسأل الحق في حصوله ، وقد عاينت ذلك من شيخنا قدّس اللّه روحه سنين كثيرة في أمور لا أحصيها ، وأخبرني رضي اللّه عنه أنه رأى النبي صلى اللّه عليه وسلم في بعض وقائعه ، وأنه بشّره وقال له : اللّه أسرع إليك بالإجابة منك إليه بالدعاء .
وهذا المقام فوق مقام إجابة الأدعية ، وأنه من خصائص كمال المطاوعة ، ومقامه فوق مقام المطاوعة ، فإن مقام المطاوعة يختص بما سبقت الإشارة إليه من المبادرة إلى امتثال
الأوامر ، وتتبع مراضي الحق ، والقيام بحقوقه بقدر الاستطاعة ، كما أشار إليه صلى اللّه عليه وسلم في جواب عمه أبي طالب حين قال له : ما أسرع ربك إلى هواك يا محمد ، لما رأى من سرعة إجابة الحق له فيما يدعوه فيه .
وجاء في رواية أخرى أنه قال له : ما أطوع ربك لك ، فقال له النبي صلى اللّه عليه وسلم : “ وأنت يا عم إن أطعته أطاعك “ .
وهذا المقام الذي قلت أنه فوق هذا راجع إلى كمال موافاة العبد من حيث حقيقته لما يريده الحق منه بالإرادة الأولى الكلية المتعلقة بحصول كمال الجلاء والاستجلاء ، فإنه الموجب لإيجاد العالم ، والإنسان الكامل الذي هو العين المقصودة للّه على التعيين ، وكل ما سواه فمقصود بطريق التبعية له وبسببه من جهة أن ما لا يوصل إلى المطلوب إلا به فهو مطلوب ، فهذا هو المراد من قولي : ( فمقصود بطريق التبعية ) .
وإنما كان الإنسان الكامل هو المراد بعينه دون غيره من أجل أنه مجلى تام للحق ، يظهر الحق به من حيث ذاته ، وجميع أسمائه وصفاته وأحكامه واعتباراته على نحو ما يعلم نفسه بنفسه في نفسه ، وما ينطوي عليه من أسمائه وصفاته ، وسائر ما أشرت إليه من الأحكام والاعتبارات ، وحقائق معلوماته التي في أعيان مكنوناته دون تغيير يوجبه نقص القبول ، وخلل في مرآتيته يفضي بعدم ظهور ما ينطبع فيه على خلاف ما هو عليه في نفسه .
فإن من كان هذا شأنه لا يكون له إرادة ممتازة عن إرادة الحق ، بل هو مرآة إرادة ربه وغيرها من الصفات ، وحينئذ يستهلك دعاؤه في إرادته التي لا تغاير إرادة ربه ، فيقع ما يريد كما قال تعالى :فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ[ البروج : 16 ] .
ومن تحقق بما ذكرناه فإنه إن دعا فإنما يدعو بألسنة العالمين ومراتبهم من كونه مرآة لجميعهم ، كما أنه متى ترك الدعاء إنما يتركه من حيث كونه مجلى للحق ، باعتبار أحد وجهيه الذي يلي الجناب الإلهي ، ولا يغايره من كونه :فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ.
وليس وراء هذا المقام مرمى لرام ، ولا مرقى لراق إلى مرتبة ولا مقام ، ودونه المتوجه إلى الحق بمعرفة تامة وتصور صحيح ، المقصود بخطاب قوله :
............................................................................
( 1 ) رواه الحاكم في المستدرك ( 1 / 727 ) .
ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ[ غافر : 60 ] ، وخبر الحق صدق ، وقد تيسّر ذلك لهذا العبد المشار إليه ، فلزمت النتيجة التي هي الإجابة ، ولا بدّ بخلاف غيره من المتوجهين المذكور شأنهم .
فاعلم ذلك تفز بأسرار عزيزة وعلوم غريبة لم تنساق إليها الأفكار والأفهام ، ولا رقمتها الأنامل بالأقلام ، واللّه المرشد .
نصّ شريف : اعلم أن أعلى درجات العلم بالشيء أي شيء كان ، وبالنسبة إلى أي عالم كان ، وسواء كان المعلوم شيئا واحدا أو أشياء ، إنما تحصل بالاتحاد بالمعلوم وعدم مغايرة العالم له ؛ لأن سبب الجهل بالشيء المانع من كمال إدراكه ليس غير غلبة حكم ما به يمتاز كل واحد منهما عن الآخر ، فإن ذلك بعد معنوي ، والبعد حيث كان مانع من كمال إدراك العبد البعيد ، وتفاوت درجات العلم بالشيء بمقدار تفاوت غلبة حكم ما به يتّحد العالم بالمعلوم ، وإنه القرب الحقيقي الرافع للفصل الذي هو البعد الحقيقي المشار إليه بأحكام ما به المباينة والامتياز .
وإذا شهدت هذا الأمر وذقته بكشف محقق علمت أن سبب كمال علم الحق بالأشياء إنما هو من أجل استجلائه إيّاها في نفسه ، واستهلاك كثرتها وغيريتها في وحدته ، فإن كينونية كل شيء في أي شيء كان ، سواء كان المحل معنويّا أو صوريّا ، إنما يكون ويظهر بحسب ما تعين وظهر فيها .
ولهذا نقول : الحق علم نفسه بنفسه ، وعلم الأشياء في نفسه بعين علمه بنفسه ، ولما ورد الإخبار الإلهي بأن اللّه تعالى : “ كان ولم يكن معه شيء “ .
انتفت غيرية الأشياء بالنسبة إلى الوحدة التي هي محلها العيني ، وثبتت أولية الحق من حيث الوحدة .
وبامتياز كثرة الأشياء المتعقلة ثانيا ، الكامنة من قبل في ضمن الوحدة ، والجمع بينهما وبين الوحدة بالفعل ، ظهر الكمال المستجن في الوحدة أولا ، فانفتح بذلك باب كمال الجلاء والاستجلاء الذي هو المطلوب الحقيقي ، وظهرت أحكام الوحدة في الكثرة ،
..................................................................................
( 1 ) رواه النسائي في السنن الكبرى ( 6 / 363 ) ، والطبري في التفسير ( 12 / 4 ) .
والكثرة في الوحدة ، فوحّدت الوحدة الكثرة ؛ لكونها صارت قدرا مشتركا بين المتكثرات المتميزة بالذات بعضها عن بعض ، فوصلت فصولها ؛ لأنها جمعت بذاتها كما ذكرنا ، وعددت المتكثرات الواحد من حيث التعينات التي هي سبب تنوعات ظهور الواحد بالصبغ والإصباغ ، والكيفيات المختلفة التي اقتضتها اختلافات استعدادات المتكثرات القابلة للتجلّي الواحد فيها ، فتجدّدت معرفة أنواع الظهورات والأحكام اللازمة لها التي هي عبارة عن تأثير بعضها في البعض بالإبرام والنقض ، ظاهرا وباطنا ، علوّا وسفلا ، مؤقتا وغير مؤقت ، مناسبا وغير مناسب ،
كل ذلك بالاتصال الحاصل بينها بالتجلّي الوجودي الوحداني الجامع شملها كما ذكرنا .
فالعلم والنعيم والسعادة على اختلاف ضروب الجميع إنما هو بحسب المناسبة ، والجهل والعذاب والشقاء بحسب قوة أحكام المباينة والامتياز ، وأما امتزاج أحكام ما به الاتحاد وأحكام ما به الامتياز فأيدي السلطنة ، ومحتد كل جملة من تلك الأحكام بضروب ما من المناسبة ومرجعها من حيث الإضافة ومستندها هو المسمّى بالمرتبة فافهم .
ولما شرعت في كتابة هذا النص قيل لي في باطني في أثناء الكتابة : الأحكام المضافة إلى الوحدة والواحد الحق ، والمعبر عنها بأحكام الوجوب أصلها من حيث الوحدة حكم واحد هو حقيقة القضاء ، والمقادير أثر تعددات المعلومات لذلك الحكم الواحد ، وظهور الوجود الواحد بموجب تلك التعديدات تأثيرا أولا ، وتأثيرا ثانيا في المعدودات بإعادة أثرها عليها ، فاعلم ذلك وتدبّر غريب ما نبّهت عليه تفز بالعلم العزيز ، واللّه المرشد .
نصّ شريف يوضح بقية أسرار هذا النص : اعلم أن أعلى درجات العلم بالشيء أي شيء كان ما عدا الحق هو أن تعلمه بعلم يكون نتيجة رؤيتك إيّاه في علم الحق تماما ، ولهذا العلم آيتان :
أحدهما : استغناؤك بما حصل لك من العلم به عن معاودة النظر فيه وتكراره طلبا لمزيد معرفة به ، فإن تجدّد العلم بالشيء بطريق الازدياد ، بعد دعوى معرفة سابقة به إنما موجبه نقصان العلم به أولا ، فلو كمل العلم به أولا لاستغنى عن الازدياد كما هو شأن الحق ، وذلك موقوف على كمال الإحاطة العلمية بالمعلوم .
والآية الأخرى التي يستدل بها على حصول هذا العلم وصحّته ، هو أن ينسحب حكم علمه على الشيء حتى
يتجاوز تقيده ، فينتهي إلى أن يرى آخره متّصلا بإطلاق الحق . والعلم بالحق ليس كذلك ، فإنه إنما يتعلق به من حيث تعينه سبحانه في مرتبة أو مظهر أو حال أو حيثية أو اعتبار ، وكلما انضبط للعالم به بتعينه من إحدى الوجوه المذكورة ، يظهر علمه ويتعين له من مطلق الذات بحسب حال المتجلي له ؛ إذ ذاك ما لم يسبق تعينه قبل ذلك .
فكما لا ينتهي أحوال الإنسان إلى غاية تقف عندها فكذلك لا تتناهى تعينات الحق وتنوعات ظهوراته للإنسان ، بحسب أحواله التي هي تعيّنات مطلق ذات الحق وتنوعات ظهوراته ، وقد سبق التنبيه في غير هذا الموضع على أن الأسماء أسماء أحوال ، وعلى أن الأعيان يتقلب عليها الأحوال بخلاف الحق ؛ فإنه يتقلب في الأحوال ، كما أخبر سبحانه عن ذلك بقوله :كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ[ الرحمن : 29 ] ،
فافهم ، ولا تتأول بل اجتهد أن تعاين أولا ، فأمن واسلم تسلم ، واللّه الموفق .
نصّ جليل : اعلم أن ليس في الوجود موجود يوصف بالإطلاق إلا وله وجه التقييد ، ولو من حيث تعينه في تعقل متعقل ما أو متعقلين ، وكذلك ليس في الوجود موجود محكوم عليه بالتقييد إلا وله وجه إلى الإطلاق ، ولكن لا يعرف ذلك إلا من عرف الأشياء معرفة تامة بعد معرفة الحق ، ومعرفة كل ما يعرفه به ، ومن لم يشهد هذا المشهد ذوقا لم يتحقق بمعرفة الحق والخلق .
نصّ في بيان سر الكمال والأكملية : اعلم أن للحق كمالا ذاتيّا وكمالا أسمائيّا يتوقف ظهوره على إيجاد العالم ، والكمالان معا من حيث التعين أسمائيان ؛ لأن الحكم من كل حاكم على كل أمر ما مسبوق بتعين المحكوم عليه في تعقل الحاكم ، فلو لا تعقّل ذات الحق قبل إضافة الأسماء إليه وامتيازه بغناه في ثبوت وجوده له عما سواه لما حكم بأن له كمالا ذاتيّا ،
ولا شكّ أن كل تعين يتعقل للحق هو اسم له ، فإن الأسماء ليست عند المحققين إلا تعينات الحق ، فإذن كل كمال يوصف به الحق فإنه يصدق عليه أنه كمال أسمائي من هذا الوجه ، وأما من حيث أن انتشاء أسماء الحق من حضرة وحدته هو من مقتضى ذاته فإن جميع الكمالات التي يوصف بها كمالات ذاتية .
وإذا تقرّر هذا فنقول : ما كان له هذا الكمال من ذاته ، فإنه لا ينقص بالعوارض
واللوازم الخارجية في بعض المراتب ، بمعنى أنها تقدح في كماله ، ولا جائز أن يتوهم في كماله نقص أيضا بحيث يكمل بها ، بل قد يظهر بالعوارض واللوازم في بعض المراتب وصف أكمليّته ، ومن جملتها معرفة أن هذا شأنه .
نصّ شريف جدّا : حقيقة الحق عبارة عن صورة علمه بنفسه من حيث تعينه في تعقله نفسه باعتبار يوحد العلم والعالم والمعلوم ، وصفته الذاتية التي لا تغاير ذاته أحدية جمع لا يتعقل وراءها جمعية ، ولا نسبة ، ولا اعتبار ، والتحقق بشهود هذه الصفة ومعرفتها تماما إنما يكون بمعرفة أن الحق في كل متعين قابل للحكم عليه بأنه متعين بحسب الأمر المقتضي إدراك الحق فيه ، متعينا مع العلم بأنه غير محصور في التعين ، وأنه من حيث هو هو غير متعين ، وهذا هو صورة علمه بنفسه ، فيعرف ذاته متعيّنة بالنسبة إلى ظهوره في المتعينات بحسبها ، وبالنسبة إلى من لم يشهده إلا في مظهر ، ويعرف سبحانه أنه من حيث هو هو غير متعين أيضا حال الحكم عليه بالتعين ؛ لقصور إدراك من لم يدركه إلا في مظهر ، وسواء اعتبر المظهر عين الظاهر أو غيره .
وحقيقة الخلق عبارة عن صورة علم ربهم بهم ، وصفتهم الذاتية الفقر المثمر لمطلق الغناء ليس كل فقر فافهم .
نصّ شريف جدّا : اعلم أن ثمرة التنزيه العقلي هو تميز الحق عمّا يسمّى سواه بالصفات السلبية ؛ حذرا من نقائص مفروضة في الأذهان ، غير واقعة في الوجود ، والتنزيهات الشرعية ثمرتها نفي التعدد الوجودي ، والاشتراك في المرتبة الألوهية ، وهي ثابتة أيضا شرعا مع تقرير الاشتراك مع الحق في الصفات الثبوتية ؛ لنفي المشابهة والمساواة .
وإليه الإشارة بقوله تعالى : وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ [ الجمعة : 11 ] ، و خَيْرُ الْغافِرِينَ [ الأعراف : 156 ] . و أَحْسَنُ الْخالِقِينَ [ المؤمنون : 14 ] و أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ [ يوسف : 92 ] ، و اللَّهِ أَكْبَرُ ونحو ذلك .
وأما تنزيه أهل الكشف فهو بإثبات الجمعية للحق مع عدم الحصر ، وتمييز أحكام الأسماء بعضها عن بعض ، فإنه ليس كل حكم يصح إضافته إلى كل اسم ، بل من الأسماء
ما يستحيل إضافة بعض الأحكام إليها ، وإن كانت ثابتة لأسماء أخر ، وهذا الأمر في الصفات ، ومن ثمرات التنزيه الكشفي نفي السوى مع بقاء الحكم العددي ، دون فرض نقص يسلب أو تعقل كمال يضاف إلى الحق بإثبات مثبت والسلام .
نصّ شريف : كينونة كل شيء في شيء إنما يكون بحسب المحل ، وسواء كان المحل معنويّا أو صوريّا ، ولهذا وصفت المعلومات الممكنة من حيث ثبوت تعيّنها في علم الحق ، وارتسامها فيه بالقدم ، كما أن كل متعين في علم الحق من وجه آخر لا يخلو عن حكم الحدوث ؛ لأن وجود العالم وعلوم أهله حادثان منفعلان ، بخلاف وجود الحق وعلمه ، فاعلم ذلك ترشد إن شاء اللّه .
نصّ شريف من أشرف النصوص وأجلّها وأجمعها لكليات أصول المعرفة الإلهية والكونية : اعلم أن إطلاق اسم الذات لا يصدق على الحق إلا باعتبار تعيّنه ، التعيّن الذي يلي في تعقل الخلق غير الكمل الإطلاق المجهول النعت العديم الاسم ، وأنه وصف سلبيّ للذات ، فإنه مفروض الامتياز عن كل تعين ، وإنما الأمر الثبوتي الواقع هو التعيّن الأول ، وأنه بالذات مشتمل على الأسماء الذاتية التي هي مفاتيح الغيب ، ومسمّى الذات لا يغاير أسماؤها بوجه ما .
وأما الأسماء فتتغاير ويضاد بعضها بعضا ، ويتحد أيضا بعضها مع البعض من حيث الذات الشاملة لجميعها .
والأحدية وصف التعين لا وصف المطلق المعين ؛ إذ لا اسم للمطلق ولا وصف .
ومن حيثية هذه الأسماء باعتبار عدم مغايرة الذات لها نقول : إن الحق مؤثر بالذات فافهم .
وللذات لازم واحد فحسب ، لا يغايرها إلا مغايرة نسبية ، وذلك اللازم هو العلم .
والوحدانية ثابتة للحق من حيث العلم ، فإن فيه وبه يتعيّن مرتبة الإلهية وغيرها من المراتب والمعلومات ؛ لارتسام الجميع فيه ، وهو مرآة الذات من حيث اشتمالها على الأسماء الذاتية التي لا يغايرها الذات بوجه ما ، كما مرّ ،
وهو أعني العلم محتد الكثرة المعنوية ومشرعها ، وإنما قلت أن العلم كالمرآة للمعلومات وللذات أيضا مع أسمائها الذاتية من
أجل أنه باعتبار امتياز العلم عن الذات الامتياز الاعتباري ، تعقل تعين الحق في تعقله نفسه في نفسه ، فعلمه الذاتي كالمرآة له .
ولهذا قلنا في غير هذا الموضع أن حقيقة الحق عبارة عن صورة علمه بنفسه ، ونبّهنا أيضا على أن كل ظاهر في مظهر ، فإنه يغاير المظهر من وجه أو وجوه إلا الحق ، فإن له أن يكون عين الظاهر وعين المظهر فتذكّر .
وأما المراتب فعبارة عن تعيّنات كلية ، يشتمل عليها اللازم الواحد الذاتي الذي هو العلم ، وهو كالمحال لما يمر عليها من مطلق فيض الصادر عن الذات ، باعتبار عدم مغايرة الفيض للمفيض ، كما سبق التنبيه عليه في شأن مظهرية الحق وظاهريته ، ولها مدخل في حقيقة التأثير لا مطلقا ، بل من حيث ما قلت أنها كالمحال .
فكل مرتبة مجلى معنوي لجملة من أحكام الوجوب والإمكان المتفرعة من الأسماء الذاتية وأمهات الأسماء الإلهية ، وما يليها من الأسماء التالية ، ولها أعني للمراتب أعيان ثابتة في عرصة العلم والتعقل ، ولا أثر لها على سبيل الاستقلال بل بالوجود ، وهكذا شأن الوجود مع المراتب ، فإنها مؤثرة ظاهرة الحكم في كل ما يتصل بها ، ويتعيّن لديها بتكيفات مطلق الفيض الواصل إليها والمار عليها .
وإنها كالنهايات النسبية باعتبار سير الفيض الذاتي والتجلّي الوجودي في المنازل والدرجات المتعينة بين الأزل والأبد ، لا إلى غاية ولا إلى قرار ، فقد استبان بما ذكرته أن المراتب مجمع جمل الأحكام المستقرة لديها من حضرة الوجوب والإمكان ، وهي المظهرة لنتائج تلك الاجتماعات ، لكن بحسبها لا بحسب الأحكام ، ولا بحسب مطلق الفيض ، فحكمها حكم الأشكال والقوالب مع كل متشكل ومتقولب يتصل بها ويحل فيها ، فهذا أثرها ، فهي ثابتة العين ، وإليها يستند نتائج الأحكام وينضاف آخرا ؛ لأنها المشرع والمرجع فافهم .
ثم اعلم أن المراتب متعقلة الانتشاء بعضها من بعض ، وكذلك الأسماء ، فالألوهية بأسمائها الكلية التي هي ( الحي ، العالم ، المريد ، القادر ) ظلّ للذات من حيث اشتمالها بذاتها على مفاتيح الغيب ، لكن بين الألوهية والذات في ذلك فرق دقيق في ذوق الكمّل ، وهو أن
الألوهية تتعقّل ممتازة عن أمهات أسمائها المذكورة ، والذات لا يعقل تميزها عن أسمائها الذاتية إلا المحجوبون عن التجلّي الذاتي ، وأما أهل التجلّي الذاتي فلا يعقلون هذا النوع من التميز ، ولا يشهدونه إلا باعتبار علمهم بعلم المحجوبين ، وأما التميز عندهم في ذلك فهو بما أشرت إليه من أن الذات غير مغايرة لأسمائها الذاتية بوجه ما ، وهي تغاير بعضها بعضا مع أنه لا انفكاك ، ومع أن درجات المفاتيح متفاوتة ، فإن بعضها تابع للبعض ، كما نبّهت عليه في أسماء الألوهية من تبعية اسم : الخالق ، والبارئ ، والمصور ، أمثالها فتذكّر .
فصل في وصل : وأما سر المناسبات فهو من حيث الاشتراك في الأمر القاضي برفع أحكام المغايرة من الوجه المثبت للمناسبة ، وأولها وأعلاها المناسبة الذاتية ؛ فالمناسبة الذاتية بين الحق والإنسان الذي هو العين المقصودة ،
يثبت من وجهين :
أحدهما من جهة ضعف تأثير مرآتيته في التجلّي المتعين لديه ، بحيث لا يكسبه وصفا قادحا في تقديسه سوى قيد التعين الغير القادح في عظمة الحق وجلاله ووحدانيته ، وخلوه عن أكثر أحكام الإمكان وخواص الوسائط ، وتفاوت درجات المقرّبين والأفراد عند الحق من هذا الوجه .
وأما المناسبة مع الحق من الوجه الآخر فهو بحسب حظ العبد من صورة الحضرة الإلهية ، وذلك الحظ يتفاوت بحسب تفاوت الجمعية فيه ، فتضعف المناسبة وتقوى بحسب ضيق ، فلك جمعية ذلك الإنسان من حيث قابليته وسعتها ، فتنقص الحظوظ لذلك وتتوفر تارة لذلك .
والمستوعب لما يشتمل عليه مقام الوجوب والإمكان من الصفات والأحكام ، وما يمكن ظهوره بالفعل من ذلك في كل عصر وزمان ، مع ثبوت المناسبة أيضا من الوجه الأول له الكمال ، وهو محبوب الحق والمقصود لعينه ، فهو من حيث حقيقته التي هي برزخ البرازخ ، مرآة الذات والألوهية معا ولوازمها ، وصاحب المناسبة الذاتية من الوجه الأول محبوب مقرّب لا غير ، وقد سبق التنبيه على ذلك .
وأما المناسبة الذاتية بين الناس فتثبت من وجهين أيضا ، وهما مثالان للوجهين الإلهيين المذكورين : أحدهما من جهة اشتراك المتناسبين في المزاج ، بمعنى وقوع مزاجيهم
في درجة واحدة من درجات الاعتدالات التي يشتمل عليها مطلق عرض الأمزجة الإنسانية ، أو يكون درجة مزاج أحدهما مجاورة لدرجة مزاج الآخر ، وهذا أصل عظيم في مشرب التحقيق ، قلّ من يعرفه ذوقا ؛ لأن تعيّنات أرواح الأناس من العوالم الروحانية وتفاوت درجاتها في الشرف ، وعلو المنزلة من حيث قلة الوسائط وكثرتها ، وتضاعف وجوه الإمكان وقوتها بسبب كثرة الوسائط وقلتها وضعفها ، إنما موجبه بعد قضاء اللّه تعالى وقدره ، المزاج المستلزم لتعيّن الروح بحسبه .
فالأقرب نسبة إلى الاعتدال الحقيقي الذي يعين نفوس الكمّل في نقطة دائرته ، يستلزم قبول روح أشرف وأعلى نسبة من درجة العقول والنفوس العالية ، والأبعد عن النقطة الاعتدالية المشار إليها بالعكس من الخسة ونزول الدرجة .
فاعلم ذلك وتفهّم ما ذكرته في أمر الاشتراك المزاجي ترق به إلى معرفة المناسبة الروحانية الخصيصة بالوجه الآخر المشابه للمناسبة الذاتية الخفية الحقية المحضة .
وإذا عرفت هذا عن شهود أو فهم محقق ، رأيت أن بعض الأرواح يكون مبدأ مقامها في التعين اللوح المحفوظ ، ومبدأ تعين بعضها من روحانية العرش من مقام إسرافيل ، وبعضها من الكرسي من مقام ميكائيل ، وبعضها من السدرة من مقام جبرائيل ،
هكذا متنازلا حتى ينتهي الأمر إلى سماء الدنيا المختصّة بإسماعيل رئيس ملائكتها على جمعيهم السلام ، فتعرف حينئذ أن الشرط الأكبر الموجب لما ذكرته من تفاوت درجات أرواح الناس في ذلك بعد سابق علم اللّه وعنايته وقضائه ومشيئته ،
هو ما سبق ذكره في شأن الأمزجه وقربها من نقطة الاعتدال الحقيقي وبعدها ، وأثر العناية والمشيئة تختص بحسن التسوية الربّانية التي يليها نفخ الروح وتعينه ، فافهم وتذكّر .
وأما المناسبة المرتبية فإنها ليست من وجه واحد ، بل من وجوه متعددة : أحدها من جهة معادنها الأصلية ، التي هي مبدأ تعيّنات الأرواح المشار إليها آنفا ، فإن مبدأ تعين أعلاها درجة أعني أرواح الكمّل ، أمّ الكتاب ، ومبدأ تعين بعضها علما ووجودا متوحدا ذات القلم الأعلى المسمّى بالعقل الأول والروح الكلّي ،
ومبدأ تعين بعضها اللوح المحفوظ ، وبعضها عرشية إسرافيلية ، وبعضها مكائيلية من مقام الكرسي ورحانيته ،
وبعضها جبرئيلية من مقام سدرة المنتهى .
هكذا إلى آخر أجناس هذه الأصول الروحانية المختصّة بإسماعيل صاحب سماء الدنيا ، المعبّر عنه عند حكماء المشائيين بالعقل الفعّال ، كما مرّ .
والوجه الآخر من جهة مظاهرها المثالية ، فإن الأرواح على اختلاف مراتبها لا تخلو عند جميع المحققين عن مظاهر تتعين وتظهر بها ، وأول مظاهر أرواح الأناسي ما عدا الكمّل عالم المثال المطلق .
والصور الخيالية وإن كانت مواد انتشائها لطائف قوى هذه النشأة الطبيعية ، وجواهرها المطهّرة والمزكات المكتسية صفات الأرواح ، فإن صفاتها وأحوالها في الجنة إنما تظهر بحسب روحانيتها وقواها ، وخواص مظاهرها المثالية .
ومنازل أهل الجنة مظاهر مراتب الأرواح من حيث مكاناتها عند الحق ، ومن حيث مظاهرها المثالية الأولى ، وقد نبّه النبي صلى اللّه عليه وسلم على ذلك بإشارات لطيفة ، مثل قوله عليه السّلام : " يا علي إن قصرك في الجنة في مقابلة قصري " ، وفي رواية : " في محاذاة قصري " .
وقال في حق العباس قريبا من ذلك .
وقال في حق جمهور المؤمنين : “ لأحدكم أهدى إلى منزله في الجنة منه إلى منزله في الدّنيا “ ، وليس هذا لا من حكم المناسبة .
وأما سوق الجنة المشتمل على الصور الإنسانية المستحسنة ، التي يتخير أهل الجنة التلبّس بما شاءوا منها ، فمن بعض جداول عالم المثال المطلق الذي هو معدن المظاهر وينبوعها ، وهو مجرى المدد الواصل من عالم المثال إلى مظاهر أرواح أهل الجنة ، ومنشأ مآكلهم ومشاربهم وملابسهم ، وكل ما يتنعمون به في أراضي مراتب أعمالهم واعتقاداتهم وأخلاقهم وصفاتهم ودرجات اعتدالاتهم في ذلك كله .
وأما الخلع والتحف التي تأتي بها الملائكة من عند الحق إلى جمهور أهل الجنة حال حملهم إيّاهم إلى كثيب الرؤية ؛ لزيارة الحق ومجالسته هي مظاهر أحكام الأسماء
.....................................................................
( 1 ) رواه البيهقي في الشعب ( 1 / 304 ) ، والطبري في التفسير ( 24 / 36 ) .
والصفات ، التي يستند إليها الزائرون في نفس الأمر ، وإن لم يعلموا ذلك ، وبتلك التحف تقوى منسابتهم مع الحق ، وتحيا رقائق ارتباطاتهم به من حيث تلك الأسماء والصفات التي لها درجة الربوبية على أولئك الزائرين .
وقوله تعالى للملائكة في أواخر مجالس الزيارة عند أهل الجنة :
“ ردّوهم إلى قصورهم “ ، إشارة إلى أحكام المناسبات المستفادة من تلك الخلع والتحف ، وانتهاء أحكام الأسماء والصفات ، التي هي من حيث هي تثبت المناسبة بينهم وبين الحق ، وتوجب جمعيهتم وحضورهم عنده ، فمتى ظهرت سلطنة الأسماء والصفات التي تقابل أحكام الأسماء والصفات المقتضية للاجتماع ، ظهرت الأحكام القضائية بالامتياز ، فحصل البعد والحجاب فافهم .
وأما تفاوت مراتبهم حال المجالسة مع الحق فهو بحسب تفاوت مراتبهم في نفس الحق ، وبحسب صحة عقائدهم في اللّه ، أو علومهم ومشاهداتهم الصحيحة ، وإيثارهم فيما قبل جناب الحق على ما سواه ، وطول زمان المجالسة وقصرها ، وتفاوت الشرف فيما يخاطبون به ، وما يفهمونه من خطابه هو بحسب ما ذكرناه ، وبحسب حضورهم على ما كانوا يعلمون منه ، أو استحضارهم له بمقتضى اعتقادهم فيه ، ومناسبتهم لجنابه من حيث مقام كثيب الرؤية ، والتجلّي الخصيص بهم منه . فاعلم ذلك .
وأما حال الكمّل نفعنا اللّه بهم فيما ذكرنا وسواه ، فإنه بخلاف ذلك .
فإنهم قد تجاوزوا حضرات الأسماء والصفات والتجليات الخصيصة بها إلى عرصة التجلّي الذاتي ، فهم كما أخبر النبي صلى اللّه عليه وسلم عن شأنهم بقوله : “ صنف من أهل الجنة لا يستتر الرب عنهم ولا يحتجب “ .
وذلك أنهم غير محصورين في الجنة وغيرها من العوالم والحضرات ، كما قد أشرت إليه في غير هذا الموضع ، من أن الجنة لا تسع إنسانا كاملا ولا غير الجنة ، فهم وإن ظهروا فيما شاءوا من المظاهر فإنهم منزّهون عن الحصر والقيود ، والأمكنة والأزمنة ، كسيدهم ،
...................................................
( 1 ) رواه الحكيم الترمذي في النوادر ( 1 / 101 ) بنحوه .
بل هم معه أينما كان ، وحيث لا أين ولا حيث ولا جرم ولا بعد ولا حجاب ولا انتقال لزيارة ولا انتهاء بحكم وقت من الأوقات ، والأسماء والصفات .
فافهم واجتهد ، وتمن أن تلحق بهم ، وأن تشاركهم في بعض مراتبهم العالية ، فإن اللّه ولي الإحسان .
وأما المناسبات الثابتة بين الناس من جهة المراتب البرزخية ، فأنموذجها المنّبه على تفاصيلها لمن لم يكشفها ولم يشهدها ، هو ما ذكره النبي صلى اللّه عليه وسلم في حديث الإسراء من رؤيته آدم عليه السّلام في سماء الدنيا ، وأن على يمينه أسودة السعداء من ذريته ، وعلى يساره أسودة الأشقياء من ذريته ، وأنه إذا نظر عن يمينه ضحك ، وإذا نظر عن يساره بكى .
فهذه إشارة إلى مراتب عموم الأشقياء والسعداء ، فأهل الشقاء هم الذين لم يفتح لهم أبواب السماء حال الموت ، وهم في شقائهم على مراتب مختلفة ، فإن النبي عليه وعلى أهل بيته التحية أخبر عن أرواح بعض الأشقياء أنها تجمع في برهوت والحليتين والخاسئين والخابتين .
فمبدأ مراتب الأشقياء من مقعر السماء الدنيا التي فيها آدم ، وأنزلها ما ذكره عليه السّلام ، ومراتب عموم السعداء في البرزخ السماء الدنيا على درجات متفاوتة ، يجمعها مرتبة واحدة ،
ومراتب أهل الخصوص من السعداء ما أشار إليه صلى اللّه عليه وسلم في حديث الإسراء بعد ذكره آدم من أن عيسى عليه السّلام في الثانية ، ويوسف في الثالثة ، وإدريس في الرابعة ، وهارون في الخامسة ، وموسى في السادسة ، وإبراهيم في السابعة ، على جميعهم السلام .
وهكذا شأن مشاركي هؤلاء الأنبياء ، والوارثين لهم تماما متفاوت المراتب في هذه السماوات ، فإن هذه الأخبار من الرسول صلى اللّه عليه وسلم هو باعتبار ما شاهده في إحدى إسرائه ، فإنه ثبت أن النبي صلى اللّه عليه وسلم حصل له أربع وثلاثون معراجا ، رواها وجمعها وأثبت رواياتها أبو نعيم الحافظ الأصبهاني رحمة اللّه عليه .
وكيف ينحصر هذا الحال مع هؤلاء الأنبياء السبعة دون غيرهم ، ومن البين أن الرسل والأنبياء كثيرون ، وفيهم الكمّل بتعريف اللّه ، كداود عليه السّلام المنصوص على خلافته ، وغيره من أكابر الأنبياء والمرسلين ، فأين تتعين مراتبهم البرزخية بعد الموت ، وما ثمّ إل
العالم الأعلى والأسفل .
وعالم السفلى محل تعيّنات مراتب الأشقياء على اختلافهم ، فتعيّن أن يكون طبقات تعينات مراتب الأنبياء والمرسلين والكمّل من ورثتهم .
وأهل الخصوص من السعداء بعد الموت وقبل الحشر في الحضرات السماوية ، وأن موجب ما ذكره عليه وعلى آله السلام هو ما سبقت الإشارة إليه ، فهو كالأنموذج لما لم يتعين ذكره فافهم .
فهذه الرواية الخاصة من النبي صلى اللّه عليه وسلم لهؤلاء السبعة إنما موجبها حالتئذ مناسبة صفاتية أو فعلية أو حالية لا غير ، كالأمر في شأن يحيى عليه السّلام من أن يكون تارة مع عيسى عليه السّلام .
وتارة مع هارون عليه السّلام وليس ذلك إلّا من مقتضى مشاركته لهما ، على جميعهم السلام . فتدبر ترشد إن شاء اللّه تعالى .
نصّ شريف جدّا : اعلم أن الحق هو الوجود المحض لا اختلاف فيه ، وأنه واحد وحدة حقيقية ، لا يتعقل في مقابلة كثرة ، ولا يتوقف تحققها في نفسها ، ولا تصورها في العلم الصحيح المحقق على تصور ضد لها ، بل هي لنفسها ثابتة مثبتة لا مثبتة .
وقولنا : وحدة للتنزيه والتفهيم لا للدلالة على مفهوم الوحدة على نحو ما هو متصور في الأذهان المحجوبة .
وإذا عرفت هذا فنقول : إنه سبحانه من حيث اعتبار وحدته المنبه عليها ، وتجرده عن المظاهر ، وعن الأوصاف المضافة إليه من حيث المظاهر ، وظهوره فيها لا يدرك ، ولا يحاط به ، ولا يعرف ، ولا ينعت ، ولا يوصف .
وكل ما يدرك في الأعيان ، ويشهد من الأكوان بأي وجه كان أدركه الإنسان ، وفي أي حضرة حصل الشهود ، ما عدا الإدراك المتعلق بالمعاني المجردة والحقائق في حضرة غيبها بطريق الكشف ، ولذلك قلت في الأعيان : أي ما أدرك في مظهر ما كان ، فإنما ذلك
..........................................................
( 1 ) وقع في الأصل : ومن كلامه قدس روحه وهو نص ملحق ولكن هكذا وجدت النسخة التي كتبت منها وهي بخط بعض الأفاضل .
المدرك ألوان وأضواء ، وسطوح مختلفة الكيفية متفاوتة الكمية ، تظهر أمثلتها في عالم المثال المتصل بنشأة الإنسان ، أو المنفصل عنه من وجه على نحو ما هو في الخارج ، أو ما مفرداته في الخارج وكثرة الجميع محسوسة ، والأحدية فيها معقولة أو محدوسة ، وكل ذلك أحكام الوجود ، أو قل صور نسب علمه ، أو صفات لازمة له من حيث اقترانه بكل عين موجودة بسر ظهوره ، فيظهر فيها وبها ولها بحسبها كيف شئت ، وأطلقت ليس هو الوجود .
فإن الوجود واحد ، ولا يدرك بسواه من حيث ما يغايره على ما مرّ من أن الواحد من كونه واحدا لا يدرك بالكثير من حيث هو كثير وبالعكس .
ولم يصح الإدراك للإنسان من كونه واحدا وحدة حقيقية كوحدة الوجود ، بل إنما صحّ له ذلك من كونه حقيقة متصفة بالوجود والحياة وقيام العلم به ، وثبوت المناسبة بينه وبين ما يروم إدراكه ، وارتفاع الموانع العائقة عن الإدراك ، فما أدرك ما أدركه إلا من حيث كثرته ، لا من حيث أحديته ، فتعذّر إدراكه من حيث هو ما لا كثرة فيه أصلا لما مرّ .
ولهذه النكتة أسرار نفيسة ذكرتها بتفصيل أكثر من هذا في كتابي المسمّى ب “ كشف سر الغيرة عن سر الحيرة “ .
وسيرد أيضا في داخل الكتاب ما يزيد بيان لما ذكرناه وأصّلناه إن شاء اللّه تعالى .
ثم نرجع إلى تمام ما كنا بسبيله فنقول :
الوجود في حق الحق عين ذاته فيما عداه أمر زائد على حقيقته ، وحقيقة كل موجود عبارة عن نسبة تعينة في علم ربه أزلا ، ويسمّى باصطلاح المحققين من أهل اللّه تعالى عينا ثابتة ، وباصطلاح غيرهم : ماهية ، والمعلوم المعدوم والشيء الثابت ونحو ذلك .
والحق سبحانه من حيث وحدة وجوده لم يصدر عنه إلا واحد ؛ لاستحالة إظهار الواحد وإيجاده من حيث كونه واحدا ، ما هو أكثر من واحد ، لكن ذلك الواحد عندنا هو الوجود العام المفاض على أعيان المكونات ، ما وجد منها وما لم يوجد مما سبق العلم بوجوده ، وهذا الوجود مشترك بين القلم الأعلى الذي هو أول موجود ، المسمّى أيضا بالعقل الأول ، وبين سائر الموجودات ليس كما ذكره أهل النظر من الفلاسفة ، فإنه ما ثمّ عند المحققين إلا الحق والعالم ، والعالم ليس بشيء زائد على حقائق معلومة للّه تعالى كم
أشرنا إليه من قبل متصفة بالوجود ثابتا .
والحقائق من حيث معلوميتها وتعين صورها في علم الحق الذاتي الأزلي يستحيل أن تكون مجعولة ؛ لاستحالة قيام الحوادث بذات الحق سبحانه وتعالى ، واستحالة أن يكون الحق ظرفا لسواه أو مظروفا ، ولمفاسد أخر لا تخفى على المستبصرين فافهم .
ولهذا لا توصف بالجعل عند المحققين من أهل الكشف والنظر أيضا ؛ إذ المجعول هو الوجود ، فما لا وجود له لا يكون مجعولا ، ولو كان كذلك لكان للعلم القديم في تعيّن معلوماته فيه أزلا أثر مع أنها غير خارجة من العالم بها ، فإنها معدومة لأنفسها ، لا ثبوت لها إلا في نفس العالم بها .
فلو قيل بجعلها لزم إما مساوقتها للعالم بها في الوجود ، وإما أن يكون العالم بها محلّا لقبول الأثر من نفسه في نفسه ، وظرفا لغيره أيضا كما مرّ ، وكل ذلك باطل ؛ لأنه قادح في صرافة وحدته سبحانه ، وقاض بأن الوجود المفاض عرض للأشياء الموجودة لا المعدومة ، وكل ذلك محال من حيث أنه تحصل للحاصل ومن وجوه أخر ، لا حاجة إلى التطويل بذكرها فافهم .
فثبت أنها من حيث ما ذكرنا غير مجعولة ، وليس ثمة وجودان كما ذكرنا ، بل الوجود واحد ، وأنه مشترك بين سائرها ، مستفاد من الحق سبحانه وتعالى .
ثم إن هذا الوجود الواحد العارض للممكنات المخلوقة ليس بمغاير في الحقيقة للوجود الحق الباطن المجرّد عن الأعيان والمظاهر إلا بنسب واعتبارات ، كالظهور والتعيّن والتعدّد الحاصل بالاقتران وقبول حكم الاشتراك ، ونحو ذلك من النعوت التي تلحقه بواسطة التعلق بالمظاهر .
وينبوع مظاهر الوجود باعتبار اقترانه حضرة تجليه ، ومنزل تعينه وتدليه العماء الذي ذكره النبي صلى اللّه عليه وسلم ، وهو مقام التنزل الربّاني ، ومنبع الجود الذاتي الرحماني من غيب الهوية ، وحجاب عز الأنية ، وفي هذا العماء يتعين مرتبة النكاح الأول الغيبي الأزلي ، الفاتح حضرات الأسماء الإلهية بالتوجّهات الذاتية الأزلية ، وسنفك ختم مفتاح مفاتيحه عن قريب إن شاء اللّه تعالى ،
فللوجود إن فهمت اعتباران :
أحدهما : من كونه وجودا فحسب
وهو الحق ، وإنه من هذا الوجه كما سبقت الإشارة إليه لا كثرة فيه ، ولا تركيب ، ولا صفة ، ولا نعت ، ولا اسم ، ولا رسم ، ولا نسبة ، ولا حكم ، بل هو وجود بحت .
وقولنا : ( وجود ) هو للتفهيم ، لا أن ذلك الاسم حقيقي له ، بل اسمه عين صفته ، وصفته عين ذاته . وكماله نفس وجوده الذاتي الثابت له من نفسه لا من سواه ، وحياته وقدرته عين علمه ، وعلمه بالأشياء أزلا عين علمه بنفسه ، بمعنى أنه علم نفسه بنفسه ، وعلم كل شيء بنفس علمه بنفسه .
تتحد فيه المختلفات ، وتنبعث منه المتكثرات هي دون أن تحويه أو يحويها ، أو تبديه عن بطون متقدم ، أو هو بنفسه يبرزها فيبديها ، له وحدة هي محتد كل كثرة ، وبساطة هي عين كل تركيب آخر ، وأول مرة كل ما يتناقض في حق غيره فهو له على أكمل الوجوه ثابت ، وكل من نطق عنه لا به ، ونفى عنه كل أمر مشتبه وحصره في مدركه ، فهو أبكم ساكت ، وجاهل مباهت ، حتى يرى به كل ضدّ في نفس ضده ، بل عينه مع تميزه بين حقيقته وبينه .
وحدته عين كثرته ، وبساطته عين تركيبه ، وظهوره نفس بطونه ، وآخريته عين أوليته ، لا ينحصر في المفهوم من الوحدة أو الوجود ، ولا ينضبط لشاهد ولا في مشهود له أن يكون كما قال وظهر كما يريد ، دون الحصر في الإطلاق والتقييد ، له المعنى المحيط بكل حرف ، والكمال المستوعب كل وصف كل ما خفي عن المحجوبين حسنه ، مما يتوهم فيه شين ونقص ، فإنه متى كشف عن ساقه بحيث يدرك صحة انضيافه إليه ألقى فيه صورة الكمال ، ورئي أنه منصة لتجلّي الجلال أو الجمال .
سائر الأسماء والصفات عنده متكثرة في عين وحدة هي عينه ، لا يتنزه عمّا هو ثابت له ، ولا يحتجب عمّا أبداه ليكمل .
وحجابه وعزته وغناه وقدسه عبارة عن امتياز حقيقته عن كل شيء يضادها ، وعن عدم تعلقه بشيء ، أو عدم احتياجه في ثبوت وجوده له وبقائه إلى ذلك ، لا تحقق لشيء بنفسه ولا بشيء إلا به فانتبه .
لا تدركه سبحانه من هذه الحيثية العقول والأفكار ، ولا تحويه الجهات والأقطار ،
ولا تحيط بمشاهدته ومعرفته البصائر والأبصار ، ومنزّه عن القيود الصورية والمعنوية ، مقدّس عن قبول كل تقدير متعلق بكمية أو كيفية ، متعال عن الإحاطات الحدسية والفهمية والظنية والعلمية ، محتجب بكمال عزته عن جميع بريته ، الكامل منهم والناقص ، والمقبل إليه في زعمه والناكس .
جميع تنزيهات العقول من حيث أفكارها ومن حيث بصائرها أحكام سلبية ، لا تفيد معرفة حقيقية ، وهي مع ذلك دون ما يقتضيه جلاله ويستحقه قدسه وكماله ، ومنشأ تعلق علمه بالعالم من عين علمه بنفسه ، وظهور هذا التعلق بظهور نسب علمه التي هي معلوماته ، وإنما هو عالم بما لا يتناهى من حيث إحاطة علمه ، وكونه مصدرا لكل شيء ، فيعلم ذاته ولازم ذاته ، ولازم اللازم جمعا وفرادى ، وإجمالا وتفصيلا ، هكذا إلى ما لا يتناهى ، وما عينه أو علم تعين مرتبته عند شرط وسبب ، فإنه يعلمه بشرطه وسببه ، ولازمه أن سبق علمه بذلك تعينه ، وإلا فيعلمه بنفسه سبحانه ، وكيف شاء ، غير أنه لا يتجدّد له علم ، ولا يتعين في حقه أمر ينحصر فيه ولا حكم .
كماله بنفسه ، ووجوده بالفعل لا بالقوة ، وبالوجوب لا بالإمكان ، منزّه عن التغير المعلوم والحدثان ، لا تحويه المحدثات لتبديه أو تصونه ، ولا يكوّنها لحاجة إلى سواه ، ولا تكوّنه ترتبط الأشياء به من حيث ما تعين منه ، ولا يرتبط بها من حيث امتيازها بتعدّدها عنه ، فيتوقف وجودها لها عليه ، ولا يتوقف عليها ، مستغن بحقيقته عن كل شيء ، مفتقر إليه في وجوده كل شيء .
ليس بينه وبين الأشياء نسبة إلا العناية ، كما قيل ، ولا حجاب إلا الجهل والتلبيس والتخيل ؛ لغاية قربه ودنوه ، وفرط عزه وعلوه ، وعنايته في الحقيقة إفاضة نوره الوجودي على من انطبع في مرآة عينه التي هي نسب معلوميته ، واستعد لقبول حكم إيجاده ومظهريته سبحانه ،لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌمن الوجه الأول ،وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ[ الشورى : 11 ] من الوجه الثاني .
ومتى أدرك أو شوهد أو خاطب أو خوطب فمن وراء حجاب عزته في مرتبة نفسه المذكورة ، بنسبة ظاهريته وحكم تجليه في منزل تدليه من حيث اقتران وجوده العام
بالممكنات ، وشروق نوره على أعيان الموجودات ليس غير ذلك .
فهو سبحانه من حيث هذا الوجه إذا لومح تعين وجوده متقيدا بالصفات اللازمة لكل متعين من الأعيان الممكنة ، التي هي في الحقيقة نسب علمه جمعا وفرادى ، وما يتبع تلك الصفات من الأمور المسمّاه شؤونا وخواص وعوارض ، والآثار التابعة لأحكام الاسم الدهر المسمّاه أوقاتا ، والمراتب أيضا والمواطن ، فإن ذلك التعين والتشخص يسمّى خلقا وسوى ، كما ستعرف عن قريب سره إن شاء اللّه تعالى .
وينضاف إليه إذ ذاك كل وصف ، ويسمّى بكل اسم ، ويظهر بكل رسم ، ويقبل كل حكم ، ويتقيّد في كل مكان بكل رسم ، ويدرك لكل مشعر من بصر وسمع وعقل وفهم ، وغير ذلك من القوى والمدارك فاذكر .
واعلم أن ذلك بسريانه في كل شيء بنوره الذاتي المقدّس عن التجزئ والانقسام ، والحلول في الأرواح والأجسام فافهم ، ولكن كل ذلك متى أحب وكيف شاء .
وهو في كل وقت وحال القابل لهذين الحكمين الكليين المذكورين المتضادين بذاته ، لا بأمر زائد ، والجامع بين كل أمرين مختلفين من غائب وحاضر وصادر ووارد ، إذا شاء ظهر في كل صورة ، وإن لم يشأ لم ينضاف إليه صورة .
لا يقدح تعيّنه وتشخّصه بالصور ، واتصافه بصفاتها في كمال وجوده وعزه وقدسه ، ولا ينافي ظهوره في الأشياء وإظهاره وتعينه وتقيده بها وبأحكامها من حيث هي علوه وإطلاقه من القيود ، وغناه بذاته عن جميع ما وصف بالوجود ، بل هو سبحانه الجامع بين ما تماثل من الحقائق وتخالف فيتألف ، وبين ما تغاير وتباين فيختلف .
بتجليه الوجودي ظهرت الخفيات ، وتنزلت من الغيب إلى الشهادة البركات من حيث أسمائه : الباسط والمبدي ، وبارتفاع حكم تدليه تخفى وتنعدم الموجودات باسميه :
القابض والمعيد .
إنه تعالى كان محتجبا بعزه ، كان غفورا ، وإن أحب أن يعرف دنا وظهر فيما شاء كيف شاء ، فكان ودودا ، فبالمحبة يبدي من كونه محبّا وهي تبديه ، وبها من كونه محبّا ومحبوبا يعيد كل شيء في قبضته ، ومقهور تحت قوة بطشه لقوة فعله وضعف المنفعل .
ومظهر قدرته وآلة حكمته في فعله بسنته ، ومحل ظهور سر القبض والبسط والإبداء والإخفاء والغيب والشهادة والكشف والحجاب الصوري السببي ، الذي به يفعل ما ذكره لا مطلقا هو عرشه المجيد .
ولهذا قال سبحانه وتعالى مبدأ سر هذا الأمر : لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ [ ق : 37 ] ، إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ * إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ * وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ * ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ * فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ [ البروج : 12 - 16 ] .
في مرتبتي الإطلاق والتقييد ، وقوله تعالى :فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ جواب سؤال مقدار ، علم أنه يبدو من معترض محجوب .
* * *
نصّ شريف هو آخر النصوص :
اعلم أن أعظم الشبه والحجب أن التعددات الواقعة في الوجود الواحد يوجب آثار الأعيان الثابتة فيه ، فتوهم أن الأعيان ظهرت في الوجود وبالوجود ، وإنما ظهرت آثارها في الوجود ولم تظهر هي ، ولا تظهر أبدا ؛ لأنها لذاتها لا تقتضي الظهور .
ومتى أخبر محقق بغير هذا أو نسب إليها الوجود والظهور ، فإنما ذلك الإخبار بلسان بعض المراتب والأذواق النسبية : أي إنما تثبت صحتها بالنسبة إلى مقام معين أو مقامات مخصوصة دون ذوق مقام الكمال .
وأما النص الذي لا ينسخ حكمه فهو ما ذكرناه ، وهكذا كل ما ذكر في هذا الكتاب ، فإنه الحق الصريح الذي هو الأمر عليه ، وما سواه فقد يكون صحيحا مطلقا كهذا الذي ذكرنا ، وقد يكون صحيحا بالنسبة والإضافة إلى مقام ما ، كما سبقت الإشارة إليه .
ومتى وضح لك ما ذكرته في هذا النص علمت أن الظهور للوجود ، لكن بشرط التعدّد مع آثار الأعيان فيه ، وأن البطون صفة ذاتية للأعيان ، والوجود أيضا من حيث تعقل وحدته ، والأمر دائر بين ظهور وبطون لغلبة ومغلوبية ، بمعنى أنه ما نقص من الظاهر اندرج في الباطن وبالعكس ، والنسب والإضافات صور أحوال وأحكام تنشئ بين المراتب ، فيظهر بعضها بعضا ، ويخفي بعضها بعضا ، بحسب الغلبة والمغلوبية المشار إليها آنفا فافهم .
تمّ الكتاب والحمد لله وحده وصلّى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلم * * *
 |
 |