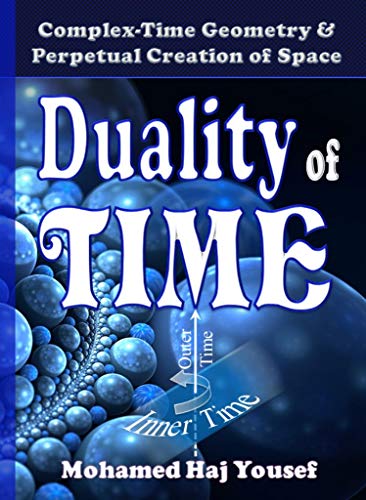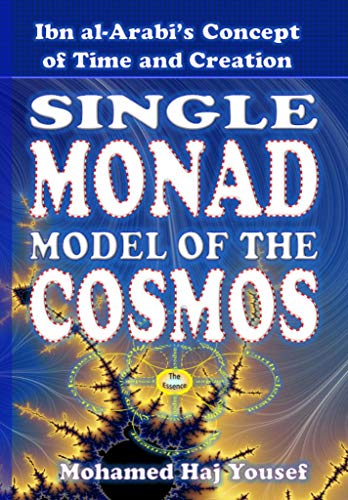المكتبة الأكبرية: القرآن الكريم: سورة الحشر: [الآية 9]
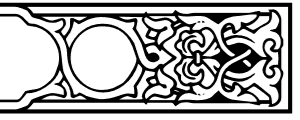 |
|
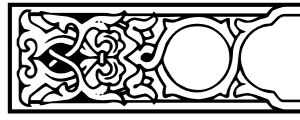 |
| سورة الحشر | ||
|
|
تفسير الجلالين:
تفسير الشيخ محي الدين:
هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (23)
لما كان وجود العالم مرتبطا بوجود الحق فعلا وصلاحية ، لهذا كان اسم الملك للّه تعالى أزلا - وإن كان عين العالم معدوما في العين - لكن معقوليته موجودة باسم المالك ، فهو مملوك للّه تعالى وجودا وتقديرا قوة وفعلا ، وقال تعالى : «هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ»
[ التوحيد الرابع والثلاثون في القرآن ، وهو توحيد النعوت : ]
بنسبة ملك السماوات والأرض إليه فإنه رب كل شيء ومليكه ، والاسم الملك هو المهيمن على الأجناد الأسمائية ، فإن أسماءه سبحانه وتعالى عساكره ، وهي التي يسلطها على من يشاء ويرحم بها من يشاء «الْقُدُّوسُ» بقوله : (وَما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ)
وتنزيهه عن كل ما وصف به ، فتقدست الألوهة أي تنزهت أن تدرك وفي منزلتها أن تشرك ، والقدوس من القدس وهي الطهارة الذاتية ، كتقديس الحضرة الإلهية التي أعطيها الاسم القدوس ، فهو اسم إلهي منه سرت الطهارة في الطهارات كلها ،
وهو قدوس مطهر من الأسماء النواقص ، وهي التي لا تتم إلا بصلة وعائد ، فإن من أسمائه سبحانه الذي وما ، فهو القدوس أي المطهر عن نسبة الأسماء النواقص إليه ، وهو قدوس عن تغيره في نفسه بتغير الأحكام- إشارة
- اعلم أن الاسم القدوس يصحب الموجودات وبه ثبت قوله تعالى : (وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ) فلا ينبغي أن يحال بين العبد وسيده ، ولا يدخل بين العبد وسيده إلا بخير ، ولا شك أن النجاسة أمر عرضي عيّنه حكم شرعي ، والطهارة أمر ذاتي ، فلا أصل للنجاسة في الأعيان،
إذ الأعيان طاهرة بالأصل ، فما في الوجود بحكم الحقيقة إلا طاهر . «السَّلامُ» بسلامته من كل ما نسب إليه مما كره من عباده أن ينسبوه إليه . «الْمُؤْمِنُ» هنا له وجهان : بمعنى المصدق ، وبمعنى معطي الأمان بما أعطاهم من الأمان إذا وفوا بعهده ، فهو المؤمن بما صدق عباده ، ورد في الخبر أن العبد يقول في حال من الأحوال : اللّه أكبر ، فيقول اللّه : أنا أكبر ، يقول العبد : لا إله إلا أنت ، يقول اللّه : لا إله إلا أنا ، يقول العبد :لا إله إلا اللّه له الملك وله الحمد ، يقول اللّه : لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد ، يصدق عبده ، ومن هنا كان اسمه المؤمن ، فهو مصدق الصادقين من عباده عند من لم يثبت صدقهم عنده ،
فإذا صدق المؤمن في جميع أقواله وأفعاله وأحواله وإعطاء الأمان منه لكل خائف من جهته ، فإذا صدق في ذلك كله ، صدّقه اللّه تعالى ، لأنه لا يصدق سبحانه إلا الصادق ،
ولا يصدقه تعالى إلا من اسمه المؤمن لا غير ؛ - ومن وجه آخر - لما كان الإيمان نصف صبر ونصف شكر ، واللّه هو الصبور الشكور ، فمن اسمه المؤمن شكر عباده على ما أنعموا به على الأسماء الإلهية ، بقبولهم لآثارها ، وصبر على أذى من جهله من عباده فنسب إليه ما لا يليق به ونسبوا إليه عدوا بغير علم - كما أخبرنا عنهم - فصبر على ذلك ، ولا شخص أصبر على أذى من اللّه لاقتداره على الأخذ ، فهو المؤمن الكامل في إيمانه بكمال صبره وشكره ، ومن كون الحياء من الإيمان فإنه يستحي أن يكذب ذا شيبة يوم القيامة ، فيصدقه مع كذبه ويأمر به إلى الجنة . «الْمُهَيْمِنُ» هو الشاهد على الشيء بما هو له وعليه ، فهو الشاهد على عباده بما هم فيه من جميع أحوالهم مما لهم وعليهم." الْعَزِيزُ " لغلبه من غالبه إذ هو الذي لا يغالب ، وامتناعه في علو قدسه أن يقاوم «الْجَبَّارُ» في اللسان : الملك العظيم ، وهو الجبار بما جبر عليه عباده في اضطرارهم واختيارهم ، فهم في قبضته تعالى ، فهو تعالى الجبار بما للذات من جبر في العالم بالأسماء الإلهية ، وله الجبر بالإحسان على الظاهر والباطن ، فله الجبر بطريق القهر والمغالبة على الظاهر ، وله الجبر الذاتي بالتجلي في العظمة الحاكمة على كل نفس فتذهل عن ذاتها وعزتها ، فلله قهر خفي في العالم لا يشعر به ، وهو ما جبرهم عليه في اختيارهم ، وقهر جلي وهو ما ليس فيه اختيار يحكم عليهم ، فللحق الرفعة أصلا وذلك بقوله «الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ» ولكنه لما نزل لعباده حتى ظن بعض الناس أن ذلك له حقيقة قال «الْمُتَكَبِّرُ» فهي رفعة للحق بعد نزوله إلى عباده ، لما حصل في النفوس الضعيفة من نزوله إليهم في خفي ألطافه لمن تقرب بالحد والمقدار ، من شبر وذراع وباع وهرولة وتبشيش وفرح وتعجب
وضحك وأمثال ذلك ، فكان التكبر من صفات الحق لما كان من نزوله في الصفات إلى ما يعتقده أصحاب النظر وأكثر الخلق أنه صفة المخلوق ، فلما علم ذلك منهم وهو سبحانه قد وصف لهم نفسه بتلك الصفات حتى طمعوا فيه ، وضل بها قوم عن طريق الهدى ، كما اهتدى بها قوم في طريق الحيرة ، قام لهم تعالى في صفة التكبر عن ذلك النزول ، ليعلمهم أنه وإن اشترك معهم في الاسمية فإن نسبتها إليه تعالى ليست كنسبتها إلى المخلوق ، فيكون مثل هذا تكبرا فإن نسبة التكبر محيرة ، فتحير من تحير في نسبة التكبر إلى الحق وتحقيقها أن لو علم نزول الحق لعباده - إذ ليس في قوة الممكن نيل ما يستحقه الحق من الغنى عن العالم ، وفي قوة الحق مع غناه من باب الفضل والكرم النزول لعباده - لعلمنا تلك النسبة ، فإن جهل أحد من العباد قدر هذا النزول الإلهي ، وتعاظم العبد في نفسه لنزول الحق له ، ولم يعلم أن نزول الحق لعباده ما هو لعين عباده ، وإنما ذلك لظهور أحكام أسمائه الحسنى في أعيان الممكنات ، فما علم أنه لنفسه نزل لا لخلقه ، كما قال تعالى : (وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) فما خلقهما إلا من أجله ، والخلق نزول من مقام ما يستحقه من الغنى عن العالمين ، فالمتخيل من العباد خلاف هذا وأنه تعالى ما نزل إلا لما هو المخلوق عليه من علو القدر والمنزلة ، فهذا أجهل الجاهلين ، فأعطى الحق هذا النزول أو ما توهمه الجاهل أن يتسمى الحق بالمتكبر عن هذا النزول ، ولكن بعد هذا النزول لا قبله وجودا وتقديرا لا بد من ذلك .
واعلم أن التكبر لا يكتسبه الكبير وإنما يكتسبه الأدنى في الرتبة ، فيكسب العبد الكبرياء بما هو الحق صفته ، فالكبرياء للّه لا للعبد ، فهو محمود مشكور في كبريائه وتكبره ، ويكسب الحق هذا الاسم ، فإنه تعالى ذكر عن نفسه أنه متكبر ، وذلك لنزوله تعالى إلى عباده في خلقه آدم بيديه ، وغرسه شجرة طوبى بيده ، وكونه يمينه الحجر الأسود ، وفي يد المبايع بالإمامة من الرسل في قوله : (إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبايِعُونَ اللَّهَ) ونزوله في قوله [ جعت فلم تطعمني ، وظمئت فلم تسقني ، ومرضت فلم تعدني ]وما وصف الحق به نفسه مما هو عندنا من صفات المحدثات ، فلما تحقق بهذا النزول عندنا حتى ظن أكثر المؤمنين أن هذه له صفة استحقاق ، وتأولها آخرون من المؤمنين ، فمن اعتقد أن اتصاف الحق بهذا أن المفهوم منه ما هو المفهوم من اتصاف الخلق به ، أعلم الحق هذه الطائفة خاصة أنه يتكبر عن هذا ، أي عن المفهوم الذي فهمه القاصرون من كون نسبته إليه تعالى على حد نسبته إلى المخلوق ، وبه يقول أهل الظاهر أهل الجمود منهم القاصرة أفهامهم عن استحقاق كل مستحق حقه ،
فقال عن نفسه تعالى إنه «الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ» عن هذا المفهوم وإن اتصف بما اتصف به ، فله تعالى الكبرياء من ذاته ، وله التكبر عن هذا المفهوم لا عن الاتصاف ، لأنه لو تكبر عما وصف به نفسه مما ذكرنا لكان كذبا ، والكذب في خبره محال ، فالاتصاف بما وصف به نفسه حق يعلمه أولو الألباب .
ومن كون الحق متكبرا أن يجد العبد في قلبه كبرياء الحق فلا يعصه ، فالذي اجرأ العصاة ومن اجترأ على اللّه من عباده على المخالفة ، ما وصف الحق به نفسه من العفو والمغفرة ، ونهاهم عن القنوط من رحمة اللّه ، فما عندهم رائحة من نعت التكبر الإلهي الذي هو به متكبر في قلوب عباده ، إذ لو كبر عندهم ما اجترءوا على شيء من ذلك ،
ولا حكمت عليهم هذه الأسماء التي أطمعتهم ، فإن كبرياء الحق إذا استقر في قلب عبد وهو التكبر ، من المحال أن تقع منه مخالفة لأمر الحق بوجه من الوجوه ، فالحق المتكبر إنما هو في نفس هذا الموافق الطائع عبد اللّه على الحقيقة ،
والتوحيد في هذه الآية هو التوحيد الرابع والثلاثون في القرآن ، وهو توحيد النعوت ، وهو من توحيد الهوية المحيطة ، فله النعوت كلها ، نعوت الجلال ، فإن صفات التنزيه لا تعطي الثبوت ، والأمر وجودي ثابت ، فلهذا قدم الهوية وأخرها حتى إذا جاءت نعوت السلب ، وحصلت الحيرة في قلب السامع ، منعت الهوية بإحاطتها أن يخرج السامع إلى العدم ، فيقول : فما تمّ شيء وجودي ، إذ قد خرج عن وجود العقل والحس فيلحقه بالعدم فتمنعه الهوية ، فإن الضمير لا بد أن يعود على أمر مقرر:
[سورة الحشر (59) : آية 24]
هُوَ اللَّهُ الْخالِقُ الْبارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى يُسَبِّحُ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (24)
هُوَ اللَّهُ الْخالِقُبالتقدير والإيجاد ، والخالق هنا صفة للّه موصوف للبارئ ، وعلى ذلك تؤخذ الأسماء الإلهية إذا وقعت بين اسمين إلهيين ، فالخالق صفة للّه موصوف للبارئ «الْبارِئُ» بما أوجده من مولدات الأركان «الْمُصَوِّرُ» بما فتح في الهباء من الصور ، وفي أعين المتجلى لهم من صور التجلي المنسوبة إليه ، ما نكر منها وما عرف ، وما أحيط بها وما لم يدخل تحت إحاطة . «لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى» وهي تسعة وتسعون اسما ، مائة إلا واحد ، وكل اسم واحد مدلوله ليس مدلول عين الاسم الآخر ، وإن كان المسمى بالكل واحدا ،
فهذه أحدية المجموع وآحاده ، فما ثمّ جمع يقتضي هذا الحكم وهو أن يكون إلها إلا هذا المسمى بهذه الأسماء الحسنى المختلفة المعاني ، التي افتقر إليها الممكن في وجود عينه . «يُسَبِّحُ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ» ولم يقل . «وَما فِي الْأَرْضِ» لأن كثيرا من الناس في الأرض لا يسبحون اللّه ، وممن يسبح اللّه منهم ما يسبحه في كل حال ، والأرض تسبحه في كل حال ، والسماوات وما فيها من الملائكة والأرواح المفارقة تسبحه كما قال (يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ لا يَفْتُرُونَ) فراعى هنا من يدوم تسبيحه وهو الأرض ، كما راعى في موطن آخر من القرآن تسبيح من في الأرض وإن كان البعض من العالم ،
فقال عزّ من قائل (تُسَبِّحُ لَهُ السَّماواتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ)
بجمع من يعقل ، ثم أكد ذلك بقوله (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ)
وزاد في التأكيد بقوله (وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ) فأتى بلفظة من ولم يأت بما ، وأتى هنا بما ولم يأت بمن ، فإن سيبويه يقول : إن اسم ما يقع على كل شيء ؛ إلا أنه لم يعم الموجودات . واعلم أن حضرة التصوير هي آخر حضرة الخلق وليس وراءها حضرة للخلق جملة واحدة ، فهي المنتهى والعلم أولها ، والهوية هي المنعوتة بهذا كله ، أعني الهوية فابتدأ بقوله «هُوَ» لأن الهوية لا بد منها ، ثم ختم بها في السلب والثبوت
وهو قوله (هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) وابتدأ من الصفات بالعلم بالغيب والشهادة وختم بالمصور ، ولم يعين بعد ذلك اسما بعينه ، بل قال «لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى» ثم ذكر أن له يسبح ما في السماوات والأرض ، فإن إنشاء الصور لا يتناهى دنيا ولا آخرة ، فالإنشاء متصل دائم وإن تناهت الدنيا ، فسبحان من يجهل فلا يعلم ويعلم فلا يجهل «لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» ومن خصائص هذه السورة سورة الحشر :
جعل الرحمن آخرها *** عصمة لنا من الفتن
عصم الرحمن قارئها *** أبدا في السر والعلن
تحقيق -[ تحقيق : ما خلق اللّه تعالى الثقلين إلا بأسماء اللطف والحنان ]
اعلم أن الثقلين ما خلقهم اللّه تعالى إلا بأسماء اللطف والحنان ، والرأفة والرحمة ، والتنزل الإلهي ، فخلقهم بالاسم الرحمن ، فلما نظروا إلى الأسماء التي وجدوا عنها ما رأوا اسما إليها منها يقتضي أخذهم وعقوبتهم إن عصوا أمره ونهيه ، وتكبروا على أمره ، فلم يطيعوه وعصوه ، لأنه تعالى بالرحمة أوجدنا ، لم يوجدنا بصفة القهر ، وكذلك تأخرت المعصية فتأخر الغضب عن الرحمة في الثقلين ، فاللّه يجعل حكمهما في الآخرة كذلك ، ولو كانت بعد حين ، ألا ترى اللّه تعالى إذا ذكر أسماءه لنا يبتدي بأسماء الرحمة ويؤخر أسماء الكبرياء ،
لأنا لا نعرفها ، فإذا قدّم لنا أسماء الرحمة عرفناها وحننا إليها ، عند ذلك يتبعها أسماء الكبرياء لنأخذها بحكم التبعية ، فقال تعالى : «هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ» فهذا نعت يعم الجميع أي جميع المخلوقات ، وليس واحدته بأولى من الآخر ، ثم ابتدأ فقال «هُوَ الرَّحْمنُ» فعرفنا «الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ» لأنا عنه وجدنا ، ثم قال بعد ذلك «هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ» ابتدأ ليجعله فصلا بين «الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ» وبين «الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ» فقال «الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ» وهذا كله من نعوت الرحمن ، ثم جاء وقال «الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ» فقبلنا هذه النعوت بعد أن آنسنا بأسماء اللطف والحنان وأسماء الاشتراك التي لها وجه إلى الرحمة ، ووجه إلى الكبرياء وهو «اللَّهُ» و «الْمَلِكُ» فلما جاء بأسماء العظمة والمحل قد تأنس بترادف الأسماء الكثيرة الموجبة الرحمة ، قبلنا أسماء العظمة لما رأينا أسماء الرحمة قد قبلتها حيث كانت نعوتا لها ، فقبلناها ضمنا تبعا لأسمائنا ، ثم إنه لما علم الخالق أن صاحب القلب والعلم باللّه وبمواقع خطابه إذا سمع مثل أسماء العظمة لا بد أن تؤثر فيه أثر خوف وقبض ، نعتها بعد ذلك وأردفها بأسماء لا تختص بالرحمة على الإطلاق ، ولا تعرى عن العظمة على الإطلاق فقال : «هُوَ اللَّهُ الْخالِقُ الْبارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى» وهذا كله تعليم من اللّه عباده وتنزل إليهم ، ولهذا قدّم سبحانه في كتابه بسم اللّه الرحمن الرحيم في كل سورة إذ كانت تحوي على أمور مخوفة تطلب أسماء العظمة والاقتدار ، فقدم أسماء الرحمة تأنيسا وبشرى ، وما طلب اللّه تعالى من عباده في حقه إلا أن يعلموا أنه إله واحد لا شريك له وبشرى ، وما طلب اللّه تعالى من عباده في حقه إلا أن يعلموا أنه إله واحد لا شريك له في ألوهته لا غير ، وأن له الأسماء الحسنى بما هي عليه من المعاني في اللسان ، وقرن النجاة والسعادة بمن وقف عندما جاء من عنده عزّ وجل في كتبه وعلى ألسنة رسله «لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» .
(60) سورة الممتحنة مدنيّة
------------
(23) الفتوحات ج 1 / 183 - ج 4 / 322 - ج 2 / 42 - ج 1 / 51 - ج 2 / 109 - ج 4 / 201 ، 202 - ج 1 / 707 ، 382 ، 707 - ج 4 / 322 - ج 3 / 218 - ج 4 / 322 - ج 2 / 92 - ج 1 / 455 - ج 2 / 92 - ج 1 / 597 - ج 4 / 262 ، 205 ، 322 - ج 1 / 98 - ج 4 / 209 ، 208 - ج 3 / 229 - ج 4 / 209 ، 226 ، 322 ، 91 ، 42 ، 209 - ج 2 / 420تفسير ابن كثير:
ثم قال تعالى مادحا للأنصار ، ومبينا فضلهم ، وشرفهم ، وكرمهم ، وعدم حسدهم ، وإيثارهم مع الحاجة ، فقال : ( والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم ) أي : سكنوا دار الهجرة من قبل المهاجرين وآمنوا قبل كثير منهم .
قال عمر : وأوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ، ويحفظ لهم كرامتهم . وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبل ، أن يقبل من محسنهم ، وأن يعفو عن مسيئهم . رواه البخاري ها هنا أيضا .
وقوله : ( يحبون من هاجر إليهم ) أي : من كرمهم وشرف أنفسهم ، يحبون المهاجرين ويواسونهم بأموالهم .
قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد ، حدثنا حميد ، عن أنس ، قال : قال المهاجرون : يا رسول الله ، ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ، ولا أحسن بذلا في كثير ، لقد كفونا المؤنة ، وأشركونا في المهنإ ، حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله ! قال : " لا ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم " .
لم أره في الكتب من هذا الوجه .
وقال البخاري : حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، سمع أنس بن مالك حين خرج معه إلى الوليد قال : دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - الأنصار أن يقطع لهم البحرين ، قالوا : لا إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها . قال : " إما لا فاصبروا حتى تلقوني ، فإنه سيصيبكم بعدي أثرة " .
تفرد به البخاري من هذا الوجه
قال البخاري : حدثنا الحكم بن نافع ، أخبرنا شعيب ، حدثنا أبو الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال : قالت الأنصار : اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل . قال : لا . فقالوا : تكفونا المؤنة ونشرككم في الثمرة ؟ قالوا : سمعنا وأطعنا . تفرد به دون مسلم .
( ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ) أي : ولا يجدون في أنفسهم حسدا للمهاجرين فيما فضلهم الله به من المنزلة والشرف ، والتقديم في الذكر والرتبة .
قال : الحسن البصري : ( ولا يجدون في صدورهم حاجة ) يعني : الحسد .
( مما أوتوا ) قال قتادة : يعني فيما أعطى إخوانهم . وكذا قال ابن زيد . ومما يستدل به على هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد حيث قال : حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا معمر ، عن الزهري ، عن أنس قال : كنا جلوسا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة " . فطلع رجل من الأنصار تنظف لحيته من وضوئه ، قد تعلق نعليه بيده الشمال ، فلما كان الغد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل ذلك ، فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى . فلما كان اليوم الثالث قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل مقالته أيضا ، فطلع ذلك الرجل على مثل حالته الأولى فلما قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص ، فقال : إني لاحيت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثا ، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت . قال : نعم . قال أنس : فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الثلاث الليالي فلم يره يقوم من الليل شيئا ، غير أنه إذا تعار تقلب على فراشه ، ذكر الله وكبر ، حتى يقوم لصلاة الفجر . قال عبد الله : غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا ، فلما مضت الثلاث ليال وكدت أن أحتقر عمله ، قلت : يا عبد الله ، لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر ولكن سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول لك ثلاث مرار : يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة " . فطلعت أنت الثلاث المرار فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به ، فلم أرك تعمل كثير عمل ، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ قال : ما هو إلا ما رأيت . فلما وليت دعاني فقال : ما هو إلا ما رأيت ، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه . قال عبد الله : هذه التي بلغت بك ، وهي التي لا تطاق .
ورواه النسائي في اليوم والليلة ، عن سويد بن نصر ، عن ابن المبارك ، عن معمر به ، وهذا إسناد صحيح على شرط الصحيحين ، لكن رواه عقيل ، وغيره ، عن الزهري ، عن رجل ، عن أنس . فالله أعلم .
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله : ( ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ) يعني ( مما أوتوا ) المهاجرون . قال : وتكلم في أموال بني النضير بعض من تكلم من الأنصار ، فعاتبهم الله في ذلك ، فقال : ( وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ) قال : وقال رسول الله : " إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم " . فقالوا : أموالنا بيننا قطائع . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أو غير ذلك ؟ " . قالوا : وما ذاك يا رسول الله ؟ قال : " هم قوم لا يعرفون العمل ، فتكفونهم وتقاسمونهم الثمر " . فقالوا : نعم يا رسول الله
وقوله : ( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ) يعني : حاجة ، أي : يقدمون المحاويج على حاجة أنفسهم ، ويبدءون بالناس قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك .
وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " أفضل الصدقة جهد المقل " . وهذا المقام أعلى من حال الذين وصف الله بقوله : ( ويطعمون الطعام على حبه ) [ الإنسان : 8 ] . وقوله : ( وآتى المال على حبه ) [ البقرة : 177 ] .
فإن هؤلاء يتصدقون وهم يحبون ما تصدقوا به ، وقد لا يكون لهم حاجة إليه ولا ضرورة به ، وهؤلاء آثروا على أنفسهم مع خصاصتهم وحاجتهم إلى ما أنفقوه . ومن هذا المقام تصدق الصديق رضي الله عنه ، بجميع ماله ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ما أبقيت لأهلك ؟ " . فقال : أبقيت لهم الله ورسوله . وهذا الماء الذي عرض على عكرمة وأصحابه يوم اليرموك ، فكل منهم يأمر بدفعه إلى صاحبه ، وهو جريح مثقل أحوج ما يكون إلى الماء ، فرده الآخر إلى الثالث ، فما وصل إلى الثالث حتى ماتوا عن آخرهم ولم يشربه أحد منهم ، رضي الله عنهم وأرضاهم .
وقال البخاري : حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير ، حدثنا أبو أسامة ، حدثنا فضيل بن غزوان ، حدثنا أبو حازم الأشجعي ، عن أبي هريرة قال : أتى رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ، أصابني الجهد ، فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " ألا رجل يضيف هذا الليلة ، رحمه الله ؟ " . فقام رجل من الأنصار فقال : أنا يا رسول الله . فذهب إلى أهله فقال لامرأته : ضيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تدخريه شيئا . فقالت : والله ما عندي إلا قوت الصبية . قال : فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالي فأطفئي السراج ونطوي بطوننا الليلة . ففعلت ، ثم غدا الرجل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " لقد عجب الله - عز وجل - أو : ضحك من فلان وفلانة " . وأنزل الله عز وجل : ( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ) .
وكذا رواه البخاري في موضع آخر ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي من طرق ، عن فضيل بن غزوان به نحوه . وفي رواية لمسلم تسمية هذا الأنصاري بأبي طلحة ، رضي الله عنه .
وقوله : ( ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ) أي : من سلم من الشح فقد أفلح وأنجح .
قال أحمد : حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا داود بن قيس الفراء ، عن عبيد الله بن مقسم ، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " إياكم والظلم ، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ، واتقوا الشح ، فإن الشح أهلك من كان قبلكم ، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم " .
انفرد بإخراجه مسلم فرواه عن القعنبي ، عن داود بن قيس به . .
وقال الأعمش ، وشعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن الحارث ، عن زهير بن الأقمر ، عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " اتقوا الظلم ; فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ، واتقوا الفحش ، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش ، وإياكم والشح ; فإنه أهلك من كان قبلكم ، أمرهم بالظلم فظلموا ، وأمرهم بالفجور ففجروا ، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا " .
ورواه أحمد ، وأبو داود من طريق شعبة ، والنسائي من طريق الأعمش كلاهما عن عمرو بن مرة به .
وقال الليث عن يزيد بن الهاد ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن صفوان بن أبي يزيد ، عن القعقاع بن اللجلاج ، عن أبي هريرة ، أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا ، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا " .
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا عبدة بن سليمان ، أخبرنا ابن المبارك ، حدثنا المسعودي ، عن جامع بن شداد ، عن الأسود بن هلال قال : جاء رجل إلى عبد الله فقال : يا أبا عبد الرحمن ، إني أخاف أن أكون قد هلكت فقال له عبد الله : وما ذاك ؟ قال : سمعت الله يقول : ( ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ) وأنا رجل شحيح ، لا أكاد أن أخرج من يدي شيئا ! فقال عبد الله : ليس ذلك بالشح الذي ذكر الله في القرآن ، إنما الشح الذي ذكر الله في القرآن أن تأكل مال أخيك ظلما ، ولكن ذلك البخل ، وبئس الشيء البخل "
وقال سفيان الثوري ، عن طارق بن عبد الرحمن ، عن سعيد بن جبير ، عن أبي الهياج الأسدي قال : كنت أطوف بالبيت ، فرأيت رجلا يقول : اللهم قني شح نفسي " . لا يزيد على ذلك ، فقلت له ، فقال : إني إذا وقيت شح نفسي لم أسرق ولم أزن ولم أفعل " ، وإذا الرجل عبد الرحمن بن عوف ، رضي الله عنه ، رواه ابن جرير
وقال ابن جرير : حدثني محمد بن إسحاق ، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ، حدثنا إسماعيل بن عياش ، حدثنا مجمع بن جارية الأنصاري ، عن عمه يزيد بن جارية ، عن أنس بن مالك ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " بريء من الشح من أدى الزكاة ، وقرى الضيف ، وأعطى في النائبة " .
تفسير الطبري :
التفسير الميسّر:
تفسير السعدي
وبين أنصار وهم الأوس والخزرج الذين آمنوا بالله ورسوله طوعا ومحبة واختيارا، وآووا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنعوه من الأحمر والأسود، وتبوأوا دار الهجرة والإيمان حتى صارت موئلا ومرجعا يرجع إليه المؤمنون، ويلجأ إليه المهاجرون، ويسكن بحماه المسلمون إذ كانت البلدان كلها بلدان حرب وشرك وشر، فلم يزل أنصار الدين تأوي إلى الأنصار، حتى انتشر الإسلام وقوي، وجعل يزيد شيئا شيئا فشيئا، وينمو قليلا قليلا، حتى فتحوا القلوب بالعلم والإيمان والقرآن، والبلدان بالسيف والسنان.
الذين من جملة أوصافهم الجميلة أنهم { يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ } وهذا لمحبتهم لله ولرسوله، أحبوا أحبابه، وأحبوا من نصر دينه.
{ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا } أي: لا يحسدون المهاجرين على ما آتاهم الله من فضله وخصهم به من الفضائل والمناقب التي هم أهلها، وهذا يدل على سلامة صدورهم، وانتفاء الغل والحقد والحسد عنها.
ويدل ذلك على أن المهاجرين، أفضل من الأنصار، لأن الله قدمهم بالذكر، وأخبر أن الأنصار لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، فدل على أن الله تعالى آتاهم ما لم يؤت الأنصار ولا غيرهم، ولأنهم جمعوا بين النصرة والهجرة.
وقوله: { وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ } أي: ومن أوصاف الأنصار التي فاقوا بها غيرهم، وتميزوا بها على من سواهم، الإيثار، وهو أكمل أنواع الجود، وهو الإيثار بمحاب النفس من الأموال وغيرها، وبذلها للغير مع الحاجة إليها، بل مع الضرورة والخصاصة، وهذا لا يكون إلا من خلق زكي، ومحبة لله تعالى مقدمة على محبة شهوات النفس ولذاتها، ومن ذلك قصة الأنصاري الذي نزلت الآية بسببه، حين آثر ضيفه بطعامه وطعام أهله وأولاده وباتوا جياعا، والإيثار عكس الأثرة، فالإيثار محمود، والأثرة مذمومة، لأنها من خصال البخل والشح، ومن رزق الإيثار فقد وقي شح نفسه { وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } ووقاية شح النفس، يشمل وقايتها الشح، في جميع ما أمر به، فإنه إذا وقي العبد شح نفسه، سمحت نفسه بأوامر الله ورسوله، ففعلها طائعا منقادا، منشرحا بها صدره، وسمحت نفسه بترك ما نهى الله عنه، وإن كان محبوبا للنفس، تدعو إليه، وتطلع إليه، وسمحت نفسه ببذل الأموال في سبيل الله وابتغاء مرضاته، وبذلك يحصل الفلاح والفوز، بخلاف من لم يوق شح نفسه، بل ابتلي بالشح بالخير، الذي هو أصل الشر ومادته، فهذان الصنفان، الفاضلان الزكيان هم الصحابة الكرام والأئمة الأعلام، الذين حازوا من السوابق والفضائل والمناقب ما سبقوا به من بعدهم، وأدركوا به من قبلهم، فصاروا أعيان المؤمنين، وسادات المسلمين، وقادات المتقين
تفسير البغوي
( والذين تبوءوا الدار والإيمان ) الأنصار تبوءوا الدار توطنوا الدار أي : المدينة اتخذوها دار الهجرة والإيمان ( من قبلهم ) أي أسلموا في ديارهم وآثروا الإيمان وابتنوا المساجد قبل قدوم النبي - صلى الله عليه وسلم - بسنتين .
ونظم الآية : والذين تبوءوا الدار من قبلهم أي من قبل قدوم المهاجرين عليهم وقد آمنوا لأن الإيمان ليس بمكان تبوء .
( يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ) حزازة وغيظا وحسدا ( مما أوتوا ) أي مما أعطى المهاجرين دونهم من الفيء وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسم أموال بني النضير بين المهاجرين ولم يعط منها الأنصار فطابت أنفس الأنصار بذلك ( ويؤثرون على أنفسهم ) أي يؤثرون على إخوانهم من المهاجرين بأموالهم ومنازلهم على أنفسهم ( ولو كان بهم خصاصة ) فاقة وحاجة إلى ما يؤثرون وذلك أنهم قاسموهم ديارهم وأموالهم :
أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستضافه فبعث إلى نسائه هل عندكن من شيء فقلن : ما معنا إلا الماء . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من يضم أو يضيف هذا ؟ فقال رجل من الأنصار : أنا يا رسول الله فانطلق به إلى امرأته فقال : أكرمي ضيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت : ما عندنا إلا قوت الصبيان فقال : هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته فجعلا يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين فلما أصبح غدا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما فأنزل الله - عز وجل - : ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون
أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قالت الأنصار : اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال : لا فقالوا : تكفونا المؤنة ونشرككم في الثمرة قالوا : سمعنا وأطعنا .
أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد سمع أنس بن مالك حين خرج معه إلى الوليد قال : دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين فقالوا : لا إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها قال : ألا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض فإنه سيصيبكم أثرة بعدي " .
وروي عن ابن عباس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم النضير للأنصار : " إن شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم وتشاركونهم في هذه الغنيمة وإن شئتم كانت لكم دياركم وأموالكم ولم يقسم لكم شيء من الغنيمة " فقالت الأنصار : بل نقسم لهم من أموالنا وديارنا ونؤثرهم بالغنيمة ولا نشاركهم فيها فأنزل الله - عز وجل - : " ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون " .
" والشح " في كلام العرب : البخل ومنع الفضل وفرق العلماء بين الشح والبخل . روي أن رجلا قال لعبد الله بن مسعود : إني أخاف أن أكون قد هلكت فقال : وما ذاك قال : أسمع الله يقول : ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وأنا رجل شحيح لا يكاد يخرج من يدي شيء فقال عبد الله : ليس ذاك بالشح الذي ذكر الله - عز وجل - في القرآن ولكن الشح أن تأكل مال أخيك ظلما ولكن ذاك البخل وبئس الشيء البخل .
وقال ابن عمر : ليس الشح أن يمنع الرجل ماله إنما الشح أن تطمح عين الرجل إلى ما ليس له وقال سعيد بن جبير : " الشح " هو أخذ الحرام ومنع الزكاة وقيل : الشح هو الحرص الشديد الذي يحمله على ارتكاب المحارم .
قال ابن زيد : من لم يأخذ شيئا نهاه الله عنه ولم يدعه الشح إلى أن يمنع شيئا من شيء أمره الله به فقد وقاه شح نفسه
أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي أخبرنا أبو سعد خلف بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي نزار حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن حزاز القهندري حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسحاق السعدي حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا القعنبي حدثنا داود بن قيس الفراء عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم "
أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا أبي وشعيب قالا أخبرنا الليث عن يزيد بن الهاد عن سهيل بن أبي صالح عن صفوان بن أبي يزيد عن القعقاع هو ابن اللجلاج عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا " .
الإعراب:
(وَالَّذِينَ) حرف عطف ومبتدأ (تَبَوَّؤُا الدَّارَ) ماض وفاعله ومفعوله والجملة صلة (وَالْإِيمانَ) مفعول به لفعل محذوف والجملة المقدرة معطوفة على تبؤوا (مِنْ قَبْلِهِمْ) متعلقان بمحذوف حال (يُحِبُّونَ) مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعله والجملة خبر الذين وجملة الذين.. معطوفة على ما قبلها، (مِنْ) مفعول به (هاجَرَ) ماض وفاعله مستتر والجملة صلة (إِلَيْهِمْ) متعلقان بالفعل (وَلا يَجِدُونَ) لا نافية ومضارع مرفوع والواو فاعله والجملة معطوفة على ما قبلها (فِي صُدُورِهِمْ) متعلقان بالفعل (حاجَةً) مفعول به (مِمَّا) متعلقان بمحذوف صفة حاجة (أُوتُوا) ماض مبني للمجهول ونائب فاعل والجملة صلة، (وَيُؤْثِرُونَ) مضارع مرفوع والواو فاعله والجملة معطوفة على ما قبلها (عَلى أَنْفُسِهِمْ) متعلقان بالفعل والواو حالية (لَوْ) وصلية (كانَ) ماض ناقص (بِهِمْ) خبر مقدم (خَصاصَةٌ) اسم كان المؤخر والجملة حال.
(وَمَنْ) شرطية مبتدأ (يُوقَ) مضارع مبني للمجهول مجزوم بحذف حرف العلة لأنه فعل الشرط ونائب الفاعل مستتر (شُحَّ نَفْسِهِ) مفعول به ثان مضاف إلى نفسه والجملة استئنافية لا محل لها.
(فَأُولئِكَ) الفاء رابطة (أولئك) مبتدأ (هُمُ) ضمير فصل (الْمُفْلِحُونَ) خبر والجملة في محل جزم جواب الشرط وجملتا الشرط والجواب خبر من.