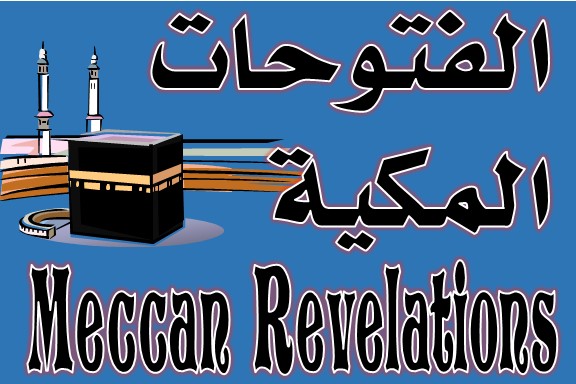المكتبة الأكبرية: القرآن الكريم: سورة الفاتحة: [الآية 1]
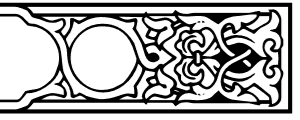 |
|
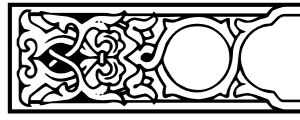 |
| سورة الفاتحة | ||
|
|
تفسير الجلالين:
تفسير الشيخ محي الدين:
1 - سورة الفاتحة هي فاتحة الكتاب ، والسبع المثاني ، والقرآن العظيم ، وأم القرآن ، وأم الكتاب ، والكافية ، وتسمى سورة الحمد ، والبسملة آية منها ، وقد قيل في الفاتحة إن اللّه أعطاها نبيه محمدا صلّى اللّه عليه وسلم خاصة دون غيره من الرسل ، من كنز من كنوز العرش ، لم توجد في كتاب منزل من عند اللّه ولا صحيفة إلا في القرآن خاصة ، وبهذا سمي قرآنا لأنه جمع بين ما نزل في الكتب والصحف وما لم ينزل ، ففيه كل ما في الكتب كلها المنزلة ، وفيه ما لم ينزل في كتاب ولا صحيفة ، وهي فاتحة الكتاب ، لأن الكتاب يتضمن الفاتحة وغيرها ، ولأنها منه ، وإنما صح لها اسم الفاتحة من حيث أنها أول ما افتتح به كتاب الوجود ، وجعلها اللّه مفتاحا له ، وهي أم القرآن لأن الأم محل الإيجاد ، والموجود فيها هو القرآن ، وهي أم الكتاب الذي عنده ، في قوله «وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ» لأن الأم هي الجامعة ، ومنها أم القرى ، والرأس أم الجسد ، يقال أم رأسه لأنه مجموع القوى الحسية والمعنوية كلها التي للإنسان ، وكانت الفاتحة أما لجميع الكتب المنزلة ، وهي القرآن العظيم ، أي المجموع العظيم الحاوي لكل شيء ، ولما كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم مبعوثا إلى الناس كافة ، والناس من آدم إلى آخر إنسان ، فجميع الرسل نوابه بلا شك ، فلما ظهر بنفسه لم يبق حكم إلا له ، ولا حاكم إلا راجع إليه ، واقتضت مرتبته أن تختص بأمر عند ظهور عينه في الدنيا ، لم يعطه أحد من نوابه ، ولا بد أن يكون ذلك الأمر من العظم بحيث أنه يتضمن جميع ما تفرق في نوابه وزيادة ، فأعطاه أم الكتاب ، فتضمنت جميع الصحف والكتب ، وظهر بها فينا مختصرة ، سبع آيات تحتوي على جميع الآيات ، فأم الكتاب ألحق اللّه بها جميع الكتب والصحف المنزلة على الأنبياء نواب محمد صلّى اللّه عليه وسلم ، فادخرها له ولهذه الأمة ، ليتميز على الأنبياء بالتقدم ، وإنه الإمام الأكبر ، وأمته التي ظهر فيها خير أمة أخرجت للناس ، لظهوره بصورته فيهم ، وهي السبع المثاني والقرآن
العظيم الصفات ، فظهرت في الوجود في واحد وواحد ، فحضرة تفرد ، وحضرة تجمع ، فمن البسملة إلى «الدين» إفراد إلهي ، ومن «اهدنا» إلى «الضالين» إفراد العبد المألوه ، وقوله «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» تشمل وما هي العطاء ، وإنما العطاء ما بعدها ، و «إياك» في الموضعين ملحق بالإفراد الإلهي ، فصحت السبع المثاني ، يقول العبد ، فيقول اللّه ، «وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ» الجمع ، وليس سوى «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ»
إشارة من اسم فاتحة الكتاب وأم الكتاب
وسميت الفاتحة الكافية ، لأن بقراءتها وحدها تصح الصلاة ، وهي قرآن من حيث ما اجتمع العبد والرب في الصلاة ، وهي فرقان من حيث ما تميز به العبد من الرب ، مما اختص به في القراءة من الصلاة ، والعبد في الفاتحة قد أبان الحق بمنزلته فيها ، وأنه لا صلاة للعبد إلا بها ، فإنها تعرفه بمنزلته من ربه ، وأنها منزلة مقسمة بين عبد ورب كما ثبت ، وتسمى الفاتحة سورة الحمد ، فإنها الجامعة للمحامد كلها ، وما أنزلت على أحد قبل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ، ولا ينبغي أن تنزل إلا على من له لواء الحمد ، فهي الجامعة للمحامد كلها فإنه سبحانه لا ينبغي أن يحمد إلا بما يشرع أن يحمد به ، من حيث ما شرعه لا من حيث ما تطلبه الصفة الحمدية من الكمال ، فذلك هو الثناء الإلهي ، ولو حمد بما تعطيه الصفة لكان حمدا عرفيا عقليا ، ولا ينبغي مثل هذا الحمد لجلاله . إشارة وتحقيق : اعلم أن الفاتحة لها طرفان وواسطة ، ومقدمتان ورابطة ، فالطرف الواحد بالحقائق الإلهية منوط ، والطرف الآخر بالحقائق الإنسانية منوط ، والواسطة تأخذ منهما على قدر ما تخبر به عنهما ، والمقدمة الواحدة سماوية ، والمقدمة الأخرى أرضية ، والرابطة لهما هوائية ، فهي الفاتحة ، للتجليات الواضحة ، وهي المثاني ، لما في الربوبية والعبودية من المعاني ، وهي الكافية ، لتضمنها البلاء والعافية ، وهي السبع المثاني ، لاختصاصها بصفات المعاني ، وهي القرآن العظيم ، لأنها تحوي صورة المحدث والقديم ، وهي أم الكتاب ، لأنها الجامعة للنعيم والعذاب - إشارة : هي فاتحة الكتاب لأن الكتاب عبارة من باب الإشارة عن المبدع الأول . وكذلك الروح ازدوج مع النفس بواسطة العقل ، فصارت النفس محل الإيجاد حسا ، فهذه النفس هو الكتاب المرقوم لنفوذ الخط ، فظهر في الابن ما خط القلم في الأم -إشارة : الأم أيضا عبارة عن وجود المثل محل الأسرار ، فهو الرق المنشور الذي أودع فيه الكتاب المسطور المودعة فيه تلك الأسرار الإلهية.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الوجه الأول : البسملة آية مستقلة ، ونقول فيها في سورة النمل إنها جزء من آية «بسم اللّه» هو اللّه من حيث هويته وذاته «الرحمن» بعموم رحمته التي وسعت كل شيء «الرحيم» بما أوجب على نفسه للتائبين من عباده ، فقدم سبحانه في كتابه العزيز «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» *في كل سورة ، إذا كانت السورة تحتوي على أمور مخوفة ، تطلب أسماء العظمة والاقتدار ، فقدم أسماء الرحمة تأنيسا وبشرى ، فإنه تعالى القائل «وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ» لهذا ليس في البسملة شيء من أسماء القهر ظاهرا ، بل هو اللّه الرحمن الرحيم وإن كان يتضمن الاسم «اللّه» القهر ، فكذلك يتضمن الرحمة ، فما فيه من أسماء الغلبة والقهر والشدة ، يقابله بما فيه من الرحمة والمغفرة والعفو والصفح ، وزنا بوزن في الاسم «اللّه» من البسملة ، ويبقى لنا فضل زائد على ما قابلنا به الأسماء في الاسم «اللّه» وهو قوله «الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» فأظهر عين «الرحمن» وعين «الرحيم» خارجا زائدا على ما في الاسم اللّه الجامع من البسملة ، فرجح ، فكأن اللّه عرفنا بما يحكمه في خلقه ، وأن الرحمة بما هي في الاسم اللّه الجامع من البسملة ، هي رحمته بالبواطن ، وبما هي ظاهرة في «الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» هي رحمته بالظواهر ، فعمت ، فعظم الرجاء للجميع ، وما من سورة من سور القرآن إلا والبسملة في أولها ، فأولناها أنها إعلام من اللّه بالمآل إلى الرحمة ، فإنه جعلها ثلاثة : الرحمة المبطونة في الاسم «اللّه» و «الرحمن» و «الرحيم» ولم يجعل للقهر سوى المبطون في الاسم «اللّه» فلا عين له موجودة في الظاهر . واعلم أن اختصاص البسملة في أول كل سورة ، تتويج الرحمة الإلهية في منشور تلك السورة ، أنها تنال كل مذكور فيها ، فإنها للسورة كالنية
من كتاب إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن:
سورة الفاتحة الترجمة عن فاتحة الكتاب «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» البسملة عندي آية من القرآن حيث ما وقعت منه إذا تكررت للفصل بين السور ، فقد تكررت قصة آدم وموسى وغيرهما وذكر الأنبياء في مواضع كثيرة من القرآن ، ولم يقل أحد أن ذلك ليس من القرآن ، وإن أسقطت في بعض الروايات كقراءة حمزة
للعمل ، فكل وعيد ، وكل صفة توجب الشقاء مذكورة في تلك السورة ،
[ البسملة فاتحة الفاتحة ]
فإن البسملة بما فيها من «الرحمن» في العموم و «الرحيم» في الخصوص ، تحكم على ما في تلك السورة من الأمور التي تعطي من قامت به الشقاء ، فيرحم اللّه ذلك العبد ، إما بالرحمة الخاصة ، وهي الواجبة ، وإما بالرحمة العامة ، وهي رحمة الامتنان ، فالمآل إلى الرحمة لأجل البسملة ، فهي بشرى.
والبسملة فاتحة الفاتحة، وهي آية أولى منها ، أو ملازمة لها ، كالعلاوة ، على الخلاف المعلوم بين العلماء ، و «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» عندنا ، خبر ابتداء مضمر ، وهو ابتداء العالم وظهوره ، لأن الأسماء الإلهية سبب وجود العالم ، وهي المسلطة عليه والمؤثرة ، فكأنه يقول : ظهور العالم بسم اللّه الرحمن الرحيم ، أي باسم اللّه الرحمن الرحيم ظهر العالم ، والبسملة التي تنفصل عنها الكائنات على الإطلاق هي بسملة الفاتحة ، لا بسملة سائر السور ، فإن بسملة سائر السور لأمور خاصة ، واختص الثلاثة الأسماء لأن الحقائق تعطي ذلك ، فاللّه هو الاسم الجامع للأسماء كلها ، والرحمن صفة عامة ، فهو رحمن الدنيا والآخرة ، بها رحم كل شيء من العالم في الدنيا ، ولما كانت الرحمة في الآخرة لا تختص إلا بقبضة السعادة ، فإنها تنفرد عن أختها ، وكانت في الدنيا ممتزجة ، يولد كافرا ، ويموت مؤمنا ، أي ينشأ كافرا في عالم الشهادة ، وبالعكس ، وتارة وتارة ، وبعض العالم تميز بإحدى القبضتين بإخبار صادق ، فجاء الاسم «الرحيم» مختصا بالدار الآخرة لكل من آمن ، وتم العالم بهذه الثلاثة الأسماء ، جملة في الاسم «اللّه» وتفصيلا في الاسمين «الرحمن
من كتاب إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن:
ابن حبيب الزيات وكإسقاط هو من سورة الحديد «1» ، والباء من بالزبر «2» ، ولم يجرح إسقاطها في قراءة من أثبتها من القرآن ، وأما في الفاتحة وفي النمل فما أحد من القراء أسقطها رأسا ، إلا بسملة الفاتحة في الصلاة ، فمنع مالك قراءتها سرا وجهرا ، في المكتوبة ، وأجازها في النافلة ، وأما الثوري وأبو حنيفة فقالا يقرؤها سرا في كل ركعة ، وقال الشافعي يقرؤها ولا بد في الجهر جهرا وفي السر سرا ، وهي عندي آية من الفاتحة وهو مذهب أبي ثور وأحمد ، ومن بعض أقوال الشافعي أن البسملة
(1) «فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ» *قرأ المدنيان وابن عامر بغير (هو) وكذلك هو في مصاحف المدينة والشام ، وقرأ الباقون بزيادة (هو) وكذلك في مصاحفهم - سورة الحديد .
(2) «بِالْبَيِّناتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتابِ» قرأ ابن عامر «وبالزبر» بزيادة باء بعد الواو والباقي بحذفها - آل عمران.
20
الرحيم» «فبسم اللّه» أي بي قام كل شيء وظهر «الرحمن» من أعربه بدلا من اللّه ، جعله ذاتا ، ومن أعربه نعتا ، جعله صفة ، وفيها بسط الرحمة على العالم «الرحيم» وبه تمت البسملة ، وبتمامها تم العالم خلقا وإبداع.
أما سورة التوبة ، فهي والأنفال سورة واحدة ، قسمها الحق على فصلين ، فإن فصلها القارئ وحكم بالفصل ، فقد سماها سورة التوبة ، أو سورة الرجعة الإلهية بالرحمة على من غضب عليه من العباد ، فما هو غضب أبد ، لكنه غضب أمد ، واللّه هو التواب ، فما قرن بالتواب إلا الرحيم ، ليئول المغضوب عليه إلى الرحمة ، أو الحكيم ، لضرب المدة في الغضب ، وحكمها فيه إلى أجل ، فيرجع عليه بعد انقضاء المدة بالرحمة ، فانظر إلى الاسم الذي نعت به «التواب» تجد حكمه كما ذكرنا ، والقرآن جامع لذكر من رضي عنه وغضب عليه ، وتتويج منازله ب «الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» والحكم للتتويج ، فإنه به يقع القبول ، وبه يعلم أنه من عند اللّه.
من كتاب إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن:
آية من كل سورة ، وبه نقول ، وأما قراءة الفاتحة في الصلاة قال تعالى «فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضى» فروي عن عمر أن الصلاة تجوز بغير قراءة ، وروي عن ابن عباس أنه لا يقرأ في صلاة السر ، وأوجب الشافعي قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة من الصلاة ، وهي أشهر الروايات عن مالك ، وروي عنه أنه إن قرأها في ركعتين من الرباعية أجزأه ، وقال الحسن البصري وكثير من فقهاء البصرة : تجوز في قراءة واحدة ، قال أبو حنيفة : يجب قراءة أي آية اتفقت في الركعتين الأوليين ، ويستحب فيما بقي من الصلاة التسبيح دون القراءة ، وبه قال الكوفيون ، وجمهور العلماء يستحبون القراءة في الصلاة كلها «بِسْمِ اللَّهِ» العامل في الباء من بسم اللّه ما في الحمد لله من معنى الفعل ، أي يضمر له فعل من لفظه ، مثل حمدته أو أحمده ، وبه تتعلق الباء من بسم اللّه ، وهكذا في كل سورة في القرآن أولها الحمد ، وفي بعض سور القرآن تكون في أولها أفعال تطلب الباء من بسم اللّه . أذكرها في موضعها أن شاء اللّه «اللّه» اسم للذات وإن كان يجري مجرى العلمية له سبحانه ، فإن المفهوم منه مع هذا بأول الإطلاق من له نعوت الألوهية من الكمال والتنزيه والجلال ، وفي طريق الاشتقاق فيه تكلف وتعسف ، وهو اسم مختلف في اشتقاقه فأضربنا عن الخوض في ذلك لقلة فائدته ، غير أن الغالب عليه أن يجري مجرى الأسماء الأعلام ، وهو اسم محفوظ من أن يسمى به غيره سبحانه على هذه الصورة الخاصة «الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» من وقف عند قوله سبحانه (قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ
والقراء في وصل البسملة على أربعة مذاهب :
المذهب الواحد لا يرونه أصلا، وهو أن يصل آخر السورة بالبسملة ويقف ويبتدئ بالسورة ، هذا لا يرتضيه أحد من القراء العلماء منهم ، وقد رأيت الأعاجم من الفرس يفعلون مثل هذا ، مما لا يرتضيه علماء الأداء من القراء .
والمذهب الحسن الذي ارتضاه الجميع، ولا أعرف لهم مخالفا من القراء ، الوقوف على آخر السورة ، ووصل البسملة بأول السورة التي يستقبلها .
والمذهبان الآخران ، وهما دون هذا من الاستحسان: أن يقطع في الجميع ، أو يصل في الجميع ، وأجمع الكل أن يبتدئ بالتعوذ والبسملة عند الابتداء بالقراءة في أول السورة ، وأجمع على قراءة البسملة في الفاتحة جماعة القراء بلا خلاف ، واختلفوا في سائر سور القرآن ، ما لم يبتدئ أحد منهم بالسورة ، فخيّر من خيّر في ذلك «كورش» ومنهم من ترك «كحمزة» ومنهم من بسمل ولم يخيّر كسائر القراء .
الجمد لله رب العالمين 2
قرئ «الحمد» بخفض الدال ، و «الحمد لله» برفع اللام اتباعا لحركة الدال ، والحمد : ثناء عام ، ما لم يقيده الناطق به بأمر ،وله ثلاث مراتب :
حمد الحمد ،
وحمد المحمود نفسه ،
وحمد غيره له ،
وما ثم مرتبة رابعة في الحمد ، ثم في الحمد بما يحمد الشيء
من كتاب إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن:
الْحُسْنى) *أجراه مجرى الاسم اللّه في العلمية ، فاتحد المدلول وهو الذات ، وهو فعلان ، وإن كان هذا اللفظ مشتقا من لفظ الرحمة وهو الأظهر ، فمعناه الذي له تعميم الرحمة في خلقه ، أي هذه النسبة إليه صحيحة ، وإن كان المرحومون معدومين ، و «الرحيم» تخصيص الرحمة بالسعداء في الدنيا بالتوفيق والهداية ، وفي الآخرة بالنجاة من العذاب وحصول النعيم ، وسيأتي ذلك في الفاتحة ، والرحمن [ نعت لعموم الرحمة بالخلق ] «*» من الاسم الرحمن ، والنعت وإن كان يأتي لرفع اللبس فقد يجاء به لمجرد المدح والثناء ، قيل لهم : اعبدوا اللّه ، لم يقولوا : وما اللّه ؟ قيل لهم : اسجدوا للرحمن ، قالوا : وما الرحمن ؟ فعلى كل وجه النعت فيه أولى ، ولا يلتفت لما قاله الطبري في ذلك ، فإنه مدخول معلول من عدم معرفة العرب بالرحمن (2) «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ» «الْحَمْدُ لِلَّهِ» بسم اللّه ، أي الثناء عليه بأسمائه الحسنى ، وهذا يدلك على أن أسماءه سبحانه تجري مجرى النعوت
(*) بياض في الأصل.
نفسه ، أو يحمده غيره ، تقسيمان : إما أن يحمده بصفة فعل ، وإما أن يحمده بصفة تنزيه ، وما ثم حمد ثالث هنا . وأما حمد الحمد له ، فهو في الحمدين بذاته ، إذ لو لم يكن لما صح أن يكون لها حمد ، ثم إن الحمد على المحمود قسمان :القسم الواحد أن يحمد بما هو عليه ، وهو الحمد الأعم ، والقسم الثاني : أن يحمد على ما يكون منه ، وهو الشكر ، وهو الأخص ، فإن النبي صلّى اللّه عليه وسلم يقول في المقام المحمود : فأحمده بمحامد لا أعلمها الآن ، وقال :
لا أحصي ثناء عليك ، لأن ما لا يتناهى لا يدخل في الوجود ، ولما كان كل عين حامدة ومحمودة في العالم كلمات الحق ، رجعت إليه عواقب الثناء ، فلا حامد إلا اللّه ، ولا محمود إلا اللّه ، وحمد الحمد صفته ، لأن الحمد صفته ، وصفته عينه ، إذ لا يتكثر ، فما في المحامد أصدق من حمد الحمد ، فإنه عين قيام الصفة به ، فلا محمود إلا من حمده الحمد ، لا من حمد نفسه ، ولا من حمده غيره ، فإذا كان عين الصفة عين الموصوف عين الواصف ، كان الحمد عين الحامد والمحمود ، وليس إلا اللّه ، فهو عين حمده ، سواء أضيف ذلك الحمد إليه أو إلى غيره ، فإن قيام الصفة بالموصوف ما فيها دعوى ، ولا يتطرق إليها احتمال ، والواصف نفسه أو غيره بصفة ما ، يفتقر إلى دليل على صدق دعواه ، فالحمد : هو الثناء على اللّه بما هو أهله ، والشكر : الثناء على اللّه بما يكون منه من النعم ، ولا يكون الثناء أبدا على اللّه إلا مقيدا إما بالنطق ، وإما بالمعنى الباعث على الحمد ، وقد يرد في النطق مطلقا ومقيدا مثل قوله تعالى في المطلق اللفظي «قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ» *وأما المقيد فتارة يقيده بصفة تنزيه كقوله تعالى «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً» وتارة يقيده بصفة فعل ، كقوله «الحمد للّه
من كتاب إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن:
لا مجرى العلمية ، لأن الأسماء الأعلام لا يكون بها الثناء ، وإنما يقع الثناء على المثنى عليه بما تدل عليه هذه الألفاظ من نعوت الجلال له سبحانه ، فبها يحمد ، فمن المفهوم الثاني من الاسم اللّه يكون الاسم اللّه ثناء عليه سبحانه ، بل أتم الثناء لجمعيته مراتب الألوهية ، ولذا علقنا الباء بما في الحمد من معنى الفعل ، يقول سبحانه الثناء للّه من حيث أنه مثني عليه سبحانه ومثن اسم فاعل واسم مفعول بجميع أوصاف الثناء ، دل على الأول اللام من للّه ، فلا حامد ولا محمود الا هو ، وكل ثناء من غيره فهو راجع إليه بما يكون منه وهو عليه ، فله عواقب الثناء كله ، وله الحمد في الأولى والآخرة في الحالتين معا ، ودل على الثاني الألف واللام لاستغراق أجناس الثناء ، فالثناء عليه سبحانه بوجهين ، بما هو عليه من نعوت الجلال وبما يكون منه من الإنعام والإحسان ، وهذا
الذي أنزل الكتاب على عبده» وقوله «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ» وما خرج حمد من محاميد الكتب المنزلة من عنده عن هذا التقسيم . الحمد للّه تملأ الميزان ، لأنه كل ما في الميزان ، فهو ثناء على اللّه وحمد للّه ، فما ملأ الميزان إلا الحمد ، فالتسبيح حمد ، وكذلك التهليل والتكبير والتمجيد والتعظيم والتوقير والتعزيز ، وأمثال ذلك كله حمد ، فالحمد للّه هو العام الذي لا أعم منه ، وكل ذكر فهو جزء منه ، كالأعضاء للإنسان ، والحمد كالإنسان بجملته ، «الحمد لله» بعد ما خلق اللّه آدم وسواه ، نفخ فيه الروح ، فاستوى قاعدا ، فعطس ، فقال «الحمد لله» فقال له الحق «يرحمك اللّه يا آدم ، لهذا خلقتك» ولهذا قال عقيب قوله «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ» «الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» فقدم الرحمة ، ثم قال «غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ» فأخر غضبه ، فسبقت الرحمة الغضب في أول افتتاح الوجود ، فسبقت الرحمة إلى آدم قبل العقوبة على أكل الشجرة ، ثم رحم بعد ذلك ، فجاءت رحمتان بينهما غضب ، فتطلب الرحمتان أن تمتزجا ، لأنهما مثلان ، فانضمت هذه إلى هذه ، فانعدم الغضب بينهما ، فإذا قال العالم «الْحَمْدُ لِلَّهِ» *أي لا حامد إلا هو ، فأحرى أن لا يكون محمودا سواه ، وتقول العامة «الْحَمْدُ لِلَّهِ» *أي لا محمود إلا اللّه ، وهي الحامدة ، فاشتركا في صورة اللفظ . «رَبِّ الْعالَمِينَ» [ اعلم أن العالم عبارة عن كل ما سوى اللّه ، وليس إلا الممكنات ، سواء وجدت أو لم توجد ، فإنها بذاتها علامة على علمنا ، أو على العلم بواجب الوجود
من كتاب إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن:
النوع الواحد يسمى شكرا ، والحمد يجمعها فمن فسر الحمد هنا بالشكر خاصة فقد قصر وما أعطى الكلمة حقها في الدلالة ، يقول العبد في الصلاة «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ» يقول اللّه حمدني عبدي ، وما قال شكرني عبدي ، فصح ما ذكرناه من عموم الثناء هنا أنه مراد ، وللّه متعلق أيضا بما في الكلام من معنى الفعل وهو كائن ومستقر . - إشارة - اللام من للّه الخافضة حرف ، فهي عبد ، إذ الحرف يدل على المعنى ، والعبد يدل على اللّه ، والهاء من للّه معمولة للام بما حصل لها من الخفض ، الحق مدلول دليل العبد ، من عرف نفسه عرف ربه ، فجعله دليلا على معرفته ، فكان العلم به معمولا للعلم بنا ، وكونه خفضا لأنه يتعالى عن أن نعرف حقه ، فلا نعلم منه إلا ما يناسبنا ولهذا نتخلق بأسمائه الحسنى التي بيدنا ، فهذا معنى الخفض لأنها معرفة نازلة عن علمه بنفسه سبحانه . قوله «رَبِّ الْعالَمِينَ» يقول مصلح العالم ، واسم العالمين هنا كل ما سوى اللّه ،
لذاته ، وهو اللّه ، فإن الإمكان حكم لها لازم في حال عدمها ووجودها ، بل هو ذاتي لها ، لأن الترجيح لها لازم ، فالمرجح لها لازم ، فالمرجح معلوم ، ولهذا سمى عالما من العلامة ، لأنه الدليل على المرجح ، فاعلم ذلك . وليس العالم في حال وجوده بشيء سوى الصور التي قبلها العماء وظهرت فيه ، فالعالم إن نظرت حقيقته إنما هو عرض زائل ، أي في حكم الزوال ، وهو قوله تعالى «كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ» وقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : أصدق بيت قالته العرب قول لبيد «ألا كل شيء ما خلا اللّه باطل» يقول ما له حقيقة يثبت عليها من نفسه ، فما هو موجود إلا بغيره ، ولذلك قال صلّى اللّه عليه وسلم أصدق بيت قالته العرب «ألا كل شيء ما خلا اللّه باطل» فالجوهر الثابت هو العماء ، وليس إلا نفس الرحمن ، والعالم جميع ما ظهر فيه من الصور ، فهي أعراض فيه ، يمكن إزالتها ، وتلك الصور هي الممكنات ، ونسبتها من العماء نسبة الصور من المرآة ، تظهر فيها لعين الرائي ، والحق تعالى هو بصر العالم ، فهو الرائي ، وهو العالم بالممكنات ، فما أدرك إلا ما علمه من صور الممكنات ، فظهر العالم بين العماء وبين رؤية الحق ، فكان ما ظهر دليلا على الرائي ، وهو الحق ، فتفطن[ دحض ما جاء في فتاوى الإمام ابن تيمية وما نسب إلى الشيخ الأكبر ابن العربي أنه يقول : إن وجود المحدث هو عين وجود القديم وأنه ينكر التمييز بين القديم والمحدث]
واعلم من أنت ] «*» . والرب لا يعقل إلا مضافا ، ولذلك ما جاء في القرآن قط مطلقا من غير إضافة وإن اختلفت إضافاته ، فتارة يضاف إلى أسماء مضمرة ، وتارة يضاف إلى الأعيان ، وتارة يضاف إلى الأحوال ، فقال تعالى «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ» لم يقل رب نفسه ، لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه ، وأثبت بقوله هذا حضرة الربوبية ، أي مربيهم ومغذيهم ،
من كتاب إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن:
والرب هو المصلح والمربي والسيد والمالك والثابت ، والعالم إذا كان مشتقا من العلامة أي هو دليل عليه ، فإصلاح الدليل أن يكون سادا لا يدخله خلل ، وإذا لم يكن مشتقا ، فهو سبحانه مصلح العالمين بما جعل فيهم من صلاح دنياهم وآخرتهم وجميع أسبابهم ، كما أنه سبحانه من هذا الاسم مغذيهم ومربيهم ، كما أنه سيدهم ومالكهم ، فهو الثابت وجوده الذي لا ينقطع ، ويكون العالم محفوظا ببقائه وثبات وجوده . - إشارة - والرب هنا أيضا معمول للام الجر ، والعالمين في موضع خفض بالإضافة لا باللام ، فإن الرب هنا هو المضاف إلى العالم ، ولما كان حرف الباء
(*) هذه الفقرة تدحض وترد ما جاء في فتاوى الإمام ابن تيمية في الصفحة رقم 239 من المجلد الحادي عشر من مجموعة فتاويه المطبوعة بالرياض عام 1382 ه ، حيث ينسب إلى الشيخ الأكبر ، أن وجود المحدث هو عين وجود القديم ، وأن الشيخ رضي اللّه عنه ينكر التمييز بين القديم والمحدث .
والعالمين عبارة عن كل ما سوى اللّه ، وهذه وصية إلهية لعباده ، لما خلقهم على صورته ، وأعطى من أعطى منهم الإمامة الكبرى والدنيا وما بينهما ، وذلك قوله صلّى اللّه عليه وسلم : كلكم راع ومسؤول عن رعيته ، وجعل هذا التحميد بين الرحمة المركبة ، فإنه تقدمه «الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» وتأخر بعده «الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» فصار العالم بين رحمتين ، فأوله مرحوم ومآله إلى الرحمة .
[ إشارة إلى معنى اسم الرب بالثابت ]
إشارة -الرب الثابت فلا يزول ، فلا تزيله «1» .
الحمد للّه رب العالمين على .... ما كان منه من الأحوال في الناس
مما يسرهمو مما يسوؤهمو ..... وكل ذلك محمول على الرأس
له الثناء له التمجيد أجمعه .... من قبل والدنا المنعوت بالناسي
عبدته وطلبت العون منه كم .... قد قال شرعا على تحرير أنفاسي
وأن يهيئ لي من أمرنا رشد ..... وأن يلين مني قلبي القاسي
حتى أكون على النهج القويم به .... خلقا كريما بإسعاد وإيناس
الرحمن الرحيم 3
"الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ " من أسماء اللّه تعالى وهو من الأسماء المركبة ، كبعلبك ورام هرمز ، فكانت تربيته تعالى للعالم باللطف والحنان والرحمة الرحمانية المؤكدة بالرحيمية ، فعم بالرحمن ، فالرحمن مبالغة في الرحمة العامة ، التي تعم الكون أجمعه ، وخص بالرحيم ، وجعل اللّه تعالى في أم الكتاب أربع رحمات : فضمن الآية الأولى من أم الكتاب وهي البسملة
من كتاب إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن:
من الرب معمولا للام للّه ، لم يكن العالم من طريق المعنى مرفوعا ، فبقي على أصله من الخفض ، فلا وجه للرفع هنا أصلا ، لفظا ومعنى ، وقد نبهتك على مأخوذ الإشارات كيف هي عند أصحابنا ، فإنها لا تجري مجرى التفسير ، ولكن تجري مجرى الدلالة ، فارجع إلى الترجمة من غير إشارة تتخللها والحمد للّه ، قوله (3) «الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» اعلم أنه مهما وقع ذكر العالم مجاورا لاسم إلهي وبين اسمين من أسماء اللّه ، فلا بد أن يكون للاسم معنى فيه ، فينبغي للمفسر أن لا يغفل عن هذا القدر ، والرحمن هو الذي وسعت رحمته كل شيء بإخراج كل شيء من العدم إلى الوجود ،
(1) لا : هنا نافية أي أنك بإزالته في زعمك فإنه لا يزول.
رحمتين ، هو قوله
[ نصيحة : الرحمن الرحيم ]
الرحمن الرحيم ، وضمن الآية الثالثة منها أيضا رحمتين ، وهما قوله الرحمن الرحيم ، فهو رحمن بالرحمتين ، العامة ، وهي رحمة الامتنان ، وهو رحيم بالرحمة الخاصة وهي الواجبة ، في قوله «فَسَأَكْتُبُها لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ» الآيات ، وقوله «كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ» وأما رحمة الامتنان فهي التي تنال من غير استحقاق بعمل ، وبرحمة الامتنان رحم اللّه من وفقه للعمل الصالح الذي أوجب له الرحمة الواجبة ، فبها ينال العاصي وأهل النار إزالة العذاب ، وإن كان مسكنهم ودارهم جهنم ، وهذه رحمة الامتنان ، فالرحمن في الدنيا والآخرة ، والرحيم اختصاص الرحمة بالآخرة - نصيحة - الزم الاسم المركب من اسمين فإن له حقا عظيما ، وهو قولك الرحمن الرحيم خاصة ، ما له اسم مركب غيره فله الأحدية ، ومن ذكره بهذا الاسم لا يشقى أبد
مالك يوم الدين 4
يريد يوم الجزاء فهو يوم الدنيا والآخرة ، فإن الحدود ما شرعت في الشرائع إلا جزاء ،
من كتاب إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن:
وبما خلق في الموجودات من الرحمة التي يتعاطفون بها بعضهم على بعض ، وذلك سار في كل حيوان ، وهي لهم من باب المنة ، ومن حكم هذه الرحمة اجترأ من اجترأ على مخالفة أوامر اللّه من المؤمنين ، فإنهم لا يقنطون من رحمة اللّه ، قال تعالى «يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً» وفي حديث الشفاعة يقول اللّه : وبقي أرحم الراحمين ، فأتى بنعت الرحمة ، ومن رحمته تلقين عبده حجته «يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ؟» ليقول له العبد : كرمك ، فيلطف به ، فلو قال : الشديد العقاب ، ذهل وتحير ، وقد يمكن أن يجري «الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» مجرى الاسم الواحد المركب ، مثل بعلبك ورام هرمز ، لما قيل في مسيلمة رحمان اليمامة ، ولم يطلق على أحد قط مجموع الاسمين ، وقد يكون الرحيم مبالغة في رحمته بعباده السعداء ، فإن رحمته قد خصها بقوله (فَسَأَكْتُبُها لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ) أي أوجبها على نفسي لهم (كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ) الآية ، فهؤلاء يأخذونها من طريق الوجوب لقيام الأسباب التي جعلها الحق موجبة لها بهم ، ومن عدا هؤلاء فينتظرونها من باب المنة ، فإن التقييد من صفة الخلق لا من صفة الحق ، حتى إن إبليس يطمع فيها من باب المنة ، إذ لا مكره له ، وإن دخلوا النار ، يقول العبد في الصلاة (الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) يقول اللّه أثنى عليّ عبدي ، فهو قولنا إن أسماءه لا تجري مجرى الأعلام . (4) «مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ» يقول : مالك يوم الجزاء ، وهو يوم الدنيا
وما أصابت المصائب من أصابته إلا جزاء بما كسبت يده ، مع كونه يعفو عن كثير ، وكذلك ما ظهر من الفتن والخراب والحروب والطاعون ، فهو كله جزاء أعمال عملها الناس ، استحقوا بذلك ما ظهر من الفساد في البر والبحر فهو جزاء في الدنيا ، فيوم الدنيا يوم الجزاء ويوم الآخرة هو يوم الجزاء ، غير أنه في الآخرة أشد وأعظم ، لأنه لا ينتج أجرا لمن أصيب وقد ينتج في الدنيا أجرا لمن أصيب وقد لا ينتج ، ومن الجزاء في الدنيا مجازاة أهل الشقاء بما عملوا من مكارم الأخلاق في الدنيا ، بما أنعم اللّه به عليهم من النعم حتى انقلبوا إلى الآخرة وقد جنوا ثمرة خيرهم في الدنيا ، فلو لم تكن الدنيا دار جزاء ما كان هذا ، فلا اختصاص ليوم الدين بيوم عند العلماء باللّه ، أقام لهم الحق في ذلك دليلا لما جهلوا «ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا» فأخبر أنه جزاء ما هو ابتداء ، فما ابتليت البرية وهي برية ، وهذه مسألة صعبة المرتقى لا تنال إلا بالإلقاء ، اختلفت فيها طائفتان كبيرتان (الأشاعرة والمعتزلة) ، فمنعت واحدة ما أجازته أخرى والرسل بما اختلفت فيه تترى ، ولا تحقق واحد ما جاء به الرسول ، ولا يسلك فيه سواء السبيل ، بل ينصر ما قام في غرضه وهو عين مرضه ، إلا الطبقة العليا فإنهم علموا الأمور في الدنيا فلم يتعدوا بالأمر مرتبته ، وأنزلوه منزلته ، فما رأوا في الدنيا أمرا إلا كان جزاء ما كان ابتداء ،
من كتاب إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن:
والآخرة ، لأنه المجازي في الدنيا والآخرة ، فأما في الآخرة فمعلوم عند الجميع ، وأما في الدنيا فبما شرع من إقامة الحدود جزاء لأعمال نص عليها ، كالزنا والسرقة والمحاربة وغير ذلك ، وبما شرع من مكافأة المحسن وشكر المنعم ، وبما أخبر عليه السلام من جزاء اللّه تعالى الكافر في الدنيا بما فعله من الخير ، وهذا يدلك على أن الكل مخاطبون بفروع الشريعة ، مؤاخذون بها مجازون عليها ، كما خوطبوا بأصولها سواء ، وأن الشرائع قد عمت جميع الخلق من آدم إلى نبينا محمد صلى اللّه عليهما ، قال تعالى : (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا) وقال (وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلا فِيها نَذِيرٌ) وقال : (وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ) ،وكل نذير من جنس من بعث إليه (وَلَوْ جَعَلْناهُ مَلَكاً لَجَعَلْناهُ رَجُلًا) و (لَوْ كانَ فِي الْأَرْضِ مَلائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ مَلَكاً رَسُولًا) يعني من جنسهم ، فالجزاء محقق في الدنيا والآخرة ، وقد قال تعالى (ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا) وجعله جزاء ، وقال : (وَما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ) وهذا هو الجزاء ، فمن خصه بيوم الآخرة فما أعطى الآية حقها ، يقول العبد في الصلاة «مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ» يقول اللّه (فوض إليّ
والملك على الحقيقة هو الحق تعالى المالك للكل ومصرفه ، وهو الشفيع لنفسه عامة وخاصة ، خاصة في الدنيا وعامة في الآخرة من وجه ما ، ولذلك قدم على قوله «مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ» الرحمن الرحيم ، لتأنس أفئدة المحجوبين عن رؤية رب العالمين ، ألا تراه يقول يوم الدين (شفعت الملائكة والنبيون وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين) ولم يقل الجبار ولا القهار ليقع التأنيس قبل وجود الفعل في قلوبهم .
إياك نعبد وإياك نستعين 5
إياك نعبد أي لك نقر بالعبودية وحدك لا شريك لك ، فقدم قول إياك نعبد وهو قول العبد المحض بذاته إياك نعبد ، فمن قالها متحققا بعبوديته فقد وفّى حق سيده ، ولم يلتفت إلى نفسه ولا إلى صورة ما خلقه اللّه عليها التي توجب له الكبرياء بل كان عبدا محضا ، ثم قال بالصورة التي خلق عليها «إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» على عبادتك ولا يطلب العون إلا من له نوع تعمّل في العمل ، فيقول وإليك نأوي في الاستعانة لا إلى غيرك ، فبهذه الآية نفى الشريك .
من كتاب إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن:
عبدي) وفي رواية (مجدني عبدي) فهو قولنا إن الدين هنا هو الجزاء في الدارين ، فإن التفويض تكليف ومحله الدنيا ، بل لا يصح أن يكون إلا فيها ، وهو أخص من (مجدني عبدي) فإن التمجيد له في الدارين ، وهو الشرف ، والتفويض من العبد لا يكون إلا هنا ، فإن الآخرة لا يصح فيها تفويض من العباد ، إذ لا دعوى هناك ، بل الأمور كلها مكشوفة للعباد أنها بيد اللّه ، ولا يفوض المفوض إلا ما له فيه تصرف ، وليس ذلك هناك ، فتأمل ، قوله (5) «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» أفرد نفسه بالكاف في الموضعين ، لأنه المعبود وحده ، ولا يعبد غيره ، والمطلوب منه ، لأنه المعين وحده بكل وجه ، يؤيد ذلك قوله (وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ) والألوهية هي المعبودة من كل معبود ، ولكن أخطئوا في النسبة فشقوا شقاوة الأبد ، وكذلك هو المعين بما يوجده ويخلقه في خلقه من أسباب المعونة ، وجمع عباده بالنون فيهما ، لأن العابدين والمستعينين كثيرون ، سواء كان العابد شخصا واحدا أو ما زاد عليه ، فإن الشخص وإن كان واحدا ، فإن كل عضو فيه ، عليه عبادة ، فصحت الكثرة في الشخص الواحد ، فلهذا له أن يأتي بنون الجماعة ، قال عليه السلام «يصبح على كل سلامي منكم صدقة» وهي العروق ، وقال تعالى (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ) لسترها عنا ، ولهذا قال في الآية : (إِنَّهُ كانَ حَلِيماً
6 - اهدنا الصراط المستقيم
قرئ الزراط بالزاي وهي لغة وقرأ ابن كثير السراط بالسين وحمزة وباقي القراء بالصاد ، والصراط الذي سألته النفس هنا هو صراط النجاة بالتوحيد والتنزيه الذي سار عليه الذين أنعمت عليهم وهو الشرع هنا ، ولا يزال العبد في كل ركعة من الصلاة يقول «اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ» لأنه أدق من الشعر وأحد من السيف ، وكذا هو علم الشريعة في الدنيا ، لا يعلم الحق في المسألة عند اللّه ولا من هو المصيب من المخطئ بعينه ، ولذلك تعبدنا بغلبة الظنون بعد بذل المجهود في طلب الدليل ، فالنص الصريح أحد من السيف وأدق من الشعر في الدنيا ، والصراط ظهوره في الآخرة محسوس أبين وأوضح من ظهوره في الدنيا ، إلا لمن دعا إلى اللّه على بصيرة كالرسول وأتباعه.
من كتاب إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن:
غَفُوراً) والغفر الستر ، وسيأتي الترجمة عنها في موضعها ، كما أنه سبحانه إذا كنى عن نفسه بالنون في مثل (نزلنا) و (خلقنا) و (نحن) فالناس يجعلون ذلك للعظمة ، وليس في الأصل بصحيح ، بل هي على بابها من الجمع في الدلالة ، وغاية من قدر على معناها وقرب أن قال : إذا قال بقوله جماعة لمكانته وشرفه ولا يرد له قول ، فبذلك الاعتبار يكنى بالنون عن الواحد ، وليس كذلك ، ولكنه أقرب الوجوه ، بل الوجه الصحيح أن الكناية هنا عن الأسماء التي عنها تقع الآثار على اختلافها ، وإن جمعتها ذات واحدة ، فهو العالم من حيث كذا ، والقادر من حيث كذا ، والمريد من حيث كذا ، والرازق من حيث كذا ، فكثرت الوجوه والنسب ، فطلبت النون ، ومعنى نعبد نتذلل ، يقال أرض معبدة أي مذللة ، وسمي العبد عبدا لذلته ، يقول العبد في الصلاة «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» يقول اللّه (هذه الآية بيني وبينك ، ولعبدي ما سأل) يعني الكاف له والنون للعبد ، والسؤال هنا الاستعانة ، فقد وعد بها ، بل هي له في الوقت ، فإنه لولا معونته ما قام إلى الصلاة ، فليس يطلب إلا استصحاب المعونة ، والذي لنا القيام بالعبودة وطلب المعونة منه ، إذ لا حول ولا قوة إلا باللّه ، والذي له إعطاء المعونة ، وتعيين ما عبد من أجله ، كل على حسب ما ألقي فيه من القصد ، فمن عابد لما تقتضيه الربوبية من التعظيم ، ومن عابد وفاء بحق العبودة والعبودية معا ، ومن عابد طمعا فيما وعد ، ومن عابد حذرا مما أوعد ، وهذا تقتضيه العبودة.
قوله (6) «اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ» الآية يقول : بيّن لنا الطريق الموصلة إلى سعادتنا عندك ، إذ كل طريق موصلة إليه ، قال تعالى (وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ) و (أَلا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ) و (ما مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِناصِيَتِها إِنَّ رَبِّي عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) فأتى به نكرة ، لأنه على كل صراط
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 7
صراط الذين أنعمت عليهم من نبي ورسول ، أي الطريق وليس إلا الشرع الذي أنعمت به عليهم وهو الرحمة التي أعطتهم التوفيق والهداية في دار التكليف ، وهي رحمة عناية فكانوا بذلك غير مغضوب عليهم ولا ضالين ، لما أعطاهم اللّه الهداية فلم يحاروا «غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ» نعت للذين أنعمت عليهم وهو نعت تنزيه يقول من غضب اللّه عليه ، منّ علينا بالرحمة التي مننت بها على أولئك ابتداء من غير استحقاق حتى وصفتهم بأنهم غير مغضوب عليهم ، إذ قد مننت عليهم بالهداية فأزالت الضلالة التي هي الحيرة عنهم ، فمنّ بالذي يزيل ما استحققناه من غضب اللّه ، فيرحمهم اللّه برحمة الامتنان وهي الرحمة الثالثة بالاسم الرحمن ، فيزيل عنهم العذاب ويعطيهم النعيم فيما هم فيه بالاسم الرحيم ، فليس في أم الكتاب آية غضب بل كلها رحمة ، وهي الحاكمة على كل آية في الكتاب لأنها الأم ، فسبقت رحمته غضبه ، وكيف لا يكون ذلك والنسب الذي بين العالم وبين اللّه إنما هو من الاسم الرحمن ، فجعل الرحم قطعة منه فلا تنسب الرحم إلا إليه .
قال صلّى اللّه عليه وسلم : الرحم شجنة من الرحمن من وصلها وصله اللّه ومن قطعها قطعه اللّه ، وما في العالم إلا من عنده رحمة بأمر ما لا بد من ذلك ، فلا بد أن ينال الخلق كلهم رحمة اللّه ، فمنهم العاجل والآجل ، فإن رحمة اللّه سبقت غضبه فهي أمام الغضب ، فلا يزال غضب اللّه يجري في شأوه بالانتقام من العباد حتى ينتهي إلى آخر مداه ، فيجد الرحمة قد سبقته ، فتتناول منه العبيد المغضوب
من كتاب إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن:
شهيد ، وجاء في هذا بالتعريف ، فهو صراط مخصوص ، فلذا فسرناه بالصراط المؤدي إلى السعادة ، ولما كان الإنسان تعتريه في أكثر الأوقات الشبه المضلة الصارفة عن طريق العلم باللّه ، من حيث توحيده وما يجب له ، وغير ذلك ، ولا سيما لأرباب الفكر والنظر ، احتاج أن يقول:
بيّن لنا طريق الحق في ذلك ، والمطلوب هنا بالصراط المستقيم الاجتماع منه على إقامة الدين مطلقا ، حتى لا يؤمن ببعض ويكفر ببعض لما ذكرناه ، ونون الجماعة في اهدنا هي النون في نعبد ، وإنما
عليهم ، فتنبسط عليهم ويرجع الحكم لها فيهم ، والمدى الذي يعطيه الغضب هو ما بين الرحمن الرحيم الذي في البسملة وبين الرحمن الرحيم الذي بعد قوله «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ» فالحمد للّه رب العالمين هو المدى ، فأوله الرحمن الرحيم وانتهاؤه الرحمن الرحيم ، وإنما كان الحمد للّه رب العالمين عين المدى ، فإن في هذا المدى تظهر السراء والضراء ولهذا كان الحمد فيه وهو الثناء ، ولم يقيد بضراء ولا سراء في هذا المدى لأنه يعم السراء والضراء ، فكان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول في السراء: " الحمد للّه المنعم المفضل "
وفي الضراء «الحمد للّه على كل حال»
ويرجو رحمته ويخاف عذابه واستمراره عليه ، فجعل اللّه عقيب «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ» قوله «الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» فالعالم بين هذه الرحمة ورحمة البسملة بما هو عليه من محمود ومذموم ، وهذا تنبيه عجيب من اللّه لعباده ليقوى عندهم الرجاء والطمع في رحمة اللّه فإنه أرحم الراحمين ، فإنه إن لم يزد على عبيده في الرحمة بحكم ليس لهم فما يكون أرحم الراحمين ، وهو أرحم الراحمين بلا شك ، فو اللّه لا خاب من أحاطت به رحمة اللّه من جميع جهاته ، وإذا صحت الحقائق فليقل الأخرق ما شاء ، فإن جماعة نازعوا في ذلك ولولا أن رحمة اللّه بهذه المثابة من الشمول لكان القائلون بمثل هذا لا تنالهم رحمة اللّه أبدا .
الوجه الثاني الفاتحة في الصلاة :الصلاة جامعة بين اللّه والعبد في قراءة فاتحة الكتاب ، ومن هنا يؤخذ الدليل بفرضيتها على المصلي في الصلاة ، فمن لم يقرأها في الصلاة فما صلى الصلاة التي قسمها اللّه بينه وبين عبده ، فإنه ما قال قسمت الفاتحة وإنما قال قسمت الصلاة بالألف واللام اللتين للعهد والتعريف ، فلما فسر الصلاة المعهودة بالتقسيم جعل محل القسمة قراءة الفاتحة ، وهذا أقوى دليل يوجد في فرض قراءة الحمد في الصلاة ، والذي أذهب إليه وجوب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة وإن تركها لم تجزه صلاته ، فقراءة أم القرآن في الصلاة واجبة إن حفظها ، وما عداها ما
من كتاب إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن:
قلنا الاجتماع على إقامة الدين لقوله (7) «صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ» يعني من النبيين ، فإنه جعل لكل نبي شرعة ومنهاجا ، وقال تعالى : (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ) أي في القيام به ، فهذه الصفة هي الجامعة لكل ذي شرع ، وهو قوله تعالى لما ذكر الأنبياء لنبيه صلى اللّه على جميعهم : (أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ) أي فيما ذكرناه ، لا في فروع الأحكام ، وإن
فيه توقيت ، وينبغي أن يكون العامل في «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» (أذكر) فتتعلق الباء بهذا الفعل إن صح الخبر ، يقول العبد «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» يقول اللّه «ذكرني عبدي» وإن لم يصح فيكون الفعل أقرأ بسم اللّه ، فإنه ظاهر في «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ» هذا يتكلفه لقولهم إن المصادر لا تعمل عمل الأفعال إلا إذا تقدمت ، وأما إذا تأخرت فتضعف عن العمل ، وهذا عندنا غير مرضي في التعليل لأنه تحكم من النحوي ، فإن العرب لا تعقل ولا تعلل ، فيكون تعلق البسملة عندي بقوله «الْحَمْدُ لِلَّهِ» بأسمائه فإن اللّه لا يحمد إلا بأسمائه غير ذلك لا يكون ، ولا ينبغي أن نتكلف في القرآن محذوفا إلا لضرورة وما هنا ضرورة .
فإن صح قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم عن اللّه تبارك وتعالى إن العبد إذا قال «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» في مناجاته في الصلاة يقول اللّه يذكرني عبدي فلا نزاع ، هكذا روي هذا الخبر عن
[ الفاتحة في الصلاة ]
أبي هريرة عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاث غير تمام» .
فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام فقال : اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول «قال اللّه تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل» ، وذكر مسلم هذا الحديث ولم يذكر البسملة فيه ، فمن عبيد اللّه من يسمع ذلك القول بسمعه ، فإن لم تسمعه بسمعك فاسمعه إيمانا به فإنه أخبر بذلك ، فمن الأدب الإصغاء ، وهي السكتات بين الآيات في الصلاة ، فإذا قال العبد «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» علق الباء بما في الحمد من معنى الفعل كما قلنا يقول لا يثنى على اللّه إلا بأسمائه الحسنى ، فذكر من ذلك ثلاثة أسماء : الاسم اللّه لكونه جامعا غير مشتق ، فينعت ولا ينعت به فإنه للأسماء كالذات للصفات فذكره أولا من حيث أنه دليل على الذات ، كالأسماء الأعلام كلها في اللسان وإن لم يقو قوة الأعلام لأنه وصف للمرتبة كاسم السلطان ، فلما لم يدل إلا على
من كتاب إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن:
ظهر في شرعنا من فروع شرع من قبلنا ، فمن حيث هو شرع لنا ، وقد يقع الاتفاق في بعض الأحكام كالتوحيد والإيمان بالآخرة وما فيها ، لا ينكر ذلك ، وكلا الصراطين معرّفة ، فالتعريف للصراط بالإضافة أخرج الصراط المستقيم من حكم ما تعطيه الألف واللام من استغراق الجنس إلى حكم ما تعطيه من العهد ، وقوله (7) «غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ» يعني المرضي عنهم (7) «وَلَا الضَّالِّينَ» يعنى المهتدين ، ولذا قال : اهدنا كما هديت هؤلاء ، فهما نعتان للذين أنعمت عليهم ،
الذات المجردة على الإطلاق من حيث ما هي لنفسها من غير نسب لم يتوهم في هذا الاسم اشتقاق ، ولهذا سميت بالبسملة وهو قولك الاسم مع اللّه أي قولك بسم اللّه خاصة ، ثم قال بعد «بِسْمِ اللَّهِ» «الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» من حيث ما هو أعني «الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» من الأسماء المركبة كمثل بعلبك ورام هرمز ، فسماه به من حيث ما هو اسم له لا من حيث المرحومين ولا من حيث تعلق الرحمة بهم ، بل من حيث ما هي صفة له جل جلاله فإنه ليس لغير اللّه ذكر في البسملة أصلا ، فإذا قال العبد «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ»
قال اللّه تعالى «ذكرني عبدي» وما قيد هذا الذكر بشيء لاختلاف أحوال الذاكرين أعني البواعث لذكرهم ، فذكر تبعثه الرغبة وذكر تبعثه الرهبة وذكر يبعثه التعظيم والإجلال ، فأجاب الحق على أدنى مراتب العالم وهو الذي يتلو بلسانه ولا يفهم بقلبه ، لأنه لم يتدبر ما قاله إذا كان التالي عالما باللسان ولا ما ذكره ، فإن تدبر تلاوته أو ذكره كانت إجابة الحق له بحسب ما حصل في نفسه من العلم بما تلاه ، فإن اللّه يقول عند قراءة العبد القرآن كذا جوابا على حكم الآية ، فينبغي للإنسان إذا قرأ الآية أن يستحضر في نفسه ما تعطيه تلك الآية على قدر فهمه ، فإن الجواب يكون مطابقا لما استحضرته من معاني تلك الآية ، ولهذا ورد الجواب على أدنى مراتب العامة مجملا ، إذا العامي والعجمي الذي لا علم له بمعنى ما يقرأ يكون قول اللّه له ما ورد في الخبر ، فإن فصّلت في الاستحضار فصل اللّه لك الجواب ، فعلى هذا القدر في القراءة تتميز مراتب العلماء باللّه والناس في صلاتهم ، ثم قال : قال اللّه تعالى فإذا قال العبد «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ» في الصلاة
يقول اللّه «حمدني عبدي» والحمد للّه رب العالمين يعني العبد أن عواقب الثناء ترجع إلى اللّه ، ومعنى عواقب الثناء أي كل ثناء يثنى به على كون من الأكوان دون اللّه فعاقبته ترجع إلى اللّه لا لذلك الكون ، فرجعت عواقب الثناء إلى اللّه ومن وجه آخر إذا نظر إلى موضع اللام من قوله «لِلَّهِ» يرى أن الحامد عين المحمود لا غيره فهو الحامد المحمود ، وينفي الحمد عن الكون من كونه حامدا ونفى كون الكون محمودا ، فالكون من وجه محمود لا حامد ، ومن وجه لا حامد ولا محمود ، وأما كونه غير حامد فإن الحمد فعل والأفعال للّه ، وأما كونه غير محمود فإنما يحمد المحمود بما هو له لا لغيره والكون لا شيء
من كتاب إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن:
وهو من أسماء النواقص ، يقول العبد في الصلاة «اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ
له فما هو محمود أصلا ، وجاء قوله تعالى «رَبِّ الْعالَمِينَ» بالاسم الرب على ما يعطيه من الثبات والإصلاح والتربية والملك والسيادة ، فهذه الخمسة يطلبها الاسم الرب ، ويحضر القارئ ما يعطيه العالم من الدلالة عليه تعالى ، فلا يكون جواب اللّه في قوله «حمدني عبدي» إلا لمن حمده بأدنى المراتب ، لأنه لكرمه يعتبر الأضعف الذي لم يجعل اللّه له حظا في العلم به تعالى رحمة به ، لعلمه أن العالم يعلم من سؤاله أو قراءته ما حضر معه في تلك القراءة من المعاني ، فيجيبه اللّه على ما وقع له ويدخل في إجمال ما خاطب به عبده العامي القليل العلم ، أو الأعجمي الذي لا علم له بمدلول ما يقرؤه.
ثم قال يقول العبد «الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» يقول اللّه «أثنى علي عبدي» فإن قلت لم اختصت الرحمة بالثناء قلنا لأنه لا يثنى عليه إلا بما هو عليه ولا يثنى عليك إلا بما تعطيك حقيقتك ، فإذا رحمك ردك إلى عبوديتك واعتقدت أن الربوبية له وحده سبحانه ، فكل من أثني عليه بوصف مشترك فما أثني عليه ، إنما ينبغي أن يثنى على الموجود بما لا يقع فيه المشاركة ، فإذا رحمك منّ عليك بثناء تنفرد به ، ومتى أشركت معه غيره في الثناء فما خصصته بل شركته بغيره .
فيقول اللّه «أثنى علي عبدي» يعنى بصفة الرحمة لاشتقاق هذين الاسمين منها ، ولم يقل في ما ذا لعموم رحمته ، ولأن العامي ما يعرف من رحمة اللّه به إلا إذا أعطاه ما يلائمه في غرضه وإن ضره ، أو ما يلائم طبعه ولو كان فيه شقاؤه . أما العالم إذا قال «الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» فإنه يحضر في نفسه مدلول هذا القول من حيث ما هو الحق موصوف به ، ومن حيث ما يطلبه المرحوم لعلمه بذلك كله ، ويحضر في قلبه أيضا عموم رحمته الواحدة المقسمة على خلقه في الدار الدنيا ، إنسهم وجنهم ومطيعهم وعاصيهم وكافرهم ومؤمنهم وقد شملت الجميع ، ورأى أن هذه الرحمة الواحدة لو لم تعط حقيقتها من اللّه أن يرزق بها عباده من جماد ونبات وحيوان وإنس وجان ولم يحجبها عن كافر ومؤمن ومطيع وعاص عرف أن ذاتها من كونها رحمة تقتضي ذلك ، ثم جاء الوحي من أثر هذه الرحمة الواحدة بأن هذه الرحمة الواحدة السارية في العالم التي اقتضت حقيقتها أن تجعل الأم تعطف على ولدها من جميع الحيوان ، وهي واحدة من مائة رحمة ، وقد ادخر سبحانه لعباده في الدار الآخرة تسعا وتسعين رحمة ، فإذا كان يوم القيامة ونفذ في العالم حكمه وقضاؤه وقدره بهذه الرحمة الواحدة ، وفرغ الحساب ونزل الناس منازلهم من الدارين ، أضاف سبحانه هذه الرحمة إلى التسع والتسعين رحمة فكانت
من كتاب إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن:
عليهم» إلى آخر السورة ، يقول اللّه : هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل ، فقد ضمن الإجابة .
مائة ، فأرسلها على عباده مطلقة في الدارين فسرت الرحمة فوسعت كل شيء ، فمنهم من وسعته بحكم الوجوب ، ومنهم من وسعته بحكم الامتنان ، فوسعت كل شيء في موطنه وفي عين شيئيته ، وقد كان الحكم في الدنيا بالرحمة الدنيا ما قد علمتم ، وهي الآن أعني بالآخرة من جملة المائة فما ظنك ، ثم قال يقول العبد «مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ» يقول اللّه «مجدني عبدي» واختص الملك بالتمجيد لتصحيح التوحيد ، فأراد بالتمجيد التشريف بالوحدانية في الألوهية ، فلا إله إلا هو ، وفي رواية «فوض إلي عبدي» .
فالعالم يجب أن لا يقصر يوم الدين على الآخرة ، ويرى أن الرحمن الرحيم لا يفارقان ملك يوم الدين فإنه صفة لهما ، فيكون الجزاء دنيا وآخرة ، وكذلك ظهر بما شرع من إقامة الحدود وظهور الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ، وهذا هو عين الجزاء ، فيوم الدنيا أيضا يوم الجزاء واللّه ملك يوم الدين ، فالكفارات سارية في الدنيا ، والإنسان في الدار الدنيا لا يسلم من أمر يضيق به صدره يؤلمه حسا وعقلا حتى قرصة البرغوث والعثرة ، فالآلام محدودة موقتة ورحمة اللّه غير موقتة ، فإنها وسعت كل شيء ، فمنها تنال وتحكم من طريق الامتنان وهو أصل الأخذ لها ، ومنها ما يؤخذ من طريق الوجوب الإلهي في قوله «كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ»
وقوله «فَسَأَكْتُبُها» ،فأناس يأخذونها جزاء ، وبعض المخلوقات من المكلفين تنالهم امتنانا حيث كانوا ، فكل ألم في الدنيا والآخرة فإنه مكفر لأمور قد وقعت محدودة موقتة ، وهو جزاء لمن يتألم به من صغير وكبير بشرط تعقل التألم لا بطريق الإحساس بالتألم دون تعقله ، فالرضيع لا يتعقل التألم مع الإحساس به ، إلا أن أباه وأمه وأمثالهما من محبيه وغير محبيه يتألم ويتعقل التألم لما يرى في الرضيع من الأمراض النازلة به ، فيكون ذلك كفارة لمن تعقل الألم ، فإذا زاد ذلك العاقل الترحم به كان مع التكفير عنه مأجورا ، إذ في كل كبد رطبة أجر ، وأما الصغير إذا تعقل التألم وطلب النفور عن الأسباب الموجبة للألم واجتنبها ، فإن له كفارة فيها لما صدر منه مما آلم به غيره من حيوان أو شخص آخر من جنسه ، فإذا تألم الصغير كان ذلك الألم القائم به جزاء مكفرا ، حتى الإنسان يتألم بوجود الغيم ويضيق صدره به ، فإنه كفارة لأمور آتاها قد نسيها أو يعلمها .
فهذا كله من بعض ما يدل عليه «مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ» فيقول اللّه «فوض إلي عبدي» أو " مجدني عبدي " أي جعل لي الشرف عليه كما هو الأمر في نفسه ، فهو الحق الذي له المجد بالأصالة ، فله تعالى المجد
من كتاب إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن:
تنبيه : وإن كان النصف الأول له فقد جاء فيه ذكر العالمين ، وجاء في النصف الذي لنا ذكره
والشرف على العالم في الدنيا والآخرة ، لأنه جازاهم على أعمالهم في الدنيا والآخرة ، فيوم الدين هو يوم الجزاء ، أو يقول اللّه كلاهما ، إلا أن التمجيد راجع إلى جناب الحق من حيث ما تقتضيه ذاته ومن حيث ما تقتضي نسبة العالم إليه ، والتفويض من حيث ما تقتضي نسبة العالم إليه لا غير ، فإنه وكيل لهم بالوكالة المفوضة ، ففي حق قوم يقول «مجدني عبدي وفيّ المقصد» وفي حق قوم يقول «فوض إلي عبدي وفي المقصد أيضا» وفي حق قوم يقول «مجدني عبدي وفوض إلي عبدي» ، فإن العبد قد يجمع بين المقصدين فيجمع اللّه له في الرد بين التمجيد والتفويض - وإلى هنا - فهذا النصف كله مخلص لجناب اللّه ليس للعبد فيه اشتراك - ثم قال اللّه يقول العبد «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» يقول اللّه هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل ، فهذه الآية تتضمن سائلا ومسؤولا مخاطبا وهو الكاف من إياك فيهما ، ونعبد ونستعين هما للعبد فإنه العابد والمستعين .
فإذا قال العبد «إِيَّاكَ» وحد بحرف الخطاب بجعله مواجها لا على جهة التحديد ، ولكن امتثالا لقول الشارع لمثل ذلك السائل في معرض التعليم حين سأله عن الإحسان فقال له صلّى اللّه عليه وسلم «أن تعبد اللّه كأنك تراه» ، فلا بد أن تواجهه بحرف الخطاب وهو الكاف ، فهذه الآية وقع فيها الاشتراك بين الحق وبين عبده ، وما مضى من الفاتحة مخلص للّه وما بقي منها مخلص للعبد ، وهذه التي نحن فيها مشتركة ووقع الاشتراك من العبادة والعون لتتميز القدرة من عجز الكون ، فهو سبحانه المقصود بالعبادة ، والعبد العابد ، وهو المقصود بالاستعانة ، والعبد المستعين ، فالاشتراك في الآية كلمة للرب وكلمة للعبد ، وإنما وحّده ولم يجمعه لأن المعبود واحد ، وجمع نفسه بنون الجمع في العبادة والعون المطلوب لأن العابدين من العبد كثيرون ، وكل واحد من العابدين يطلب العون والمقصود بالعبادات واحد ، فعلى العين عبادة وعلى السمع عبادة وعلى البصر واللسان واليد والبطن والفرج والرجل والقلب فلهذا قال نعبد ونستعين بالنون ، فإذا نظر العالم إلى تفاصيل عالمه وأن الصلاة قد عم حكمها جميع حالاته ظاهرا وباطنا لم ينفرد بذلك جزء عن آخر ، فجميع عالمه قد اجتمع على عبادة ربه وطلب العون منه على عبادته ، فجاء بنون الجماعة في نعبد ونستعين فترجم اللسان عن الجماعة ، كما يتكلم الواحد من الوفد بحضورهم بين يدي الملك ، فعلم العبد من الحق لما أنزل عليه هذه الآية بإفراده نفسه أن
من كتاب إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن:
سبحانه في أنعمت بضمير المخاطب ، وإنما أتى بضمير المخاطب ، ولو أتى باسم ظاهر ، تخيل أن
لا يعبد إلا إياه ، ولما قيد العبد بالنون أنه يريد منه أن يعبده بكله ظاهرا وباطنا من قوى وجوارح ويستعين على ذلك الحد ، ومتى لم يكن المصلي بهذه المثابة من جمع عالمه على عبادة ربه لم يصدق في قوله «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ»
وهو مشغول في الالتفات ببصره والإصغاء إلى حديث الآخرين ، مشغول بخاطره في دكانه أو تجارته ، ثم قال اللّه يقول العبد «اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ»
فيقول اللّه (هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل) فيسأل العبد اللّه أن يهديه الصراط المستقيم ، وأن يبينه له وأن يوفقه إلى المشي عليه ، وهو صراط التوحيد توحيد الذات وتوحيد المرتبة التي هي الألوهية بلوازمها من الأحكام المشروعة التي هي من الإسلام في قوله صلّى اللّه عليه وسلم «إلا بحق الإسلام وحسابهم على اللّه» فهو الصراط المستقيم الذي هو عليه الرب ، من حيث ما يقود الماشي عليه إلى سعادته .
ولهذا قال «صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ» يريد الذين وفقهم اللّه وهم العالمون كلهم أجمعهم ، والصالحون من الإنس مثل الرسل والأنبياء والأولياء وصالحي المؤمنين من الجان ، كذلك لم يجعل الصراط المستقيم إلا لمن أنعم اللّه عليهم من نبي وصديق وشهيد وصالح ، وكل دابة هو آخذ بناصيتها «غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ» أي لا من غضب اللّه عليهم لما دعاهم بقوله «حي على الصلاة» فلم يجيبوا «وَلَا الضَّالِّينَ» فاستثنى بالعطف من حار ، وهم أحسن حالا من المغضوب عليهم ، فمن لم يعرف ربه وأشرك معه في ألوهيته من لا يستحق أن يكون إلها كان من المغضوب عليهم ، فإذا أحضر العبد مثل هذا وأشباهه في نفسه عند تلاوته قالت الملائكة «آمين» ويقول العبد «آمين» .
فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة في الصفة ، موافقة طهارة وتقديس ذوات ، كرام بررة ، أجابه الحق عقيب قوله «آمين» ، أي أمنا بالخير ، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ، «وآمين» كلمة شرعت بعد الفراغ من الفاتحة لما فيها من السؤال ، وهو قوله «اهْدِنَا» وهي أي آمين تقصر وتمد ، وورد في الشرع الجهر بها والإخفاء ، لأن الأمر ظاهر وباطن ، فالباطن يطلب الإخفاء والظاهر يطلب الجهر ، غير أن الظاهر أعم ، فإذا جهر بها حصل حظ الباطن ، وإذا أسر بها لم يعلم الظاهر ما جرى ، فالجهر بها عام لعام وخاص وأعم منفعة ، والسر بها أتم مقاما من الجهر بها ، وآمين معناها أجب دعاءنا ، لا بل معناه قصدنا إجابتك فيما دعوناك فيه ، يقال أمّ فلان جانب فلان إذا قصده ، وخفف آمين للسرعة المطلوبة في الإجابة ، والخفة
من كتاب إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن:
الأمر مربوط بما تعطيه حقيقة ذلك الاسم ، ونسبة الأسماء إلى الضمير نسبة واحدة ، كما أنه أتى
تقتضي الإسراع في الأشياء ، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة فقد غفر له ، ولم يقل فقد أجيب لما غفر له ، لأن المهدي ما له ما يغفر ، أي فمن أمن مثل تأمين الملائكة ، هذا معنى الموافقة لا الموافقة الزمانية ، وقد تكون الموافقة الزمانية فيحويهم زمان واحد عند قولهم آمين ، والملائكة لا يخلو قولها في آمين هل يقولونها متجسدين أو يقولونها غير متجسدين ، فإن قالتها متجسدين فربما يريد الموافقة الزمانية خاصة ، لأن التجسد يحكم عليها بالإتيان بلفظة آمين أي بترتيب هذه الحروف ، وإن قالتها غير متجسدة فلم تبق الموافقة إلا أن يقولها العبد بالحال التي يقولها الملك ، فإذا قالها غفر اللّه له ، ولا بد أن يستره عن كل أمر يضاد الهداية بما تنتج ، لا بد من ذلك ، لأن نتيجة الهداية سعادة ، وقد يكون في حياته الدنيا غير مهدي والعناية قد سبقت فيجني ثمرة الهداية ، فلهذا لم يقل أجيب وقال غفر فهذا معنى قول آمين فحصلت الإجابة بالأمن مع تأمين الملائكة ، فيجب قراءة الفاتحة على كل مصل من إمام وغير إمام .
وليس للمأموم أن يسبق إمامه بشيء من أفعال الصلاة ، ولا من أقوالها حتى في قراءة الفاتحة ، ليس له أن يشرع فيها إذا جهر بها حتى يفرغ منها أو يتبع سكتات الامام فيها ، فيقرأ ما فرغ الإمام منها في سكتة الإمام ، وفي صلاة السر يقرؤها بحسب ما يغلب على ظنه ، إلا في الصلاة بعد الجلسة الوسطى فإنه يقرؤها ابتداء ، فقراءة الفاتحة لا بد منها لكل مصل ، فإن اللّه قسم الصلاة بينه وبين عبده وما ذكر إلا الفاتحة لا غير ، فمن لم يقرأها فما صلى الصلاة المشروعة التي قسمها اللّه بينه وبين عبده ، وينبغي للعبد أن يقرأ سورة الفاتحة من غير أن تتقدمه روية فيما يقرأ من السور أو الآيات من سورة واحدة أو من سور ، فإذا فرغ المصلي من قراءة الفاتحة قرأ ما تيسر له من القرآن وما يجري اللّه على لسانه منه من غير أن يختار آية معينة أو يتردد ، والسنة إتمام السورة .
في الخبر الصحيح يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارق فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ - همة عالية شريفة - روى الشيخ محي الدين ابن العربي عن شيخه المقرئ أبي بكر محمد بن خلف بن صاف اللخمي ، من مشايخ القراءات بجامع قوس الحنية بإشبيلية ، عن بعض المعلمين من الصالحين ، أن شخصا صبيا صغيرا كان يقرأ عليه القرآن ، فرآه مصفر اللون فسأل عن حاله فقيل له إنه يقوم الليل بالقرآن كله .
فقال له يا ولدي أخبرت أنك تقوم الليل بالقرآن كله ، فقال هو ما قيل لك ، فقال يا ولدي إذا كان في هذه الليلة فأحضرني في قبلتك ، واقرأ عليّ القرآن في صلاتك ولا تغفل عني ، فقال
من كتاب إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن:
بالعالمين ، وما ذكر عالما مخصوصا ، حتى لا يخرج من العالم أحد ، فالعالم مفتقر إلى حقائق الأسماء
الشاب نعم فلما أصبح قال له هل فعلت ما أمرتك به ؟
قال نعم يا أستاذ ، قال وهل ختمت القرآن البارحة ؟
قال لا ما قدرت على أكثر من نصف القرآن ،
قال يا ولدي هذا حسن إذا كان في هذه الليلة فاجعل من شئت من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أمامك ، الذين سمعوا القرآن من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ، واقرأ عليه واحذر فإنهم سمعوه من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فلا تزل في تلاوتك ، فقال إن شاء اللّه يا أستاذ كذلك أفعل ، فلما أصبح سأله الأستاذ عن ليلته فقال :
يا أستاذ ما قدرت على أكثر من ربع القرآن ،
فقال : يا ولدي أتل هذه الليلة على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن ، واعرف بين يدي من تتلوه ، فقال نعم ، فلما أصبح قال :
يا أستاذ ما قدرت طول ليلتي على أكثر من جزء من القرآن أو ما يقاربه ،
فقال يا ولدي إذا كان هذه الليلة فلتكن تقرأ القرآن بين يدي جبريل ، الذي نزل به على قلب محمد صلّى اللّه عليه وسلم ، فاحذر واعرف قدر من تقرأ عليه ، فلما أصبح قال ، يا أستاذ ما قدرت على أكثر من كذا وذكر آيات قليلة من القرآن ،
قال يا ولدي إذا كان هذه الليلة فتب إلى اللّه وتأهب واعلم أن المصلي يناجي ربه ، وأنك واقف بين يديه تتلو عليه كلامه.
فانظر حظك من القرآن وحظه وتدبر ما تقرأ ، فليس المراد جمع الحروف ولا تأليفها ، ولا حكاية الأقوال ، وإنما المراد بالقراءة التدبر لمعاني ما تتلوه ، فلا تكن جاهلا ، فلما أصبح انتظر الأستاذ الشاب فلم يجئ إليه فبعث من يسأل عن شأنه فقيل له إنه أصبح مريضا يعاد ، فجاء إليه الأستاذ فلما أبصره الشاب بكى وقال : يا أستاذ جزاك اللّه عني خيرا ، ما عرفت أني كاذب إلا البارحة ، لما قمت في مصلاي وأحضرت الحق تعالى وأنا بين يديه أتلو عليه كتابه ، فلما استفتحت الفاتحة ووصلت إلى قوله «إِيَّاكَ نَعْبُدُ» ونظرت إلى نفسي فلم أرها تصدق في قولها ، فاستحييت أن أقول بين يديه «إِيَّاكَ نَعْبُدُ» وهو يعلم أني أكذب في مقالتي.
فإني رأيت نفسي لاهية بخواطرها عن عبادته ، فبقيت أردد القراءة من أول الفاتحة إلى قوله «مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ» ولا أقدر أن أقول «إِيَّاكَ نَعْبُدُ» إنه ما خلصت لي ، فبقيت أستحي أن أكذب بين يديه تعالى فيمقتني ، فما ركعت حتى طلع الفجر وقد رضت كبدي ، وما أنا إلا راحل إليه على حالة لا أرضاها من نفسي ، فما انقضت ثالثة حتى مات الشاب ، فلما دفن أتى الأستاذ إلى قبره فسأله عن حاله ، فسمع صوت الشاب من قبره وهو يقول له : «يا أستاذ
من كتاب إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن:
الإلهية كلها ، وأيضا لو أتى به مضمرا ، لم يجد الضمير على من يعود ، والتاء تجد على من تعود ،
أنا حي عند حي لم يحاسبني بشيء»
قال فرجع الأستاذ إلى بيته ولزم فراشه مريضا مما أثر فيه حال الفتى فلحق به.
فمن قرأ «إِيَّاكَ نَعْبُدُ» على قراءة الشاب فقد قرأ -نصيحة- إذا كان اللّه المعين فلا تبال فإنه لا يقاومه شيء .
بل هو القادر على كل شيء ، فما ثم مع الإعانة الإلهية قوة تقاوى قوة الحق ، فإن اللّه يقول فيمن سأله الإعانة «ولعبدي ما سأل» في الخبر الصحيح ، فإذا قال العبد «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» يقول اللّه : هذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل.
وإذا قال «اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ» إلى آخر السورة - وهدايته من معونته - يقول اللّه : هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل ، وخبره صدق وقد قال : ولعبدي ما سأل ، فلا بد من إعانته .
ولكن هنا شرط لا يغفل عنه العالم إذا تلا مثل هذا لا يتلوه حكاية ، فإن ذلك لا ينفعه فيما ذهبنا إليه ، وفيما أريد له وإنما اللّه تعالى ما شرع له أن يقرأ القرآن ويذكره بهذا الذكر إلا ليعلمه كيف يذكره ، فيذكره ذكر طلب واضطرار وافتقار وحضور في طلبه من ربه ما شرع له أن يطلبه ، فذلك هو الذي يجيبه الحق إذا سأله ، فإن تلا حكاية فما هو سائل ، وإذا لم يسأل وحكى السؤال فإن الحق لا يجيب من هذه صفته ، ولا جرم أن التالين الغالب عليهم الحكاية لا ثمرة عندهم ، فهم يقرءون القرآن بألسنتهم لا يجاوز تراقيهم ، وقلوبهم لاهية في حال التلاوة وفي حال سماعه ، فالمؤمن المخلوق يستعين بالمؤمن الخالق ، فيشد منه ويقوي ما ضعف عنه من كونه مخلوقا .
إشارة:
ما أحسن الإشارة في كون اللّه ما ختم القرآن العظيم الذي هو الفاتحة إلا بأهل الحيرة وهو قوله «وَلَا الضَّالِّينَ» والضلالة الحيرة ، ثم شرع عقيبها آمين أي أمنا بما سألناك فيه ، فإن غير المغضوب عليهم ولا الضالين نعت للذين أنعمت عليهم ، وهو نعت تنزيه ، ومن علم أن الغاية هي الحيرة فما حار ، بل هو على نور من ربه ، إذ الحيرة هي الانتهاء وما بيد العالم باللّه من العلم باللّه سواها .
(راجع معنى الحيرة في كتابنا الرد على ابن تيمية ص 50 - ومعنى الضالين في كتابنا شرح كلمات الصوفية ص 402)
إشارة :
في قسمة الفاتحة ، العبودية الواضحة ، واختصت الرحمة بالثنا ، ليتبين من أنت (الحق) ومن أنا ، والملك بالتمجيد ، لتصحيح التوحيد ، ووقع الشرك في العبادة والعون ، لتتميز القدرة من عجز الكون ، واختص العبد بنصفها الثاني ، ليصح عليها اسم المثاني ، فإن قلت قد ساوى موسى لمحمد في الفرقان فكيف
من كتاب إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن:لأنه قد تقدم.
صحت له السيادة ، قلنا لاختصاصه بالقرآن والعبادة ، فإن قلت قد شاركه في العبودية ، نوح وزكريا الوجيه ، قلنا : الواحد عبد نعمة ، والآخر عبد ربوبية ، ومحمد عبد تنزيه ، فإن قلنا قد شاركه يحيى في السيادة الفاخرة ، قلنا تلك السيادة الظاهرة ، ولهذا صرح بها في الكتاب المبين ، وأخفى فيه سيادة محمد سيد العالمين ، ثم صرح بها على لسانه في الشاهدين ، فهذا سيد عموم ، وهذا سيد رسوم .
------------
(7) الفتوحات ج 1 / 61 ، 731 ، 61 - ج 3 / 551 - ج 4 / 407 - الفتوحات ج 3 / 173 - ج 1 / 413 ، 456 ، 422 ، 406 ، 422 - كتاب النجاة شرح الإسراء - ج 1 / 422 - كتاب النجاة شرح الإسراء - ج 4 / 261 - كتاب النجاة شرح الإسراء - ج 2 / 101 - ج 1 / 492 ، 422 - ج 4 / 481 ، 407- كتاب الإسراء ، الإشارات المحمديةتفسير ابن كثير:
( بسم الله الرحمن الرحيم )
يقال لها : الفاتحة ، أي فاتحة الكتاب خطا ، وبها تفتح القراءة في الصلاة ، ويقال لها أيضا : أم الكتاب عند الجمهور ، وكره أنس ، والحسن وابن سيرين كرها تسميتها بذلك ، قال الحسن وابن سيرين : إنما ذلك اللوح المحفوظ ، وقال الحسن : الآيات المحكمات : هن أم الكتاب ، ولذا كرها - أيضا - أن يقال لها أم القرآن وقد ثبت في [ الحديث ] الصحيح عند الترمذي وصححه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم ويقال لها : الحمد ، ويقال لها : الصلاة ، لقوله عليه السلام عن ربه : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ، فإذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين ، قال الله : حمدني عبدي الحديث . فسميت الفاتحة صلاة ؛ لأنها شرط فيها . ويقال لها : الشفاء ؛ لما رواه الدارمي عن أبي سعيد مرفوعا : فاتحة الكتاب شفاء من كل سم . ويقال لها : الرقية ؛ لحديث أبي سعيد في الصحيح حين رقى بها الرجل السليم ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : وما يدريك أنها رقية ؟ . وروى الشعبي عن ابن عباس أنه سماها : أساس القرآن ، قال : فأساسها بسم الله الرحمن الرحيم ، وسماها سفيان بن عيينة : الواقية . وسماها يحيى بن أبي كثير : الكافية ؛ لأنها تكفي عما عداها ولا يكفي ما سواها عنها ، كما جاء في بعض الأحاديث المرسلة : أم القرآن عوض من غيرها ، وليس غيرها عوضا عنها . ويقال لها : سورة الصلاة والكنز ، ذكرهما الزمخشري في كشافه . وهي مكية ، قاله ابن عباس وقتادة وأبو العالية ، وقيل مدنية ، قاله أبو هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار والزهري . ويقال : نزلت مرتين : مرة بمكة ، ومرة بالمدينة ، والأول أشبه لقوله تعالى : ( ولقد آتيناك سبعا من المثاني ) [ الحجر : 87 ] ، والله أعلم . وحكى أبو الليث السمرقندي أن نصفها نزل بمكة ونصفها الآخر نزل بالمدينة ، وهو غريب جدا ، نقله القرطبي عنه . وهي سبع آيات بلا خلاف ، [ وقال عمرو بن عبيد : ثمان ، وقال حسين الجعفي : ستة وهذان شاذان ] . وإنما اختلفوا في البسملة : هل هي آية مستقلة من أولها كما هو عند جمهور قراء الكوفة وقول الجماعة من الصحابة والتابعين وخلق من الخلف ، أو بعض آية أو لا تعد من أولها بالكلية ، كما هو قول أهل المدينة من القراء والفقهاء ؟ على ثلاثة أقوال ، سيأتي تقريره في موضعه إن شاء الله تعالى ، وبه الثقة .
قالوا : وكلماتها خمس وعشرون كلمة ، وحروفها مائة وثلاثة عشر حرفا . قال البخاري في أول كتاب التفسير : وسميت أم الكتاب سورة الفاتحة ، لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ، ويبدأ بقراءتها في الصلاة وقيل : إنما سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمنته . قال ابن جرير : والعرب تسمي كل جامع أمر أو مقدم لأمر - إذا كانت له توابع تتبعه هو لها إمام جامع - أما ، فتقول للجلدة التي تجمع الدماغ ، أم الرأس ، ويسمون لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها أما ، واستشهد بقول ذي الرمة :
على رأسه أم لنا نقتدي بها جماع أمور ليس نعصي لها أمرا
يعني : الرمح . قال : وسميت مكة : أم القرى لتقدمها أمام جميعها وجمعها ما سواها ، وقيل : لأن الأرض دحيت منها .
ويقال لها أيضا : الفاتحة ؛ لأنها تفتتح بها القراءة ، وافتتحت الصحابة بها كتابة المصحف الإمام ، وصح تسميتها بالسبع المثاني ، قالوا : لأنها تثنى في الصلاة ، فتقرأ في كل ركعة ، وإن كان للمثاني معنى آخر غير هذا ، كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله . قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون ، أنبأنا ابن أبي ذئب وهاشم بن هاشم عن ابن أبي ذئب ، عن المقبري ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأم القرآن : هي أم القرآن ، وهي السبع المثاني ، وهي القرآن العظيم . ثم رواه عن إسماعيل بن عمر عن ابن أبي ذئب به ، وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري : حدثني يونس بن عبد الأعلى ، أنا ابن وهب ، أخبرني ابن أبي ذئب ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : هي أم القرآن ، وهي فاتحة الكتاب ، وهي السبع المثاني . وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه في تفسيره : حدثنا أحمد بن محمد بن زياد ، ثنا محمد بن غالب بن حارث ، ثنا إسحاق بن عبد الواحد الموصلي ، ثنا المعافى بن عمران ، عن عبد الحميد بن جعفر ، عن نوح بن أبي بلال ، عن المقبري ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحمد لله رب العالمين سبع آيات : بسم الله الرحمن الرحيم إحداهن ، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم ، وهي أم الكتاب .
وقد رواه الدارقطني أيضا عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه أو مثله ، وقال : كلهم ثقات . وروى البيهقي عن علي وابن عباس وأبي هريرة أنهم فسروا قوله تعالى : ( سبعا من المثاني ) [ الحجر : 87 ] بالفاتحة ، وأن البسملة هي الآية السابعة منها ، وسيأتي تمام هذا عند البسملة .
وقد روى الأعمش عن إبراهيم قال : قيل لابن مسعود : لم لم تكتب الفاتحة في مصحفك ؟ قال : لو كتبتها لكتبتها في أول كل سورة . قال أبو بكر بن أبي داود : يعني حيث يقرأ في الصلاة ، قال : واكتفيت بحفظ المسلمين لها عن كتابتها .
وقد قيل : إن الفاتحة أول شيء نزل من القرآن ، كما ورد في حديث رواه البيهقي في دلائل النبوة ونقله الباقلاني أحد أقوال ثلاثة هذا [ أحدها ] وقيل : ( يا أيها المدثر كما في حديث جابر في الصحيح . وقيل : ( اقرأ باسم ربك الذي خلق ) [ العلق : 1 ] وهذا هو الصحيح ، كما سيأتي تقريره في موضعه ، والله المستعان.
ذكر ما ورد في فضل الفاتحة
قال الإمام أحمد بن محمد بن حنبل - رحمه الله - في مسنده : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن شعبة ، حدثني خبيب بن عبد الرحمن ، عن حفص بن عاصم ، عن أبي سعيد بن المعلى - رضي الله عنه - قال : كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم أجبه حتى صليت وأتيته ، فقال : ما منعك أن تأتيني ؟ . قال : قلت : يا رسول الله ، إني كنت أصلي . قال : ألم يقل الله : ( يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ) [ الأنفال : 24 ] ثم قال : لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد . قال : فأخذ بيدي ، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت : يا رسول الله إنك قلت : لأعلمنك أعظم سورة في القرآن . قال : نعم ، الحمد لله رب العالمين هي : السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته .
وهكذا رواه البخاري عن مسدد ، وعلي بن المديني ، كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان ، به . ورواه في موضع آخر من التفسير ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه من طرق عن شعبة ، به . ورواه الواقدي عن محمد بن معاذ الأنصاري ، عن خبيب بن عبد الرحمن ، عن حفص بن عاصم ، عن أبي سعيد بن المعلى ، عن أبي بن كعب ، فذكر نحوه .
وقد وقع في الموطأ للإمام مالك بن أنس ، ما ينبغي التنبيه عليه ، فإنه رواه مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي : أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبرهم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب ، وهو يصلي في المسجد ، فلما فرغ من صلاته لحقه ، قال : فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على يدي ، وهو يريد أن يخرج من باب المسجد ، ثم قال : إني لأرجو ألا تخرج من باب المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها . قال أبي : فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك ، ثم قلت : يا رسول الله ، ما السورة التي وعدتني ؟ قال : كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة ؟ قال : فقرأت عليه : ( الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هي هذه السورة ، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت . فأبو سعيد هذا ليس بأبي سعيد بن المعلى ، كما اعتقده ابن الأثير في جامع الأصول ومن تبعه ، فإن ابن المعلى صحابي أنصاري ، وهذا تابعي من موالي خزاعة ، وذاك الحديث متصل صحيح ، وهذا ظاهره أنه منقطع ، إن لم يكن سمعه أبو سعيد هذا من أبي بن كعب ، فإن كان قد سمعه منه فهو على شرط مسلم ، والله أعلم . على أنه قد روي عن أبي بن كعب من غير وجه كما قال الإمام أحمد :
حدثنا عفان ، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ، حدثنا العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب ، وهو يصلي ، فقال : يا أبي ، فالتفت ثم لم يجبه ، ثم قال : أبي ، فخفف . ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : السلام عليك أي رسول الله . فقال : وعليك السلام [ قال ] : ما منعك أي أبي إذ دعوتك أن تجيبني ؟ . قال : أي رسول الله ، كنت في الصلاة ، قال : أولست تجد فيما أوحى الله إلي استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ) [ الأنفال : 24 ] . قال : بلى يا رسول الله ، لا أعود ، قال : أتحب أن أعلمك سورة لم تنزل لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها ؟ قلت : نعم ، أي رسول الله ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني لأرجو ألا أخرج من هذا الباب حتى تعلمها قال : فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي يحدثني ، وأنا أتبطأ ، مخافة أن يبلغ قبل أن يقضي الحديث ، فلما دنونا من الباب قلت : أي رسول الله ، ما السورة التي وعدتني قال : ما تقرأ في الصلاة ؟ . قال : فقرأت عليه أم القرآن ، قال : والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ، ولا في الفرقان مثلها ؛ إنها السبع المثاني . ورواه الترمذي ، عن قتيبة ، عن الدراوردي ، عن العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، فذكره ، وعنده : إنها من السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته ، ثم قال : هذا حديث حسن صحيح .
وفي الباب ، عن أنس بن مالك ، ورواه عبد الله بن [ الإمام ] أحمد ، عن إسماعيل بن أبي معمر ، عن أبي أسامة ، عن عبد الحميد بن جعفر ، عن العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن أبي بن كعب ، فذكره مطولا بنحوه ، أو قريبا منه . وقد رواه الترمذي والنسائي جميعا عن أبي عمار حسين بن حريث ، عن الفضل بن موسى ، عن عبد الحميد بن جعفر ، عن العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن أبي بن كعب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن ، وهي السبع المثاني ، وهي مقسومة بيني وبين عبدي ، هذا لفظ النسائي . وقال الترمذي : حسن غريب .
وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن عبيد ، حدثنا هاشم ، يعني ابن البريد حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن ابن جابر ، قال : انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أهراق الماء ، فقلت : السلام عليك يا رسول الله . فلم يرد علي ، قال : فقلت : السلام عليك يا رسول الله . فلم يرد علي ، قال : فقلت : السلام عليك يا رسول الله ، فلم يرد علي . قال : فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي ، وأنا خلفه حتى دخل رحله ، ودخلت أنا المسجد ، فجلست كئيبا حزينا ، فخرج علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تطهر ، فقال : عليك السلام ورحمة الله ، وعليك السلام ورحمة الله ، وعليك السلام ورحمة الله ، ثم قال : ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بأخير سورة في القرآن ؟ قلت : بلى يا رسول الله . قال : اقرأ : الحمد لله رب العالمين ، حتى تختمها . هذا إسناد جيد ، وابن عقيل تحتج به الأئمة الكبار ، وعبد الله بن جابر هذا هو الصحابي ، ذكر ابن الجوزي أنه هو العبدي ، والله أعلم . ويقال : إنه عبد الله بن جابر الأنصاري البياضي ، فيما ذكره الحافظ ابن عساكر . واستدلوا بهذا الحديث وأمثاله على تفاضل بعض الآيات والسور على بعض ، كما هو المحكي عن كثير من العلماء ، منهم : إسحاق بن راهويه ، وأبو بكر بن العربي ، وابن الحصار من المالكية . وذهبت طائفة أخرى إلى أنه لا تفاضل في ذلك ؛ لأن الجميع كلام الله ، ولئلا يوهم التفضيل نقص المفضل عليه ، وإن كان الجميع فاضلا ، نقله القرطبي عن الأشعري ، وأبي بكر الباقلاني ، وأبي حاتم بن حبان البستي ، ويحيى بن يحيى ، ورواية عن الإمام مالك [ أيضا ] .
حديث آخر : قال البخاري في فضائل القرآن : حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا وهب ، حدثنا هشام ، عن محمد بن معبد ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : كنا في مسير لنا ، فنزلنا ، فجاءت جارية فقالت : إن سيد الحي سليم ، وإن نفرنا غيب ، فهل منكم راق ؟ فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية ، فرقاه ، فبرئ ، فأمر له بثلاثين شاة ، وسقانا لبنا ، فلما رجع قلنا له : أكنت تحسن رقية ، أو كنت ترقي ؟ قال : لا ما رقيت إلا بأم الكتاب ، قلنا : لا تحدثوا شيئا حتى نأتي ، أو نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : وما كان يدريه أنها رقية ، اقسموا واضربوا لي بسهم .
وقال أبو معمر : حدثنا عبد الوارث ، حدثنا هشام ، حدثنا محمد بن سيرين ، حدثني معبد بن سيرين ، عن أبي سعيد الخدري بهذا .
وهكذا رواه مسلم ، وأبو داود من رواية هشام ، وهو ابن حسان ، عن ابن سيرين ، به . وفي بعض روايات مسلم لهذا الحديث : أن أبا سعيد هو الذي رقى ذلك السليم ، يعني : اللديغ ، يسمونه بذلك تفاؤلا .
حديث آخر : روى مسلم في صحيحه ، والنسائي في سننه ، من حديث أبي الأحوص سلام بن سليم ، عن عمار بن رزيق ، عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل ، إذ سمع نقيضا فوقه ، فرفع جبريل بصره إلى السماء ، فقال : هذا باب قد فتح من السماء ، ما فتح قط . قال : فنزل منه ملك ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك : فاتحة الكتاب ، وخواتيم سورة البقرة ، ولن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته . وهذا لفظ النسائي .
ولمسلم نحوه حديث آخر : قال مسلم : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، هو ابن راهويه ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن العلاء ، يعني ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : من صلى صلاة لم يقرأ فيها أم القرآن فهي خداج - ثلاثا - غير تمام . فقيل لأبي هريرة : إنا نكون وراء الإمام ، قال : اقرأ بها في نفسك ؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : قال الله عز وجل : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ، ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد : ( الحمد لله رب العالمين ) [ الفاتحة : 2 ] ، قال الله : حمدني عبدي ، وإذا قال : ( الرحمن الرحيم [ الفاتحة : 3 ] ، قال الله : أثنى علي عبدي ، فإذا قال : ( مالك يوم الدين ) [ الفاتحة : 4 ] ، قال مجدني عبدي - وقال مرة : فوض إلي عبدي - فإذا قال : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) [ الفاتحة : 5 ] ، قال : هذا بيني وبين عبدي ، ولعبدي ما سأل ، فإذا قال : ( اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) [ الفاتحة : 6 ، 7 ] ، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل .
وهكذا رواه النسائي ، عن إسحاق بن راهويه . وقد روياه - أيضا - عن قتيبة ، عن مالك ، عن العلاء ، عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة ، عن أبي هريرة ، به وفي هذا السياق : فنصفها لي ونصفها لعبدي ، ولعبدي ما سأل .
وكذا رواه ابن إسحاق ، عن العلاء ، وقد رواه مسلم من حديث ابن جريج ، عن العلاء ، عن أبي السائب هكذا .
ورواه - أيضا - من حديث ابن أبي أويس ، عن العلاء ، عن أبيه وأبي السائب ، كلاهما عن أبي هريرة .
وقال الترمذي : هذا حديث حسن ، وسألت أبا زرعة عنه فقال : كلا الحديثين صحيح ، من قال : عن العلاء ، عن أبيه ، وعن العلاء عن أبي السائب .
وقد روى هذا الحديث عبد الله ابن الإمام أحمد ، من حديث العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن أبي بن كعب مطولا .
قال ابن جرير : حدثنا صالح بن مسمار المروزي ، حدثنا زيد بن الحباب ، حدثنا عنبسة بن سعيد ، عن مطرف بن طريف ، عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ، وله ما سأل ، فإذا قال العبد : ( الحمد لله رب العالمين قال : حمدني عبدي ، وإذا قال : ( الرحمن الرحيم قال : أثنى علي عبدي . ثم قال : هذا لي ، وله ما بقي
وهذا غريب من هذا الوجه .
ثم الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث مما يختص بالفاتحة من وجوه :
أحدها : أنه قد أطلق فيه لفظ الصلاة ، والمراد القراءة كقوله تعالى : ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ) [ الإسراء : 110 ] ، أي : بقراءتك كما جاء مصرحا به في الصحيح ، عن ابن عباس وهكذا قال في هذا الحديث : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ، فنصفها لي ونصفها لعبدي ، ولعبدي ما سأل ثم بين تفصيل هذه القسمة في قراءة الفاتحة في الصلاة فدل على عظم القراءة في الصلاة ، وأنها من أكبر أركانها ، إذ أطلقت العبادة وأريد بها جزء واحد منها وهو القراءة ؛ كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة في قوله : ( وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ) [ الإسراء : 78 ] ، والمراد صلاة الفجر ، كما جاء مصرحا به في الصحيحين : من أنه يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار ، فدل هذا كله على أنه لا بد من القراءة في الصلاة ، وهو اتفاق من العلماء .
ولكن اختلفوا في مسألة نذكرها في الوجه الثاني ، وذلك أنه هل يتعين للقراءة في الصلاة فاتحة الكتاب ، أم تجزئ هي أو غيرها ؟ على قولين مشهورين ، فعند أبي حنيفة ومن وافقه من أصحابه وغيرهم أنها لا تتعين ، بل مهما قرأ به من القرآن أجزأه في الصلاة ، واحتجوا بعموم قوله تعالى : ( فاقرءوا ما تيسر من القرآن ) [ المزمل : 20 ] ، وبما ثبت في الصحيحين ، من حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : إذا قمت إلى الصلاة فكبر ، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن قالوا : فأمره بقراءة ما تيسر ، ولم يعين له الفاتحة ولا غيرها ، فدل على ما قلناه .
والقول الثاني : أنه تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة ، ولا تجزئ الصلاة بدونها ، وهو قول بقية الأئمة : مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم وجمهور العلماء ؛ واحتجوا على ذلك بهذا الحديث المذكور ، حيث قال - صلوات الله وسلامه عليه - : من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج والخداج هو : الناقص كما فسر به في الحديث : غير تمام . واحتجوا - أيضا - بما ثبت في الصحيحين من حديث الزهري ، عن محمود بن الربيع ، عن عبادة بن الصامت ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب . وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن والأحاديث في هذا الباب كثيرة ، ووجه المناظرة هاهنا يطول ذكره ، وقد أشرنا إلى مأخذهم في ذلك ، رحمهم الله .
ثم إن مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم : أنه تجب قراءتها في كل ركعة . وقال آخرون : إنما تجب قراءتها في معظم الركعات ، وقال الحسن وأكثر البصريين : إنما تجب قراءتها في ركعة واحدة من الصلوات ، أخذا بمطلق الحديث : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب .
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي : لا تتعين قراءتها ، بل لو قرأ بغيرها أجزأه لقوله : ( فاقرءوا ما تيسر من القرآن ) [ المزمل : 20 ] ، [ كما تقدم ] والله أعلم .
وقد روى ابن ماجه من حديث أبي سفيان السعدي ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد مرفوعا : لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها . وفي صحة هذا نظر ، وموضح تحرير هذا كله في كتاب الأحكام الكبير ، والله أعلم .
الوجه الثالث : هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم ؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء :
أحدها : أنه تجب عليه قراءتها ، كما تجب على إمامه ؛ لعموم الأحاديث المتقدمة .
والثاني : لا تجب على المأموم قراءة بالكلية لا الفاتحة ولا غيرها ، لا في الصلاة الجهرية ولا السرية ، لما رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ، عن جابر بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ولكن في إسناده ضعف . ورواه مالك ، عن وهب بن كيسان ، عن جابر من كلامه . وقد روي هذا الحديث من طرق ، ولا يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والله أعلم .
والقول الثالث : أنه تجب القراءة على المأموم في السرية ، لما تقدم ، ولا تجب في الجهرية لما ثبت في صحيح مسلم ، عن أبي موسى الأشعري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا قرأ فأنصتوا وذكر بقية الحديث .
وهكذا رواه أهل السنن ؛ أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : وإذا قرأ فأنصتوا . وقد صححه مسلم بن الحجاج أيضا ، فدل هذان الحديثان على صحة هذا القول وهو قول قديم للشافعي ، رحمه الله ، ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل .
والغرض من ذكر هذه المسائل هاهنا بيان اختصاص سورة الفاتحة بأحكام لا تتعلق بغيرها من السور ، والله أعلم .
وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري ، حدثنا غسان بن عبيد ، عن أبي عمران الجوني ، عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا وضعت جنبك على الفراش ، وقرأت فاتحة الكتاب و قل هو الله أحد فقد أمنت من كل شيء إلا الموت
الكلام على تفسير الاستعاذة
قال الله تعالى : ( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم ) [ الأعراف : 199 ، 200 ] ، وقال تعالى : ( ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ) [ المؤمنون : 96 - 98 ] وقال تعالى : ( ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ) [ فصلت : 34 - 36 ] .
فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها ، وهو أن الله يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه ، ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى الموادة والمصافاة ، ويأمر بالاستعاذة به من العدو الشيطاني لا محالة ؛ إذ لا يقبل مصانعة ولا إحسانا ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم ، لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل ؛ كما قال تعالى : ( يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ) [ الأعراف : 27 ] وقال : ( إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ) [ فاطر : 6 ] وقال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ) [ الكهف : 50 ] ، وقد أقسم للوالد إنه لمن الناصحين ، وكذب ، فكيف معاملته لنا وقد قال : ( فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ) ، وقال تعالى : ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ) [ النحل : 98 ، 99 ]
قالت طائفة من القراء وغيرهم : نتعوذ بعد القراءة ، واعتمدوا على ظاهر سياق الآية ، ولدفع الإعجاب بعد فراغ العبادة ؛ وممن ذهب إلى ذلك حمزة فيما ذكره ابن قلوقا عنه ، وأبو حاتم السجستاني ، حكى ذلك أبو القاسم يوسف بن علي بن جبارة الهذلي المغربي في كتاب الكامل .
وروي عن أبي هريرة - أيضا - وهو غريب .
[ ونقله فخر الدين محمد بن عمر الرازي في تفسيره عن ابن سيرين في رواية عنه قال : وهو قول إبراهيم النخعي وداود بن علي الأصبهاني الظاهري ، وحكى القرطبي عن أبي بكر بن العربي عن المجموعة ، عن مالك ، رحمه الله تعالى ، أن القارئ يتعوذ بعد الفاتحة ، واستغربه ابن العربي . وحكى قولا ثالثا وهو الاستعاذة أولا وآخرا جمعا بين الدليلين ، نقله فخر الدين ] .
والمشهور الذي عليه الجمهور أن الاستعاذة لدفع الوسواس فيها ، إنما تكون قبل التلاوة ، ومعنى الآية عندهم : ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ) [ النحل : 98 ] أي : إذا أردت القراءة كقوله : ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية [ المائدة : 6 ] أي : إذا أردتم القيام . والدليل على ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ؛ قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله :
حدثنا محمد بن الحسن بن آتش حدثنا جعفر بن سليمان ، عن علي بن علي الرفاعي اليشكري ، عن أبي المتوكل الناجي ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال : سبحانك اللهم وبحمدك ، وتبارك اسمك ، وتعالى جدك ، ولا إله غيرك . ويقول : لا إله إلا الله ثلاثا ، ثم يقول : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ، من همزه ونفخه ونفثه .
وقد رواه أهل السنن الأربعة من رواية جعفر بن سليمان ، عن علي بن علي ، وهو الرفاعي ، وقال الترمذي : هو أشهر حديث في هذا الباب . وقد فسر الهمز بالموتة وهي الخنق ، والنفخ بالكبر ، والنفث بالشعر . كما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن عاصم العنزي ، عن نافع بن جبير بن مطعم ، عن أبيه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة ، قال : الله أكبر كبيرا ، ثلاثا ، الحمد لله كثيرا ، ثلاثا ، سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا ، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه .
قال عمرو : وهمزه : الموتة ، ونفخه : الكبر ، ونفثه : الشعر .
وقال ابن ماجه : حدثنا علي بن المنذر ، حدثنا ابن فضيل ، حدثنا عطاء بن السائب ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم ، وهمزه ونفخه ونفثه .
قال : همزه : الموتة ، ونفثه : الشعر ، ونفخه : الكبر .
وقال الإمام أحمد : حدثنا إسحاق بن يوسف ، حدثنا شريك ، عن يعلى بن عطاء ، عن رجل حدثه : أنه سمع أبا أمامة الباهلي يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثلاثا ، ثم قال : لا إله إلا الله - ثلاث مرات ، وسبحان الله وبحمده ، ثلاث مرات . ثم قال : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، من همزه ونفخه ونفثه . وقال الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي في مسنده : حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان الكوفي ، حدثنا علي بن هشام بن البريد عن يزيد بن زياد ، عن عبد الملك بن عمير ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن أبي بن كعب ، قال : تلاحى رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فتمزع أنف أحدهما غضبا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني لأعلم شيئا لو قاله ذهب عنه ما يجد : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم .
وكذا رواه النسائي في " اليوم والليلة " ، عن يوسف بن عيسى المروزي ، عن الفضل بن موسى ، عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد ، به .
وقد روى هذا الحديث أحمد بن حنبل ، عن أبي سعيد ، عن زائدة ، وأبو داود عن يوسف بن موسى ، عن جرير بن عبد الحميد ، والترمذي ، والنسائي في " اليوم والليلة " عن بندار ، عن ابن مهدي ، عن الثوري ، والنسائي - أيضا - من حديث زائدة بن قدامة ، ثلاثتهم عن عبد الملك بن عمير ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن معاذ بن جبل ، قال : استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى خيل إلي أن أحدهما يتمزع أنفه من شدة غضبه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب ، قال : ما هي يا رسول الله ؟ قال : يقول : اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم . قال : فجعل معاذ يأمره ، فأبى [ ومحك ] ، وجعل يزداد غضبا . وهذا لفظ أبي داود . وقال الترمذي : مرسل ، يعني أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلق معاذ بن جبل ، فإنه مات قبل سنة عشرين .
قلت : وقد يكون عبد الرحمن بن أبي ليلى سمعه من أبي بن كعب ، كما تقدم وبلغه عن معاذ بن جبل ، فإن هذه القصة شهدها غير واحد من الصحابة ، رضي الله عنهم . قال البخاري : حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا جرير ، عن الأعمش ، عن عدي بن ثابت ، قال : قال سليمان بن صرد : استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ، ونحن عنده جلوس ، فأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد ، لو قال : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، فقالوا للرجل : ألا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إني لست بمجنون .
وقد رواه - أيضا - مع مسلم ، وأبي داود ، والنسائي ، من طرق متعددة ، عن الأعمش ، به .
وقد جاء في الاستعاذة أحاديث كثيرة يطول ذكرها هاهنا ، وموطنها كتاب الأذكار وفضائل الأعمال ، والله أعلم . وقد روي أن جبريل - عليه السلام - أول ما نزل بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بالاستعاذة ، كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير :
حدثنا أبو كريب ، حدثنا عثمان بن سعيد ، حدثنا بشر بن عمارة ، حدثنا أبو روق ، عن الضحاك ، عن عبد الله بن عباس ، قال : أول ما نزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم قال : يا محمد ، استعذ . قال : أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ، ثم قال : قل : بسم الله الرحمن الرحيم . ثم قال : ( اقرأ باسم ربك الذي خلق قال عبد الله : وهي أول سورة أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وسلم ، بلسان جبريل . وهذا الأثر غريب ، وإنما ذكرناه ليعرف ، فإن في إسناده ضعفا وانقطاعا ، والله أعلم .
مسألة : وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة ليست بمتحتمة يأثم تاركها ، وحكى فخر الدين عن عطاء بن أبي رباح وجوبها في الصلاة وخارجها كلما أراد القراءة قال : وقال ابن سيرين : إذا تعوذ مرة واحدة في عمره فقد كفى في إسقاط الوجوب ، واحتج فخر الدين لعطاء بظاهر الآية : فاستعذ وهو أمر ظاهره الوجوب وبمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها ، ولأنها تدرأ شر الشيطان وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، ولأن الاستعاذة أحوط وهو أحد مسالك الوجوب . وقال بعضهم : كانت واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته ، وحكي عن مالك أنه لا يتعوذ في المكتوبة ويتعوذ لقيام شهر رمضان في أول ليلة منه .
مسألة : وقال الشافعي في الإملاء ، يجهر بالتعوذ حكم الجهر بالاستعاذة ، وإن أسر فلا يضر ، وقال في الأم بالتخيير لأنه أسر ابن عمر وجهر أبو هريرة ، واختلف قول الشافعي فيما عدا الركعة الأولى : هل يستحب التعوذ فيها ؟ على قولين ، ورجح عدم الاستحباب ، والله أعلم . فإذا قال المستعيذ : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كفى ذلك عند الشافعي وأبي حنيفة وزاد بعضهم : أعوذ بالله السميع العليم ، وقال آخرون : بل يقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، إن الله هو السميع العليم ، قاله الثوري والأوزاعي وحكي عن بعضهم أنه يقول : أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ؛ لمطابقة أمر الآية ، ولحديث الضحاك عن ابن عباس المذكور ، والأحاديث الصحيحة - كما تقدم - أولى بالاتباع من هذا ، والله أعلم .
مسألة : ثم الاستعاذة في الصلاة إنما هي للتلاوة وهو قول أبي حنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف : بل للصلاة ، فعلى هذا يتعوذ المأموم وإن كان لا يقرأ ، ويتعوذ في العيد بعد الإحرام وقبل تكبيرات العيد ، والجمهور بعدها قبل القراءة .
ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث ، وتطييب له وتهيؤ لتلاوة كلام الله وهي استعانة بالله واعتراف له بالقدرة وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطني الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي خلقه ، ولا يقبل مصانعة ، ولا يدارى بالإحسان ، بخلاف العدو من نوع الإنسان كما دلت على ذلك آيات القرآن في ثلاث من المثاني ، وقال تعالى : ( إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ) [ الإسراء : 65 ] ، وقد نزلت الملائكة لمقاتلة العدو البشري يوم بدر ، ومن قتله العدو البشري كان شهيدا ، ومن قتله العدو الباطني كان طريدا ، ومن غلبه العدو الظاهر كان مأجورا ، ومن قهره العدو الباطن كان مفتونا أو موزورا ، ولما كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه استعاذ منه بالذي يراه ولا يراه الشيطان .
فصل : والاستعاذة معناها : هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر ، والعياذة تكون لدفع الشر ، واللياذ يكون لطلب جلب الخير كما قال المتنبي :
يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به ممن أحاذره لا يجبر الناس عظما أنت كاسره
ولا يهيضون عظما أنت جابره
فصل معنى الاستعاذة
ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، أي : أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي ، أو يصدني عن فعل ما أمرت به ، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه ؛ فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله ؛ ولهذا أمر الله تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته بإسداء الجميل إليه ، ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى ، وأمر بالاستعاذة به من شيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل ؛ لأنه شرير بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه ، وهذا المعنى في ثلاث آيات من القرآن لا أعلم لهن رابعة ، قوله في الأعراف : ( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) [ الأعراف : 199 ] ، فهذا فيما يتعلق بمعاملة الأعداء من البشر ، ثم قال : ( وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم ) [ الأعراف : 200 ] ، وقال تعالى في سورة " قد أفلح المؤمنون " : ( ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ) [ المؤمنون : 96 - 98 ] ، وقال تعالى في سورة حم السجدة : ( ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ) [ فصلت : 34 - 36 ] .
والشيطان معناه في لغة العرب مشتق من شطن إذا بعد ، فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر ، وبعيد بفسقه عن كل خير ، وقيل : مشتق من شاط لأنه مخلوق من نار ، ومنهم من يقول : كلاهما صحيح في المعنى ، ولكن الأول أصح ، وعليه يدل كلام العرب ؛ قال أمية بن أبي الصلت في ذكر ما أوتي سليمان ، عليه السلام :
أيما شاطن عصاه عكاه ثم يلقى في السجن والأغلال
فقال : أيما شاطن ، ولم يقل : أيما شائط .
وقال النابغة الذبياني - وهو : زياد بن عمرو بن معاوية بن جابر بن ضباب بن يربوع بن مرة بن سعد بن ذبيان - :
نأت بسعاد عنك نوى شطون فبانت والفؤاد بها رهين
يقول : بعدت بها طريق بعيدة .
[ وقال سيبويه : العرب تقول : تشيطن فلان إذا فعل فعل الشيطان ولو كان من شاط ، لقالوا : تشيط ] . والشيطان مشتق من البعد على الصحيح ؛ ولهذا يسمون كل ما تمرد من جني وإنسي وحيوان شيطانا ، قال الله تعالى : ( وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ) [ الأنعام : 112 ] . وفي مسند الإمام أحمد ، عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أبا ذر ، تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن ، فقلت : أوللإنس شياطين ؟ قال : نعم . وفي صحيح مسلم عن أبي ذر - أيضا - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود . فقلت : يا رسول الله ، ما بال الكلب الأسود من الأحمر والأصفر فقال : الكلب الأسود شيطان . وقال ابن وهب : أخبرني هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، أن عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، ركب برذونا ، فجعل يتبختر به ، فجعل يضربه فلا يزداد إلا تبخترا ، فنزل عنه ، وقال : ما حملتموني إلا على شيطان ، ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي . إسناده صحيح .
والرجيم معناه : فعيل بمعنى مفعول ، أي : أنه مرجوم مطرود عن الخير كله ، كما قال تعالى : ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين ) [ الملك : 5 ] ، وقال تعالى : ( إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملإ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب ) [ الصافات : 6 - 10 ] ، وقال تعالى : ( ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين ) [ الحجر : 16 - 18 ] ، إلى غير ذلك من الآيات . [ وقيل : رجيم بمعنى راجم ؛ لأنه يرجم الناس بالوساوس والربائث والأول أشهر ] .
" بسم الله الرحمن الرحيم " افتتح بها الصحابة كتاب الله ، واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل ، ثم اختلفوا : هل هي آية مستقلة بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورة ، أو من أول كل سورة كتبت في أولها ، أو أنها بعض آية من أول كل سورة ، أو أنها كذلك في الفاتحة دون غيرها ، أو أنها [ إنما ] كتبت للفصل ، لا أنها آية ؟ على أقوال للعلماء سلفا وخلفا ، وذلك مبسوط في غير هذا الموضع .
وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح ، عن ابن عباس ، رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم وأخرجه الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في مستدركه أيضا ، وروي مرسلا عن سعيد بن جبير . وفي صحيح ابن خزيمة ، عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ البسملة في أول الفاتحة في الصلاة وعدها آية ، لكنه من رواية عمر بن هارون البلخي ، وفيه ضعف ، عن ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ، عنها . وروى له الدارقطني متابعا ، عن أبي هريرة مرفوعا . وروى مثله عن علي وابن عباس وغيرهما . وممن حكي عنه أنها آية من كل سورة إلا " براءة " : ابن عباس ، وابن عمر ، وابن الزبير ، وأبو هريرة ، وعلي . ومن التابعين : عطاء ، وطاوس ، وسعيد بن جبير ، ومكحول ، والزهري ، وبه يقول عبد الله بن المبارك ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، في رواية عنه ، وإسحاق بن راهويه ، وأبو عبيد القاسم بن سلام ، رحمهم الله . وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما : ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور ، وقال الشافعي في قول ، في بعض طرق مذهبه : هي آية من الفاتحة وليست من غيرها ، وعنه أنها بعض آية من أول كل سورة ، وهما غريبان .
وقال داود : هي آية مستقلة في أول كل سورة لا منها ، وهذه رواية عن الإمام أحمد بن حنبل . وحكاه أبو بكر الرازي ، عن أبي الحسن الكرخي ، وهما من أكابر أصحاب أبي حنيفة ، رحمهم الله . هذا ما يتعلق بكونها من الفاتحة أم لا . فأما ما يتعلق بالجهر بها بسم الله الرحمن الرحيم ، فمفرع على هذا ؛ فمن رأى أنها ليست من الفاتحة فلا يجهر بها ، وكذا من قال : إنها آية من أولها ، وأما من قال بأنها من أوائل السور فاختلفوا ؛ فذهب الشافعي ، رحمه الله ، إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة ، وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلفا وخلفا ، فجهر بها من الصحابة أبو هريرة ، وابن عمر ، وابن عباس ، ومعاوية ، وحكاه ابن عبد البر ، والبيهقي عن عمر وعلي ، ونقله الخطيب عن الخلفاء الأربعة ، وهم : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ، وهو غريب . ومن التابعين : عن سعيد بن جبير ، وعكرمة ، وأبي قلابة ، والزهري ، وعلي بن الحسين ، وابنه محمد ، وسعيد بن المسيب ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، وسالم ، ومحمد بن كعب القرظي ، وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، وأبي وائل ، وابن سيرين ، ومحمد بن المنكدر ، وعلي بن عبد الله بن عباس ، وابنه محمد ، ونافع مولى ابن عمر ، وزيد بن أسلم ، وعمر بن عبد العزيز ، والأزرق بن قيس ، وحبيب بن أبي ثابت ، وأبي الشعثاء ، ومكحول ، وعبد الله بن معقل بن مقرن . زاد البيهقي : وعبد الله بن صفوان ، ومحمد ابن الحنفية . زاد ابن عبد البر : وعمرو بن دينار .
والحجة في ذلك أنها بعض الفاتحة ، فيجهر بها كسائر أبعاضها ، وأيضا فقد روى النسائي في سننه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما ، والحاكم في مستدركه ، عن أبي هريرة أنه صلى فجهر في قراءته بالبسملة ، وقال بعد أن فرغ : إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم . وصححه الدارقطني والخطيب والبيهقي وغيرهم .
وروى أبو داود والترمذي ، عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم . ثم قال الترمذي : وليس إسناده بذاك .
وقد رواه الحاكم في مستدركه ، عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، ثم قال : صحيح وفي صحيح البخاري ، عن أنس بن مالك أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : كانت قراءته مدا ، ثم قرأ " بسم الله الرحمن الرحيم " ، يمد " بسم الله " ، ويمد " الرحمن " ، ويمد " الرحيم .
وفي مسند الإمام أحمد ، وسنن أبي داود ، وصحيح ابن خزيمة ، ومستدرك الحاكم ، عن أم سلمة ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته : ( بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين . وقال الدارقطني : إسناده صحيح .
وروى الشافعي ، رحمه الله ، والحاكم في مستدركه ، عن أنس : أن معاوية صلى بالمدينة ، فترك البسملة ، فأنكر عليه من حضره من المهاجرين ذلك ، فلما صلى المرة الثانية بسمل .
وفي هذه الأحاديث ، والآثار التي أوردناها كفاية ومقنع في الاحتجاج لهذا القول عما عداها ، فأما المعارضات والروايات الغريبة ، وتطريقها ، وتعليلها وتضعيفها ، وتقريرها ، فله موضع آخر .
وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة ، وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مغفل ، وطوائف من سلف التابعين والخلف ، وهو مذهب أبي حنيفة ، والثوري ، وأحمد بن حنبل .
وعند الإمام مالك : أنه لا يقرأ البسملة بالكلية ، لا جهرا ولا سرا ، واحتجوا بما في صحيح مسلم ، عن عائشة ، رضي الله عنها ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير ، والقراءة ب الحمد لله رب العالمين . وبما في الصحيحين ، عن أنس بن مالك ، قال : صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر وعمر وعثمان ، فكانوا يستفتحون ب الحمد لله رب العالمين . ولمسلم : لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها . ونحوه في السنن عن عبد الله بن مغفل ، رضي الله عنه .
فهذه مآخذ الأئمة - رحمهم الله - في هذه المسألة وهي قريبة ؛ لأنهم أجمعوا على صحة صلاة من جهر بالبسملة ومن أسر ، ولله الحمد والمنة .
قال الإمام العالم الحبر العابد أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم ، رحمه الله ، في تفسيره : حدثنا أبي ، حدثنا جعفر بن مسافر ، حدثنا زيد بن المبارك الصنعاني ، حدثنا سلام بن وهب الجندي ، حدثنا أبي ، عن طاوس ، عن ابن عباس ؛ أن عثمان بن عفان سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بسم الله الرحمن الرحيم . فقال : هو اسم من أسماء الله ، وما بينه وبين اسم الله الأكبر ، إلا كما بين سواد العينين وبياضهما من القرب .
وهكذا رواه أبو بكر بن مردويه ، عن سليمان بن أحمد ، عن علي بن المبارك ، عن زيد بن المبارك ، به .
وقد روى الحافظ ابن مردويه من طريقين ، عن إسماعيل بن عياش ، عن إسماعيل بن يحيى ، عن مسعر ، عن عطية ، عن أبي سعيد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن عيسى ابن مريم أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه ، فقال المعلم : اكتب ، قال ما أكتب ؟ قال : باسم الله ، قال له عيسى : وما باسم الله ؟ قال المعلم : ما أدري . قال له عيسى : الباء بهاء الله ، والسين سناؤه ، والميم مملكته ، والله إله الآلهة ، والرحمن رحمن الدنيا والآخرة ، والرحيم رحيم الآخرة
وقد رواه ابن جرير من حديث إبراهيم بن العلاء الملقب : زبريق ، عن إسماعيل بن عياش ، عن إسماعيل بن يحيى ، عن ابن أبي مليكة ، عمن حدثه ، عن ابن مسعود ، ومسعر ، عن عطية ، عن أبي سعيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكره . وهذا غريب جدا ، وقد يكون صحيحا إلى من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويكون من الإسرائيليات لا من المرفوعات ، والله أعلم .
وقد روى جويبر ، عن الضحاك ، نحوه من قبله .
وقد روى ابن مردويه ، من حديث يزيد بن خالد ، عن سليمان بن بريدة ، وفي رواية عن عبد الكريم أبي أمية ، عن ابن بريدة ، عن أبيه ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أنزلت علي آية لم تنزل على نبي غير سليمان بن داود وغيري ، وهي بسم الله الرحمن الرحيم .
وروى بإسناده عن عبد الكبير بن المعافى بن عمران ، عن أبيه ، عن عمر بن ذر ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن جابر بن عبد الله ، قال : لما نزل بسم الله الرحمن الرحيم هرب الغيم إلى المشرق ، وسكنت الرياح ، وهاج البحر ، وأصغت البهائم بآذانها ، ورجمت الشياطين من السماء ، وحلف الله تعالى بعزته وجلاله ألا يسمى اسمه على شيء إلا بارك فيه .
[ وقال وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال : من أراد أن ينجيه الله من الزبانية التسعة عشر فليقرأ : بسم الله الرحمن الرحيم ، ليجعل الله له من كل حرف منها جنة من كل واحد ، ذكره ابن عطية والقرطبي ووجهه ابن عطية ونصره بحديث : فقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها لقول الرجل : ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ، من أجل أنها بضعة وثلاثون حرفا وغير ذلك ] .
وقال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده : حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن عاصم ، قال : سمعت أبا تميمة يحدث ، عن رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال : عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فقلت : تعس الشيطان . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تقل تعس الشيطان . فإنك إذا قلت : تعس الشيطان تعاظم ، وقال : بقوتي صرعته ، وإذا قلت : باسم الله ، تصاغر حتى يصير مثل الذباب .
هكذا وقع في رواية الإمام أحمد وقد روى النسائي في اليوم والليلة ، وابن مردويه في تفسيره ، من حديث خالد الحذاء ، عن أبي تميمة هو الهجيمي ، عن أبي المليح بن أسامة بن عمير ، عن أبيه ، قال : كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وقال : لا تقل هكذا ، فإنه يتعاظم حتى يكون كالبيت ، ولكن قل : بسم الله ، فإنه يصغر حتى يكون كالذبابة . فهذا من تأثير بركة بسم الله ؛ ولهذا تستحب في أول كل عمل بسم ا
تفسير الطبري :
التفسير الميسّر:
تفسير السعدي
{ بِسْمِ اللَّهِ } أي: أبتدئ بكل اسم لله تعالى, لأن لفظ { اسم } مفرد مضاف, فيعم جميع الأسماء [الحسنى]. { اللَّهِ } هو المألوه المعبود, المستحق لإفراده بالعبادة, لما اتصف به من صفات الألوهية وهي صفات الكمال. { الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ } اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء, وعمت كل حي, وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله. فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة, ومن عداهم فلهم نصيب منها. واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها, الإيمان بأسماء الله وصفاته, وأحكام الصفات. فيؤمنون مثلا, بأنه رحمن رحيم, ذو الرحمة التي اتصف بها, المتعلقة بالمرحوم. فالنعم كلها, أثر من آثار رحمته, وهكذا في سائر الأسماء. يقال في العليم: إنه عليم ذو علم, يعلم [به] كل شيء, قدير, ذو قدرة يقدر على كل شيء.
تفسير البغوي
( بسم الله الرحمن الرحيم ) بسم الله الباء أداة تخفض ما بعدها مثل من وعن والمتعلق به الباء محذوف لدلالة الكلام عليه تقديره أبدأ بسم الله أو قل بسم الله . وأسقطت الألف من الاسم طلبا للخفة وكثرة استعمالها وطولت الباء قال القتيبي ليكون افتتاح كلام كتاب الله بحرف معظم كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول لكتابه طولوا الباء وأظهروا السين وفرجوا بينهما ودوروا الميم . تعظيما لكتاب الله تعالى وقيل لما أسقطوا الألف ردوا طول الألف على الباء ليكون دالا على سقوط الألف ألا ترى أنه لما كتبت الألف في " اقرأ باسم ربك " ( 1 - العلق ) ردت الباء إلى صيغتها ولا تحذف الألف إذا أضيف الاسم إلى غير الله ولا مع غير الباء .
والاسم هو المسمى وعينه وذاته قال الله تعالى : " إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى " ( 7 - مريم ) أخبر أن اسمه يحيى ثم نادى الاسم فقال : يا يحيى " وقال : ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها " ( 40 - يوسف ) وأراد الأشخاص المعبودة لأنهم كانوا يعبدون المسميات وقال : سبح اسم ربك " ( 1 - الأعلى ) ، وتبارك اسم ربك " ثم يقال للتسمية أيضا اسم فاستعماله في التسمية أكثر من المسمى فإن قيل ما معنى التسمية من الله لنفسه؟ قيل هو تعليم للعباد كيف يفتتحون القراءة .
واختلفوا في اشتقاقه قال المبرد من البصريين هو مشتق من السمو وهو العلو فكأنه علا على معناه وظهر عليه وصار معناه تحته وقال ثعلب من الكوفيين : هو من الوسم والسمة وهي العلامة وكأنه علامة لمعناه والأول أصح لأنه يصغر على السمي ولو كان من السمة لكان يصغر على الوسيم كما يقال في الوعد وعيد ويقال في تصريفه سميت ولو كان من الوسم لقيل وسمت . قوله تعالى " الله " قال الخليل وجماعة هو اسم علم خاص لله عز وجل لا اشتقاق له كأسماء الأعلام للعباد مثل زيد وعمرو . وقال جماعة هو مشتق ثم اختلفوا في اشتقاقه فقيل من أله إلاهة أي عبد عبادة وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما " ويذرك وآلهتك " ( 127 - الأعراف ) أي عبادتك - معناه أنه مستحق للعبادة دون غيره وقيل أصله إله قال الله عز وجل " وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق " ( 91 - المؤمنون ) قال المبرد : هو من قول العرب ألهت إلى فلان أي سكنت إليه قال الشاعر
ألهت إليها والحوادث جمة
فكأن الخلق يسكنون إليه ويطمئنون بذكره ويقال ألهت إليه أي فزعت إليه قال الشاعر
ألهت إليها والركائب وقف
وقيل أصل الإله " ولاه " فأبدلت الواو بالهمزة مثل وشاح وإشاح اشتقاقه من الوله لأن العباد يولهون إليه أي يفزعون إليه في الشدائد ويلجئون إليه في الحوائج كما يوله كل طفل إلى أمه وقيل هو من الوله وهو ذهاب العقل لفقد من يعز عليك .
قوله ( الرحمن الرحيم ) قال ابن عباس رضي الله عنهما هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر . واختلفوا فيهما منهم من قال هما بمعنى واحد مثل ندمان ونديم ومعناهما ذو الرحمة وذكر أحدهما بعد الآخر تطميعا لقلوب الراغبين . وقال المبرد : هو إنعام بعد إنعام وتفضل بعد تفضل ومنهم من فرق بينهما فقال الرحمن بمعنى العموم والرحيم بمعنى الخصوص . فالرحمن بمعنى الرزاق في الدنيا وهو على العموم لكافة الخلق . والرحيم بمعنى المعافي في الآخرة والعفو في الآخرة للمؤمنين على الخصوص ولذلك قيل في الدعاء يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة فالرحمن من تصل رحمته إلى الخلق على العموم والرحيم من تصل رحمته إليهم على الخصوص ولذلك يدعى غير الله رحيما ولا يدعى غير الله رحمن . فالرحمن عام المعنى خاص اللفظ والرحيم عام اللفظ خاص المعنى والرحمة إرادة الله تعالى الخير لأهله . وقيل هي ترك عقوبة من يستحقها وإسداء الخير إلى من لا يستحق فهي على الأول صفة ذات وعلى الثاني صفة ( فعل ) .
واختلفوا في آية التسمية فذهب قراء المدينة والبصرة وفقهاء الكوفة إلى أنها ليست من فاتحة الكتاب ولا من غيرها من السور والافتتاح بها للتيمن والتبرك . وذهب قراء مكة والكوفة وأكثر فقهاء الحجاز إلى أنها من الفاتحة وليست من سائر السور وأنها كتبت للفصل وذهب جماعة إلى أنها من الفاتحة ومن كل سورة إلا سورة التوبة وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي لأنها كتبت في المصحف بخط سائر القرآن .
واتفقوا على أن الفاتحة سبع آيات فالآية الأولى عند من يعدها من الفاتحة ( بسم الله الرحمن الرحيم ) وابتداء الآية الأخيرة ( صراط الذين ) ومن لم يعدها من الفاتحة قال ابتداؤها " الحمد لله رب العالمين " وابتداء الآية الأخيرة " غير المغضوب عليهم " واحتج من جعلها من الفاتحة ومن السور بأنها كتبت في المصحف بخط القرآن وبما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي أنا أبو محمد عبد العزيز بن أحمد الخلال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا عبد المجيد عن ابن جريج قال أخبرني أبي عن سعيد بن جبير ( قال ) " ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم " ( 87 - الحجر ) هي أم القرآن قال أبي وقرأها علي سعيد بن جبير حتى ختمها ثم قال : بسم الله الرحمن الرحيم " الآية السابعة قال سعيد : قرأتها على ابن عباس كما قرأتها عليك ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة ، قال ابن عباس : فذخرها لكم فما أخرجها لأحد قبلكم .
الإعراب:
(اسْمَ) ذهب أهل البصرة في اشتقاقه إلى أنه مشتق من السمو وهو العلو بينما ذهب أهل الكوفة إلى أنه مشتق من السمة وهي العلامة- وحذفت الألف في البسملة لكثرة استعمالها.
(الرَّحْمنِ) وزنه فعلان وفيه معنى المبالغة، ولا يوصف به إلا اللّه تعالى.
(الرَّحِيمِ) وزنه فعيل وفيه كذلك معنى المبالغة.
(بِسْمِ) جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره ابتدئ أو بخبر محذوف تقديره ابتدائي (اللَّهِ) لفظ الجلالة مضاف إليه.
(الرَّحْمنِ) صفة للّه.
(الرَّحِيمِ) صفة ثانية.
وجملة البسملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب.