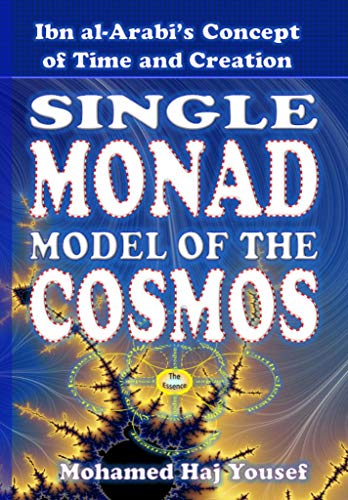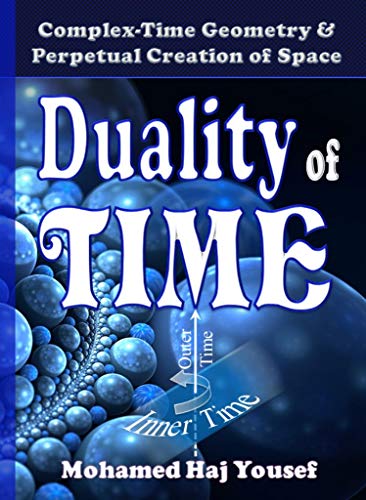كتاب جواهر النصوص
في حل كلمات الفصوص
تأليف: الشيخ عبد الغني النابلسي
فص حكمة علوية في كلمة موسوية
 |
 |
فص حكمة علوية في كلمة موسوية
25 - فص حكمة علوية في كلمة موسوية .شرح جواهر النصوص في حل كلمات الفصوص الشيخ عبد الغني النابلسي
كتاب جواهر النصوص في حل كلمات الفصوص الشيخ عبد الغني النابلسي على فصوص الحكم الشيخ الأكبر محيي الدين ابن العربي
هذ فص الحكمة الموسوية ، ذكره بعد حكمة هارون عليه السلام ، لأن اللّه تعالى وهبه رحمة لأخيه موسى عليهما السلام كما قال تعالى :وَوَهَبْنا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنا أَخاهُ هارُونَ نَبِيًّ( 53 ) [ مريم:53].
والرحمة سابقة على المرحوم بها ولأنه أكبر من موسى عليه السلام في السن فهو مقدم عليه في الذكر فيوجد قبله في الرسم .
قال صلى اللّه عليه وسلم : « الأكبر من الأخوة بمنزلة الأب » . رواه الطبراني في المعجم الكبير ورواه ابن عبد البر في الاسيتعاب ورواه غيرهم .
فص حكمة علوية منسوبة إلى العلووهو الرفعة والشرف في كلمة موسوية .
" قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى (68) سورة طه "
إنم اختصت حكمة موسى عليه السلام بكونها علوية لارتفاعها على حكمة أخيه وشرفه عليها ، فإن نبوة موسى عليه السلام أكبر وأعظم من نبوة أخيه هارون عليه السلام لتبعيته له .
قال تعالى : سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ [ القصص : 35 ] وما شد به العضد كان تابع .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( حكمة قتل الأبناء من أجل موسى عليه السلام لتعود إليه بالإمداد حياة كلّ من قتل لأجله لأنّه قتل على أنّه موسى . وما ثمّ جهل ، فلا بدّ أن تعود حياته على موسى عليه السّلام أعني حياة المقتول من أجله وهي حياة طاهرة على الفطرة لم تدنّسها الأغراض النّفسيّة ، بل هي على فطرة "بلى " . فكان موسى مجموع حياة من قتل على أنّه هو؛ فكلّ م كان مهيّئا لذلك المقتول ممّا كان استعداد روحه له، كان في موسى عليه السّلام .
وهذا اختصاص إلهيّ لموسى لم يكن لأحد قبله .
فإنّ حكم موسى كثيرة فأنا إن شاء اللّه تعالى أسرد منها في هذ الباب على قدر ما يقع به الأمر الإلهيّ في خاطري )
(حكمة) تقدير اللّه تعالى (قتل الأبناء) جمع ابن بأمر فرعون ، فإن الكهنة قالوا لفرعون إنه يولد مولود يكون هلاكك وهلاك قومك على يديه ، فكان يقتل كل مولود يولد حتى قتل أولاد كثيرون لاحتمال أن يكون واحد منهم هو الغلام المذكور ، ثم سلم اللّه تعالى موسى عليه السلام ، ووضعته أمه وحفظه اللّه تعالى من شر عدوّه حتى كان سبب هلاك فرعون وقومه وإغراقهم في البحر بإذن اللّه تعالى ، ولم يمنع الحذر من القدر (من أجل) ظهور (موسى عليه السلام لتعود إليه) ، أي إلى موسى عليه السلام بالإمداد له أي تقوية الروحانية (حياة كل من قتل) من أبناء المذكورين (من أجله) ، أي موسى عليه السلام (لأنه) ، أي كل من قتل إنما قتل بناء (على أنه) ، أي ذلك المقتول (موسى) عليه السلام (وما ثم) ، أي هناك في نفس الأمر (جهل) للحق تعالى بموسى عليه السلام بل قدر اللّه تعالى ذلك على علم منه سبحانه بأن كل مقتول هو غير موسى عليه السلام وتقدير اللّه تعالى ليس بعبث بل كل أفعاله جارية على الحكمة (فل بد أن تعود حياته) ، أي كل مقتول (على موسى) عليه السلام (أعني حياة المقتول من أجله) ، أي موسى عليه السلام (وهي) ، أي تلك الحياة التي لكل مقتول (حياة طاهرة) من الطهارة التي هي ضد الدنس ، أي نظيفة كائنة (على الفطرة) ، أي على الخلقة الأصلية وهي فطرة الإسلام لأنهم كانوا كلما ولد مولود حي ذبحوه .
قال تعالى :فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ[ الروم : 30 ] .
وفي الحديث : كل مولود يولد على الفطرة ولكن أبواه يهوّداته أو ينصرانه أو يمجسانه » .
رواه البخاري ورواه مسلم ورواه غيرهم .
لم تدنسها ، أي تلك الحياة الأغراض بالمعجمة أي الحظوظ والمقاصد النفسية ، أي المنسوبة إلى النفس بل هي ، أي تلك الحياة على فطرة أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى أي نعم أنت ربنا كما قال تعالى : أي خلقة عالم الذر حين جمع اللّه تعالى ذرية آدم عليه السلام وهم كالذر فتجلى عليهم
وقال لهم : وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى شَهِدْنا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّ كُنَّا عَنْ هذا غافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّما أَشْرَكَ آباؤُنا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَ فَتُهْلِكُنا بِما فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ( 173 ) [ الأعراف : 172 - 173 ] .
فكان موسى عليه السلام مجموع حياة كل من قتل ، من الأبناء المذكورين بناء على أنه ، أي
ذلك المقتول هو ، أي موسى عليه السلام فكل ما كان مهيئا بطريق الإمكان لذلك المقتول من الأبناء مما كان استعداد روحه ، أي روح ذلك المقتول له من أنواع الكمال التي لو عاش في الدنيا ذلك المقتول لنافسها ووصل إليها بقوّة روحانيته وقبلتها حقيقته من الجناب المقدس .
كان ذلك في موسى عليه السلام وهذا الأمر المذكور اختصاص إلهي بموسى عليه السلام لم يكن لأحد من الأنبياء عليهم السلام قبله ، أي موسى عليه السلام ،
ولعل هذه هي الحكمة في كثرة الأنبياء في بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام ، وكانو يحكمون بالتوراة فكأنما موسى عليه السلام لما كان مجموع حياة كل من قتل تفرق ذلك المجموع بموت موسى عليه السلام
فكانت كل حياة في نبي من الأنبياء الذين جاؤوا بعد موسى عليه السلام ممدة من تلك الحياة المجموعة ،
فقد روي أن اللّه تعالى بعث بعد موسى عليه السلام إلى عصر عيسى عليه السلام أربعة آلاف نبي ، وقيل : سبعين ألف نبي وكلهم كانوا على دين موسى عليه السلام .
حتى روي عن ابن عباس رضي اللّه عنهم أنه قال : "كل الأنبياء عليهم السلام من بني إسرائيل إلا عشرة : نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ومحمد صلى اللّه عليه وسلم" . رواه الحاكم في المستدرك ورواه الطبراني في الكبير وضياء المقديسي في المختارة والبيهقي وغيرهم.
ول يذهب عليك أن هذا هو التناسخ الباطل ، فإنه مجرد إمداد من حضرة الروح الكل بدلا عن إمداد تلك الأرواح التي انقصرت عن التصرف في أجسامها لعروض الفساد في الأجسام ، وليس هذا انتقال الأرواح كما يزعم أهل التناسخ ؛ ولهذا كانت العبارة هنا بلفظ الحياة والإمداد .
فإنّ حكم جمع حكمة موسى عليه السلام أو ما أودع اللّه تعالى في أحواله ووقائعه من الأسرار كثيرة لا تحصى وأنا إن شاء اللّه تعالى أسرد ، أي أذكر منها ، أي من تلك الحكم في هذا الباب ، أي النوع من أنواع العلم الإلهي على قدر ما يقع به الأمر الإلهي ، أي الإلهام الرباني في خاطري من غير فكر أصلا ، لأن الفكر ظلمة النفس فلا يمكن أن يكتسب بها أحد نور العلم الرباني فكان هذا ، أي ما ذكر من حكمة قتل الأبناء من أجل موسى عليه السلام أوّل ما شوفهت ، أي خوطبت من حضرة الإلهية به في قلبي من هذا الباب ، أي النوع من أنواع العلم الإلهي .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( فما ولد موسى إلّا وهو مجموع أرواح كثيرة وجمع قوى فعّالة لأنّ الصّغير يفعل في الكبير .
ألا ترى الطّفل يفعل في الكبير بالخاصيّة فينزّل الكبير من رياسته إليه فيلاعبه ويزقزق له ويظهر له بعقله .
فهو تحت تسخيره وهو لا يشعر ؛ ثمّ يشغله بتربيته وحمايته وتفقّد مصالحه وتأنيسه حتّى لا يضيق صدره . هذا كلّه من فعل الصّغير بالكبير وذلك لقوّة المقام فإنّ الصّغير حديث عهد بربه لأنّه حديث التّكوين والكبير أبعد . فمن كان من اللّه أقرب سخّر من كان من اللّه أبعد .
كخواصّ الملك للقرب منه يسخّرون الأبعدين . )
فم ولد موسى عليه السلام إلا وهو مجموع أرواح ، أي قوى أرواح لو بقيت في الدنيا تدبر أجسامها لظهرت لها هذه القوى المذكورة بطريق الإمكان كثيرة بعدد استعداد من قتل من الأبناء المذكورين ولهذا قال جمع قوى واحده قوّة لا أنه عليه السلام مجموع تلك الأرواح بعينها وإلا كان تناسخا ، فإن تلك القتلى تحشر يوم القيامة كلها بأرواحها المنفوخة في أجسامها على حسب ما قتلت عليه من أحوال الفطرة لم ينقص منها شيء ، وموسى عليه السلام يحشر أيضا بروحه المنفوخة في جسمه الترابي ولكن روحه مجموعة من قوى فعالة طاهرة من كل دنس ، لأنها كانت قابلة أن تكون قوى لتلك الأرواح الكثيرة المنفوخة في أجسام القتلى من الأبناء المذكورين ، فصرفها اللّه عنها وجعلها لروحانية موسى عليه السلام وإطلاق الأرواح على القوى الفعالة سائغ في الكلام ، فإن قوّة البصر روح العين وقوّة السمع روح الأذن ، وقوّة البطش روح اليد وقوّة المشي روح الرجل ، ونحو ذلك ، فسرها بها قدس اللّه سره بعد ذلك .
فعالة ، تلك القوى بطريق التسخير لا المباشرة لأن الصغير من الأطفال يفعل ، أي يؤثر في نفس الكبير ألا ترى يا أيها السالك الطفل الصغير يفعل ، أي يؤثر في الإنسان الكبير ما يقتضيه حاله بالخاصية المودوعة فيه فينزل الإنسان الكبير في القدر من مقام رياسته وجاهه إليه ، أي إلى ذلك الطفل فيلاعبه بأفعال مخصوصة تعجب ذلك الطفل فيضحك منها ويزقزق ، أي يصوت له ، أي للطفل بصوت يفرحه ويضحكه ويظهر ، أي ذلك الكبير له ، أي للطفل بعقله ، أي بفعل يناسب أفعال عقل ذلك الطفل .
فهو ، أي الكبير تحت تسخيره ، أي تسخير الصغير يسعى في خدمته وإدخال السرور عليه وهو ، أي الكبير لا يشعر بذلك ثم يشغله ،
أي الصغير يشغل الكبير بتربيته حتى يكبر في طعامه وشرابه وكسوته وغسل ثيابه وبدنه من النجاسات والأوساخ وحمايته ، أي حفظه من كل ما يؤذيه وتفقد مصالحه ، أي حوائجه التي تقوم بها مؤونته في كل أحواله وتأنيسه بالكلام وغيره مع محبة بقائه وسلامته حتى لا يضيق صدره ، أي الصغير من أمر من الأمور ومتى أصابه وجع أو مرض أو موت تأسف عليه غاية الأسف وحزن غاية الحزن هذ كله الذي ذكر وغيره أيضا أكثر من ذلك من فعل الصغير بالكبير وقد يخرج بعد ذلك عدو له كما قال تعالى :ي أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْواجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّ لَكُمْ [ التغابن : 14 ] .
وذلك ، أي فعل الصغير إنما كان منه لقوة المقام الذي فيه الصغير والقرب الإلهي الذي هو عليه فإن الصغير حديث ، أي قريب عهد بربه تعالى لأنه حديث جديد التكوين ، أي الخلقة والكبير أبعد منه عهدا بربه ولحدوث معنى الغيرية واستحكامها في نفس الكبير حتى أوجب ذلك بعدا عن خلقته ول وجود لذلك في نفس الصغير بربه فمن كان من اللّه تعالى أقرب ، أي أكثر قربا سخر من كان من اللّه تعالى أبعد ، أي أكثر بعدا ، والقرب من اللّه تعالى هو قرب الخلقة في الصغير ، والكبير أيضا إذا كان من أولي الأمر القائمين بأمر اللّه تعالى بأن غلبت عليه روحانيته وضعفت فيه جسمانيته وزال عنه الالتباس الطبيعي من الخلق الجديد وهي فطرة الإسلام التي فطر عليها الناس كما قال تعالى فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْه[ الروم : 30 ] .
وهي التي غيرها على الصغير صحبة أبويه وأمثاله بوسواس القرين من الشياطين في أنه يريهم ما يرى من جمود الكائنات والتباس الخلق الجديد عليهم ، والبعد من اللّه تعالى هو بعد الالتباس والجهل بالأمر الإلهي والوقوف مع عالم الخلق الظاهر كخواص الملك ، أي السلطان يعني المقربين عنده للقرب ، أي لأجل القرب منه والحظوة لديه يسخرون الأبعدين جمع البعد من بقية الناس فينقادون إليهم رغبة في القرب إلى الملك وقضاء حوائجهم عنده .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يبرز بنفسه للمطر إذا نزل ويكشف رأسه له حتّى يصيب منه ويقول إنّه حديث عهد بربّه . فانظر إلى هذه المعرفة باللّه من هذا النّبيّ ما أجلّها وما أعلاها وأوضحها . فقد سخّر المطر أفضل البشر لقربه من ربّه فكان مثل الرّسول الّذي ينزل إليه بالوحي فدعاه بالحال بذاته إليه ليصيب منه ما أتاه به من ربّه .فلولا ما حصّلت له منه الفائدة الإلهيّة بما أصاب منه ، ما برز بنفسه إليه . فهذه رسالة ماء جعل اللّه منه كلّ شيء حيّ فافهم . )
كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كما ورد عنه في الحديث يبرز ، أي يظهر بنفسه للمطر أوّل ما يكون في السنة إذا نزل من السماء ويكشف رأسه عليه السلام له ، أي لذلك المطر حتى يصيب رأسه منه ويقول عليه السلام إنه ، أي ذلك المطر حديث ، أي "قريب (عهد بربه ") تعالى ، رواه مسلم وأبو داود .
أي هو مخلوق جديد يعلمهم الاحتفال بالخلق الجديد والاحترام له والتبرك به
فانظر ي أيها السالك إلى هذه المعرفة باللّه تعالى من هذا النبي الجليل العظيم صلى اللّه عليه وسلم ما أجلها ، أي هذه المعرفة وما أعظمها وم أوضحه ،
أي أبينها وأكشفها لكل من عنده أدنى ذوق من مشارب أهل اللّه تعالى وما يصدف "يعرض" عنها إلا المتكبرون عن طريق الفقراء الصادقين جهلا منهم بهم .
فقد سخر المطر النازل من السماء أفضل البشر وهو نبينا محمد صلى اللّه عليه وسلم حيث أبرزه له من بيته بنفسه وحمله على كشف رأسه لقربه ،
أي المطر من ربه وحدوث عهده بالخلقة فكان ، أي ذلك المطر مثل الرسول ، أي الملك الذي ينزل من السماء إليه ،
أي إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم بالوحي من اللّه تعالى فدعاه ، أي المطر دعا النبي صلى اللّه عليه وسلم بالحال ،
أي بحال المتلبس به ذلك المطر بذاته التي هو عليها في نفس الأمر مما يعلمه النبي صلى اللّه عليه وسلم ما يعلمه غيره من الحاضرين كما كان يأتيه الملك في صورة رجل أعرابي وفي صورة دحية بن خليفة الكلبي ، فيكون ذلك وحيا إليه من اللّه تعالى ، ولا يعلم به الحاضرون فبرز ، أي ظهر صلى اللّه عليه وسلم إليه ،
أي إلى المطر بنفسه ليصيب عليه السلام منه ، أي من ذلك المطر م أتاه ، أي ذلك المطر به من ربه تعالى من الوحي العلمي .
فلول ما حصّلت له صلى اللّه عليه وسلم منه ، أي المطر الفائدة الإلهية ، أي المنسوبة إلى الإله تعالى بما ، أي بالجزء المطر الذي أصاب صلى اللّه عليه وسلم منه ، أي من ذلك المطر ما برز ، أي ظهر صلى اللّه عليه وسلم بنفسه إليه ،
أي إلى ذلك المطر فهذه ، أي الحكمة المستفادة له صلى اللّه عليه وسلم من المطر رسالة ماء من اللّه تعالى إليه عليه السلام (جعل اللّه تعالى منه)، أي من ذلك الماء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ [ الأنبياء : 30 ].
كم قال تعالى : وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، والحي هو اللّه تعالى .
كم قال سبحانه : هُوَ الْحَيُّ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ[ غافر : 65 ] .
فحصر الحياة فيه تعالى بتعريف الخبر فكل شيء مجعول من الماء هالك إلا وجهه والوجه هو الحي تعالى (فافهم) يا أيها السالك ما تضمنته هذه الرسالة المائية إلى الحضرة المحمدية .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( وأمّا حكمة إلقائه في التّابوت ورميه في اليمّ : فالتّابوت ناسوته ، واليمّ ما حصل له من العلم بواسطة هذا الجسم مما أعطته القوّة النّظريّة الفكريّة والقوى الحسيّة والخياليّة الّتي لا يكون شيء منها ولا من أمثالها لهذه النّفس الإنسانيّة إلا بوجود هذا الجسم العنصريّ .
فلما حصلت النّفس في هذا الجسم وأمرت بالتّصرّف فيه وتدبيره ، جعل اللّه لها هذه القوى آلات تتوصّل بها إلى ما أراده اللّه منها في تدبير هذ التّابوت الّذي فيه سكينة الرّبّ .
فرمي به في اليمّ ليحصل بهذه القوى على فنون العلم .
فأعلمه بذلك أنّه وإن كان الرّوح المدبّر له هو الملك ؛ فإنّه ل يدبّره إلّا به ، فأصحبه هذه القوى الكائنة في هذا النّاسوت الّذي عبّر عنه بالتّابوت في باب الإشارات والحكم . )
وأم حكمة إلقائه ، أي موسى عليه السلام وهو صغير في التابوت من الخشب الذي ألهم اللّه تعالى أمه أن تصنعه له وترضعه وتضعه فيه وحكمة رميه ، أي ذلك التابوت الذي فيه موسى عليه السلام بعد ذلك في اليم ، أي البحر .
كم قال تعالى :وَأَوْحَيْنا إِلى أُمِّ مُوسى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلا تَخافِي وَل تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ( 7 ) [ القصص :7].
وقال تعالى : وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرى ( 37 ) إِذْ أَوْحَيْنا إِلى أُمِّكَ ما يُوحى ( 38 ) أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ[ طه : 37 – 39].
(فالتابوت) بطريق الإشارة (ناسوته) ، أي جسم موسى عليه السلام واليم ، أي البحر ما حصل له ، أي لموسى عليه السلام من العلم الإلهي الشرعي والعقلي بواسطة هذا الجسم الطبيعي العنصري مما أعطته القوّة النظرية ، أي الحاصلة بنظر العقل الفكرية ، أي المنسوبة إلى الفكر والقوى الحسية ، أي الظاهرة في الحواس الخمس والقوى الخيالية كالمصورة والموهمة التي نعت للقوى كلها لا يكون شيء ، أي إدراك وغيره منها ،
أي من تلك القوى ولا من أمثالها من بقية القوى السارية في مواضع في البدن كالقوّة الجاذبة والدافعة والماسكة وغير ذلك لهذه النفس الإنسانية الناطقة التي بها يتميز الإنسان عن بقية الحيوان إلا بوجد هذا الجسم العنصري ، أي المركب من العناصر الأربعة .
فلم حصلت النفس الإنسانية المذكورة في هذا الجسم بالنفخ الإلهي من الروح الأمري وأمرت النفس المذكورة ، أي أذن لها اللّه تعالى بالتصرف فيه ، أي في هذا الجسم وتدبيره في أمر معاشه ومعاده على وفق الحكمة الشرعية جعل اللّه تعالى لها ، أي لتلك النفس هذه القوى المذكورة آلات جمع آلة وهي الأداة التي يستعان بها في العمل المقصود تتوصل تلك النفس به ، أي بتلك الأداة إلى ما أراده اللّه تعالى منها من الأحوال النافعة في تدبير هذا التابوت ، أي الجسم الإنساني الذي فيه ، أي في ذلك التابوت سكينة ، أي هيبة وعظمة الرب تعالى كما حكى تعالى عن فتى موسى يوشع بن نون عليهما السلام لما أخبر بني إسرائيل عن طالوت الملك : وَقالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّ تَرَكَ آلُ مُوسى وَآلُ هارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ [ البقرة : 248 ] .
فرمى تعالى به ، أي بهذا التابوت في اليم ، أي بحر العلم ليحصل ، أي موسى عليه السلام بهذه القوى المذكورة على فنون العلم الإلهي فأعلمه ، أي اعلم تعالى موسى عليه السلام بذلك ، أي برميه في اليم أنه ، أي موسى عليه السلام وإن كان الروح ، أي روحه المدبر له هو الملك القائم بأمر اللّه تعالى فإنه ، أي ذلك الملك لا يدبره إلا به ، أي بموسى عليه السلام فأصحبه ، أي اصحب اللّه تعالى موسى عليه السلام ، أي أبقى له إلى آخر عمره هذه القوى الكائنة ، أي الموجودة في هذا الناسوت ، أي الجسم الذي عبر عنه بالتابوت في الآية المذكورة من باب الإشارات القرآنية والحكم الربانية .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( كذلك تدبير الحقّ العالم فإنّه ما دبّره إلّا به أو بصورته .
فما دبّره إلّا به كتوقّف الولد على إيجاد الوالد ، والمسبّبات على أسبابها ، والمشروطات على شروطها ، والمعلولات على عللها ، والمدلولات على أدلّته ، والمحقّقات على حقائقها . وكلّ ذلك من العالم . وهو تدبير الحقّ فيه فما دبّره إلّا به .
وأمّا قولنا أو بصورته - أعني صورة العالم - فأعني به الأسماء الحسنى والصّفات العلى الّتي تسمّى الحقّ بها واتّصف به . )
كذلك ، أي مثل ذلك تدبير الحق تعالى العالم بفتح اللام بأسره محسوسه ومعقوله وموهومه فإنه ما دبره تعالى إلا به ، أي بالعالم نفسه على حسب ما يقتضيه حاله من القوى المختلفة فيه أو بصورته ، أي العالم التي تسمى اللّه تعالى بها واتصف بها فما دبره أي دبر اللّه تعالى العالم به أي العالم نفسه بل العالم دبر من حيث إنه صورته تعالى نفسه من حيث إنه عالم فإذا دبر الحق تعالى العالم بالعالم توقف بعض العالم على بعض كتوقف وجود الولد على إيجاد الوالد من كل نوع من أنواع الحيوان وتوقف وجود المسببات العادية والشرعية والعقلية على وجود أسبابها كذلك وتوقف وجود المشروطات الشرعية وغيرها على وجود شروطها ، كذلك وتوقف وجود المعلولات العقلية وغيرها على وجود عللها ، كذلك وتوقف وجود المدلولات من كل نوع من حيث هي مدلولات لثبوتها عند المستدل على وجود أدلتها كذلك وتوقف وجود المحققات من كل شيء على وجود حقائقه ، أي ماهياتها ولوازمها الذاتية .
وكل ذلك ، أي المسببات والأسباب والمشروطات والشروط والمعلولات والعلل والمدلولات والأدلة والمحققات والحقائق من جملة العالم بفتح اللام بل هي العالم لا غير ، فالعالم منقسم إلى مؤثر ومتأثر باللّه تعالى لا بنفسه وهو ، أي هذا التدبير من بعض العالم في بعض تدبير الحق تعالى فيه ، أي في العالم فما دبره ، أي دبر اللّه تعالى العالم إلا به ، أي بالعالم من حيث قيام الكل باللّه تعالى .
وأم قولن فيما مر قريبا أو بصورتهأعني صورة العالم يعني أن اللّه تعالى ما دبر العالم إلا بصورة العالم فأعني به ، أي بالمدبر من صورة العالم الأسماء الحسنى الجميلة الجليلة والصفات العلى ، أي المنزهة المقدسة التي تسمى الحق تعالى بها واتصف بها من حيث مراتبه تعالى الوجودية المعتبرة أزلا وأبدا بالنسبة إلى الأعيان الثابتة بأنفسها في العدم الأصلي الموجودة مرتبة كما هي عليه بتلك المراتب الوجودية المذكورة ، فالأعيان عينت المراتب الأسمائية والحضرات الصفاتية من الذات العلية ، والمراتب المذكورة عينت الوجود للأعيان على حسب ما تقتضيه تلك الأعيان فالأزل للمراتب والأبد للأعيان .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( فما وصل إلينا من اسم يسمّى به إلّا وجدنا معنى ذلك الاسم وروحه في العالم . فما دبّر العالم أيضا إلّا بصورة العالم .
ولذلك قال في آدم الّذي هو البرنامج الجامع لنعوت الحضرة الإلهيّة الّتي هي الذات والصّفات والأفعال : « إنّ اللّه خلق آدم على صورته » وليست صورته سوى الحضرة الإلهيّة . فأوجد في هذا المختصر الشّريف الّذي هو الإنسان الكامل جميع الأسماء الإلهيّة وحقائق ما خرج عنه في العالم الكبير المنفصل ( * ) ، وجعله روح للعالم فسخّر له العلو والسّفل لكمال الصّورة)
فم وصل إلينا معشر المكلفين من اسم تسمى به الحق تعالى في القرآن والسنة إلا ووجدنا معنى ذلك الاسم ، أي مقتضاه الظاهر بآثاره كالعليم والقدير ، فإن معناهما الكشف عن الأثر المعدوم ، ثم إفاضة الوجود عليه بحسبه وروحه ، أي سر ذلك الاسم وهو خصوصية الموقوف عليها تأثير الاسم الآخر كجعل الأثر متميز عما سواه في نفسه الثابتة في العدم الأصلي بالاسم العليم ، فإن ذلك روح ، أي سر الاسم العليم زيادة على معناه الذي هو مجرد الكشف عن ذلك وكتحقيق معنى الوجود في الأثر بالاسم القدير فإنه روح ،
أي سر الاسم القدير زيادة على معناه الذي هو مجرد إفاضة الوجود على الأثر المعدوم في هذا العالم المحسوس والمعقول ،
فكل عليم قدير ممن يصنع معنى الاسم العليم ظاهر فيه بالكشف عن معلومه وروح الاسم بتميزه عما سواه ، ومعنى الاسم القدير بإضافة الوجود عليه بنقله من حالة مادية إلى حالة غائية ، كالنجار يفيض الوجود بالصنع للكرسي المقدر في نفسه وهو في مادته التي هي الخشب ، فينتقل ذلك الكرسي من بطون مادته الخشبية إلى ظهور عينه الصورية ، وروح الاسم بتحقيق معنى ذلك الصنع وإثبات صورة الكرسي تامة الهيئة في الحس ، وهكذا في كل صانع وفي جميع الأسماء .
فم دبر ، أي الحق تعالى العالم كله أيضا ، أي زيادة على مجرد تدبيره إلا وهو ظاهر للعالم بصورة العالم ، أي مجموع أسماء العالم وصفاته .
ولذلك ، أي لكون الأمر كذلك قال عليه السلام كما ورد في الحديث في حق آدم عليه السلام الذي هو ، أي آدم عليه السلام الأنموذج وهي كلمة معربة وقد تسمى بالفهرست ومعناها مجموع ما اشتمل عليه الشيء من كل عنوان فيه على نوع من أنواعه الجامع ذلك لنعوت الحضرة الإلهية ، أي عنوانات أنواع مراتبها التي هي ، أي تلك النعوت الذات الواحدة والصفات والأسماء الكثيرة والأفعال الكثيرة إن اللّه تعالى خلق آدم عليه السلام على صورته ، أي صورة اللّه تعالى على التنزيه المطلق ، ويؤيده الرواية الأخرى على صورة الرحمن وليست صورته ،
""ونصه : ( لا تقبحوا الوجه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن ) . رواه الطبراني في الكبير
ورواه الدارقطني ولفظه عنده : ( لا تقبحوا الوجه فإن اللّه خلق آدم على صورة الرحمن عز وجل ) .""
أي اللّه تعالى سوى الحضرة الإلهية التي هي مجمع ذاته تعالى وصفاته وأسمائه وأفعاله وأحكامه ؛ خمس مراتب بعضها أعلى من بعض في حقيقة الوجود المطلق بالإطلاق الحقيقي المنزه عن معرفة العارفين به وجهل الجاهلين له ، لأنه من حيث هو لا يعرف ولا يجهل .
فأوجد سبحانه في هذا المختصر من العالم الكبير الشريف من قوله تعالى : وَلَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ [ الإسراء : 70 ] .
(الذي هو الإنسان الكامل) في الظاهر والباطن (جميع الأسماء الإلهية) ، التي هي مجموع المراتب الخمس المذكورة فله ذات وله صفات وله أسماء وله أفعال وله أحكام مضاهاة للحضرة الإلهية وأوجد تعالى فيه أيضا (حقائق) ، أي ماهيات وأعيان مثل جميع ما خرج عنه ،
أي عن ذلك الإنسان من الأشياء الموجودة (في العالم الكبير المنفصل) عنه عنه ففيه:
سماوات وهي دماغه ،
ونجوم وهي حواسه الظاهرة والباطنة ،
وعرش وهو روحه ،
وكرسي وهو نفسه ،
وقلم هو عقله ،
ولوح هو ذهنه ،
وعوالم ملائكة وهي قواه السارية في بدنه ،
وجن وهي قواه الباطنة منها مطيع ومنه عاص ،
وشياطين وهي قواه الخبيثة في أفعال المعاصي ،
وفيه أرضون وهي جسمه ،
وفيه بحر محيط وهو دمه ،
وجبال وهي عظامه ،
وتلال وهي عروقه ،
ونبات هو شعره ،
وماء حلو في فمه ،
وماء مر في أذنه ،
وماء وسخ في أنفه ،
وماء قذر في بوله ،
وفيه عناصر أربعة :
صفراء هي ناره ،
ودم هو هواه ،
وبلغم هو ماؤه ،
وسوداء هي ترابه ،
وهكذا مما يطول بيانه مضاهاة للعالم الكبير بأسره (وجعله) ، أي جعل اللّه تعالى هذا الإنسان الكامل (روح للعالم) الكبير جميعه (فسخر اللّه) تعالى (له) ، أي لهذ الإنسان الكامل (العلو) من السماوات وما فيها والسفل من الأرضين وم فيهن لكمال الصورة التي هو فيها مضاه للحضرة الإلهية وللعوالم الإمكانية كله .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( فكما أنّه ليس شيء في العالم إلّا وهو يسبّح اللّه بحمده ، كذلك ليس شيء في العالم إلّا وهو مسخّر لهذا الإنسان لما تعطيه حقيقة صورته .
فقال تعالى :" وَسَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ " [ الجاثية : 13 ] فكلّ ما في العالم تحت تسخير الإنسان علم ذلك من علمه - وهو الإنسان الكامل - وجهل ذلك من جهله ، وهو الإنسان الحيوان . )
فكم أنه ، أي الشأن ليس شيء من هذا العالم إلا وهو ، أي ذلك الشيء يسبح اللّه تعالى ، أي ينزهه بحمده ، أي يوصفه تعالى بجميل صفاته وجليلها كما قال تعالى :تُسَبِّحُ لَهُ السَّماواتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ[ الإسراء :44].
كذلك ليس شيء من العالم المسبح للّه تعالى بحمده إلا وهو ، أي ذلك الشيء مسخر لهذا الإنسان الكامل لما ، أي لأجل الذي تعطيه حقيقة صورته ، أي صورة هذا الإنسان الكامل من الجمعية الذاتية والحضرة الإحاطية .
(قال اللّه تعالى :وَسَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ ) من فلك أو ملك ("وَما فِي الْأَرْضِ") من جماد أو نبات أو حيوانات ، وغير ذلك أيضا من عالم الحس والمعاني ، ومن المركبات والمباني جميعا تأكيد لذلك (" مِنْهُ" ) [ الجاثية :13].
أي صادر ذلك من الحق تعالى ، لأنه القيوم على كل شيء فمفهومه شرط للتسخير ، إذ من لم يعرف الحق تعالى في كل شيء فليس بإنسان كامل ، فلا يسخر له ذلك فكل ما في العالم العلوي والسفلي تحت تسخير الإنسان الكامل علم ذلك الأمر من علمه من الناس وهو ، أي الذي يعلمه الإنسان الكامل لا غير وجهل ذلك الأمر من جهله منهم وهو ، أي الذي يجهله الإنسان الناقص الذي غلبت عليه حيوانيته فهو الحيوان
وهو قسمان :
قسم مع جهله مؤمن به مذعن لأهله على الغيب وله السعادة بالتبعية لا بالإضافة ، لأن السعادة بالأصالة للإنسان الكامل لا غير ، ومن ذلك قول الجنيد رضي اللّه عنه : الإيمان بكلام هذه الطائفة ولاية يعني ولاية بطريق التبعية والالتحاق لا الاستقلال .
وقسم مع جهله منكر جاحد ينفي ما لا يعرفه من أحوال أهل الصدق وهو كافر عند اللّه تعالى ، وإن حكم بإسلامه ظاهر في معاملة الدنيا بين الجاهلين مثله الذين لا يعرفون .
قال الشيخ رضي الله عنه : (فكانت صورة إلقاء موسى في التّابوت ، وإلقاء التّابوت في اليمّ صورة هلاك في الظّاهر وفي الباطن كانت نجاة له من القتل . فحيّي كما تحيا النّفوس بالعلم من موت الجهل .
كما قال :أَوَمَنْ كانَ مَيْتاً يعني بالجهل فَأَحْيَيْناهُ يعني بالعلم وَجَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ[ الأنعام : 122 ] وهو الهدى كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ[ الأنعام : 122 ] وهي الضّلال لَيْسَ بِخارِجٍ مِنْها[ الأنعام : 122 ] أي لا يهتدي أبدا : فإنّ الأمر في نفسه لا غاية له يوقف عندها . )
فكانت صورة إلقاء موسى عليه السلام في التابوت وبعد ذلك إلقاء التابوت في اليم ، أي البحر صورة هلاك لموسى عليه السلام مرتين : مرة بإلقائه مع صغره في التابوت ومرة مع إلقائه في البحر وفي الباطن ، أي في سر هذا الأمر كانت تلك الفعلة نجاة له ، أي لموسى عليه السلام من القتل لو ظفر به جماعة فرعون فإنهم كانوا يقتلونه لأمر فرعون وتشديده في ذلك فيحيى موسى عليه السلام بذلك الفعل ، فإنه لما جاء به الموج إلى تحت قصر فرعون أمر بإخراجه ، فإذا فيه غلام صغير فألقى اللّه تعالى الشفقة والمحبة له في قلب فرعون ، فلم يقتله ورباه إلى أن كان منه ما كان .
قال تعالى :وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي[ طه : 39 ] كما تحيا النفوس البشرية بالعلم من موت الجهل كما سبق في معنى إشارة الآية أن
التابوت : جسد موسى عليه السلام ،
والبحر : ما حصل له من العلم بواسطة هذا الجسد فهي حياة علمية ، وفي العبارة حياة حسية
( كما قال) تعالى : (" أَوَمَنْ كانَ مَيْتاً " [ الأنعام : 122 ] يعني بالجهل "فَأَحْيَيْناهُ " بالعلم ) وهو العلم الإلهي ، لأنه اليقين وكل ما سوى الحق تعالى ظن فليس بعلم لعدم اليقين فيه .
ولهذ قال المفسرون من أهل الظاهر في آيات العلم : إن المراد به العلم باللّه تعالى فقالوا في قوله تعالى :إِنَّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ[ فاطر : 28 ] ،
أي العلماء باللّه دون غيرهم . وقال بعضهم : متى شهد نفسه احتجب اللّه عنه بنور وحدانيته المنزهة عن شهود غير معها أصلا ، فلا يكون عارفا بل هو جاهل ، وإن حمل أوقارا من أسفار العلوم ، وإنسانيته إنما هي بنور معرفته ، فمتى ثبت له الجهل انتفت عنه الإنسانية نوبة واحدة .
وجعلن له ، أي للذي أحييناه بالعلم نورا وهو نور اللّه تعالى وجعله ظهور تعلقه به فقيوميته عليه (" يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ ") [ الأنعام : 122 ] كقوله عليه السلام : « اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور اللّه عز وجل » . أخرجه الترمذي عن أبي سعيد الحكيم والطبراني وابن عدي عن أبي أمامة .
وفي رواية ابن جرير عن ثوبان قال عليه السلام : « احذروا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور اللّه وينطق بتوفيق اللّه ». رواه الطبراني والديلمي في الفردوس ورواه غيرهما.
وهو ، أي جعل ذلك النور الهدى ، أي الإرشاد إلى الحق في كل أمر كمن ، أي كالذي مثله ، أي مثاله يعني حاله يشبه حال من هو في الظلمات الحسية كالإنسان في بيت لا منفذ له تحت الأرض بالليل ، فهي ثلاث ظلمات لو انفردت واحدة منها لكانت ظلمة مستقلة وهي ، أي تلك الظلمات الضلال في الاعتقاد والقول والعمل (" لَيْسَ بِخارِجٍ مِنْها ") [ الأنعام : 122].
أي من الظلمات يعني لا يهتدي أبدا لاستحكام الضلال منه حيث كان في اعتقاده فصار على لسانه ثم ظهر في علمه فإن الأمر الإلهي في نفسه لا غاية له من حيث هو أمر اللّه تعالى والغاية للحق القائم به ، فإذا التبس الأمر على أحد فكان ضلالا ، فلم يزل صاحب ذلك الضلال يتقلب في أنواع من ذلك الضلال إلى الأبد إذ لا نهاية لما دخل فيه يوقف عندها ، أي عند تلك الغاية . وفي الهدى كذلك إذ انكشف له أمر اللّه تعالى لا نهاية لهدايته أيض .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( فالهدى هو أن يهتدي الإنسان إلى الحيرة ، فيعلم أنّ الأمر حيرة .
والحيرة قلق وحركة ، والحركة حياة ، فلا سكون ، فلا موت ؛ ووجود ، فلا عدم .
وكذلك في الماء الّذي به حياة الأرض ، وحركتها ، قوله تعالى :اهْتَزَّتْوحملها ، قوله :وَرَبَتْ[ الحج : 5 ] وولادتها قوله :وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ [ الحج : 5 ] . أي أنّه ما ولدت إلّا من يشبهها أي طبيعيّا مثلها . فكانت الزّوجيّة الّتي هي الشّفعيّة لها بما تولّد منها وظهر عنه ).
(فالهدى) المذكور (هو أن يهتدي الإنسان) ، أي يصل (إلى الحيرة) في الحق تعالى ، هل هو الظاهر أو هو الباطن فلا يذهب إلى واحدة منهما وينكر الآخر لورودهما مع في قوله تعالى :"هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْباطِنُ"[ الحديد : 3 ] .
والعقل ينفي اجتماع الضدين والإيمان يقتضي ذلك حيث ثبت بقول الصادق ، فيتجاذب العقل والإيمان طرفي القضية ، فتقع الحيرة في قلب الإنسان بالتنزيه العقلي والتشبيه الإيماني (فيعلم) ،
أي الإنسان أن الأمر الإلهي كله (حيرة) في اللّه تعالى (والحيرة قلق) ، أي انزعاج واضطراب وحركة دائما لعدم القطع بحال يجده المخلوق من صورة أو نفيها في الحس أو العقل أو الوهم ، لأن الكل قائم بالأمر الإلهي الواحد سواء كان صورة حسية أو عقلية أو وهمية أو نفي شيء من ذلك ، لأن النفي صورة أيضا ، لأنه أحد قسمي الحكم العقلي وهما النفي والإثبات والحركة في شيء حياة ، والكل متحرك لأنه يتحرك إلى الوجود ويتحرك إلى العدم فالكل حي فلا سكون لشيء أصل في الحس والعقل والوهم وإن كانت الأجسام جامدة في نظر العقل والحس ، فهو حسبان كم قال تعالى :وَتَرَى الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً[ النمل : 88 ] وهذا ليس مخصوصا بيوم القيامة وإنما المخصوص ظهوره للكل ، فإن أمر اللّه تعالى كلمح بالبصر كما قال سبحانه :وَم أَمْرُنا إِلَّا واحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ [ القمر : 50 ] .
وقال تعالى :وَمِنْ آياتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّماءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ[ الروم : 25 ] فالسماوات والأرض كلمح بالبصر فل موت لشيء أصلا إذ الكل مسبح كما قال تعالى :وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ[ الإسراء : 44 ] ،
والمسبح حي وكل مسبح ملك من الملائكة كما قال تعالى :وَإِنَّ لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ [ الصافات : 166 ] .
وتعريف الخبر يفيد الحصر والحركة وجود أيضا لأنها كون جديد في كل لمحة بالبصر فكل متحرك موجود والكل متحرك فهو موجود فلا عدم لشيء أصلا من وجه حركته وله العدم من وجه سكونه ، لأنه تعالى الظاهر بالوجود ، فأمره الذي هو كلمح بالبصر ظهوره ، والكل باطن فهو ساكن في عين حركة الأمر الإلهي . قال تعالى :وَلَهُ ما سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهارِ[ الأنعام : 13 ] . وهذا الوجه ليس هو صورة الحيرة وإنما صورة الحيرة هو الأوّل .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( كذلك وجود الحقّ كانت الكثرة له وتعدّد الأسماء أنّه كذا وكذا ، بما ظهر عنه من العالم الّذي يطلب بنشأته حقائق الأسماء الإلهيّة .
فثبت به وبخالقه أحديّة الكثرة .
وقد كان أحديّ العين من حيث ذاته كالجوهر الهيولانيّ أحديّ العين من حيث ذاته كثير بالصّور الظّاهرة فيه الذي هو حامل لها بذاته .
كذلك الحقّ بما ظهر منه من صور التّجلّي ، فكان الحقّ مجلى صور العالم مع الأحديّة المعقولة)
وكذلك الحكم في الماء لأنه من جملة الأشياء الذي به ، أي الماء حياة الأرض بالحياة النباتية فإن به تتحرك الأرض حركة حياة وحركتها ، أي الأرض لأن الحركة حياة كما ذكر قوله تعالى :"وَتَرَى الْأَرْضَ هامِدَةً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ"[ الحج : 5 ] .
فاهتزت تحركت وحملها قوله تعالى بعد ذلك ("وَرَبَتْ") ، أي زادت وولادته قوله تعالى بعده ("وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ") ، أي مبتهج من البهجة وهي الحسن أي أنها يعني الأرض (ما ولدت إلا من يشبهها) بعد نزول الماء عليها فإنها صارت به زوجا كأنها أنثى والماء ذكر (أي) مولودا طبيعيا ، أي منسوبا إلى الطبيعة لتركبه منها كالنباتات المختلفة وغيرها من أنواع الحيوانات فإنها مخلوقة من الأرض أيضا بسبب مادة المأكل والمشرب الذي هو أصل النطفة . قال تعالى :وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً [ نوح : 17 ] (مثلها) ، أي مثل الأرض في كونه زوجا ، وهو ظاهر في الحيوانات ، كلها وفي النباتات أيضا ، كالتمر يشتمل على النواة في وسطه والحشيش والساق والورق وشرشه في الأرض ، والسنبل فيه الحب بحيث لا ينبت بشيء من الأرض إلا وهو زوج لا يكون فردا أصل .
(فكانت الزوجية التي هي الشفعية لما يولد منها) ، أي من الأرض كأنواع الحيوانات كلها (وظهر عنها) ، أي عن الأرض كأنواع النباتات والمعادن والأحجار ، فإن منها المليح وضده فهما زوج كذلك ، أي نظير ما ذكر (وجود الحق) تعالى المطلق بالإطلاق الحقيقي كانت ، أي ثبتت الكثرة في المظاهر له ، أي لوجوده تعالى وكان له أيضا (تعداد الأسماء) الإلهية أنه تعالى كذا وكذا ، أي حي عليم قدير إلى آخر الأسماء الحسنى بما متعلق بكانت أي بسبب الذي ظهر عنه تعالى من العالم المختلف بالجنس والنوع والشخص (الذي يطلب بنشأته) ، أي خلقته حقائق الأسماء الإلهية أن يكون آثارا لها وتكون مؤثرة فيه فثبتت أي حقائق الأسماء الإلهية يعني تعينت من ذات الوجود المطلق به ، أي بالعالم الثابت في العدم الأصلي من غير وجود ، فقد ظهرت الأسماء الإلهية عن الوجود المطلق ، وتفرعت حضراتها وتكثرت باعتبار إضافة أعيان العالم الثابتة في عدمها الأصلي إلى ذلك الوجود المطلق وظهر للأسماء الإلهية أيضا آثارا مضافة إليها (ويخالفه) . "" وفي نسخة وبخالقه بدل ويخالفه .""
أي العالم المقتضي للكثرة أحدية تلك الكثرة ، أي كونها واحدة باعتبار صدوره عن الوجود المطلق فإنه واحد أحد ، وهو بهذا الوصف في كل فرد من أجزاء العالم .
(وقد كان) ، أي العالم قبل أن تظهر كثرته المختلفة للحس والعقل والوهم (أحديّ العين) ، أي عينه واحدة كقول من قال : لا يصدر عن الواحد إلا الواحد وكان الأمر كذلك ، وقد صدر عن الواحد واحد ولكن من غير لزوم عليه لأنه يمكن صدور الكثرة عن الواحد ابتداء عندنا لأمر يقتضيه وسع الواجب وعدم القيد فيه لإطلاقه الحقيقي (من حيث ذاته) ، أي العالم يعني مادته الأصلية التي تفرعت أصوله وأركانه منها (كالجوهر) الفرد (الهيولاني أحديّ العين من حيث ذاته) المسمى بنور محمد صلى اللّه عليه وسلم باعتبار كما ورد في مسند عبد الرزاق بسنده عن جابر ،
قال : يا رسول اللّه أخبرني عن أوّل شيء خلقه اللّه تعالى قبل الأشياء .
قال صلى اللّه عليه وسلم : « يا جابر إن اللّه خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره » إلى آخر الحديث .
ويسمى بالقلم الأعلى أيضا باعتبار كما صح في الحديث : « أوّل ما خلق اللّه القلم » .
ويسمى بالعقل كما ورد « أوّل ما خلق اللّه العقل الحديث » .
وللقوم فيه أسماء مختلفة :
منهم من يسميه الجوهر الهيولاني ،
ومنهم من يسميه المادة الأولى ،
ومنهم من يسميه العلم الأوّل ،
ومنهم من يسميه المرآة الحق والحقيقة ،
ومنهم من يسميه المفيض ،
ومنهم من يسميه مركز الدائرة ،
وغير ذلك مما يطول ذكره كثير كثرة مختلفة بالصور الظاهرة فيه حسا وعقلا ووهما الذي نعت للصور هو ،
أي ذلك الجوهر الهيولاني حامل لها ، أي لتلك الصور بذاته ، أي بسبب كون ذاته عين كل صورة مع زيادة تشخص تلك الصورة .
كذلك أي نظير ذلك الحق تعالى بما ، أي بسبب الذي ظهر منه تعالى من صور التجلي الإلهي والانكشاف الرباني فإنه تعالى واحد بذاته كثير بصور تجلياته التي هي مقتضى كثرة أسمائه وصفاته فكان ،
أي الحق تعالى مجلى ، أي موضع انجلاء ظهور وانكشاف صور العالم كلها لها بحيث يرى بعضها بعضا فيه تعالى كالمرآة يرى الإنسان نفسه فيها من غير أن يحل فيها شيء منه ولا يحل فيه شيء منها ولا يتحد كذلك مع ثبوت الأحدية للحق تعالى المعقولة بحيث يؤمن بها العقل غيبا في حال شهوده كثرته .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( فانظر ما أحسن هذا التّعليم الإلهيّ الّذي خصّ اللّه بالاطلاع عليه من شاء من عباده .
ولمّا وجده آل فرعون في اليمّ عند الشّجرة سمّاه فرعون موسى : والمو هو الماء بالقبطيّة ، والسّا هو الشّجر فسمّاه بما وجده عنده ، فإنّ التّابوت وقف عند الشّجرة في اليمّ . فأراد قتله فقالت امرأته - وكانت منطقة بالنّطق الإلهيّ - فيما قالت لفرعون ، إذ كان اللّه خلقها للكمال كما قال عليه السّلام عنها حيث شهد لها ولمريم بنت عمران بالكمال الّذي هو للذّكران ، فقالت لفرعون في حقّ موسى : " قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ " [ القصص : 9 ] . )
فانظر ي أيها السالك ما أحسن هذا التعليم الإلهي من اللّه تعالى ومنا لغيرن الذي خص اللّه تعالى بالاطلاع عليه ، أي بفهمه ومعرفته والتحقق به من شاء ، أي أراده سبحانه من عباده المؤمنين.
(ولم وجده) ، أي موسى عليه السلام وهو موضوع في التابوت (آل فرعون) ، أي قومه (في اليم ) ، أي البحر (عند الشجرة) في حافة البحر (سماه فرعون موسى والمو هو الماء) ، أي اسم الماء بالقبطية ، أي لغة فرعون وقومه والس هو الشجرفسماه ، أي فرعون بما وجده ، أي موسى عليه السلام عنده من الماء والشجر بلغته لغة القبط فإن التابوت ، أي تابوت موسى عليه السلام الذي وضعته فيه أمه وألقته في اليم وقف عند الشجر في شط اليم ، أي البحر .
قال الشيخ زاده رحمه اللّه في حاشية البيضاوي ، موسى هو موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام .
وقيل : أن موسى اسم مركب من كلمتين بالعبرانية وهما : مووشا بالشين المعجمة فمو هو الماء بلسانهم وشا هي الشجر فعربته العرب فقالو : موسى وقالوا : إنما سمي به لأن أمه جعلته في التابوت حين خافت عليه من فرعون وألقته في البحر ، فدفعته أمواج البحر حتى أدخلته بين أشجار عند بيت فرعون ، فخرجت جواري آسية امرأة فرعون يغتسلن فوجدن التابوت ، فأخذنه فسمي عليه السلام باسم المكان الذي أصيب فيه وهو الماء والشجر .
فأراد فرعون قتله ، أي موسى عليه السلام فقالت امرأته ، أي آسية امرأة فرعون وكانت منطقة ، أي تنطق بالنطق الإلهي لا بالنطق النفساني لإيمانها باللّه تعالى وكفرها بفرعون باطنا فيما قالت ، أي في قوله لفرعون من الكلام الآتي إذ كان اللّه تعالى من قبل خلقها ، أي امرأة فرعون للكمال ، أي متهيئة له مستعدة لقبوله كما قال ، أي نبينا عليه السلام عنها ، أي عن آسية امرأة فرعون في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة عن أبي موسى الأشعري .
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ».
رواه البخاري ورواه مسلم والترمذي وابن ماجة ورواه غيرهم .
حيث شهد صلى اللّه عليه وسلم لها ، أي لآسية امرأة فرعون ولمريم بنت عمران بالكمال الإلهي الذي هو للذكران ، أي حاصل للكاملين منهم فقالت ، أي آسية لفرعون في حق موسى عليه السلام إنه ، أي موسى عليه السلام ("قُرَّتُ عَيْنٍ") ، أي سرور دائم ("لِي وَلَك َأيضا") [ القصص : 9 ] .
قال تعالى : "وَقالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لا تَقْتُلُوهُ عَسى أَنْ يَنْفَعَنا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ" [ القصص : 9 ] .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( فبه قرّت عينها بالكمال الّذي حصل لها كما قلنا ؛ وكان قرّة عين لفرعون بالإيمان الّذي أعطاه اللّه عند الغرق .
فقبضه طاهرا مطهّرا ليس فيه شيء من الخبث لأنّه قبضه عند إيمانه قبل أن يكتسب شيئا من الآثام . والإسلام يجبّ ما قبله . وجعله آية على عنايته سبحانه لمن شاء حتّى لا ييأس أحد من رحمة اللّه إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكافِرُونَ[ يوسف : 87 ] فلو كان فرعون ممّن ييأس ما بادر إلى الإيمان . )
(فبه) ، أي بموسى عليه السلام (قرت عيناها) ، أي آسية بالكمال الإلهي الذي حصل لها ببركة تربية موسى عليه السلام وحفظه وحمايته ممن يريده بسوء كما قلنا ، أنه شهد له بذلك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وكان أيضا (قرة عين لفرعون بالإيمان) ، أي الإذعان والتصديق بدين موسى عليه السلام ونبوته ورسالته (الذي أعطاه اللّه) تعالى (عند الغرق) في البحر أي قبله ، لما شاهد أسباب الهلاك ، وقد رأى موسى وقومه من بني إسرائيل نجوا من الغرق في البحر والهلاك فيه بإيمانهم وإسلامهم ،
وتحقق بأن ذلك حق فأمن وأسلم طمعا في اللحاق بهم ورجاء في السلامة والنجاة من الغرق ل يأسا من الحياة ، كما قال بعضهم بأن : إيمان اليأس غير مقبول كما سيأتي ؛ ولهذ قال لما أدركه الغرق :آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ[ يونس : 90 ] وخص بني إسرائيل لعله يلتحق بهم وينجيه اللّه تعالى من الغرق كما أنجاهم وكانت قد حضرت منيته واستكملت حياته ولن يؤخر اللّه نفسا إذا جاء أجله .
(فقبضه) ، أي فرعون ، يعني أماته اللّه تعالى (طاهرا) من دنس الكفر ، أي مؤمنا مسلما بإيمان وإسلام ثابت في النص المتواتر وهو القرآن العظيم فيجب الإيمان به وتصديقه وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلً[ النساء : 122 ] ، وأما كون ذلك لم يقبل منه وليس بصريح الآية ولا مفهوما أيضا فإن قوله تعالى :آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ[ يونس : 91 ] .
يقتضي المعاتبة له في تأخير إيمانه إلى ذلك الوقت لا عدم قبوله ، وقد خص عصيانه بعدم إيمانه بكونه قبل ، أي عصيت قبل الآن لا الآن ، والآن لم تعص فأطعت .
وقوله تعالى :فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ[ يونس : 92 ] ، أي وحدك ولا ننجي معك أحدا من قومك لكونك آمنت إيمان طمع ورجاء كم ذكرنا ،
ومن قال أن نجاته بكون حيتان البحر لم تأكل جسده فليس هذا المعنى بنجاة ، وإن وقع فإن النجاة المعتبرة عند حلول الأجل إنما هي نجاة الإيمان والإسلام خصوصا ، وقد أضافه اللّه تعالى إليه بنون العظمة ، وقرنها بقوله سبحانه لتكون لمن خلفك آية للأمم المتأخرين علامة على سعة رحمة اللّه تعالى في كل من جاءها مؤمنا مسلما مثلك طامع فيها بمراده راجيا منها حصول مقصوده حتى لا ييأس أحد من رحمة اللّه تعالى ، ول يقنط من إحسانه وقبول توبته ، وما ذكره البغوي في المصابيح وذكره غيره أيضا من حديث أن جبريل عليه السلام كان يأخذ من طين البحر ويضع في فم فرعون لئلا يتوب لم يصح .
قال الفخر الرازي في تفسيره :
الأقرب أنه لا يصح ، لأن في تلك الحالة إما أن يقال إن كان التكليف ثابتا لم يجز لجبريل عليه السلام أن يمنعه من التوبة ، بل يجب عليه أن يعينه على التوبة وعلى الطاعة لقوله تعالى :وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ[ المائدة : 2 ] ،
وأيض لو منعه بما منعه من الطين كانت التوبة ممكنة لأن الأخرس قد يتوب بأن يندم بقلبه ويعزم على ترك معاودة القبيح ، وحينئذ لا يبقى لما فعله جبريل عليه السلام فائدة .
وأيض لو منعه لكان قد رضي ببقائه على الكفر والرضى بالكفر كفر وأيضا ،
فكيف يليق باللّه تعالى أن يقول لموسى وهارون عليهما السلام :فَقُول لَهُ قَوْلًا لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى [ طه : 44 ] ، ثم يأمر جبريل بأن يمنعه من الإيمان ،
(ولو قيل) : إن جبريل عليه السلام إنما فعل ذلك عن نفسه لا بأمر اللّه تعالى ، فهذا يبطله قول جبريل عليه السلام عن نفسه وعن الملائكة وما نتنزل إلا بأمر ربك ، وقوله تعالى في صفتهم :وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ[ الأنبياء : 28 ] .
(وقوله تعالى) :لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ [ الأنبياء : 27 ] .
وأم إن قيل : التكليف كان زائلا عن فرعون في ذلك الوقت فحينئذ لا يبقى لهذا الفعل الذي نسب جبرائيل عليه السلام إليه فائدة أصل .
وذكر أبو عيسى الترمذي في جامعه بإسناده عن ابن عباس إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم قال :
"لما أغرق اللّه تعالى فرعون قال : آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل فقال جبريل عليه السلام : يا محمد فلو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فيه مخافة أن تدركه الرحمة " هذ حديث حسن . سنن الترمذي .
وروي بإسناده أيضا عن ابن عباس عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه ذكر أن جبريل عليه السلام جعل يدس في في فرعون الطين خشية أن يقول : ل إله إلا اللّه فيرحمه اللّه أو خشية أن يرحمه اللّه . هذا حديث حسن غريب صحيح انتهى .
(فقوله) : خشية أن يرحمه اللّه مخافة أن تدركه الرحمة يعني في الحياة الدنيا فينجو من الغرق فيكون فتنة لبني إسرائيل أو فيعود إلى ما كان عليه من الكفر قال تعالى :وَلَوْ رُدُّو لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ[ الأنعام :28] الآية .
ولا يتصوّر أحد أن المعنى مخافة أن تدركه الرحمة في الآخرة فيموت على الإيمان فإن هذا أمر بعيد من قصد جبريل له الملك المعصوم عليه السلام كما ذكرناه عن الرازي (مطهرا )،
أي مغسولا بماء البحر (ليس فيه) ، أي فرعون في ذلك الوقت (شيء من الخبث) ،
أي النجاسة المعنوية والحسية (لأنه) ، أي اللّه تعالى (قبضه) ، أي مات فرعون (عند إيمانه) ،
أي في وقت حصول الإيمان منه والإسلام للّه تعالى بإخلاص قلبه وصدق لبه كما قال تعالى :فَإِذ رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ[ العنكبوت : 65 ] .
وهذا حالهم وهم في السفينة مشرفون على الهلاك ، فكيف بمن هو في وسط البحر وقد أشرف على الهلاك وطمع في النجاة والسلامة لمعاينة وقوع ذلك لغيره في ذلك الوقت فإن إخلاصه للّه تعالى في إيمانه وتوبته أبلغ وأكثر (قبل أن يكتسب) ، أي فرعون (شيئا من الآثام) ، أي الذنوب (والإسلام) إذا حصل من المكلف (يجبّ) ، أي يقطع حكم (ما) كان (قبله) من جميع المعاصي والمخالفات .
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « الإسلام يجبّ ما كان قبله » . رواه ابن سعد عن الزبير وعن جبير بن مطعم وهذا في حقوق اللّه تعالى . رواه ابن سعد في طبقاته ورواه أحمد الطبراني
وأم في حقوق العباد فيبقى عليه بعد الإسلام أمر التبعات والمظالم كتسخيره لقومه قهر عنهم في البعض وغصب أموالهم وإضلالهم بعبادته كما قال تعالى :وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَما هَدى [ طه : 79 ] ،
وقد يكون في ضمن إيمانه وإسلامه ندم على صدور ذلك منه كله ولم يعش بعده زمانا يتيسر فيه الاستحلال من قومه في مظالمهم والهداية لهم بدلالتهم على الإيمان بموسى عليه السلام فيكون مات تائبا أيضا من حقوق العبد والاستحلال بإرضاء الخصوم شرط التوبة من حقوق العباد إذا أمكنه ذلك وإذا لم يمكنه فالندم يكفيه كما ورد في الحديث : « الندم توبة » أخرجه ابن ماجة « 2 » والحاكم في مستدركه عن ابن مسعود والبيهقي عن أنس بن مالك .
وفي رواية الطبراني وأبي نعيم في الحلية عن أبي سعيد الأنصاري : « الندم توبة ، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ».
وفي الفتاوى البزارية أوائل كتاب الزكاة : من مات وعليه ديون وكان من قصده الأداء لا يؤاخذ به يوم القيامة ، لأنه يتحقق المطل انتهى .
وذكر اللقاني المالكي في شرح جوهرته .
قال : وأما رد المظالم والخروج عنها برد المال أو الإبراء منه أو الاعتراف إلى المغتاب واسترضائه إن بلغته الغيبة ونحو ذلك فواجب عندنا في نفسه لا يدخل له في الندم على ذنب آخر لما قاله إمام الحرمين في الشامل وهو مذهب الجمهور
قال الآمدي : إذا أتى المظلمة كالقتل والضرب مثل فقد وجب عليه أمران :
التوبة والخروج عن المظلمة بتسليم نفسه مع الإمكان ليقتص منه ، ومن أتى بأحد الواجبين لم تكن صحة ما أتى به لتوقفه على الإتيان بالواجب الآخر ، كمن وجب عليه صلاتان فأتى بإحداهما دون الأخرى ،
نعم إذا أراد أن يتوب من تلك الظلامة نفسها فلا بد من ردها أو التحليل ممن هي له ، إن وجد فيه شرط التحليل وأمن عند الطلب ذلك مما هو أعظم من المعصية التي ارتكبه انتهى . وتمامه هناك .
وغرضن من هذا الكلام أن حقوق العباد إذا تاب منها العبد بالندم بقلبه صحت توبته من معصية التجري على الغير والتعدي عليه في حقه ، وبقي عين الحق في ذمة التائب دينا عليه يلزمه أداؤه ، فإذا كان ناويا أداءه لو عاش زمانا وتمكن من ذلك فإنه لا يؤاخذ به أيضا يوم القيامة ، خصوصا وقد مات فرعون غرقا في البحر ، فحصل له رتبة شهيد البحر بعد قبول إيمانه ، واللّه على كل شيء قدير .
وفي حديث الطبراني وابن ماجة عن أبي أمامة : « شهيد البحر مثل شهيد البر والميت في البحر كالمتشحط في دمه في البر وما بين الموجتين في البحر كقاطع الدنيا في طاعة اللّه وأن اللّه عز وجل وكّل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهداء البحر فإنه يتولى قبض أرواحهم ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين ويغفر لشهيد البحر الذنوب كلها والدين ». المزي في تهذيب الكمال
فاعتنى اللّه تعالى به وجعل حاله بعكس حال إبليس في سعادته آخرا وسعادة إبليس أوّل . وكان ذلك ببركة تربية موسى عليه السلام وصبره على انتهاك حرمته حين قبض على لحيته وهو رئيس قومه ، وكانت لحية فرعون منظومة بالجواهر واللآلىء وموسى عليه السلام صغير في حجره حتى أراد فرعون قتله لفعله ذلك فقالوا لفرعون إنه ل يفرق بين التمرة والجمرة ، ولما عرض عليه ذلك أخذ الجمرة ووضعها في فمه فأحرقت لسانه ،
فقيل : إن اللكنة التي كانت في لسان موسى عليه السلام كانت من ذلك كما قال :وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي ( 27 ) يَفْقَهُوا قَوْلِي ( 28 )[ طه : 27 - 28 ] . وقال : أخي هارون هو أفصح مني لسان .
(وجعله) ، أي جعل اللّه تعالى فرعون آية كما قال تعالى لتكون لمن خلفك آية أي علامة واضحة (على عنايته) ، أي اعتنائه (سبحانه بمن شاء) من عباده (حتى لا ييأس واحد من رحمة اللّه) تعالى (فإنه) ، أي الشأن كما قال تعالى :"ل يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ،" أي رحمته "إِلَّ الْقَوْمُ الْكافِرُونَ"[ يوسف : 87 ].
فلو كان فرعون ممن ييأس من رحمة اللّه تعالى م بادر إلى الإيمان وأسرع إليه حين أدركه الغرق معرفة منه وتحققا أن الإيمان ينجيه لا نجاة له سواه وقد واجهه من اللّه تعالى صريح النجاة بقوله سبحانه :فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ[ يونس : 92 ] .
ولم ينقل عنه أنه سلم من الغرق ولم يمت من ذلك ، فتعين أن تكون نجاته هي النجاة التي أرادها بإيمانه وإسلامه ، أعني نجاة القبول له من اللّه تعالى وإلحاقه ببني إسرائيل في إيمانهم وإسلامهم وسلامتهم من الغرق .
وفي تقدير اللّه تعالى أنه يموت غريقا ، وقد حل أجله فمات ، وكذلك وبنو إسرائيل أطول معه عمرا فعاشوا بعده وقد حصل له اللحاق بهم في إيمانهم وإسلامهم كما ورد في صريح الآية :آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ[ يونس : 90 ] ، والأصل القبول حتى يأتي قاطع من الأدلة ينفيه .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( فكان موسى عليه السلام كما قالت امرأة فرعون فيه :قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لا تَقْتُلُوهُ عَسى أَنْ يَنْفَعَن [ القصص : 12 ].
وكذلك وقع فإنّ اللّه نفعهما به عليه السّلام وإن كانا ما شعر بأنّه هو النّبيّ الّذي يكون على يديه هلاك ملك فرعون وهلاك آله .
ولمّا عصمه اللّه من فرعون وَأَصْبَحَ فُؤادُ أُمِّ مُوسى فارِغاً[ القصص : 10 ] من الهمّ الّذي كان قد أصابها . )
فكان موسى عليه السلام كما قالت آسية امرأة فرعون فيه ، أي في موسى عليه السلام أنه ، أي موسى عليه السلام ("قُرَّتُ عَيْنٍ") ، أي فرح دائم وسرور لازم ("لِي وَلَكَ لا تَقْتُلُوهُ عَسى أَنْ يَنْفَعَنا") [ القصص : 12 ] ، أي في وقت الشدة وكذلك وقع فإن اللّه تعالى نفعهما به ، أي بموسى عليه السلام وحقق رجاءهما وطمعمهما في ذلك ،
كم حقق اللّه تعالى رجاء عبد المطلب جد نبينا صلى اللّه عليه وسلم لما وضعته آمنة بعد موت أبيه عبد اللّه ، فسماه جده محمدا حتى قيل له : لم سميت ابنك محمدا وليس من أسماء آبائك ولا قومك ؟
فقال : رجوت أن يحمد في السماء والأرض ، فكان الأمر كذلك ، ولو رجى أن ينتفع به لحقق اللّه تعالى رجاءه بالأولى .
وإن كان ، أي فرعون وآسية امرأته ما شعرا ، أي علم بأنه ، أي موسى عليه السلام هو النبي الذي يكون على يديه هلاك ملك ، أي سلطنة فرعون في مصر ونواحيها وهلاك آله ، أي آل فرعون يعني قومه وأتباعه كم قال تعالى :وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ[ القصص : 9 ]
ول يرد على القول بقبول إيمان فرعون وإسلامه كما ذكرنا ذكره تعالى لفرعون في القرآن بالذم والتقبيح عليه في صريح الآيات كقوله تعالى :وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَما هَدى [ طه : 79 ]
وَدَمَّرْنا ما كانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَما كانُو يَعْرِشُونَ[ الأعراف : 137 ]
وم أشبه ذلك ، فإنه كان قبل توبته وإيمانه وإسلامه ، وأما قوله تعالى :وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا وَسُلْطانٍ مُبِينٍ ( 96 ) إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ [ هود : 96 - 97 ].
يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ ( 98 ) وَأُتْبِعُوا فِي هذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ( 99 ) [ هود : 98 - 99 ]
فل يخفى أن قوله وما أمر فرعون برشيد حكاية حاله قبل توبته ، وقوله : يقدم قومه يوم القيامة .
أي يتقدم عليهم ، لأنه كان في الدنيا أمامهم في الكفر ، وكان سبب كفرهم بمتابعتهم له فيقدمهم ، أي يتقدم عليهم في يوم القيامة من حيث صورته وشخصه الذي كانوا يعبدون ، لأنهم كانوا يرونه إلها مع اللّه تعالى وهو في نفسه عبد مخلوق مبرأ من وصف الألوهية ، فالذي يقدمهم يوم القيامة بل يكون معهم في النار صورته التي عبدوها كم قال تعالى :إِنَّكُمْ وَما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَها وارِدُونَ[ الأنبياء : 98 ]
وقال تعالى :وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ[ البقرة : 24 ] ، وهي الأصنام التي كانوا يعبدونها تكون معهم في النار يعذبون به لا هي تعذب معهم ، وكذلك عباد الملائكة وعباد عيسى ابن مريم والعزير عليهم السلام يكون معهم في النار عين ما عبدوا ، وهم إنما عبدوا الصور التي تخيلوها في نفوسهم آلهة من الملائكة وعيسى والعزير عليهم السلام لا أن الملائكة وعيسى وعزيرا عليه السلام يكون معهم في النار ، وكذلك فرعون بمقتضى قولنا بقبول إيمانه .
ولهذ قال تعالى :"فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ" بصيغة الماضي يعني فعل ذلك بهم في الدنيا قبل توبته ولم يقل تعالى : فيوردهم بصيغة المضارع كما قال : يقدم قومه ، وإيرادهم النار كناية عن إيقاعهم فيما يقتضي خلودهم فيها ، ويؤيده قوله تعالى :وَأُتْبِعُوا فِي هذِهِ لَعْنَةً[ هود : 99 ] ،
أي في الدنيا ، ولئن كان أوردهم في الآخرة ما ذكر أنه يرد معهم ،
وقال تعالى في حق فرعون :وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنا لا يُرْجَعُونَ ( 39 ) فَأَخَذْناهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْناهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ( 40 ) وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيامَةِ لا يُنْصَرُونَ ( 41 ) وَأَتْبَعْناهُمْ فِي هذِهِ الدُّنْي لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ( 42 ) [ القصص: 39- 42].
ول يخفى عليك أن استكباره وظنه ونبذه في اليم كان قبل توبته ، وباقي الآية في حق قومه خصوصا بعد قوله : وجعلناهم ، أي قوم فرعون ، أئمة يدعون إلى النار ، يعني كانو يدعون بعضهم بعضا إلى عبادة فرعون التي هي كفر ، فهي نار يوم القيامة .
وقال تعالى :فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولى( 25 ) [ النازعات ] ، أي أخذه أخذا يقتضي النكال عليه والتقبيح في الدنيا والآخرة ، وأصل النكال القيد ، وهو إغراقه في البحر هو وقومه ، فإنه عقاب واحد جمع اللّه تعالى عليه عقاب الدنيا والآخرة ، وآية إيمانه وإسلامه السابق ، بيانها تقتضي أن ما وقع له من الغرق ما ذكر ههنا من نكال الآخرة والدني ، ولهذا قدم الآخرة على الدنيا لتقدم نكالها عليها ، وجمعه مع نكال الدنيا والآيات يفسر بعضها بعض .
(ولم عصمه) ، أي موسى عليه السلام حفظه (اللّه) تعالى (من) شر عدوّه
(فرعون "وَأَصْبَحَ فُؤادُ")، أي قلب ("أُمِّ مُوسى فارِغاً") ، أي خاليا من الهم والحزن الذي كان قد أصابه خوفا على موسى عليه السلام من فرعون أن يقتله .
قال تعالى :وَأَصْبَحَ فُؤادُ أُمِّ مُوسى فارِغاً إِنْ كادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْ ل أَنْ رَبَطْنا عَلى قَلْبِها لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ[ القصص : 10 ] ، أي كادت أن تخبر أنه ولدها من عدم خوفها عليه لما رأت من الحظوظ عند فرعون ، لكن اللّه تعالى ربط قلبها عن ذلك لئلا يفتنها فرعون بقتل ولدها فيفوتها الإيمان بالحق .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( ثمّ إنّ اللّه حرّم عليه المراضع حتّى أقبل على ثدي أمّه فأرضعته ليكمّل اللّه لها سرورها به .
كذلك علم الشّرائع ، كما قال تعالى :لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً- أي طريقا -وَمِنْهاجاً[ المائدة : 5 ] . أي من تلك الطّريقة جاء . فكان هذا القول إشارة إلى الأصل الّذي منه جاء .
فهو غذاؤه كما أنّ فرع الشّجرة لا يتغذّى إلّا من أصله . )
ثم إن اللّه تعالى حرم عليه ، أي موسى عليه السلام النساء المراضع ، فكان لا يقبل ثدي واحدة منهنّ حتى جيء له بأمه لترضعه ولم يعلم أحدا أنه أمه فقبلها أقبل على ثدي أمّه فأرضعته ، أي أمه ليكمل اللّه تعالى له ، أي لأمه سرورها به ، أي بموسى عليه السلام .
كذلك ، أي مثل المراضع بالنسبة إلى المكلفين علم الشرائع ، فإنه يختلف باختلاف أحوال المكلفين كما قال تعالى ("لِكُلّ") ٍأي لكل واحد ("جَعَلْنا مِنْكُمْ") [ المائدة : 48 ] يا معشر المكلفين ("شِرْعَةً") أي طريقا يسلكه بمقتضى أحواله عليه من دين الحق ("وَمِنْهاجاً") [ المائدة : 48 ] أي من تلك الشرعة والطريق جاء أي كل واحد منكم أي من تلك الطريقة جاء فهو متولد فهي أمه التي ترضعه ، أي تمده بمقتضاها ، وقد حرمت عليه المراضع غيره فكان هذا القول في معنى الآية إشارة لا عبارة إلى الأصل الذي منه ، أي من ذلك الأصل جاء ، أي ذلك المكلف فهو ، أي ذلك الأصل غذاؤه ، أي غذاء ذلك المكلف كما أن فرع الشجرة جاء من أصلها فالفرع لا يتغذى ، أي يصل إليه الغذاء أي المادة إلا من أصله .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( فما كان حراما في شرع يكون حلالا في شرع آخر يعني في الصّورة : أعني قولي يكون حلالا ، وفي نفس الأمر ما هو عين ما مضى ، لأنّ الأمر خلق جديد ولا تكرار . فلهذا نبّهناك . فكنّى عن هذا في حقّ موسى بتحريم المراضع . )
فم كان من أفعال المكلفين حراما في شرع من الشرائع الماضية يكون ذلك الفعل حلالا في شرع آخر غير الشرع الأوّل يعني بذلك الفعل أنه عين الأوّل في مثل الصورة الأولى لا أنه عين الفعل الأوّل المحكوم عليه أوّلا من حيث كليته بكونه حراما حكم عليه ثانيا بأنه حلال إلا من حيث صورته أعني بكونه في الصورة قولي يكون حلالا ، وهو ذلك الفعل الكلي المحكوم عليه بالحرمة وفي نفس الأمر ما هو ، أي المحكوم عليه بالحل ثانيا عين ما مضى فحكم عليه بالحرمة أوّلا لأن الأمر الإلهي دائما ("خلق جديد") بالصورة المتشابهة ولا تكرار في ذلك الخلق الجديد بل كان لمحة يذهب الأمر بخلق ويأتي بخلق آخر غير الأول فلهذا ، أي لكون الأمر كذلك نبهناك يا أيها السالك على ما ذكرناها هن .
وكنّي بالبناء للمفعول ، أي كنى اللّه تعالى عن هذا الأمر الذي هو اختلاف الشرائع للأمم فكل جاءت شريعتها ممدة لها لأنها أصلها فهي ترضعها وتغذوه وقد حرم عليها غيرها في حق موسى عليه السلام بتحريم المراضع عليه ، لأنه يأتي بشريعة ناسخة للشرائع قبله فشريعته هي أمه التي ترضعه بطريق الإشارة .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( فأمّه على الحقيقة من أرضعته لا من ولدته ، فإنّ أمّ الولادة حملته على جهة الأمانة فتكوّن فيها وتغذّى بدم طمثها من غير إرادة لها في ذلك حتى لا يكون لها عليه امتنان ، فإنّه ما تغذي إلّا بما لو لم يتغذّ به ولم يخرج عنها ذلك الدّم لأهلكها ، وأمرضها ، فللجنين المنّة على أمّه بكونه تغذّى بذلك الدّم فوقاها بنفسه من الضّرر الّذي كانت تجده لو امتسك هذا الدّم عندها ولا يخرج ولا يتغذّى به جنينها والمرضعة ليست كذلك . فإنّها قصدت برضاعته حياته وإبقاءه . )
(فأمه في الحقيقة هي من أرضعته) ، لأنها تغذيه بجزء منها ولهذا حرمت عليه المراضع لئلا ينتسب إلى غير أمه التي ولدته ، فيفوت حظها منه وقد تعبت في حمله ووضعه وحمل همه وحزنه خوفا من أذية فرعون ، فهي أحق به من غيرها ؛ ولهذا قال تعالى :فَرَجَعْناكَ إِلى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُها وَلا تَحْزَنَ[ طه : 40 ]
(لا) أمه في الحقيقة (من ولدته فإن أم الولادة حملته) ، أي ولدها فهو (على جهة الأمانة) فيها لأبيه لا لها كما قال تعالى :ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ[ الأحزاب : 5 ] ، وقال تعالى :وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ[ البقرة : 233 ] ،
وقال تعالى :وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّه[ هود : 6 ] وهو الموضع الذي تستقر فيه ، أي تسكين ومستودعها ، أي الموضع الذي أودعت فيه وهو رحم أمه فيرزقها ولا ينساه .
(فتكوّن) بالتشديد ، أي أنشىء وخلق (فيها) ، أي في أمه يعني في بطنها (وتغذى) ، أي اقتات (بدم طمثها) بالمثلثة ، أي حيضها ، ولهذا كانت الحامل لا تحيض ، وما رأته من الدم من زمن حملها فهو استحاضة وليس بحيض ، لأن الجنين يأكل دم الحيض في بطنها (من غير إرادة لها) ، أي لأمه (في ذلك) ، أي في التغذي بدمها (حتى لا يكون لها )، أي للام (عليه) ،
أي على ولدها (امتنان) ، أي فضل وإنعام بذلك (فإنه) ، أي الجنين (م تغذى) في بطن أمه (إلا بما) ، أي بدم (لو لم يتغذ ذلك) الجنين (به و) لو (لم يخرج عنها) ، أي عن الأم (ذلك الدم) الفاسد المحتبس في رحمها (لأهلكها) باستيلائه على قلبها (وأمرضها) بأمر آخر من أمور تصرفه في بطنه .
(فللجنين المنة) ، أي الفضل (على أمه) الحاملة به (بكونه) ، أي الجنين (تغذى بذلك الدم) في رحمها ولم يتركه يضرها (فوقاها) ، أي حفظ أمه (بنفسه) حيث أكل دمها (من الضرر الذي كانت) ، أي أمه (تجده لو امتسك) بالبناء للمفعول أي بقي (ذلك الدم عندها) في بطنها (ولا) كان (يخرج) منها ولا كان (يتغذى به) ، أي بذلك الدم (جنينها والمرضعة) للولد (ليست كذلك) ، أي ما هي كأم الولادة (فإنها قصدت برضاعته) لبنها الذي هو جزء منها (حياته) ، أي الولد (وإبقاءه) في الدني بوصف الصحة والعافية .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( فجعل اللّه تعالى ذلك لموسى في أمّ ولادته ، فلم يكن لامرأة عليه فضل إلّا لأمّ ولادته لتقرّ عينها أيضا بتربيته وتشاهد انتشاءه في حجرها ،وَل تَحْزَنَ [ طه : 40 ] .
ونجّاه اللّه تعالى من غمّ التّابوت ، فخرق ظلمة الطّبيعة بم أعطاه اللّه من العلم الإلهيّ وإن لم يخرج عنه .
وفتنه فتونا أي اختبره في مواطن كثيرة ليتحقّق في نفسه صبره على م ابتلاه اللّه به .)
فجعل اللّه تعالىذلك الأمر الذي في المرضعة لموسى عليه السلام في أمّ ولادته فكانت مرضعته دون غيرها فلم يكن لامرأة أجنبية عليه ، أي على موسى عليه السلام فضل ومنة إلا لأم ولادته حيث جعلها اللّه تعالى ترضعه لتقر عينها ، أي أم ولادته أيضا بتربيته كما قرت عينها بولادته وتشاهد انتشاءه ، أي كبره شيئا فشيئا في حجرها الحجر مثلث الحاء المهملة فالجيم الساكنة حضن الإنسان ولا تحزن عليه ونجاه ، أي سلم موسى عليه السلام اللّه تعالىمن غم التابوت الذي وضعته أمه فيه بإلهام من اللّه تعالى ، وأما في إشارة التابوت .
فخرق موسى عليه السلام حجاب ظلمة الطبيعة الجسمانية بما أعطاه اللّه تعالى لروحه النورانية من العلم الإلهي وإن لم يخرج ، أي موسى عليه السلام عنه ، أي عن ظلمة طبيعته بالكلية لأنه بشر ولكن غلب عليها بنورانيته وفتنه ، أي فتن اللّه تعالى موسى عليه السلام فتونا مصدر مؤكد للفعل أي اختبره وامتحنه في مواطن كثيرة من أحوال الدنيا ووقائعها ليتحقق ، أي موسى عليه السلام يصير متحققا في نفسه ، أي نفس موسى عليه السلام صبره ، أي موسى عليه السلام مفعول يتحقق على ما ابتلاه اللّه تعالى به من أنواع البلاء فيكمل فيه مقام الصبر بالتحقق به في نفسه .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( فأوّل ما ابتلاه اللّه قتله القبطيّ بما ألهمه اللّه ووفّقه له في سرّه وإن لم يعلم بذلك ، ولكن لم يجد في نفسه اكتراثا بقتله مع كونه ما توقّف حتّى يأتيه أمر ربّه بذلك ، لأنّ النّبيّ معصوم الباطن من حيث لا يشعر حتّى ينبّا أي يخبر بذلك .
ولهذا أراه الخضر قتل الغلام فأنكر عليه قتله ولم يتذكّر قتله القبطيّ فقال له الخضروَما فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي[ الكهف : 82 ] ينبّهه على مرتبته قبل أن ينبّأ أنّه كان معصوم الحركة في نفس الأمر وإن لم يشعر بذلك وأراه أيضا خرق السّفينة الّتي ظاهرها هلاك وباطنها نجاة من يد الغاصب . جعل له ذلك في مقابلة التّابوت الّذي كان في اليمّ مطبقا عليه . فظاهره هلاك وباطنه نجاة . )
(فأوّل ما ابتلاه اللّه) تعالى (به) من البلاء (قتله) ، أي موسى عليه السلام (القبطي) الذي هو من آل فرعون وكزه موسى عليه السلام فقضى عليه بما ألهمه اللّه تعالى فعل ذلك ووفقه ، أي أرشده له في سره ، أي قلبه وإن لم يعلم ، أي موسى عليه السلام بذلك ، أي أنه بإلهام له من اللّه تعالى وتوفيق ؛ ولهذا قال إنه من عمل الشيطان إنه عدو مضلّ مبين
(ولكن لم يجد) ، أي موسى عليه السلام في نفسه اكتراثا بالمثلثة ، أي استعظام ومبالاة بقتله ، أي القبطي مع كونه ، أي موسى عليه السلام ما توقف في القتل حتى يأتيه أمر ربه ، تعالى له بذلك القتل بل بادر إليه بالإلهام والتوفيق لأن النبي معصوم ، أي محفوظ الباطن خصه ، لأنه منشأ الحركة الاختيارية من حيث لا يشعر بعصمة باطنه عن جميع المخالفات حتى ينبأ أي يخبر ، مبنيان للمفعول بذلك ، أي أنه معصوم الباطن .
ولهذ ، أي لكون الأمر كذلك أراه ، أي موسى عليه السلام الخضر عليه السلام قتل الغلام كما قال تعالى :حَتَّى إِذ لَقِيا غُلاماً فَقَتَلَهُ[ الكهف : 74 ] .
فأنكر ، أي موسى عليه ، أي على الخضر عليه السلام قتله ، أي الغلام كما قال تعالى : قال :أَقَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُكْراً[ الكهف : 74 ] ولم يتذكر ، أي موسى عليه السلام قتله القبطي من قوم فرعون فقال له ، أي لموسى عليه السلام الخضر عليه السلام في آخر قوله ("وَما فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي") [ الكهف : 82].
يعني بل عن أمر اللّه تعالى بذلك في باطن ينبهه ، أي يوقظ موسى عليه السلام على مرتبته وهي عصمته لما قتل القبطي قبل أن ينبأ ، أي يخبره اللّه تعالى أنه كان معصوم الحركة في نفس الأمر عن كل مخالفة لأمر اللّه تعالى وإن لم يشعر بذلك ، أي بكون الخضر عليه السلام ينبهه كما ذكر .
وأراه ، أي الخضر أرى موسى عليه السلام أيضا خرق السفينة التي ركبا فيها وهي ظاهره هلاك ، لكل من فيها والقياس ظاهره ، أي خرقها وتأنيث الضمير باعتبار المضاف إليه نحو قول الشاعر :
كم شرقت صدر القناة من الدم
وكذلك قوله : (وباطنها نجاة) ، أي سلامة وخلاص (من يد الغاصب) ، وهو الملك الذي يأخذ كل سفينة غضبا (جعل له) ، أي لموسى عليه السلام (ذلك) ، أي السفينة التي خرقها (في (مقابلة التابوت له) ، أي لموسى عليه السلام الذي كان في اليم ، أي البحر (مطبقا) بصيغة اسم المفعول (عليه) ، أي على موسى عليه السلام فظاهره ، أي التابوت (هلاك) ، لأنه حبس لطفل صغير في داخل صندوق مقفل ، وقد ألقى في البحر (وباطنه) ، أي التابوت (نجاة) من الهلاك .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( وإنّما فعلت به أمّه ذلك خوفا من يد الغاصب فرعون أن يذبحه صبرا وهي تنظر إليه .
مع الوحي الّذي ألهمها اللّه تعالى به من حيث لا تشعر . فوجدت في نفسها أنّها ترضعه .
فإذا خافت عليه ألقته في اليمّ فإنّ في المثل « عين لا ترى قلب ل يفجع » فلم تخف عليه خوف مشاهدة عين ، ولا حزنت عليه حزن رؤية بصر ، وغلب على ظنّها أنّ اللّه ربّما ردّه إليها لحسن ظنّها به ، فعاشت بهذا الظّن في نفسها ، والرّجاء يقابل الخوف واليأس ، وقالت حين ألهمت لذلك لعلّ هذا هو الرّسول الّذي يهلك فرعون والقبط على يديه . فعاشت وسرّت بهذا التّوهم والظّنّ بالنّظر إليها ؛ وهو علم في نفس الأمر . )
(وإنما فعلت به) أي بموسى عليه السلام (أمه ذلك) بأن ألقته في التابوت فألقته في اليم (خوفا) عليه (من يد الغاصب) لهالذي هو (فرعون أن يذبحه صبرا) ، أي على وجه الصبر منه عليه السلام وهي ، أي أمه (تنظر إليه) ، أي على موسى عليه السلام ولا يمكنها الدفع عنه (مع الوحي) الإلهامي (الذي ألهمها اللّه تعالىبه من حيث لا تشعر) ، أي أم موسى بأنه وحي إلهامي (فوجدت) ، أي أم موسى عليه السلام (في نفسه أنها ترضعه) ،
أي موسى عليه السلام (فإذا خافت عليه السلام ) من عدوّه فرعون (ألقته في اليم) ، أي البحر ليذهب خوفها عنها بعدم علمها بحاله ، كأنها قالت في نفسها إن كان هذ هو صاحب الشأن فهو محفوظ ، وإن لم يكن فلا يبقى فإن في المثل المشهور (عين لا ترى قلب لا يفجع) ، أي لا يشتد حزنه وأسفه (فلم تخف) ، أي أم موسى عليه السلام (عليه )، أي موسى عليه السلام (خوف مشاهدة عين) باصرة ، وإن خافت عليه في أمر مغيب عنه .
وقد (غلب على ظنها) ، أي أم موسى عليه السلام أن اللّه تعالى ربما رده ، أي موسى عليه السلام إليها في خير وعافية (لحسن ظنها به) ، أي باللّه تعالى فعاشت ، أي أم موسى عليه السلام بهذا الظن المذكور في نفسها والرجاء ، أي المتأمل والطمع في حصول الشيء يقابل ، أي يضادد الخوف ويضادد اليأس ، أي القنوط من الشيء ، فقد جمعت بين أمرين متقابلين :
خوفها على موسى عليه السلام ، ورجائها من اللّه تعالى سلامته وحفظه وعدم يأسها من ذلك وقالت في نفسها (حين ألهمت) ، أي ألهمها اللّه تعالى لذلك الفعل الذي هو جعله في التابوت ثم إلقاؤه في اليم (لعل هذا) المولود
(هو الرسول الذي يهلك فرعون والقبط )وهم قوم فرعون (على يديه) كما اشتهر من ذلك قول الكهنة ، فقتل فرعون بسبب كل مولود ولد (فعاشت) ، أي أم موسى عليه السلام ، أي بقيت في الدنيا منتعشة وسرت ، أي فرحت (بهذا التوهم والظن) في نفسها الموجود (بالنظر إليها) مما لا يشعر به أحد غيرها (وهو) ، أي ذلك التوهم والظن (علم) مطابق للواقع (في نفس الأمر) من غير شعور بذلك منه .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( ثمّ أنّه لمّا وقع عليه الطّلب خرج فارّا خوفا في الظّاهر وكان في المعنى حبّا في النّجاة ، فإنّ الحركة أبدا إنّما هي حبّيّة ، ويحجب النّاظر فيها بأسباب أخر ، وليست تلك .
وذلك لأنّ الأصل حركة العالم من العدم الّذي كان ساكنا فيه إلى الوجود ، ولذلك يقال إنّ الأمر حركة عن سكون : فكانت الحركة الّتي هي وجود العالم حركة حبّ . وقد نبّه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على ذلك بقوله : "كنت كنزا مخفيّا لم أعرف فأحببت أن أعرف" ).
(ثم إنه) ، أي موسى عليه السلام (لما وقع عليه الطلب) بالقتل من قوم فرعون حين قتل القبطي (خرج) من مصر (فارا) ، أي هاربا من فرعون وقومه لما علم بذلك قال تعالى :وَجاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعى قالَ يا مُوسى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ( 20 ) فَخَرَجَ مِنْه خائِفاً يَتَرَقَّبُ قالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ( 21 ) [ القصص : 20 21 ] .
وكان خروجه (خوفا في الظاهر) من القتل (وإن كان في المعنى حبا) ، أي رجاء وطمعا (في النجاة) والسلامة (فإن الحركة) خصوصا السريعة (أبد إنما هي حبية) ، أي منسوبة إلى الحب بمعنى المحبة ، فإن مبدأها الشوق إلى التحرك إليه من كل أمر (ويحجب الناظر فيها) ، أي في الحركة عن معرفة كونه حبية (بأسباب أخر) غير الحب الداعي إليها تسمى بها مقاصد الحركة كالأكل والشرب والكلام والمشي ونحو ذلك (وليست تلك) الأسباب بحاجبة في نفس الأمر للمتأمل .
(وذلك) ، أي بيان كون الحركة حبية (لأن الأصل) في التكوين (حركة العالم) ، أي المخلوقات (من العدم الذي كان) ذلك العالم (ساكنا فيه) على معنى التوهم إذ العالم كان عدما صرفا في نفسه (إلى الوجود) الذي اتصف به ظاهرا وهي حركة أمر اللّه تعالى الذي قام به خلقه كلمح بالبصر وهو قوله :”كُنْ فَيَكُونُ”؛
(ولذلك) ، أي لأجل ما ذكر (يقال) عند المحققين (إن الأمر) الإلهي (حركة) تصدر (عن سكون) متقدم فيها فيتحرك الساكن الذي هو المأمور بالحركة التي هي ذلك الأمر ، كالانفعال الذي هو عين ظهور فعل الفاعل كقولهم : كسرت الإناء فانكسر ، فحركة الكسر هي بعينها حركة الانكسار ، ظهرت على المنفعل لها ، وكانت ساكنة فيه .
(فكانت الحركة التي هي) نفس (وجود العالم) ، لأنها عين الأمر الإلهي (حركة حب) ، أي محبة من صاحب الأمر تعالى (وقد نبّه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على ذلك) ، أي كون حركة وجود العالم حبية بقوله في الحديث القدسي ("كنت كنزا مخفيّا لم أعرف") بالبناء للمفعول ("فأحببت أن أعرف ") بالبناء للمفعول أيضا وبقية الحديث : " فخلقت خلقا تعرفت إليهم فبي عرفوني ".
قال الشيخ رضي الله عنه : ( فلولا هذه المحبّة ما ظهر العالم في عينه . فحركته من العدم إلى الوجود حبّ الموجد لذلك ، ولأنّ العالم أيضا يحبّ شهود نفسه وجودا كما شهدها ثبوتا ، فكانت بكلّ وجه حركته من العدم الثّبوتي إلى الوجود حركة حبّ من جانب الحقّ ومن جانبه فإنّ الكمال محبوب لذاته .
وعلمه تعالى بنفسه من حيث هو غنيّ عن العالمين هو له وما بقي له إلّا تمام مرتبة العلم بالعلم الحادث الّذي يكون من هذه الأعيان ، أعيان العالم ، إذا وجدت . فتظهر صورة الكمال بالعلم المحدث والقديم فتكمل مرتبة العلم بالوجهين . )
(فلول هذه المحبة) من الحق تعالى (ما ظهر) هذا (العالم في عينه) ، أي عين العالم إذ العالم ظاهر للحق تعالى من الأزل وليس بظاهر لنفسه فظهر بالمحبة القديمة (فحركته) ، أي حركة المحبة للعالم (من العدم) الذي هو فيه (إلى الوجود) الذي اتصف به ظاهرا (حركة حب) ، أي محبة (الموجد) ، أي الحق تعالى الذي أوجد العالم (لذلك) ، أي لإيجاد العالم ليعرف به (ولأن العالم أيضا يحب شهود) ، أي معاينة (نفسه وجودا) ، أي موجودة (كما شهدها )، أي نفسه (ثبوتا) أي ثابتة في عدمها الأصلي (فأنت بكل وجه) من الوجوه (حركته) أي العالم (من العدم الثبوتي) الأصلي (إلى الوجود) الذي اتصف به (حركة حب) أي لمحبة (من جانب الحق) تعالى (ومن جانبه) اي العالم أيضا فإن الكمال الذي هو الموجود (محبوب لذاته) أي من حيث هو وجود فيحبه الحق تعالى للعالم ويحبه العالم لنفسه .
(وعلمه تعالى بنفسه من حيث هو غني عن العالمين) أي من حيث ذاته المجردة عن اعتبار مراتب أسمائه وصفاته هو أي ذلك العلم ثابت له تعالى فهو عالم بذاته أزلا أبدا ، وأما علمه تعالى بنفسه من حيث مراتب أسمائه وصفاته فقد أشار إليه بقوله (وما بقي له إلا تمام مرتبة العلم) الإلهي (بالعلم الحادث) في الظهور لا في الثبوت (الذي يكون من هذه الأعيان) الكونية بنفسها وبغيرها على قدر استعدادها في معرفة الغير ومقدار طاقتها ، فكان علمها هو علمها بنفسها عند التحقيق (أعيان) بدل من الأعيان (العالم) كالملك والإنس والجن ، بل كل المخلوقات ذات علم عندنا كما تقتضيه العبارة هنا (إذ وجدت) أي تلك الأعيان من عدم نفسها ، فإن العلم القديم بها من حيث إنها حضرات الأسماء والصفات يتفرق عليها بحسبها معلومة فيه (فتظهر صورة الكمال) الإلهي للحق تعالى (بالعلم المحدث) وهو علمه تعالى بمظاهر مراتب أسمائه وصفاته ، وذلك قوله تعالى :أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ[ النساء : 166 ] وقوله :ما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ( 2 ) لاهِيَةً قُلُوبُهُمْ[ الأنبياء : 2 - 3 ] .
(و) العلم (القديم) وهو علمه تعالى بذاته المجردة من كل مرتبة (فتكمل) حينئذ من حيث الظهور إذ هي من حيث الثبوت كاملة للّه تعالى (مرتبة العلم) الإلهي (بالوجهين) وجه الذات ووجه الأسماء والصفات .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( وكذلك تكمل مراتب الوجود ؛ فإنّ الوجود منه أزليّ وغير أزلي وهو الحادث . فالأزليّ وجود الحقّ لنفسه ، وغير الأزليّ وجود الحقّ بصور العالم الثّابت . فيسمّى حدوثا لأنّه ظهر بعضه لبعضه وظهر لنفسه بصور العالم فكمل الوجود فكانت حركة العالم حبّية للكمال فافهم . )
(وكذلك تكمل مراتب الوجود) التي هي مراتب الأسماء والصفات بظهور آثارها (فإن الوجود منه أزلي) أي قديم ومنه (غير أزلي وهو) أي غير الأزلي (الحادث فالأزلي) من الوجود (وجود الحق) تعالى (لنفسه) وهو الوجود المطلق بالإطلاق الحقيقي المنزه عن مشابهة كل شيء (وغير الأزلي) من الوجود هو (وجود الحق) تعالى أيضا لا لنفسه بل لما سواه وهو وجوده تعالى القائم (بصور العالمالثابت) ذلك العالم في العدم الأصلي (فيسمى) أي هذا الوجود المذكور (حدوثا لأنه) أي هذا الوجود (ظهر بعضه لبعضه) من حيث أنواع مراتب أسمائه وصفاته ، وترتب في الظهور بالتقدم والتأخر والزيادة والنقصان .
(فظهر) أي هذا الوجود (لنفسه) متجليا (بصور العالم) المختلفة كما هو ظاهر لها من الأزل بغير تلك الصور (فكمل الوجود) في ظهوره بمراتب أسمائه وصفاته ، وهو كامل في ظهوره بذاته لذاته من الأزل (فكانت حركة) وجود (العالم) في كل لمحة حركة (حبية) أي منبعثة عن المحبة من الحق تعالى ومن أعيان العالم أيضا كما مر ، وهي حركة إيجاد للعالم بالنسبة إلى الحق تعالى ، وحركة عمل خير أو شر أو إباحة في المكلف ،
وغير ذلك في غيره بالنسبة إلى أعيان العالم ، وهي حركة واحدة في نفس الأمر للأمر الإلهي لا لغيره ، ولكنها كثرت وتنوعت نسبتها إلى أنواع كثيرة كما كثر الأمر مع وحدته في نفسه ، وكثرت المحبة لكثرة أنواع الحركة الواحدة ، فكانت أنواع المحبة كلها (للكمال) أي لطلبه وتحصيله وهو الوجود المتنوع بالصور (فافهم) يا أيها السالك .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( ألا تراه كيف نفّس عن الأسماء الإلهيّة ما كانت تجده من عدم ظهور آثاره في عين مسمّى العالم فكانت الرّاحة محبوبة له .
ولم يوصل إليها إلّا بالوجود الصّوريّ الأعلى والأسفل . فثبت أنّ الحركة كانت للحبّ ، فما ثمّ حركة في الكون إلّا وهي حبيّة .
فمن العلماء من يعلم ذلك ومنهم من يحجبه السّبب الأقرب لحكمه في الحال واستيلائه على النّفس . )
(أل تراه) أي لوجود الحق (كيف نفّس) بتشديد الفاء من قوله عليه السلام : " نفس الرحمن يأتيني من قبل اليمن " .
فكان الأنصار ، والنفس : بفتح الفاء يحصل التنفيس به أي التعريج عما في القلوب الحيوانية من حرارة الروح المنفوخ على جهة المثال للمقصود ، فإذا أراد الحيوان أخرج ذلك النفس بالتنفيس صوتا فإن كان إنسانا يظهره صور حروف وكلمات تحمل معاني مقصودة له أو غير مقصودة كما قال تعالى :فَوَ رَبِّ السَّماءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ ما أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ[ الذاريات : 23 ] .
(عن الأسماء الإلهية ما كانت تجده) أي الأسماء من الكرب (من عدم ظهور آثارها) المقدرة لها (في عين مسمى العالم) على اختلافه ، فلم يزل ذلك التنفيس أبدا ، ومنه إجابة الدعاء لكل داع خصوصا المسلم والمؤمن والمحسن لانكشاف ذلك له ولو إسلاما ولو إيمان
(فكانت الراحة) من تعب التوجه بالآثار على الظهور والتحقق كتعب الداعي في قضاء حاجة بطريق التشبيه في تقريب المعاني البعيدة عن الأفهام (محبوبة له) أي للحق تعالى (ولم يوصل) أي يتوصل الحق تعالى لاقتضاء التقدير الأزلي ذلك (إليها) أي إلى تلك الراحة المحبوبة له كمحبة الراحة بالحاجة للداعي في قضائها بل هو منه لو (عرف إلا بالوجود الصوري) أي المصوّر بالصورة المخصوصة في العالم (الأعلى والأسفل) ولا يكون غير ذلك (فثبت) مما ذكر (أن الحركة) الوجودية الإيجادية بالنظر إليها وإلى غيرها (كانت للحب) أي لأجل المحبة الباعثة له من الأصل والفرع (فما ثمّ) بالفتح أي هناك (حركة في الكون) ظاهرا أو باطنا مطلقا إلا (وهي) أي تلك الحركة حركة (حبية) أي مبدؤها المحبة من القديم والحادث والمحبة واحدة أيضا وتختلف باختلاف النسب في صور الأعيان والتجرد عنه .
(فمن العلماء) باللّه تعالى (من يعلم ذلك) التعميم في الحركة الحبية ، فيعرف استقامة العالم في حالة اعوجاجه وكماله في حالة نقصه ، ويشهد الاعتبارات التي به يظهر الكمال والنقص في العالم ، ويصدق بها لسان الشريعة والحقيقة .
(ومنهم) أي العلماء باللّه تعالى (من يحجبه) عن علم ذلك شهود (السبب الأقرب) للحركة في العالم فيعتبر داعي النية في كل حركة ويسميها باسمه المخصوص في الظاهر (لحكمه) أي لأجل حكم ذلك النسب (في الحال) الذي هو فيه (واستيلائه) أي السبب (على النفس) الإنسانية بمقتضاه المخصوص .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( فكان الخوف لموسى مشهودا له بما وقع من قتله القبطيّ ، وتضمّن الخوف حبّ النّجاة من القتل . ففرّ لمّا خاف ؛ وفي المعنى ففرّ لمّا أحبّ النّجاة من فرعون وعمله به . فذكر السّبب الأقرب المشهود له في الوقت الّذي هو كصورة الجسم للبشر . وحبّ النّجاة مضمّن فيه تضمين الجسد للرّوح المدبّر له . )
فكان الخوف من القتل لموسى عليه السلام وهو السبب الأقرب للحركة مشهود له في ذلك الحين بما وقع منه من قتل القبطي الذي هو من قوم فرعون وتضمن ذلك الخوف من القتل حب النجاة منه والسلامة لموسى عليه السلام من القتل ففر أي هرب لما خاف من ذلك كما قال ففررت منكم لما خفتكم
(والمعنى ففر لمّا أحب النجاة من فرعون وعمله به) وهو القتل (فذكر) في كلامه (السبب الأقرب) لتلك الحركة الحبية (المشهود) أي ذلك السبب (له) أي لموسى عليه السلام في ذلك (الوقت الذي هو) أي ذلك السبب للسبب الحبي (كصورة الجسم للبشر) يظهر بها الواحد من البشر وتظهر به وحب النجاة الذي هو السبب الأصلي الحبي للحركة الفرارية (مضمن فيه) ، أي في ذلك السبب الأقرب الذي هو الخوف من القتل مثل (تضمين الجسد) البشري (للروح المدبر له) ، وهو كمال الظهور .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( والأنبياء صلوات اللّه عليهم لهم لسان الظّاهر به يتكلّمون لعموم الخطاب ، واعتمادهم على فهم السّامع العالم . فلا يعتبر الرّسل إلّا العامّة لعلمهم بمرتبة أهل الفهم ؛ كما نبّه عليه السّلام على هذه الرّتبة في العطايا فقال : « إنّي لأعطي الرّجل وغيره أحبّ إليّ منه مخافة أن يكبّه اللّه في النّار ) .
(والأنبياء) عليهم السلام (لهم لسان الظاهر) ، أي التعبير عن المعاني الظاهرة به ، أي بلسان الظاهر المفهوم لكل أحد (يتكلمون) ، فينزلون البواطن في صور الظواهر ويأتون بالأسرار الغيبية في قوالب الأشياء الحسية (لعموم الخطاب) في خواص أممهم وعوامهم كما قال تعالى :وَم أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ[ إبراهيم : 4 ] .
(واعتمادهم) ، أي الأنبياء عليهم السلام في معرفة المراد (على فهم) الإنسان (العالم) ، أي صاحب العلم (السامع) لذلك الخطاب كما قال نبينا عليه السلام « فليبلغ الشاهد منكم الغائب » . رواه الطبراني في المعجم الكبير ورواه أحمد في المسند ورواه غيرهما .
مثل أولاد المكتب يقري بعضهم بعضا ينسبون في التعليم إلى الشيخ (فلا تعتبر الرسل) عليهم السلام ، أي لا اعتبار لهم في خطابهم (إلا العامة) من أممهم دون الخاصة فيراعونهم في الفهم ليفهموا عنهم ما يخاطبونهم (لعلمهم) ، أي الرسل عليهم السلام (بمرتبة أهل الفهم) ، من خواص أممهم (كما نبّه) نبينا (عليه السلام على هذه المرتبة) التي هي الاعتماد على فهم أهل الخصوص من الأمم (في) أمر (العطايا) الدنيوية في الغنائم وغيرها (فقال) صلى اللّه عليه وسلم (إني لأعطي الرجل) من مال اللّه تعالى الذي تحت يدي (وغيره) ، ممن أحرمه من العطايا وأعطيه أقل من الأوّل (أحب) ، أي أكثر حبا (إلي منه) ، أي
من ذلك الرجل (مخافة) ، أي خوفا مني عليه من ضعف يقينه بأمر الآخرة وكثرة حبه للدنيا أن (يكبّه) ، أي يسقطه ويلقيه (اللّه) تعالى على وجهه (في النار) بإساءة أدبه ظاهرا وباطنا في حقي.
والحديث برواية « أما بعد فو اللّه إني لأعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي ولكن أعطي أقواما لما يرى في قلوبهم من الجزع والهلع وأكل أقواما إلى ما جعل اللّه في قلوبهم من الغنى والخير منهم عمرو بن ثعلب » رواه البخاري عن عمرو بن ثعلب .
وفي حديث آخر أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده والنسائي عن سعد قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « إني أعطي رجالا وأدع من أحب إلي منهم لا أعطيه شيئا مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم » .
وفي حديث البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « رحم اللّه موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر » ،
وهذ ما قاله النبي صلى اللّه عليه وسلم حين قال رجل يوم حنين :" واللّه إن هذه لقسمة ما عدل فيها ولا أريد بها وجه اللّه فتغير وجهه صلى اللّه عليه وسلم " ثم ذكره ، وكان كلامه هذا شفقة عليهم ونصحا في الدين لا تهديدا ولا تثريب .
قال الشيخ رضي الله عنه : (فاعتبر الضّعيف العقل والنّظر الّذي غلب عليه الطّمع والطّبع .
فكذا ما جاؤوا به من العلوم جاؤوا به وعليه خلعة أدنى الفهوم ليقف من لا غوص له عند الخلعة ، فيقول ما أحسن هذه الخلعة ! ويراها غاية الدّرجة . ويقول صاحب الفهم الدّقيق الغائص على درر الحكم - بما استوجب هذا - « هذه الخلعة من الملك » . فينظر في قدر الخلعة وصنفها من الثّياب ، فيعلم منها قدر من خلعت عليه ، فيعثر على علم لم يحصل لغيره ممّن لا علم له بمثل هذ . )
فاعتبر صلى اللّه عليه وسلم في تفريقه المال الرجل الضعيف العقل والضعيف النظر ، أي الرأي والفكر الذي غلب عليه الطمع في الدنيا وغلب عليه الطبع الخسيس ، فأعطاه وأجزل نصيبه من المال ، ولم يعتبر أهل القوة الإيمانية واليقين الصادق ، فربما حرمهم من ذلك ، كما كان عليه السلام يقسم الغنائم على بعض المهاجرين
ويحرم الأنصار منها وهم أحوج منهم لمعرفته بقلوبهم فكذا ، أي مثل العطايا م جاؤوا ، أي الأنبياء عليهم السلام به فبلغوه إلى الناس من العلوم الإلهية جاؤوا به من عند اللّه تعالى بالوحي وعليه خلعة أدنى الفهوم من الناس يعني بعبارات العامة فيما اصطلحوا عليه من الكلام ليقف ، أي يطلع على ذلك من لا غوص له ، أي لا معرفة عنده بدقائق الأمور وغوامض الأسرار عند الخلعة التي هي خلعة أدنى الفهوم المناسبة له لكونه من عامة الناس فيقول عند ذلك ما أحسن هذه الخلعة ، أي العبارة التي لبسها ذلك المعنى فظهر به له ويراها غاية الدرجة فيما يمكن بالنسبة إليه من الكلام ويقول عند ذلك صاحب الفهم الدقيق من خواص الأمّة الغائص في بحر الكلم النبوية على درر الحكم جمع حكمة بما يعني بأي سبب استوجب ، أي استحق هذا المعنى العظيم أن يلبس هذه الخلعة التي هي أدنى منه فيظهر بها بين المكلفين من الخاص والعام من الملك الحق الذي منه كل شيء فينظر ، أي صاحب الفهم في قدر ، أي مرتبة الخلعة التي لبسها ذلك المعنى الوارد عن الحق تعالى بلسان الرسول عليه السلام وفي صنفها يعني من أي نوع هي من أنواع الثياب المعتبرة عند الناس فيعلم ، أي صاحب الفهم منها ، أي من تلك الخلعة قدر ، أي مرتبة ومزية من ، أي المعنى الإلهي الذي خلعت تلك الخلعة عليه فترتفع عنده مزايا الأمور المخفوضة عند العامة لعدم علمهم بها ، ويعرف مقدار قصور العامة عن إدراك ما عندهم من الظواهر الإلهية والأحوال الربانية فيعثر ، أي يطلع على علم إلهي عظيم شريف لم يحصل لغيره ممن لا علم له بمثل هذا العلم الرباني الشريف .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( ولمّا علمت الأنبياء والرّسل والورثة أنّ في العالم وفي أمّتهم من هو بهذه المثابة ، عمدوا في العبارة إلى اللّسان الظّاهر الّذي يقع فيه إشتراك الخاصّ والعامّ ، فيفهم منه الخاصّ ما فهم العامّة منه وزيادة ممّا صحّ له به اسم أنّه خاصّ فتميّز به عن العامّي . فاكتفى المبلّغون العلوم بهذ .
فهذا حكمة قوله : عليه السلام :فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّ خِفْتُكُمْ [ الشعراء : 21 ] ولم يقل ففررت منكم حبّا في السّلامة والعافية . )
ولم علمت الأنبياء والرسل عليهم السلام والأولياء الورثة لعلومهم كما قال تعالى :ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِن[ فاطر : 32 ] ، وقال تعالى :أُولئِكَ هُمُ الْوارِثُونَ [ المؤمنون : 10 ] .
وفي الحديث : " العلماء مصابيح الأرض وخلفاء الأنبياء وورثتي وورثة الأنبياء " أخرجه السيوطي في الجامع الصغير أخرجه أيضًا: الرافعى وأورده العجلوني في كشف الخفاء وقال رواه ابن عدي عن علي رضي اللّه عنه ، وهو حديث صحيح كما قال المناوي .
وفي رواية : " العلماء ورثة الأنبياء يحبهم أهل السماء وتستغفر لهم الحيتان في البحر إذا ماتوا إلى يوم القيامة ". رواه ابن النجار عن أنس بن مالك رضي اللّه عنه . وأبو نعيم، والديلمى، وابن النجار عن البراء. و روى نحوه ابن ماجة في سننه
وفي رواية العلم : " ميراثي وميراث الأنبياء قبلي ". السيوطي في الجامع الصغير ورواه أبو حنيفة في المسند ، روايته عن إسماعيل بن عبد الملك و أخرجه الديلمي في مسند الفردوس عن أم هانىء رضي اللّه عنها و أخرجه أبو نعيم.
أن في جملة العالم بالفتح أي المخلوقات وفي أمتهم ، أي اتباعهم المؤمنين بهم من هو بهذه المثابة من أصحاب الفهم الدقيق والذوق الأنيق عمدوا في العبارة التي يكشفون بها عما عندهم من العلوم الإلهية والأسرار الربانية إلى اللسان الظاهر المفهوم للكل الذي يقع فيه اشتراك الخاص والعام من الناس فيفهم منه الخاص من الناس ما فهم العامة منه وزيادة اختصوا بها دون العامة مما ، أي من الأمر الذي صح له ، أي للواحد من الخاص به ،
أي بسبب ذلك الأمر اسم فاعل أنه ، أي ذلك الواحد منهم خاص فيتميز ذلك الخاص به ، أي بذلك الأمر عن العامي من الناس فاكتفى المبلغون الذين يبلغون العلوم الإلهية إلى الناس من الأنبياء وورثتهم كما مر بهذا بمراعاة اللسان الظاهر المفهوم للكل .
فهذ الأمر هو حكمة قوله ، أي موسى ("عليه السلام فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ")[ الشعراء : 21 ] والخوف من غير اللّه تعالى مذموم كما قال سبحانه :فَلا تَخافُوهُمْ وَخافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ[ آل عمران : 175 ] . وقال تعالى :وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ[ الأحزاب : 37 ] .
وحاش الأنبياء عليهم السلام والورثة على طريقهم من الخوف من غير اللّه تعالى في باطن الأمر كما قال سبحانه :وَلا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا اللَّهَ[ الأحزاب : 39 ] .
ولكن لهم لسان الظاهر كما تقرر هنا ولم يقل ، أي موسى عليه السلام ففررت منكم حبا ، أي محبة مني في السلامة والعافية ستر للمعاني الإلهية بالأمور الظاهرة الكونية .
قال الشيخ رضي الله عنه : فجاء إلى مدين فوجد الجاريتين "فَسَقى لَهُما" من غير أجر ."ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ" الإلهيّ فقال :"رَبِّ إِنِّي لِما أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ" [ القصص : 24 ] فجعل عين عمله السقي عين الخير الذي أنزل اللّه إليه ، ووصف نفسه بالفقر إلى اللّه في الخير الذي عنده) .
فجاء ، أي موسى عليه السلام إلى مدين بلاد شعيب عليه السلام وهي قريبة من مصر فوجد الجاريتين ، أي البنتين هما لشعيب عليه السلام ("فَسَقى لَهُما") غنم شعيب عليه السلام التي كانت معهما من غير أجر ، أي أجرة يأخذها على ذلك ("ثُمَّ تَوَلَّى")،(أي عدل "إِلَى الظِّلِّ" الإلهي) وهو قيامه بالمراتب الإلهية والحضرات الربانية وخروجه عن شهود نفسه بالكلية في شهود ربه المتجلي عليه في صورته الروحانية والجسمانية فكان ربانيا لا نفسانيا فأظله اللّه تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله بسبب محبته البنات في اللّه تعالى والمتحابان في اللّه تعالى في ظله كما ورد في الحديث .
وقد يكون لعدوله عن مقتضى نفسه إلى به كما في حديث السبعة الذين يظلهم اللّه تعالى في ظله أن منهم رجلّا عرضت عليه امرأة ذات منصب وجمال فتركها لجلال اللّه تعالى .
وفي رواية : « رجل غض عينه عن محارم اللّه تعالى » . رواه الطبراني في الكبير و أبو يعلى والسيوطي في الجامع الصغير و الحافظ العراقي في تخريح احاديث الإحياء .
وعلى هذا فاللام في الظل للعهد الذهني فَقالَ: ، أي موسى عليه السلام ("رَبِّ")، أي يا رب ("إِنِّي لِما")، أي لأجل الذي ("أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ") [ القصص:24 ].
إليك في إنزال غيره فجعل عليه السلام (عين عمله السقي ) لبنات شعيب عليه السلام عين الخير ، أي العمل الصالح الذي أنزله اللّه تعالى إليه ، أي إلى موسى عليه السلام ثم رفعه تعالى له في صحيفته ووصف ، أي موسى عليه السلام نفسه بالفقر ، أي الاحتياج إلى اللّه تعالى في حصول الخير الذي عنده ، أي اللّه تعالى أيض .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( فأراه الخضر إقامة الجدار من غير أجر فعتبه على ذلك فذكّره سقايته من غير أجر ، إلي غير ذلك ممّا لم نذكر حتّى تمنّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم - أن يسكت موسى عليه السّلام ولا يعترض حتّى يقصّ اللّه عليه من أمرهما ، فيعلم بذلك ما وفّق إليه موسى عليه السّلام من غير علم منه .
إذ لو كان عن علم ما أنكر مثل ذلك على الخضر الّذي قد شهد اللّه له عند موسى وزكّاه وعدّله ومع هذا غفل موسى عن تزكية اللّه وعمّا شرطه عليه في اتّباعه، رحمة بنا إذ نسينا أمر اللّه.
ولو كان موسى عالما بذلك لما قال له الخضر ما لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً[ الكهف : 68 ] أي إنّي على علم لم يحصل لك عن ذوق كما أنت على علم لا أعلمه أنا . فأنصف . )
فأراه ، أي موسى عليه السلام أراه الخضر عليه السلام في زمان متابعته له ليعلمه مما علم رشدا إقامة ، أي تعمير الجدار في القرية التي استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما من غير أجر ، أي أجرة أخذها الخضر عليه السلام منهم فعتبه ، أي موسى عتب على الخضر عليه السلام على ذلك الفعل بقوله :"لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً"[ الكهف : 77 ] ، أي أجرة تأكل بها بدل ما منعون منه حين استطعمناهم .
فذكّره بالتشديد لأن موسى عليه السلام نسي بسقايته ، أي موسى عليه السلام الغنم لبنات شعيب عليه السلام من غير أجر ، أي أجرة يأخذها على ذلك ، ولم يتذكر موسى عليه السلام فاعترضه فيما صدر منه ، وهكذا السالك الملتزم بالعهد متابعة الكامل يجد منه ما وقع له من المخالفات قبل سلوكه التي لم يتب منها تذكرا له بها ،
فإن تذكر وتاب وجد ما صدر من شيخه خيرا محضا ، وإن لم يتب وأصر في إنكاره عليه ، فإنم هو في نفس الأمر منكر على نفسه ولم يشعر بذلك ، فيفارقه شيخه لعدم قابليته في السلوك وعدم استعداده لمعارف الرجل ،
وهي عبرة عظيمة قصها اللّه تعالى لنا في القرآن إلى يوم القيامة ، وإن كانت من قبيل حسنات الأبرار سيئات المقربين (إلى غير ذلك مما لم يذكر) في القرآن منه وقائع وقعت لموسى عليه السلام لو صبر مع الخضر عليه السلام لذكره الخظر بها كلها .
(حتى تمنى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أن يسكت موسى ولا يعترض على الخضر حتى يقص اللّه) تعالى (عليه) ، أي على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم (من أمرهما) ، أي موسى والخضر عليهم السلام في بيان الخضر له جميع ما وقع منه بمثاله ليختبر قوة إدراكه في معرفة الحقائق الإلهية الطالب معرفتها ،
كم قال نبينا صلى اللّه عليه وسلم ، رحمة اللّه علينا وعلى أخي موسى لو صبر لرأى من صاحبه العجب . » أخرجه أبو داود والنسائي ذكره السيوطي في الجامع الصغير .
فيعلم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بذلك ، أي بما يقصه اللّه تعالى عليه من أمرهما ما وفّق ، أي وفق اللّه تعالى إليه موسى عليه السلام مما يصدر منه مع الخضر عليه السلام من الوقائع العجبية من غير علم منه ، أي من موسى عليه السلام بما وقع له من ذلك إذ لو كان ما وقف له عن علم منه به ما أنكر مثل ذلك الذي رآه على الخضر مثالا لما صدر منه قبله الذي نعت للخضر قد شهد اللّه تعالى له بزيادة العلم عند موسى عليه السلام كما ورد في حديث البخاري وغيره وزكّاه اللّه تعالى وعدّله حيث مدحه بقوله سبحانه :فَوَجَد عَبْداً مِنْ عِبادِنا آتَيْناهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَعَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً( 65 ) [ الكهف : 65 ] ،
(ومع هذا) التعديل والمدح من اللّه تعالى له (غفل موسى) عليه السلام عن تزكية اللّه تعالى وتعديله للحضر عليه السلام وغفل أيضا عما شرطه ، أي الخضر عليه السلام عليه ، أي على موسى عليه السلام في اتباعه له "قالَ لَهُ مُوسى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً (66) قالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً ( 67 ) وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلى ما لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً ( 68 ) قالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللَّهُ صابِراً وَلا أَعْصِي لَكَ أَمْراً ( 69 ) قالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلا تَسْئَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً( 70 ) [ الكهف : 66 - 70 ] .
رحمة بن معشر المكلفين إذا نسينا أمر اللّه تعالى في حال من الأحوال ، فنتأسى بموسى عليه السلام ، وأنه رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهو عليه كما ورد في الحديث ولو كان موسى عليه السلام عالما بذلك ، أي بما أنكره على الخضر عليه السلام لما قال له الخضر عليه السلام ما لم تحط به خبرا وتقدير كلامه أي إني على علم حاصل لي من ذوق ولم يحصل لك ، أنت هذا العلم عن ذوق كما أنك أنت على علم ذائق له ل أعلمه أنا فلست على ذوق منه فأنصف ، أي الخضر في قوله ذلك .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( وأمّا حكمة فراقه فلأنّ الرّسول يقول اللّه فيه :وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا[ الحشر : 7 ] فوقف العلماء باللّه الّذين يعرفون قدر الرّسالة والرّسول عند هذا القول . وقد علم الخضر أنّ موسى رسول اللّه فأخذ يرقب ما يكون منه ليوفّي الأدب حقّه مع الرّسول .
فقال له :" إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَها فَل تُصاحِبْنِي" [ الكهف : 76 ] ، فنهاه عن صحبته . فلما وقعت منه الثّالثة قال :هذا فِراقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ [ الكهف : 78 ] . ولم يقل له موسى لا تفعل ولا طلب صحبته لعلمه بقدر الرّتبة الّتي هو فيها الّتي أنطقته بالنّهي عن أن يصحبه . )
(وأما حكمة فراقه) ، أي الخضر لموسى عليه السلام (فلأن الرسول يقول اللّه) تعالى وفيه (" وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا") [ الحشر : 7 ] ، أي كونوا له في الأمر والنهي (فوقف اللّه العلماء باللّه) تعالى كالخضر ونحوه (الذين يعرفون قدر الرسالة) من اللّه تعالى إلى الخلق وقدر (الرسول) المبعوث بالهدى والنور (عند هذا القول) الإلهي في حق (الرسول وقد علم الخضر) عليه السلام (أن موسى) عليه السلام (رسول اللّه) إلى فرعون وبني إسرائيل (فأخذ يرقب) ، أي يضبط ويحفظ (ما يكون منه) ، أي من موسى عليه السلام ليوفي ، أي يتم (الأدب حقه مع الرسول) الذي أمر الحق تعالى بإطاعته .
(فقال )، أي موسى عليه السلام له ، أي للخضر عليه السلام (" إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَها")، أي بعد هذه المرة ("فَلا تُصاحِبْنِي") [ الكهف :76 ].
قد بلغت من لدني عذرا (فنهاه) ، أي موسى نهى الخضر عليه السلام عن صحبته فلما وقعت منه المرة الثالثة وهي قوله في إقامة الجدار لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال ، أي الخضر عليه السلام : ("هذا فِراقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ") [ الكهف : 78 ] ،
(ولم يقل له) أي للخضر (موسى) عليه السلام (لا تفعل) ، أي لا تفارقني (ولا طلب صحبته لعلمه) ، أي موسى عليه السلام (بقدر الرتبة) النبوية الرسالية (التي هو) ، أي موسى عليه السلام (فيها) وهي ما اختصه اللّه تعالى به من علوم الشريعة الظاهرة الإلهية (التي أنطقته بالنهي عن أن يصحبه) بعد ذلك لظهور الفرق بينه وبينه ، فإن علوم الخضر عليه السلام باطنية حقيقية ، وعلوم موسى عليه السلام ظاهرية شرعية ، والإشارة بمجمع البحرين الذي كان اجتماعهما فيه يقتضي أنه اجتمع بحر العلوم الظاهرية وبحر العلوم الباطنية وهم :
موسى والخضر عليهما السلام ، ثم افترقا بسبب إقامة الجدار بينهما ولا هذا علم ما عند هذا ولا هذا علم ما عند هذا .
قال تعالى :"مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ ( 19 ) بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لا يَبْغِيانِ" [الرحمن : 19 - 20 ] .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( فسكت موسى ووقع الفراق . فانظر إلى كمال هذين الرّجلين في العلم وتوفية الأدب الإلهيّ حقّه .
وإنصاف الخضر عليه السّلام فيما اعترف به عند موسى عليه السّلام حيث قال له : « أنا على علم علّمنيه اللّه لا تعلمه أنت ، وأنت على علم علّمكه اللّه لا أعلمه أنا » . فكان هذا الإعلام من الخضر دواء لما جرّحه به في قوله :وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلى ما لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً( 68 )[ الكهف : 68 ] مع علمه بعلوّ رتبته بالرّسالة ، وليست تلك الرّتبة للخضر ، وظهر ذلك في الأمّة المحمّديّة في حديث إبار النّخل ، فقال عليه السّلام لأصحابه : « أنتم أعلم بمصالح دنياكم » ول شكّ أنّ العلم بالشّيء خير من الجهل به : ولهذا مدح اللّه نفسه بأنّه بكلّ شيء عليم .
فقد اعترف صلى اللّه عليه وسلم بأنّهم أعلم بمصالح دنياهم منه لكونه لا خبرة له بذلك فإنّه علم ذوق وتجربة ولم يتفرّغ عليه السّلام لعلم ذلك ، بل كان شغله بالأهمّ فالأهمّ . )
(فسكت موسى) عليه السلام عن الكلام معه ، وكذا الخضر عليه السلام (ووقع الفراق) بينهما بعد ذلك فلا يجتمعان أصلا (فانظر) يا أيها السالك (إلى كمال هذين الرجلين) موسى والخضر عليهما السلام (في العلم) الإلهي الظاهري في هذ والباطني في هذا (وفي توفية الأدب الإلهي حقه) من كل واحد منهما للآخر (وإنصافه الخضر عليه السلام فيما اعترف به عند موسى عليه السلام حيث قال له) ، كما ورد في حديث البخاري وغيره (أنا على علم إلهي) باطني (علمنيه الله) تعالى كما قال تعالى : "وَعَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً" (لا تعلمه) ، أي ذلك (أنت ، وأنت على علم) إلهي ظاهري (علمكه) ، أي علمك (اللّه) تعالى إياه (لا أعلمه أنا) وصدور هذا من الخضر دون موسى عليه السلام دليل على زيادة علم الخضر على علم موسى عليه السلام وهو أعلم منه بنص الخبر في صحيح البخاري لما قال موسى عليه السلام لبني إسرائيل وقد قالوا له : هل في الأرض أعلم منك فقال : لا ، فأوحى اللّه تعالى إليه أن في مجمع البحرين رجلا أعلم منك ودله على الخضر عليهما السلام حتى وقع منهما ما وقع ، لأن الظاهر من خصائص النسبة النفسانية وهي حال الدنيا لا غير ، وعلم الباطن من خصائص النسبة الإلهية وهي حال الآخرة ، والدنيا سريعة الزوال فهي قليلة بالنظر إلى الآخرة ، والآخرة أبقى فعلمها أعظم .
(فكان هذا الإعلام من الخضر لموسى) عليهما السلام (دواء) ، أي مداواة منه لما جرّحه ، أي جرح الخضر عليه السلام به من الكلام في قوله له أوّل ما اجتمع به ("وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلى ما لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً") [ الكهف : 68 ] مع علمه) ، أي الخضر عليه السلام (بعلو رتبته) ، أي موسى عليه السلام عليه (بالرسالة وليست تلك الرتبة) التي لموسى (للخضر) عليه السلام (وظهر ذلك) ، أي الإعلام بأنه على علم ل يعلمه الآخر وبالعكس (في) هذه (الأمة المحمدية) ، أي المنسوبة إلى محمد صلى اللّه عليه وسلم (في حديث إبار) ، أي تلقيح القوم (النخل) لما مر عليهم النبي صلى اللّه عليه وسلم ، فقال : « لو تركوها أصلحت فتركوها فلم تثمر تلك السنة وأخبروه (فقال) عليه السلام لأصحابه (أنتم أعلم) ، أي مني ("بأمور دنياكم") » . روى نحوه ابن ماجة ورواه ابن حبان في صحيحه ورواه غيرهم .
فهم على علم لا يعلمه هو كما هو على علم لا يعلموه هم (ول شك أن العلم بالشيء) ، أي شيء كان (خير من الجهل به) ، فعلمهم خير في الجملة من الجهل به ، والأعلمية زيادة علم ، وتلك الزيادة لم تكن للنبي صلى اللّه عليه وسلم فهي علمهم الذي هو خير من الجهل بها ؛
ولهذ ، أي لكون العلم مطلقا صفة كمال (مدح اللّه) تعالى (نفسه بأنه بكل شيء عليم ، فقد اعترف) النبي (صلى اللّه عليه وسلم لأصحابه بأنهم أعلم بمصالح الدنيا منه) صلى اللّه عليه وسلم ، أي أكثر علما مع مشاركته لهم في الأصل فلا يرد أنه صلى اللّه عليه وسلم علم علم الأوّلين والآخرين كما ورد في الحديث (لكونه) صلى اللّه عليه وسلم (لا خبرة له بذلك) ، أي بمصالح الدنيا ، وإن كان له بذلك علم (فإنه) ، أي علم الخبرة (علم ذوق وتجربة) ، أي حاصل عنها (ولم يتفرغ عليه السلام لعلم ذلك) بطريق الخبرة والتجربة مثلهم حتى تثبت له الأعلمية به (بل كان) صلى اللّه عليه وسلم (شغله بالأهم فالأهم) من أمور الدين والإسلام .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( فقد نبّهتك على أدب عظيم تنتفع به إن استعملت نفسك فيه .
وقوله :فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْماً يريد الخلافة ؛وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ[ الشعراء : 21].
يريد الرّسالة : فما كلّ رسول خليفة . فالخليفة صاحب السّيف والعزل والولاية . والرّسول ليس كذلك : إنّما عليه بلاغ ما أرسل به . فإن قاتل عليه وحماه بالسّيف فذلك الخليفة الرّسول . فكما أنّه ما كلّ نبيّ رسولا ، كذلك ما كلّ رسول خليفة أي ما أعطي الملك ولا التّحكّم فيه .
وأمّا حكمة سؤال فرعون عن الماهيّة الإلهيّة فلم يكن عن جهل ، وإنّما كان عن اختبار حتّى يرى جوابه مع دعواه الرّسالة عن ربّه - وقد علم فرعون مرتبة المرسلين في العلم - فيستدلّ بجوابه على صدق دعواه . )
(فقد نبهتك) يا أيها السالك (على أدب عظيم) من الأعلى في حق الأدنى إذا كان للأدنى في وصف أعلميته في شيء على الأعلى على أن لا يضيعها له (تنتفع به) ، أي بذلك الأدب إن (استعملت نفسك فيه) ، أي في ذلك الأدب الذي هو من أدب الأنبياء والمرسلين عليهم السلام .
(وقوله) ، أي موسى عليه السلام بعد ذكره فراره من القتل ("فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْماً [ الشّعراء : 21 ] يريد الخلافة") الإلهية في الأرض
("وَجَعَلَنِي")، أي ربي ("مِنَ الْمُرْسَلِينَ") إلى فرعون وبني إسرائيل (يريد الرسالة) النبوية (فما كل رسول) من اللّه تعالى (خليفة) في الأرض عن اللّه تعالى (فالخليفة) عن اللّه تعالى (صاحب السيف) ، أي الحكم القاهر وصاحب (العزل) لمن يشاء في المناصب الدينية والدنيوية وصاحب (الولاية) كذلك لمن يشاء على رفق الحكمة الإلهية ، فهو صاحب حكم وحكمة في الظاهر والباطن
(والرسول) من اللّه تعالى (ليس كذلك إنما عليه السلام ) ، أي الرسول (البلاغ) فقط (لما أرسل به) من الأحكام إلى من أرسل إليه (فإن قاتل) ، أي الرسول (عليه) ، أي على ما أرسل به (وحماه) ، أي حفظ ما أرسل به من أحكام اللّه تعالى (بالسيف فذلك) المذكور هو (الخليفة الرسول) ، أي الجامع بين الوصفين (فكما أنّه) ، أي الشأن (ما كل نبي رسولا) إذ بعض الأنبياء رسل ، والبعض أنبياء من غير رسالة فبينهما عموم مطلق (كذلك ما كل رسول خليفة) ، أي (أعطاه اللّه تعالى الملك) ، أي الحكم والسلطنة (والتحكم فيه )، أي في الملك .
ولهذ قال بعض الأنبياء :"رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ" [ الشعراء : 83 ] ، فطلب الخلافة الإلهية ، فقد يكون رسولا وليس بخليفة ، كما أنه قد يكون خليفة وليس بنبي ولا رسول ، كالأولياء المستخلفين في الأرض والملوك ، فبينهما عموم من وجه .
(وأم حكمة سؤال فرعون) لموسى عليه السلام (عن الماهية الإلهية) بقوله :
وم رب العالمين فلم يكن ، أي ذلك السؤال له (عن جهل) منه برب العالمين ؛ ولهذا ورد أنه لما انقطع النيل في مصر دعا فرعون اللّه تعالى وتضرع إليه أن ل يفضحه بين قومه ، فأجرى اللّه تعالى له النيل ، ولولا معرفته به ما دعاه ، وإن قال :ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرِي[ القصص : 38 ] فإنه كاذب في ذلك (وإنما كان) ذلك السؤال منه (عن اختبار) ، أي امتحان لموسى عليه السلام (حتى يرى جوابه) ،
أي موسى عليه السلام عن ذلك مع دعواه ، أي موسى عليه السلام الرسالة إلى قومه عن ربه تعالى .
(وقد علم فرعون مرتبة المرسلين في العلم) باللّه تعالى (فيستدل) ، أي فرعون (بجوابه) ، أي جواب موسى عليه السلام (على صدق دعواه) ، أي موسى عليه السلام رسالة اللّه تعالى .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( وسأل سؤال إيهام من أجل الحاضرين حتّى يعرّفهم من حيث لا يشعرون بما شعر هو في نفسه في سؤاله .
فإذا أجابه جواب العلماء بالأمر ، أظهر فرعون - إبقاء لمنصبه - أنّ موسى ما أجابه على سؤاله .
فيتبيّن عند الحاضرين - لقصور فهمهم - أنّ فرعون أعلم من موسى . ولهذا لمّا قال له في الجواب ما ينبغي وهو في الظّاهر غير جواب ما سئل عنه . )
(وسأل) فرعون (سؤال إيهام) للغير خلاف الحق ليتم له باطله الذي يدعيه (من أجل الحاضرين) من قومه المؤمنين به (حتى يعرفهم) ، أي فرعون (من حيث ل يشعرون) أنه يعرفهم (بما شعر هو) ، أي فرعون به (في نفسه في سؤاله) ذلك والذي شعر به في نفسه هو عجز موسى عليه السلام عن جواب سؤاله عن الماهية .
(فإذ أجابه) ، أي موسى عليه السلام (جواب العلماء بالأمر) الإلهي على م هو عليه (أظهر فرعون) للحاضرين من قومه (إبقاء لمنصبه) وهو ألوهيته بينهم (أن موسى) عليه السلام (ما أجابه عن سؤاله) ذلك (فيتبين عند الحاضرين) من قوم فرعون( لقصور فهمهم) من كثرة جهلهم باللّه تعالى (أن فرعون أعلم) بالأمور من موسى عليه السلام (ولهذا لما قال) ، أي موسى عليه السلام له ، أي لفرعون في الجواب عن سؤاله (ما ينبغي) ، أي يليق أن يكون هذا الجواب وهو ، أي جواب موسى عليه السلام (في الظاهر) ، أي بحسب ما تقتضيه كلمة ما الاستفهامية من معنى السؤال عن الماهية (غير جواب ما سئل) ، أي موسى عليه السلام (عنه) فإنه لا جواب لذلك السؤال أصلا ، إذ ماهية الحق تعالى يستحيل أن تكون من شيء من الحوادث ، أو تكون معرفة من حيث هي ماهية لأحد من الخلق ، وإنما عرف تعالى وتميز عن خلقه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى.
قال الشيخ رضي الله عنه : ( وقد علم فرعون أنّه لا يجيبه إلّا بذلك - فقال لأصحابه "إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ" [ الشعراء : 27 ] أي مستور عنه علم ما سألته عنه ، إذ لا يتصوّر أن يعلم أصلا .
فالسّؤال صحيح ؛ فإنّ السّؤال عن الماهيّة سؤال عن حقيقة المطلوب ، ولا بد أن يكون على حقيقة في نفسه . وأمّا الّذين جعلوا الحدود مركّبة من جنس وفصل ، فذلك في كلّ ما يقع فيه الاشتراك ، ومن لا جنس له لا يلزم أن لا يكون على حقيقة في نفسه لا تكون لغيره . فالسّؤال صحيح على مذهب أهل الحقّ والعلم الصّحيح والعقل السّليم ، والجواب عنه لا يكون إلّا بما أجاب به موسى عليه السّلام . )
وقد علم فرعون أنه ، أي موسى عليه السلام لا يجيبه ، أي فرعون إلا بذلك ، أي بذكر الأوصاف كما قال تعالى :"قالَ فِرْعَوْنُ وَم رَبُّ الْعالَمِينَ ( 23 ) قالَ رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُمَ إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ( 24 ) قالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَ لا تَسْتَمِعُونَ ( 25 ) قالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ" [ الشعراء :23-26].
فقال ، أي فرعون لأصحابه الحاضرين عنده ("إِنَّ رَسُولَكُمُ") على طريق الاستهزاء به والتهكم عليه ، وإلا فلا يريد أن يصدقه أنه رسولهم ، لأنه مكذب له ("الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ") أي مستور عنه ، أي عن عقله (علم ما سألته عنه) من الماهية الإلهية (إذ لا يتصوّر أن يعلم) بالبناء للمفعول ،
أي علم ما سأله (أصلافالسؤال) عن ذلك صحيح لا شبهة فيه فإن السؤال عن الماهية ، أي ماهية الإله سؤال عن حقيقة الأمر المطلوب ولا بد أن يكون ذلك المطلوب على حقيقة ،
أي ماهية متحققة (في نفسه وأما الذين جعلوا الحدود) ، أي التعاريف الذاتية (مركبة من جنس) عام (وفصل) خاص كالحيوان الناطق مثلا في تعريف الإنسان
(فذلك) ، أي التركيب في الحد (في كل ما يقع فيه الاشتراك) بين الأنواع الداخلة تحت جنس واحد (ومن لا جنس له) إذ لا قدر مشترك بينه وبين غيره أصلا وهو اللّه تعالى لا يلزم منه (أن لا يكون على حقيقة في نفسه) حيث لم تكن حقيقة مشاركة لغيرها في قدر عام هو الجنس بحيث ينفرد بتلك الحقيقة حتى ( ل تكون لغيره) بل من لا جنس له وهو اللّه تعالى له حقيقة في نفسه انفرد بها فل تكون لغيره أصلا ( فالسؤال ) عن ماهية اللّه تعالى وحقيقته ( صحيح على مذهب أهل الحق و) أهل ( العلم الصحيح و) أهل (العقل السليم والجواب عنه) ، أي عن ذلك السؤال (لا يكون إلا بما أجاب به موسى) عليه السلام كما ذكر في القرآن من قوله :"رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما"[ مريم : 65 ] ،
وقوله :"رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ"[ الشعراء : 26 ] ،
وقوله :"رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَم بَيْنَهُما"[ الشعراء : 28 ] .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( وهنا سرّ كبير ، فإنّه أجاب بالفعل لمن سأل عن الحدّ الذّاتي ، فجعل الحدّ الذّاتي عين إضافته إلى ما ظهر به من صور العالم ، أو إلى ما ظهر فيه من صور العالم . فكأنّه قال له في جواب قوله :وَما رَبُّ الْعالَمِينَ[ الشعراء : 23 ]
قال الّذي يظهر فيه صور العالمين من علووهو السماء وسفل وهو الأرض إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ[ الشعراء : 24 ] أو يظهر هو بها .
فلمّا قال فرعون لأصحابه :إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ [ القلم : 51 ] كما قلنا في معنى كونه مجنونا .
زاد موسى في البيان ليعلم فرعون مرتبته في العلم الإلهيّ ، لعلمه بأنّ فرعون يعلم ذلك ،
فقال :رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فجاء بما يظهر ويستتر وهو الظّاهر والباطن ، وما بينهما وهو قوله :بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [ البقرة : 29 ] .إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ[ الشعراء : 28 ] أي إن كنتم أصحاب تقييد ؛ فإنّ العقل يقيّد . )
(وهنا) في ذكر الربوبية المضافة التي هي كناية عن العقل الإلهي (سر كبير) من أسرار اللّه تعالى (فإنه) ، أي موسى عليه السلام (أجاب بالفعل لمن سأل) وهو فرعون (عن الحد) ، أي التعريف (الذاتي) بقوله :"وَما رَبُّ الْعالَمِينَ"[ الشعراء : 23].
(فجعل) ، أي موسى عليه السلام (الحد الذاتي) لماهية اللّه تعالى وحقيقته (عين إضافته) ، أي نسبته تعالى (إلى ما) ، أي الذي (ظهر) تعالى (به من صور العالم) ، أي المخلوقات (أو إلى ما ظهر) ، أي تبين (فيه) ، أي في الحق تعالى (من صور العالم فكأنه) ، أي موسى عليه السلام (قال له) ، أي لفرعون في جواب قوله ، أي فرعون ("وَما رَبُّ الْعالَمِينَ" قال) ، أي موسى عليه السلام (الذي تظهر فيه صور العالمين) من غير حلول فيه ، لأنها عدم وهو وجود صرف مطلق ،
والعدم لا يحل في الوجود والوجود ل يحل في العدم من علو بيان للصور وهو ، أي العلو السماء ومن سفل وهو ، أي السفل الأرض إن كنتم موقنين باللّه تعالى أو الذي يظهر هو تعالى بها ، أي بصور العالمين من علو وسفل كما ذكر فلما قال فرعون لأصحابه الحاضرين عنده إنه ، أي موسى عليه السلام (" لَمَجْنُونٌ" [ الحجر : 6 ] كما قلنا)
فيما مر قريبا (في معنى كونه) ، أي موسى عليه السلام (مجنونا) ، أي مستورا عنه علم ما سئل عنه من الماهية الإلهية ولهذا أجاب بما ليس بجواب عن الماهية (زاد موسى) عليه السلام (في البيان) ، أي بيان الجواب (ليعلم فرعون رتبته) ، أي رتبة موسى عليه السلام (في العلم الإلهي لعلمه) ، أي موسى عليه السلام (بأن فرعون يعلم ذلك) ، أي العلم الإلهي لكن علمه باللّه على وجه الزندقة من عدم انقياده لموسى عليه السلام وإسلامه له
(فقال) ، أي موسى عليه السلام ("رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ " فجاء بما يظهر) وهو المشرق يظهر الشمس و ما يستتر وهو المغرب يستر الشمس وهو ، أي اللّه تعالى (الظاهر والباطن) فتظهر شمس الأحدية من مشرق الصور الكونية ، ثم تغرب في غيب الهوية الذاتية ، فتخفي تلك الصور في حقائقها العدمية وما بينهما ، أي بين المشرق والمغرب وهو قوله تعالى
وهو ، أي اللّه تعالى ("بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ") [ البقرة : 29 ] فحصره العلم الإلهي إذ ظهر في العبد السالك كان بين الظهور والبطون وبين المشرق والمغرب ("إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ" [ الشعراء : 28 ] ، أي إن كنتم أصحاب تقييد ) في الجناب الإلهي لا إطلاق (فإن للعقل التقييد) بالصور في التشبيه والتنزيه .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( فالجواب الأوّل جواب الموقنين وهم أهل الكشف والوجود . فقال لهم :إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ[ الشعراء : 24 ] أي أهل كشف ووجود ، فقد أعلمتكم بما تيقّنتموه في شهودكم ووجودكم .
فإن لم تكونوا من هذا الصّنف ، فقد أجبتكم في الجواب الثّاني إن كنتم أهل عقل وتقييد وحصرتم الحقّ فيما تعطيه أدلّة عقولكم فظهر موسى بالوجهين ليعلم فرعون فضله وصدقه ، وعلم موسى أنّ فرعون علم ذلك - أو يعلم ذلك لكونه سأل عن الماهيّة ، فعلم أنّه ليس سؤاله على اصطلاح القدماء في السؤال بما ، فلذلك أجاب فلو علم منه غير ذلك لخطّأه في السّؤال . )
فالجواب الأوّل وهو قول موسى عليه السلام " رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَم بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ" [ الشعراء : 24 ] . (جواب الموقنين وهم أهل الكشف) عن الحضرات الإلهية (والوجود) المطلق (فقال لهم :)، أي موسى عليه السلام لفرعون وقومه ("إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ " [ الشعراء:24] أي إن كنتم أهل كشف إلهي وأهل وجود عيني فقد أعلمتكم بما تيقنتموه ، أي عرفتموه يقينا في شهودكم لكل شيء وفي
(وجودكم) لكم (فإن لم تكونوا من هذا الصنف) المذكور (فقد أجبتكم في الجواب الثاني) وهو قول موسى عليه السلام :قالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَما بَيْنَهُما إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ( 28 ) [ الشعراء : 28 ] ، يعني (إن كنتم أهل عقل وتقييد وحصرتم الحق) تعالى (فيما تعطيه أدلة) جمع دليل (عقولكم ) من المعاني والصور الخيالية .
(فظهر موسى) عليه السلام (بالوجهين) ، أي وجه الإطلاق في المعرفة لأهل اليقين ، ووجه التقييد فيها لأهل العقول (ليعلم فرعون فضله) ، أي موسى عليه السلام في المعرفة (وصدقه) في النصح للأمة (وعلم موسى) عليه السلام (أن فرعون يعلم ذلك) ، أي الذي ذكره موسى عليه السلام له (لكونه) ، أي فرعون (سأل عن الماهية) ، أي ماهية الإله من حيث لوازمها الفعلية .
(فعلم) ، أي موسى عليه السلام (أن سؤاله) ، أي فرعون (ليس على) مقتضى (اصطلاح القدماء) من حكماء الفلاسفة (في السؤال بما )، أي عن ماهية الشيء من حيث هي ماهية (فلذلك أجاب) ، أي موسى عليه السلام عن السؤال (فلو علم) ، أي موسى عليه السلام (منه) ، أي من فرعون (غير ذلك) ، أي غير سؤاله عن الماهية من حيث اللوازم الفعلية لها (لخطأه في السؤال) إذ ليست ماهيته تعالى بمركبة من عام وخاص كماهيات الأشياء ، فلا يمكن معرفتها أصل ، فالسؤال عنها من هذه الحيثية عبث لأنه لا يتحصل للأفهام فيه شيء .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( فلمّا جعل موسى المسؤول عنه عين العالم ، خاطبه فرعون بهذا اللسان والقوم لا يشعرون . فقال له :لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلهَاً غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ[ الشعراء : 29 ] .
والسّين في « السّجن » من حروف الزّوائد : أي لأسترنّك فإنّك أجبتني بما أيّدتني به أن أقول لك مثل هذا القول .
فإن قلت لي : فقد جهلت يا فرعون بوعيدك إيّاي ، والعين واحدة ، فكيف فرقت فيقول فرعون إنّما فرقت المراتب العين ما تفرّقت العين ولا انقسمت في ذاتها . ومرتبتي الآن التّحكّم فيك يا موسى بالفعل ، وأنا أنت بالعين وغيرك بالرّتبة . )
(فلم جعل موسى) عليه السلام (المسؤول عنه) وهو ماهية الإله من حيث لوازمه الفعلية (عين العالم) ، لأنه تعالى هو الظاهر بصور العالم أو صور العالم ظاهرة به
(خاطبه فرعون بهذا اللسان) الذي كلم به موسى عليه السلام وهو لسان المعرفة الباطنية الذوقية (والقوم) الحاضرون من آل موسى وأتباعه (لا يشعرون) بما جرى بينهما من الكلام (فقال) ، أي فرعون له ، أي لموسى عليه السلام ("لَئِنِ اتَّخَذْتَ") يا موسى ("إِلهَاً")، أي معبود ("غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ" [ الشعراء : 29] والسين في السجن من حروف الزوائد)
المجموعة في قولك سألتمونيها أو قولك هويت السمان ، فهو مشتق من الجيم والنون وهي مادة الترقي في كل ما وقعت (كالجن والمجن والجنة والجنان والجنون) ،
(أي لأسترنّك )، عن شهود عين الوجود المطلق وهو وعيد له على عدم إيمانه به (فإنك) يا موسى (أجبت بما أيدتني) به من دعوى ظهور الربوبية في صورتي لأني من جملة ما قلترَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما[ مريم : 65 ] ، ورَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَما بَيْنَهُما[ الشعراء : 28 ] فإني أنا من حيث العين الواحدة ذاك الذي أشرت إليه فقد أغنيتني (أن أقول لك مثل هذا القول) الذي قلته لي .
(فإن قلت) ، أي يا موسى (لي بلسان الإشارة فقد جهلت يا فرعون بوعيدك إياي) بأن تسترني عن هذا الشهود وتجعلني غافلا عنه مثل هؤلاء القوم الغافلين الجاهلين المحجوبين (والعين) ، أي الذات الإلهية الظاهرة بالصورة مني ومنك واحدة لا تعدد لها (فكيف فرقت) وأنت تزعم الجمع (فيقول فرعون) لموسى عليه السلام (إنما فرقت المراتب) الاعتبارية بالصور الامكانية (العين) الواحدة الإلهية فتكثر الواحد بالمراتب (ما تفرقت العين) الواحدة بل هي واحدة في جميع المراتب لم تتغير (ولا انقسمت) ، أي العين (في ذاتها) أصلا (ومرتبتي الآن) ، أي في ذلك الوقت هي (التحكم) بصورتي (فيك) ، أي في صورتك يا موسىبالفعل لاقتضائها ذلك في الظهور (وأنا أنت بالعين) الواحدة (وأنا غيرك بالرتبة) لتلك العين الواحدة .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( فلما فهم ذلك موسى منه أعطاه حقّه في كونه يقول له لا تقدر على ذلك ، والرّتبة تشهد له بالقدرة عليه وإظهار الأثر فيه : لأنّ الحقّ في رتبة فرعون من الصّورة الظّاهرة ، لها التّحكّم على الرّتبة الّتي كان فيها ظهور موسى في ذلك المجلس .
فقال له يظهر له المانع من تعدّيه عليهأَ وَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ[ الشعراء : 30].
فلم يسع فرعون إلّا أن يقول له :فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ[ الشعراء : 31 ] حتّى لا يظهر فرعون عند الضّعفاء الرّاي من قومه بعدم الإنصاف فكانوا يرتابون فيه ، وهي الطّائفة الّتي استخفّها فرعون فأطاعوهإِنَّهُمْ كانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فاسِقِينَ[ الأنبياء : 74 ] أي خارجين عمّا تعطيه العقول الصّحيحة من إنكار ما ادّعاه فرعون باللّسان الظّاهر في العقل ، فإنّ له حدا يقف عنده إذا جاوزه صاحب الكشف واليقين . )
(فلم فهم ذلك) المعنى المذكور (موسى) عليه السلام (منه) ، أي من فرعون بقرائن الأحوال ومحاورات الكلام (أعطاه) ، أي أعطى موسى عليه السلام فرعون حقه الظاهر به في كونه ، أي موسى عليه السلام يقول له ، أي لفرعون بمقتضى إشارة الكلام لا تقدر من حيث رتبتك على ذلك الفعل الذي توعدتني به من ستري عن شهود العين الإلهية وسلبي مقام جمعيتي ، لأنه تصرف من حيث الباطن ولا يكون الزنديق أصلا إنما هو للصديقين خاصة ، وإن كان للزنديق التصرف من حيث الظاهر والتحكم بالصورة الظاهرة في كل ما دخل تحت يده .
والمرتبة التي كان فرعون ظاهرا بها في العين الواحدة تشهد له ، أي لفرعون بالقدرة من حيث التحكم الظاهر عليه ، أي على موسى عليه السلام وإظهار الأثر من حيث الظاهر فيه ، أي في موسى عليه السلام لأن الحق تعالى ، أي العين الواحدة الإلهية الظاهرة في رتبة فرعون من الصورة المحسوسة الظاهرة لفرعون لها التحكم على ظاهر الرتبة التي كان فيها ظهور موسى عليه السلام في ذلك المجلس ، أي مجلس فرعون وقومه فقال ، أي موسى عليه السلام له ، أي لفرعون يظهر ، أي موسى عليه السلام وهو حال من فاعل قال له ، أي لفرعون المانع لفرعون من حيث رتبة موسى عليه السلام من تعديه ، أي فرعون عليه ، أي على موسى عليه السلام وإنفاذ م توعده بهأَ وَلَوْ جِئْتُكَيا فرعون ("بِشَيْءٍ مُبِينٍ") [ الشعراء : 30 ] ، أي واضح من البراهين القاطعة الدالة على صدق دعواي .
فلم يسع عند ذلك فرعون إلا أن يقول له ، أي لموسى عليه السلام ("فَأْتِ بِهِ") [ الشعراء : 31 ] ، أي بذلك الشيء المبين ("إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ") [ الأعراف : 70 ] في دعوى مجيئك بالحق حتى ل يظهر فرعون في ذلك المجلس عند الضعفاء الرأي ، أي الفكر والنظر من قومه الحاضرين بعدم الإنصاف في رد أدلة خصومه وعدم الالتفات إليها فكانوا حينئذ يرتابون ، أي يشكون ويترددون فيه ، أي في فرعون وهي ، أي الضعفاء الرأي من قومه الطائفة التي استخفها فرعون ، أي طلب خفة عقله بما أظهره لها من زخارف الغرور فأطاعوه
في كل ما زعم ("إِنَّهُمْ") [ الأنبياء : 74 ] ، أي تلك الطائفة ("كانُو قوما فاسِقِينَ") [ الأنبياء : 74 ] كما قال تعالى : فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطاعُوهُ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ( 54 ) [ الزخرف :54] أي خارجين عما تعطيه العقول البشرية الصحيحة من إنكار ما ادعاه فرعون من الربوبية لهم باللسان الظاهر في العقل المقتضي للفرق دون الجمع فإن له ،
أي للعقل حدا يقف عنده فلا يجاوزه إذا جاوزه ، أي ذلك الحد صاحب الكشف الذوقي واليقين العيني من أهل التحقيق .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( ولهذا جاء موسى في الجواب بما يقبله الموقن والعاقل خاصّة .فَأَلْقى عَصاهُوهي صورة ما عصى به فرعون موسى في إبائه عن إجابة دعوتهفَإِذا هِيَ ثُعْبانٌ مُبِينٌ[ الشعراء : 32 ] أي حيّة ظاهرة .
فانقلبت المعصية الّتي هي السّيّئة طاعة أي حسنة كما قال :يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ[ الفرقان : 70 ] يعني في الحكم .
فظهر الحكم ههنا عينا متميّزة في جوهر واحد . فهي العصا وهي الحيّة والثّعبان الظّاهر ، فالتقم أمثاله من الحيّات من كونها حيّة والعصيّ من كونها عص . فظهرت حجّة موسى على حجج فرعون في صورة عصيّ وحيّات وحبال .
فكانت للسّحرة حبال ولم يكن لموسى حبل . والحبل التّلّ الصّغير أي مقاديرهم بالنّسبة إلى قدر موسى عند اللّه كنسبة التّلال الصّغيرة إلى الجبال الشّامخة . )
(ولهذا) ، أي لكون الأمر كذلك (جاء موسى) عليه السلام (في الجواب) عن سؤال فرعون (بما يقبله) العبد (الموقن) ، أي صاحب اليقين (والعاقل) ، أي صاحب العقل فقال:
أوّلا : إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ
وثانيا : إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ خاصة ،
أي لا غيرهما ، فإن من لم يكن له يقين ولا عقل فلا جواب له من موسى عليه السلام ("فَأَلْقى") موسى عليه السلام عند ذلك ("عَصاهُ") التي كانت في يده وهي ، أي تلك العصا صورة ما ، أي الأمر الذي (عصى به فرعون) رسوله (موسى) عليه السلام ، وذلك مثال نفس فرعون العاصية في إبائه ، أي امتناعه (عن إجابةدعوته) ، أي دعوة موسى عليه السلام ("فَإِذا هِيَ") ، أي تلك العصا ("ثُعْبانٌ مُبِينٌ") [ الشعراء : 32 ] ، أي واضح مكشوف بحيث يعرفه كل أحد يعني (حية ظاهرة فانقلبت المعصية التي هي السيئة) التي عصى بها فرعون لموسى عليه السلام (طاعة)
لو فعل ذلك فرعون أي حسنة يثاب عليها كما قال اللّه تعالى : أولئك (" يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ") [ الفرقان : 70 ] يعني ) بذلك في الحكم الإلهي فبعد أن يكون الحكم عليها بأنها سيئات يصير بأنها حسنات .
(فظهر الحكم) الإلهي (هنا) ، أي في العصا (عين متميزة) عما سواها (في جوهر واحد) وهو ماهيتها الأصلية التي كانت فيه في حال كونها عصا (فهي العصا) ومع ذلك (هي الحية والثعبان الظاهر) ، وقد ظهر لفرعون من موسى عليه السلام ما كان عنه فرعون من طاعة العين الواحدة لمقتضى رتبة موسى عليه السلام في إظهار ما شاء من المراتب ،
ثم قال موسى عليه السلام : بمرتبة عينه على مرتبة فرعون لإبطال دعواه وإظهار عجزه عما يحاول (فالتقم )ذلك الثعبان (أمثاله من الحيات) التي جاءت بها السحرة (من كونها) ، أي عصا موسى عليه السلام (حية و) التقم (العصي) بالتشديد جمع عصاة ، أي ما جاء السحرة من عصيهم (من كونها) ، أي عصا موسى عليه السلام (عصا) ولم يبق لحيات السحرة ولا لعصيهم أثر في الوجود أصلا كل هذا ولم تتغير حية موسى عليه السلام ولا عصاه كما كانت عليه .
(فظهرت) ، أي انتصرت عند ذلك (حجة موسى) عليه السلام أي آيته ودليله وبرهانه (على حجج) ، أي أدلة (فرعون) وكان ذلك (في صورة عصي) جمع عصا (وحيات وحبال فكانت للسحرة الحبال) ، لأنهم أثوابها (ولم يكن لموسى) عليه السلام (حبل) وإنما له العصا (والحبل) بالباء الموحدة التحتية قبلها حاء مهملة يطلق في اللغة على التل الصغير فهو إشارة إلى قدرهم (أي مقاديرهم) يعني السحرة في العلم (بالنسبة إلى قدر موسى) عليه السلام (بمنزلة الحبال) بالحاء المهملة ، أي التلال المستطيلة من الرمل (من الجبال) بالجيم جمع جبل (الشامخة) العالية العظيمة .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( فلمّا رأت السّحرة ذلك علموا رتبة موسى في العلم ، وأنّ الّذي رأوه ليس من مقدور البشر وإن كان من مقدور البشر فلا يكون إلّا ممّن له تميز في العلم المحقّق عن التّخيّل والإيهام ، فآمنوا بربّ العالمين ربّ موسى وهارون : أي الرّبّ الّذي يدعو إليه موسى وهارون ، لعلمهم بأنّ القوم يعلمون أنّه ما دعا لفرعون .
ولمّا كان فرعون في منصب التّحكّم صاحب الوقت ، وأنّه الخليفة بالسّيف - وإن جار في العرف النّاموسي - لذلك قال :أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلىأي وإن كان الكلّ أربابا بنسبة ما فأنا الأعلى منهم بما أعطيته في الظّاهر من التّحكّم فيكم .)
(فلم رأت السحرة ذلك) ، أي عظم ما جاء به موسى عليه السلام من الحق المبين (علموا) ، أي السحرة (رتبة موسى) عليه السلام (في العلم) باللّه تعالى (وأن الذي رأوه) من عصا موسى عليه السلام وما تلقفه من حبالهم وعصيهم (ليس من مقدور) ، أي من الأمر الذي تقدر عليه قوّة (البشر و) إن (كان) ذلك (من مقدور) بعض (البشر فلا يكون إلا ممن له تمييز) ، أي رفعة وشرف (في العلم) الإلهي (المحقق) ، أي الكاشف عن حقيقة الأمر البعيد (عن التخيل والإيهام) ، أي التمويه والزخرفة الباطلة .
("فآمنوا") ، أي السحرة عند ذلك كما قالوا (برب العالمين رب موسى وهارون أي الرب الذي يدعو إليه )، أي إلى عبادته وطاعته دون غيره من الأرباب الباطلة (موسى وهارون) عليهما السلام (لعلمهم) ، أي السحرة (بأن القوم) ، أي قوم فرعون الحاضرين (يعلمون أنه) ، أي موسى عليه السلام (ما دعا) ، أي طلب الطاعة والانقياد (لفرعون) وإنما كان يدعو إلى اللّه رب العالمين .
(ولم كان فرعون في منصب التحكم الظاهر صاحب ذلك الوقت وأنه الخليفة) عن الحق تعالى في الأرض (بالسيف وإن جار) ، أي ظلم وتعدى (في العرف) ، أي الاصطلاح (الناموسي) ، أي الشرعي الذي يعرفه موسى عليه السلام ومن تبعه ، لا في عرفه هو ، فإن اللّه تعالى يستخلف في الظاهر المؤمن والكافر والمطيع والعاصي ، ويجعله بحيث ينفذ أمره ونهيه طوعا وكرها في كل ما يريد ،
كم قال تعالى عن قوم صالح عليه السلام وهم ثمود :وَاذْكُرُو إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ عادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ[ الأعراف : 74 ] وهو كثير في القرآن لذلك ، أي لأجل ما ذكر قال : ، أي فرعون لقومه لما جمعهم كما قال تعالى :فَحَشَرَ فَنادى ( 23 ) فَقالَأَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلى( 24 ) [ النازعات : 24 ] .
وإن كان الكل من بني آدم أربابا لما تحت أيديهم من الأملاك بنسبة مّا ، فلهم التحكم في أملاكهم فأنا الأعلى منهم ، أي من الأرباب كلهم بما ، أي بسبب الأمر الذي أعطيته بالبناء للمفعول أي اقتضاه مقامي ومنزلتي في الظاهر من التحكم فيكم بحيث ينفذ أمري ونهيي .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( ولمّا علمت السّحرة صدقه فيما قاله لم ينكروه وأقرّوا له بذلك فقالوا له :فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ إِنَّما تَقْضِي هذِهِ الْحَياةَ الدُّنْي[ طه : 72 ] فالدّولة لك .
فصحّ قوله :أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلى[ النازعات : 24 ] وإن كان عين الحقّ فالصّورة لفرعون ، فقطّع الأيدي والأرجل وصلب بعين حقّ في صورة باطل لنيل مراتب لا تنال إلّا بذلك الفعل .
فإنّ الأسباب لا سبيل إلى تعطيلها لأنّ الأعيان الثّابتة اقتضتها ؛ فلا تظهر في الوجود إلّا بصورة ما هي عليه في الثّبوت إذ لا تبديل لكلمات اللّه . وليست كلمات اللّه سوى أعيان الموجودات ، فينسب إليها القدم من حيث ثبوتها وينسب إليها الحدوث من حيث وجودها وظهورها كما تقول حدث اليوم عندنا إنسان أو ضيف ول يلزم من حدوثه أنّه ما كان له وجود قبل هذا الحدوث . ولذلك قال تعالى في كلامه العزيز أي في إتيانه مع قدم كلامه :ما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ( 2 )[ الأنبياء : 2 ] وَما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ( 5 )[ الشعراء :5].
والرّحمن لا يأتي إلّا بالرّحمة . ومن أعرض عن الرّحمة استقبل العذاب الّذي هو عدم الرّحمة.)
(ولم علمت السحرة) بعد إيمانهم (صدقه) ، أي فرعون (فيم قال لهم) كما حكاه تعالى :" قالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنا أَشَدُّ عَذاباً وَأَبْقى"( 71 ) [ طه : 71].
(لم ينكروه )، أي قوله (وأقروا له بذلك) ، بنفوذ تحكمه في الحياة الدنيا (فقالو له) ،قالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلى ما جاءَنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالَّذِي فَطَرَنا فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ إِنَّما تَقْضِي هذِهِ الْحَياةَ الدُّنْيا( 72 ) [ طه : 72 ] .
وفي معنى الآية تقديم وتأخير وتقديره كما قال : ("فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ"[ طه : 72 ] فالدولة) ، أي السلطنة والمنصب (لك فصح قوله) ، أي فرعون حينئذ ("أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلى ") أنا نافذ الأمر في جميع أحوالكم وإن كان ، أي فرعون لما قال ذلك (عين الحق) تعالى من حيث الوجود الظاهر بالفعل .
(فالصورة) الظاهرة (لفرعون) فنفذ أمره (فقطع الأيدي والأرجل) من السحرة (وصلب) لهم كما توعدهم بذلك (بعين حق) ظاهر (في صورة باطل) وهو فرعون لنيل ، أي حصول (مراتب) ، أي مزايا ومقامات في الآخرة للسحرة (ل تنال) تلك المراتب (إلا بذلك) الفعل الذي فعله فرعون بالسحرة من القطع والصلب .
فإن الأسباب التي جعلها اللّه تعالى بحيث يترتب عليها المسببات (لا سبيل إلى تعطيلها) أصلا ، كما قتل اليهود أنبياءهم وقطع رأس يحيى ونشر زكريا عليهم السلام ، فهي أسباب لمسببات شريفة عظيمة جعلها اللّه تعالى وسائل إليها (لأن الأعيان الثابتة) في العلم الإلهي المعدومة بالعدم الأصلي (اقتضتها) ، أي تلك الأسباب فهي مرتبة معها كذلك (فلا تظهر) ، أي تلك الأعيان الثابتة (في ) هذا (الوجود إلا بصورة ما هي عليه في حال الثبوت) العلمي مطابقة لذلك إذ لا تبديل لكمات اللّه تعالى كما قال سبحانه :لا تَبْدِيلَ لِكَلِماتِ اللَّهِ[ يونس : 64 ] .
وليست كلمات اللّه تعالى (سوى أعيان الموجودات) المحسوسة والمعقولة والموهومة (فينسب) بالبناء للمفعول (إليها) ، أي إلى الأعيان الموجودات (القدم) فيصح أن يقال أنها قديمة (من حيثثبوتها) بالعدم الأصلي في حضرة العلم الإلهي القديم (وينسب) أيضا (إليها) ، أي إلى الأعيان الموجودات (الحدوث) فيصح أن يقال إنها حادث (من حيث وجودها) المرئي لها (وظهورها به كما تقول حدث عندنا اليوم إنسان أو) حدث (ضيف زائر) ، أي حدثت له صفة العندية والضيفية لا حدث هو في نفسه (ول يلزم من حدوثه أنه ما كان له وجود قبل هذا الحدوث الذي وقع الإخبار عنه.
(ولذلك) ، أي لأجل ما ذكر (قال تعالى في حق كلامه العزيز ، أي في إتيانه) بإنزاله على النبي صلى اللّه عليه وسلم (مع قدم كلامه) تعالى ، أي كونه قديما وليس بحادث (ما يَأْتِيهِمْ)، أي الكافرين (مِنْ ذَكَرٍ)، أي قرآن (مِنْرَبِّهِمْ مُحْدَثٍ) إتيانه عندهم مع قدمه (إِلَّا اسْتَمَعُوهُ) بآذانهم (وَهُمْ يَلْعَبُونَ)[ الأنبياء : 2 ] بقلوبهم وعقولهم في أحوال دنياهم ويلعبون به بأن يترنموا بكلماته ويطربو بها من غير تدبر للمعاني ولا عمل بها .
وقال تعالى أيضا : (وَما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمنِ مُحْدَثٍ)[ الشعراء : 5 ] ،
إتيانه أيضا مع قدمه (إِلَّا كانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ) لاشتغالهم بدنياهم أو بتحسين كلماته وتجويد ألفاظه من غير التفات إلى تدبر معانيه والعمل به (والرحمن سبحانه لا يأتي إلا بالرحمة) لأن العالم كله ما ظهر إلا بها وهي التي وسعت كل شيء ومن أعرض عن الرحمة كما قال إلا كانوا عنه معرضين (استقبل العذاب الذي هو عدم الرحمة) ، لأنه نقمة .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( وأمّا قوله :فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْ بَأْسَنا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ [ غافر :85 ].إلّا قوم يونس ، فلم يدلّ ذلك على أنّه لا ينفعهم في الآخرة بقوله في الاستثناء إلّا قوم يونس .
فأراد أنّ ذلك لا يدفع عنهم الأخذ في الدنيا ، فلذلك أخذ فرعون مع وجود الإيمان منه .
هذا إن كان أمره أمر من تيقّن بالانتقال في تلك السّاعة . وقرينة الحال تعطي أنّه ما كان على يقين من الانتقال أنّه عاين المؤمنين يمشون على الطّريق اليبس الّذي ظهر بضرب موسى بعصاه البحر . فلم يتيقّن فرعون بالهلاك إذ آمن ، بخلاف المحتضر حتى لا يلحق به .
فآمن بالّذي آمنت به بنو إسرائيل على التّيقّن بالنّجاة ، فكان كم تيقّن لكن على غير الصّورة الّتي أراد ، فنجّاه اللّه من عذاب الآخرة في نفسه ، ونجّا بدنه كما قال تعالى : فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً [ يونس : 92 ] .
لأنّه لو غاب بصورته ربّما قال قومه احتجب . فظهر بالصّورة المعهودة ميّتا ليعلم أنّه هو . فقد عمته النّجاة حسّا ومعنى . )
(وأما) الإيمان في وقت اليأس والشدة واليأس من الحياة المشار إليه بمقتضى (قوله) تعالى : (فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ)، أي الكافرين بحيث ينقذهم من العذاب لم رَأَوْا بَأْسَنا، أي شدتنا عليهم بنزول العذاب فيهم (سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي)، أي عادته تعالى (قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ ) [غافر : 85 ] .
المتقدمين كان إيمانهم لا ينفعهم عند معاينة أسباب الموت القريبة ، ولا ينقذهم من الهلاك وخسر هنالك المبطلون وقوله تعالى : " فَلَوْ لا كانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها إِيمانُها (إلّا قوم يونس) لَمَّ آمَنُوا كَشَفْنا عَنْهُمْ عَذابَ الْخِزْيِ فِي الْحَياةِ الدُّنْي وَمَتَّعْناهُمْ إِلى حِينٍ[ يونس : 98 ] (فلم يدل ذلك) ، أي انتفى نفع الإيمان في وقت نزول العذاب (على أنه) ، أي الإيمان في ذلك الوقت (ل ينفعهم في الآخرة) ، لأن معناه لا ينفعهم ، أي لا يرفع عنهم ذلك العذاب النازل بهم ، وإذا لم ينفعهم برفع العذاب عنهم لا يلزم منه أن لا ينفعهم في الآخرة ،
وكون المعنى بأنه لا ينفعهم برفع العذاب النازل بهم يستدل عليه (بقوله) تعالى( في الاستثناء) من عدم النفع في الإيمان (إلا قوم يونس فأراد) تعالى أن (ذلك) الإيمان في ذلك الوقت (لا يرفع عنهم) ، أي عن الكفار (الأخذ) ، أي الإهلاك والتدمير (في الدنيا) ولم يستثن تعالى من هذا الأمر العام إلا قوم يونس كم قال سبحانه لما آمنوا :كَشَفْنا عَنْهُمْ عَذابَ الْخِزْيِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَمَتَّعْناهُمْ إِلى حِينٍ[ يونس : 98 ] ، وملة بني إسرائيل التي مات عليها فرعون لما قال حين أدركه الغرق أنه :آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ[ يونس : 90 ] كانت هي وصية إبراهيم ويعقوب بالإيمان حين الموت ، قال تعالى :وَوَصَّى بِها إِبْراهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ( 132 ) [ البقرة : 132 ] .
والجملة حال والحال مقارنة للموت فإيمان اليأس مقبول في ملة بني إسرائيل فافهم ؛ (فلذلك) ، أي لأجل ما ذكر (أخذ فرعون) ، أي أهلكه اللّه تعالى بالغرق في البحر (مع وجود الإيمان منه) وصحة قبوله ونفعه في الآخرة ، كل إيمان يحصل في الحياة الدنيا مقبول من صاحبه ، وإن لم ينجه من العذاب الواقع يقال :
(هذا إن كان أمره) ، أي فرعون (أمر من تيقن بالانتقال) ، أي الموت والهلاك
(في تلك الساعة) بالغرق في البحر (وقرينة الحال) من فرعون (تعطي أنه ما كان على يقين من الانتقال) بالموت والهلاك إلى الآخرة (لأنه عاين) ، أي رأى وشاهد (المؤمنين) من قوم موسى عليه السلام (يمشون على الطريق اليبس) ، أي اليابس (الذي ظهر) في أرض البحر (بضرب موسى) عليه السلام (بعصاه البحر فلم يتيقن) حينئذ (فرعون بالهلاك إذا آمن بخلاف المحتضر) بصيغة اسم المفعول ،
أي الذي حضرته الوفاة وهو في النزع (حتى لا يلحق) ، أي فرعون (به) ، أي بالمحتضر ليأسه من الحياة ورجاء فرعون للحياة (فآمن) ، أي فرعون (بالذي آمنت به بنو إسرائيل) ،
كما حكاه تعالى عنه أن قال :"آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ"[ يونس : 90 ] (على التيقن بالنجاة) من الهلاك بالغرق (فكان) الأمر (كما تيقن) فحصلت له النجاة (لكن على غير الصورة التي أراد) وهي النجاة من الهلاك بالغرق .
(فنجاه اللّه) تعالى (من عذاب الآخرة في نفسه) التي هي داخل بدنه بحصول الإيمان له وقبوله منه ، فإنه لا مانع من القبول لأنه الأصل حتى يوجد دليل قاطع يمنعه (ونجّى) اللّه تعالى أيضا (بدنه كما قال تعالى :فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً) [ يونس : 92 ] ،
أي علامة (لأنه لو غاب بصورته ربما قال قومه) الباقون في مصر بلا غرق (احتجب) عن الناس بالصعود إلى السماء ونحوه (فظهر) ، أي فرعون (بالصورة المعهودة) له عندهم (ميتا) لا حياة فيه (ليعلم) بالبناء للمفعول أنه ، أي فرعون هو ، أي فرعون لا غيره فقد عمته النجاة ، أي السلامة حسا في بدنه ومعنى في نفسه بحصول الإيمان له
قال الشيخ رضي الله عنه : ( ومن حقّت عليه كلمة العذاب الأخراوي لا يؤمن ولو جاءته كلّ آية حتّى يرو العذاب الأليم ، أي يذوقوا العذاب الأخراوي .
فخرج فرعون من هذا الصّنف . هذا هو الظّاهر الّذي ورد به القرآن . ثمّ إنّا نقول بعد ذلك والأمر فيه إلى اللّه ، لما استقرّ في نفوس عامّة الخلق من شقائه ، وما لهم نصّ في ذلك يستندون إليه . وأمّا آله فلهم حكم آخر ليس هذا موضعه .
ثمّ ليعلم أنّه لا يقبض اللّه أحدا إلّا وهو مؤمن أي مصدّق بم جاءت به الأخبار الإلهيّة : وأعني من المختضرين ولهذا يكره موت الفجأة وقتل الغفلة . )
(ومن حقت) ، أي تحققت (عليه كلمة العذاب الأخروي) وهي كلمة الرب المقطوع بها في علم اللّه تعالى القديم وتقديره الأزلي .
قال تعالى :أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذابِ أَ فَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ( 19 ) [ الزمر : 19].
فذكر النار دليل على أنه العذاب الأخروي (لا يؤمن) في الدنيا أصلا (ولو جاءته) ظهرت له (كل آية ).
قال تعالى في حق فرعون :وَلَقَدْ أَرَيْناهُ آياتِن كُلَّها فَكَذَّبَ وَأَبى [ طه : 56].
يعني في حياته الدنيا قبل نزوله في البحر بدليل قوله بعده: " قالَ أَجِئْتَنا لِتُخْرِجَنا مِنْ أَرْضِن بِسِحْرِكَ يا مُوسى" [ طه : 57 ] ثم آمن بعد ذلك بعد نزوله في البحر وأدرك الغرق كما مر ذكره .
وقال تعالى :" إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ ( 96 ) وَلَوْ جاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِيمَ" [ يونس : 96 - 97 ] ،
أي ( حتى يذوقوا العذاب الأخروي فخرج فرعون من هذا الصنف) المذكورين لأنه آمن قبل أن تحق عليه كلمة ربك التي هي كلمة العذاب الأخروي وقبل أن يذوق العذاب الأليم الأخروي ، بل قبل أن يذوق الغرق الذي هو عذاب الدنيا ومن حقت عليه الكلمة لا يؤمن حتى يرى ، أي يذوق العذاب الأليم ، وهو العذاب الأخروي ، لأنه لا أكثر منه في الألم فيدل أنه يؤمن بعد الموت ، والإيمان بعد الموت غير مقبول إجماعا وفرعون لم يفعل كذلك إلا أنه آمن قبل الموت .
هذا الكلام المذكور هنا المقتضي بصحة إيمان فرعون وقبوله هو الظاهر الذي ورد به القرآن كما علمت بيانه ولم يرد في السنة النبوية ما يرده ولا في الإجماع أيضا ، لأنه قال بصحة إيمان فرعون جماعة من المجتهدين .
ذكرهم الشيخ عبد الوهاب الشعراني رحمه اللّه تعالى في أوائل كتابه اليواقيت والجواهر في عقائد الأكابر والمصنف قدس اللّه سره من جملتهم
""أضاف الجامع :
قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني في اليواقيت والجواهر الجزء الأول ص 33 :-
"ومن دعوى المنكر أن الشيخ يقول بقبول إيمان فرعون وذلك كذب وافتراء على الشيخ فقد صرح الشيخ في الباب الثاني والستين من «الفتوحات» بأن فرعون من أهل النار الذين لا يخرجون منها أبد الآبدين و «الفتوحات» من أواخر مؤلفاته فإنه فرغ منها قبل موته بنحو ثلاث سنين.
قال شيخ الإسلام الخالدي رحمه اللّه:
والشيخ محيي الدين بتقدير صدور ذلك عنه لم ينفرد به بل ذهب جمع كثير من السلف إلى قبول إيمانه لما حكى اللّه عنه أنه قال:" حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ" [يونس: 90] وكان ذلك آخر عهده بالدنيا،
وقال الشيخ أبو بكر الباقلاني:
قبول إيمانه هو الأقوى من حيث الاستدلال ولم يرد لنا نص صريح أنه مات على كفره انتهى.
ودليل جمهور السلف والخلف على كفره )أنه آمن عند اليأس( وإيمان أهل اليأس لا يقبل واللّه أعلم. أهـ ""
(ثم إنا نقول بعد ذلك) ، أي بعد تقرير ما ذكر )والأمر فيه( ، أي في حق فرعون موكول إلى اللّه تعالى لما ، أي لأجل الأمر )الذي استقر في نفوس عامة الخلق( ، أي العامة من الخلق دون الخاصة منهم أو الأكثرون الأقل )من شقائه( ، أي فرعون يعني هلاكه على الكفر وتخليده في النار ،
بناء على ذكر اللّه تعالى في حقه في القرآن من الأحوال التي كان عليها في حياته في الدنيا ، من الكفر ودعوى الربوبية والظلم والتعدي واتباع السحر وقتل النفوس بلا حق ، والتكذيب بالأنبياء عليهم السلام وإضلال قومه ، إلى غير ذلك من الأوصاف القبيحة ،
ولم يلتفتوا إلى ما ذكره اللّه تعالى أيضا عنه من إيمانه في آخر الأمر قبل أن يهلك بالغرق في البحر وقطعوا بأن ذلك إيمان غير مقبول منه ولم يبحثو عنه في ذلك الوقت كيف كان حاله مع اللّه تعالى والكل مجمعون على أن الأمور معتبرة بخواتيمها والسعيد من مات على السعادة والشقي من مات على الشقاوة ولو صدر منه في الدنيا من الأعمال كيفما صدر من كفر وغيره .
)وم لهم( ، أي العامة المذكورين )نص في ذلك (، أي في أن فرعون مات شقي )يستندون إليه( ، أي إلى ذلك في آية أو حديث غير بعض احتمالات في آياتنا قابلة للتأويل بسهولة كما قدمنا بعضه .
والحاصل أن المؤيدات من النصوص لإيمان فرعون كثيرة ، وقول المصنف قدس اللّه سره هنا : والأمر فيه إلى اللّه ، لا يدل على أنه غير قاطع في حقه بشيء ، وأنه متوقف في شأنه باعتبار ما بعده من قوله : لما استقر في نفوس عامة الخلق من شقائه ، يعني أنا نقول بتفويض أمر فرعون إلى اللّه تعالى لأجل الذي استقر في النفوس من شقائه لا باعتبار ما عندنا من ذلك ، فإن مسألة إيمان فرعون لا شبهة فيها عند أحد من أهل الكشف والبصيرة ،
لأن أصحاب القلوب المهذبة بالرياضة الشرعية أهل التحقيق والمعرفة الإلهية لا شك عندهم في أمر من الأمور أصلا ولا شبهة ، ولكن هم في تقرير العلم لأهل الظاهر مع ما تفيده الأدلة اللفظية والنصوص الكلامية ، ومع الكشف الصحيح والذوق المستقيم في تقدير ذلك لأنفسهم وأمثالهم إن كانوا ،
وليس ببعيد أن اللّه تعالى يجعل فرعون آية على سعة رحمته وكمال عنايته بمن يشاء من عباده لا سيما ، وفي الآية ما يشير إلى ذلك من قوله تعالى : " لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ عَنْ آياتِنا لَغافِلُونَ "[يونس : 92 ].
فتنبه يا أخي لهذه الآية ولا تكن من الناس الغافلين عنها فإن فرعون عاش في الدنيا من أوّل عمره فاسقا ، فاجرا ، كافرا ، ضالا ، وادعى الربوبية مع اللّه ونازع اللّه تعالى وأنبياءه ورسله ، ثم آمن وأسلم فتقبل منه ذلك ،
وغفر اللّه تعالى له جميع ما عمله من الشر ، وأماته طاهرا مطهرا ، فيبقى كل من وصل إلى غاية الشقاء بارتكاب الكثير من الذنوب والمعاصي ومتعارفه الفواحش ، بل من خاض في جميع عمره في أنواع الكفر والزندقة وبالغ في الضلال بحيث فعل جميع ما فعله فرعون وزاد عليه في ذلك إن أمكنه الزيادة ، ثم أسلم وآمن وتاب بقلبه ولسانه ،
وصدق في رجوعه عن كل ما كان فيه ، فإن اللّه تعالى يقبل منه إسلامه وإيمانه وتوبته ، ولو صدر منه ذلك في آخر أجزاء حياته قبيل موته ولو بوقت يسير ، حتى لا ييأس من رحمة اللّه تعالى أحد ، ولا يقنط من روح اللّه مخلوق .
وفي ضد ذلك قد جعل اللّه تعالى إبليس آية على غضبه وسخطه وكمال انتقامه وعظيم مكره واستدراجه ، فأحياه اللّه تعالى في الدنيا في ابتداء خلقه مسلما ، مؤمنا ، صالحا ، عابدا ، زاهدا ، عالما ، عاملا لم يبق بقعة في الأرض إلا وقد عبد اللّه تعالى فيه ، ثم صعد إلى السماء ، فكان يعبد اللّه تعالى مع الملائكة عليهم السلام ،
وكان أعبدهم وأعرفهم وأكملهم وأشرفهم ، بحيث كان يعلمهم ويرشدهم إلى كيفية الخضوع والخشوع ، ثم إن اللّه تعالى بعد ذلك أشقاه وأضله وغضب عليه ومكر به وانتقم منه ،
فكفر وعاند واستخف بحرمة اللّه تعالى ، وأبغض ربه وعاداه وأبغض إخوان الإيمان والصدق وعاداهم ،
وآذاهم وأضرهم حتى يكون عبرة وموعظة للمؤمنين الصالحين العابدين الزاهدين الكاملين في العلم والعمل ، فيخافون من اللّه تعالى أن يمكر بهم ويجعلهم مثل إبليس في الشقاء ، فلا يأمنون من مكر اللّه تعالى ولا من استدراجه لهم ، واللّه على كل شيء قدير ، واللّه يحكم لا معقب لحكمه.
وأم آله ، أي فرعون يعني قومه الذين كانوا يعبدونه من دون اللّه تعالى فلهم حكم آخر غير حكمه هو ، فإنهم ماتوا على الكفر باللّه تعالى وأنبيائه ورسله وعلى التكذيب بالحق ، ولم ينقل عن أحد منهم أنه أسلم وآمن قبل موته .
وقال تعالى في حقهم :" النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْه غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذابِ " [ غافر : 46 ] .
فإن في بيان عذابهم الآن في النار غدوّا وعشيا ، وكيفيته ، وذكر قبورهم المتنقلة في بطون الحيتان البحرية والحيوانات البرية ، وتنويع عذابهم فيها إلى يوم القيامة ، ثم دخلوا لهم في يوم القيامة إلى أشد العذاب .
وم المراد بذلك العذاب الأشد ؟
وم حكمة ذلك كله ، إلى غير ذلك من بيان أحوالهم البرزخية والأخروية ليس هذا موضع ذكره ، فإنه يحتاج إلى بسط كلام كثير .
ثم ليعلم ، أي السالك أنه ، أي الشأن لا يقبض اللّه تعالى أي يتوفى ويميت أحدا من الناس مؤمنا كان ذلك المقبوض أو كافرا إلا وهو ، أي ذلك المقبوض مؤمن بينه وبين اللّه تعالى في حال قبضه وموته أي مصدق بما جاءت به الأخبار الإلهية في الكتاب والسنة من الحق كما يشير إليه قوله تعالى : "وَلَوْ تَرى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَراتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةُ باسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُونِ بِما كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آياتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ " [ الأنعام : 3 ] ، وإذا عاينوا ذلك فكيف لا يؤمنون بقلوبهم ويصدقون .
)وأعني( بهذا التعميم في كل مقبوض إذا كان )من المحتضرين( ، أي الذين حضرتهم ملائكة الموت ، وماتوا بالنزع الكثير أو القليل ؛ )ولهذ( ، أي لكون الأمر كما ذكر )يكره موت الفجاءة( بالضم والمد وتفتح وتقصر أي البغتة ، وهي الموت بلا مرض ولا نزاع ولا ضرب ولا قتل ولا غيرها ، بل من خالص الصحة والعافية ، أو مشوبها ببعض مرض لا يحصل منه الموت عادة .
وكراهته إنما هي في حق المسرفين على أنفسهم والكافرين لتفويت التوبة والإسلام عليهم ، وهو خير في الصالحين ، كما ورد أن إبراهيم الخليل عليه السلام مات بلا مرض كما بينه جمع ، وتوفي داود عليه السلام فجأة ، وكذلك الصالحون وهو تخفيف عن المؤمن .
و يكره (قتل الغفلة) أيضا في حق غير الصالحين أيضا كالفجأة .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( فأمّا موت الفجأة فحدّه أن يخرج النّفس الداخل ولا يدخل النّفس الخارج . فهذا موت الفجأة . وهذ غير المحتضر .
وكذلك قتل الغفلة بضرب عنقه من ورائه وهو لا يشعر : فيقبض على م كان عليه من إيمان وكفر . ولذلك قال عليه السّلام : " ويحشر على ما عليه مات " .
كما أنّه يقبض على ما كان عليه :
والمحتضر ما يكون إلّا صاحب شهود ، فهو صاحب إيمان بما ثمّ فل يقبض إلّا على ما كان عليه ، لأنّ « كان » حرف وجوديّ لا ينجرّ معه الزّمان إلّ بقرائن الأحوال : فيفرق بين الكافر المحتضر في الموت وبين الكافر المقتول غفلة أو الميّت فجأة كما قلنا في حدّ الفجأة . )
(فأما موت الفجأة فحده) ، أي بيانه (أن يخرج) من الإنسان (النفس الداخل) في جسده (ولا يدخل) ذلك (النفس الخارج) ، أي عوده في جسده (فهذا موت الفجأة).
والمراد في حال الصحة والعافية ، أو قليل المرض وعدم السبب كما ذكرنا ، وإلا فكل موت كذلك (وهذا) ، أي صاحب موت الفجأة (غير المحتضر) ، أي الميت بالمرض والنزع (وكذلك قتل الغفلة بضرب عنقه من ورائه وهو لا يشعر) ونحو ذلك ، فإنه غير المحتضر أيضا (فيقبض) ، أي الميت فجأة والمقتول غفلة (على ما كان عليه) في حال الموت والقتل من إيمان (أو كفر ولذلك ) ، أي لكون الأمر كما ذكر
(قال عليه) الصلاة و(السلام) في الحديث (ويحشر) ، أي العبد (على ما عليه مات .)،
أي الحالة التي مات عليها من طاعة أو معصية أو إيمان أو كفر .
وفي رواية مسلم يبعث كل عبد على م عليه مات كما أنه ، أي العبد يقبض على ما كان عليه من الأحوال في الحياة الدني .
(والمحتضر) ، أي الميت بالمرض والنزع (م يكون إلا صاحب شهود) ومعاينة للحق المبين عند موته مؤمن أو كافرا (فهو صاحب إيمان بما ثم) بالفتح أي هناك مما شاهد وعاين من الحق (فل يقبض) ، أي يموت (إلا على ما كان عليه) من الإيمان والكفر (لأن كان حرف وجودي) ، أي معناه وجود خبره لاسمه ، أي ثبوته له ، فإذا قلت : كان زيد قائما ، فمعناه وجود القيام لزيد وثبوته له ، وإطلاق الحرف عليه باعتبار تجرده عن الحدث ، فقد خالف الأفعال في دلالتها على الحدث والزمان ، وخالف الأسماء لعدم دلالته على معنى في نفسه ، فكان حرفا لا يقيد إلا بذكر الخبر كالحرف لا يفيد إل بضم ضميمة إليه . وهذا في حال استعماله ناقصا والتام فعل بمعنى وجد (لا ينجر) ، أي لا ينسحب (معه الزمان) الماضي المفهوم منه في حال استعماله إلى زمان الحال
(إلا بقرائن الأحوال) في تراكيب الكلام كما في هذا الحديث ، فإن قوله : يقبض على ما كان عليه أي كان من قبل في الماضي واستمر إلى حال القبض (فقبض عليه فيفرق) بما ذكر (بين الكافر المحتضر) في الموت بأن مرض ونازع ومات (وبين الكافر المقتول غفلة أو الميت فجأة) كما قلنا في حد الفجأة ، أي تعريفها وتبيينها ، فالكافر المحتضر يموت مؤمنا ، وغير المحتضر يموت كافرا لعدم إيمانه في وقت الموت ،
وإذا مات الكافر المحتضر مؤمنا ل يلزم من ذلك أن يظهر حكم إيمانه في الدنيا ، وإنما إذا لم يعرف منه الإسلام والإيمان عند موته بالصريح ثم مات وهو محتضر بمرض ونزع عومل في الدنيا معاملة الكافر وكان مؤمنا في الآخرة ، وإذا علم إيمانه كان مؤمنا من غير شبهة .
وكون إيمان اليأس غير نافع يعني في رفع العذاب والنجاة من الهلاك في الدنيا لا في حق نجاة الآخرة كما تقدم بيانه .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( وأمّا حكمة التّجلّي والكلام في صورة النّار ، فلأنّها كانت بغية موسى عليه السّلام ، فتجلّى له في مطلوبه ليقبل عليه ولا يعرض عنه . فإنّه لو تجلّى له في غير صورة مطلوبه أعرض عنه لاجتماع همّه على مطلوب خاصّ .
ولو أعرض لعاد عليه فأعرض عنه الحقّ ، وهو مصطفى مقرّب . فمن قربه أنّه تجلّى له في مطلوبه وهو لا يعلم .كنار موسى رآها عين حاجته * وهو الإله ولكن ليس يدريه)
(وأم حكمة التجلي) الإلهي ، أي انكشافه تعالى وظهوره لموسى عليه السلام (و) حكمة (الكلام) الإلهي أيضا لموسى عليه السلام (في صورة النار) التي رآها بطور سيناء وكان ليلا فقال لأهله :امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ ناراً لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْه بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدىً فَلَمَّا أَتاها نُودِيَ يا مُوسى ( 11 ) إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً( 12 ) [ طه : 10 - 12 ] ،
(فلأنها) ، أي النار (كانت بغية) ، أي حاجة (موسى عليه السلام) تلك الليلة مع أهله لأجل برد أو طبخ أراده (فتجلى له) الحق تعالى في صورة (مطلوبه) وظهر له في هيئة مرغوبه ومحبوبه (ليقبل) ، أي موسى (عليه) السلام عليه ، أي على الحق تعالى إقبالا بكليته (ولا يعرض عنه) ، أي عن الحق تعالى (فإنه) ، أي الحق تعالى (لو تجلى له) ، أي لموسى عليه السلام (في غير صورة مطلوبه) في ذلك الوقت أعرض ، أي موسى عليه السلام عنه ، أي عن الحق تعالى (لاجتماع همه) ، أي هم موسى عليه السلام يعني همته وعزمه (على مطلوب) له خاص غير ذلك المتجلي له لتجليه في غير المطلوب (ولو أعرض) ، أي موسى عليه السلام عن الحق تعالى (لعاد عمله) أي إعراضه ذلك عليه أي على موسى عليه السلام (فأعرض عنه) ، أي عن موسى عليه السلام (الحق) تعالى أيضا ، لأنه تعالى الملك الديان كما يدين يدان ، وهذا من حيث الظاهر .
وفي الباطن أن الفعل واحد ، ينسب إلى العبد باعتبار وإلى الرب باعتبار ، كما قال تعالى :ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا[ التوبة : 118 ].
( وهو) ، أي موسى عليه السلام (مصطفى) ، أي اصطفاه اللّه تعالى واختاره على جميع أهل زمانه (مقرب) بصيغة اسم المفعول فيهما ، أي قربه اللّه تعالى وأدناه من جنابه وأكرمه بمناجاته وخطابه (فمن) جملة (قربه) ، أي موسى عليه السلام من حضرة ربه تعالى (أنه) تعالى (تجلى) ، أي انكشف وظهر (له) ،
أي موسى عليه السلام (في) صورة (مطلوبه) الخاص في ذلك الوقت يعني النار وهو ، أي موسى عليه السلام لا يعلم بذلك ولهذا سماه نارا فقال لأهله :" امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ ناراً" .
"" أضاف الجامع :
"أن من التحقيق أن تعطي المغالطة في موضعها حقها"
عنه قال الشيخ رضي الله عنه في الفتوحات الباب السادس والعشرون ومائة :-
فاعلم أيدك الله أن من التحقيق أن تعطي المغالطة في موضعها حقها فإن لها في كتاب الله موضعا وهو قوله في أعمال الكفار" كَسَرابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ ماءً "
والحق هو الذي أعطاه في عين هذ الرائي صورة الماء وهو ليس بالماء الذي يطلبه هذا الظمآن فتجلى له في عين حاجته " حَتَّى إِذا جاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً ".
فنكر وما قال لم يجده الماء فإن السراب لم يكن ذلك المحل الذي جاء إليه محل السراب ولو كان لقال وجد السراب وم كان سرابا إلا في عين الرائي طالب الماء فرجع هذا الرائي لنفسه
لما لم يجد مطلوبه في تلك البقعة ، فوجد الله عنده فلجأ إليه في إغاثته بالماء أو بالمزيل
لذلك الظماء القائم به ، فبأي أمر أزاله ،
فهو المعبر عنه بالماء فلما نفى عنه اسم الشيء جعل الوجود له سبحانه "لأنه لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ" فما هو شيء بل هو وجود
فانظر ما أدق هذا التحقيقفهذ كنار موسى فتجلى له في عين حاجته فلم تكن نارا كما قلنا
كنار موسى يراها عين حاجته ..... وهو الإله ولكن ليس يدريه .أهـ ""
وإلى ذلك أشار المصنف قدس اللّه سره إلى ذلك بقوله : [ شعرا ]
كنار موسى يراها عين حاجته ..... وهو الإله ولكن ليس يدريه
(كنار موسى) عليه السلام يعني أن الحق تعالى يتجلى للسالك في طريقه بالصورة التي ينصرف إليها عزمه وهمته في كل حين (رآها) ، أي رأي النار موسى عليه السلام (عين حاجته) ، أي بغيته ومطلوبه في ذلك الحين (وهو) ، أي المتجلي له في صورة النار (الإله) سبحانه من غير حلول ولا اتحاد في الصورة بها ،
لأن كل ما سوى الوجود الإلهي الحق عدم باطل ، فلا يمكن أن يحل أحدهما في الآخر أصلا كما مر بيانه غير مرة (ولكن) كان موسى عليه السلام (ليس يدريه) ، أي لا يعلمه ، يعني لا يعلم أن الحق تعالى تجلى له في صورة تلك النار التي رآه .
تم الفص الموسوي
.
....
UNzn-7pTah0
 |
 |
البحث في نص الكتاب
يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!