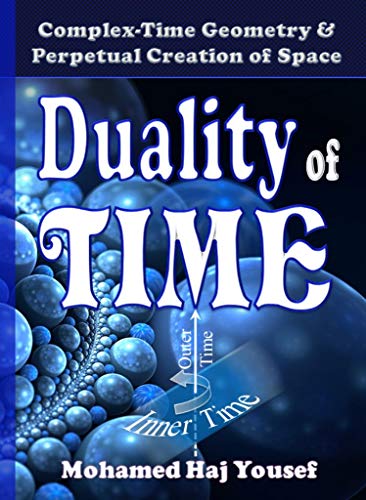كتاب خصوص النعم
في شرح فصوص الحكم
تأليف: الشيخ علاء الدين أحمد المهائمي
فص حكمة فردية في كلمة محمدية
 |
 |
فص حكمة فردية في كلمة محمدية
27 - فص حكمة فردية في كلمة محمدية .كتاب خصوص النعم فى شرح فصوص الحكم علاء الدين أحمد المهائمي
كتاب خصوص النعم في شرح فصوص الحكم الشيخ علاء الدين أحمد المهائمي
الفصّ المحمدي
قال الشيخ رضي الله عنه : ( إنّما كانت حكمته فرديّة لأنّه أكمل موجود في هذا النّوع الإنسانيّ ، ولهذا بدأ به الأمر وختم ، فكان نبيّا وآدم بين الماء والطّين ، ثمّ كان بنشأته العنصريّة خاتم النبيّين ، وأوّل الأفراد الثّلاثة ، وما زاد على هذه الأوّليّة من الأفراد فإنّها عنها ، فكان صلّى اللّه عليه وسلّم أدلّ دليل على ربّه ، فإنّه أوتي جوامع الكلم الّتي هي مسمّيات أسماء آدم فأشبه الدّليل في تثليثه ، والدّليل دليل لنفسه ) .
أي : ما يتزين به ، ويكمل العلم اليقيني المتعلق بجميع الكمالات التي أولها الفردية الأولى ، ظهر ذلك العلم بزينته وكماله في الحقيقة الجامعة المنسوبة إلى سيد الكائنات محمد المصطفى صلّى اللّه عليه وسلّم وعلى آله وسلم ؛ لكونه أجمع لكمالات الأولين والآخرين من الرسل والأنبياء والملائكة والأولياء ؛ فلذلك وقع في بعض النسخ حكمة كلية ؛
""أضاف المحقق :
(إنم اختصت الكلمة المحمدية بالحكمة الفردية ؛ لأنه صلّى اللّه عليه وسلّم أول التعينات الذي تعين به الذات الأحدية قبل كل تعين فظهر به من التعينات الغير المتناهية ، وقد سبق أن التعينات مرتبة ترتيب الأجناس والأنواع والأصناف والأشخاص مندرج بعضه تحت بعض ؛ فهو يشمل جميع التعينات . ) القاشاني ""
وإليه الإشارة بقوله : ( إنما كانت حكمته ) ، أي : العلم المختص به ( فردية ) ؛ لأنها جمعية ، وأولها الفردية الأولى ، وإنما كانت حكمته جمعية ؛ ( لأنه أكمل موجود في هذا النوع الإنساني ) الذي هو أكمل أنواع الموجودات ، فهو في أقصى مراتب جمع الكمالات ؛
( ولهذا ) أي : ولكونه في أقصى مراتب جمع الكمالات ، وهي مطلوبة بالذات ، ( بدئ به الأمر ) ، أي : أمر الكمالات الإنسانية من النبوة والولاية النبوية والرسالة ( وختم ) به ؛ لأنه لما كان مطلوبا بالذات كان صلة غائية ، ومن شأنها التقدم في الذهن ، والتأخر في الخارج ،
(فكان ) باعتبار روحه الجامع للكمالات ( نبيّا ) ، واكتفي بذكره عن ذكر اللازم وهو الولاية ، ولم يذكر الرسالة ؛ لأنها باعتبار انتسابها إلى المبعوث إليهم تتوقف عليهم ، ( وآدم بين الماء والطين ) ، أي : لا ماء ولا طينا ، فإن المتوسط من الأمرين لا يكون عين أحدهما ؛ وذلك لأن نبوته ذاتية ككمالاته بخلاف كمالات غيره ، فتوقفت نبوته على شرائط .
( ثم ) أي : بعد كونه نبيّا ، وآدم بين الماء والطين ، ( كانت نشأته العنصرية ) التي بها آخريته ( خاتم النبيين ) قبل الوحي وبعد ، لكن إنما اشتهرت نبوته عند الوحي ؛ ولذلك لم تعتبر العامة ما قبل ذلك ، فحصلت الجمعية بين أولية النبوة وآخريتها ، وهي مرتبة ثالثة ، ( وأول الأفراد ) أي : الأعداد المفردة ، وهي التي لا تنقسم بالمتساويين ( الثلاثة ) ، فكانت حكمته فردية ، وجمعيته وإن زادت على هذه الفردية الثلاثية ، فهي الأصل ؛
لأن ( ما زاد على هذه الفردية الأولية من الأفراد ) أي : الآحاد فإنه ناشز عنها ، فإنه لولا الجمعية لم ينضم فرد إلى آخر ، وقد ناسب بهذه الفردية فردية الحق في جمعه بين الذات والصفات والأسماء ، وقد زاد عنها الأفعال ، ( فكان أدل دليل على ربه ) لظهوره بجميع ذلك فيه ، والدليل عليه جمعية كلمته ؛ لأنها عن كمال العلم ، وهو بمشاهدة المعلومات بمرآة الحق الموجبة لكمال تجليه ، ( فإنه « أوتي جوامع الكلم")، رواه ابن حبان
كم ورد به الخبر ، وهي جامعة الأسماء آدم التي فضل بها الملائكة ؛ لدلالتها على الحقائق ( التي هي مسميات أسماء آدم ) ، لكنه عليه السّلام علمها بالألفاظ المتفرقة ، ونبينا عليه السّلام علمها بالألفاظ الجامعة لكمال جمعيته ، ولما كان أدل دليل على ربه باعتبار هذه الفردية ، ( فأشبه الدليل ) النظري ( في تثليثه ) من تركبه من أصغر وأوسط وأكبر ، أو من ملزوم ولازم واستثناء ، أو من متعاندين واستثناء ، أو من أصل وفرع وجامع ، أو من كلي وأكثر جريانه وحكمه ( والدليل دليل لنفسه ) ؛ لأنه عبارة عن المركب من أقوال متى سلمت لزم عنه لذاتها قول آخر ، فكانت نبوته التي عن هذه الدلالة أيضا لنفسه ، وكذا الولاية إل أنها لما كانت لخاتم الأولياء في الظاهر نسبت إليه ، وجعلت كأنها ذاتية له مع أنه دون رسالة الرسل التي هي دون ثبوتهم التي هي دون ولايتهم .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( ولمّا كانت حقيقته تعطي الفرديّة الأولى بما هو مثلّث النشأة لذلك قال في باب المحبة التي هي أصل الوجود : " حبّب إليّ من دنياكم ثلاث" ) . رواه أحمد، والنسائى، وابن سعد، وأبو يعلى، والحاكم، والبيهقى، وسمويه، والضياء عن أنس وأورده السيوطي في الجامع الصغير وضعففه العقيلي وذكره ابن حجر في « لسان الميزان » والعجلوني في كشف الخفاء .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( بما فيه من التّثليث ، ثمّ ذكر النّساء والطّيب وجعلت قرّة عينه في الصّلاة ، فابتدأ بذكر النّساء وأخّر الصّلاة ، وذلك لأنّ المرأة جزء من الرّجل في أصل ظهور عينها ، ومعرفة الإنسان بنفسه مقدّمة على معرفته بربّه ، فإنّ معرفته بربّه نتيجة عن معرفته بنفسه لذلك قال صلّى اللّه عليه وسلّم : « من عرف نفسه فقد عرف ربّه » .
فإن شئت قلت بمنع المعرفة في الخبر والعجز عن الوصول فإنّه سائغ فيه ، وإن شئت قلت بثبوت المعرفة ؛ فالأوّل أن تعرف أن نفسك لا تعرفها فلا تعرف ربّك ؛ والثّاني أن تعرفها فتعرف ربّك ، فكان محمّد صلّى اللّه عليه وسلّم أوضح دليل على ربّه ، فإنّ كلّ جزء من العالم دليل على أصله الّذي هو ربّه ؛ فافهم ).
ثم استدل على هذه الفردية بأن وجوده كان عليها ، فقال : ( ولما كانت حقيقته )
المقتضية لهذه الكمالات التي هي النبوة والولاية النبوية والرسالة ( تعطي الفردية الأولى ) ، وهي الذات الإلهية وصفاتها وأسماؤها كمالا لظهورها ( بما هو مثلث النشأة ) من الذات والصفات ، ولمعان أوجدها الحق ليحبها وتحبه ؛ (لذلك قال في باب المحبة التي هي أصل الوجود ) ، أي : سبب وجود الموجودات في قوله عزّ وجل : « كنت كنزا مخفيّا ، فأحببت أن أعرف » .
فل يحب شيئا إلا ليتوسل به إلى حب أحد الثلاثة وإن كان غيره بحب ذلك الشيء لمعنى أدنى منه ( « حبب إليّ من دنياكم ثلاث ») ، فذكروا له الثلاث ( بما فيه من التثليث ) الموجب محبة تثليث الحق ، ومحبة كل تثليث يتوسل بها إلى محبة تثليث الحق ، ( ثم ذكر ) تفصيل الثلاث التي يتوسل بها إلى محبة تثليث الحق ، ( النساء ) لحب الذات ، ( والطيب ) لحب الصفات ، ( « وجعلت قرة عينه في الصلاة ») ؛ لحب الأسماء .
( فابتدأ بذكر النساء ) ؛ لتقدم اعتبار الذات ، ( وأخر الصلاة ) لتأخير اعتبار الأسماء ، إذ هي مجموع الذات والصفات ،
( وذلك ) أي : كون حب النساء حب الذات ؛ ( لأن المرأة جزء من الرجل ) لا في ظهور جميع أفرادها ، بل ( في أصل ظهور عينها ) ؛ لأن حواء خلقت من ضلع آدم عليه السّلام ، فحبها حب الشيء لجزئه الذي هو على صورته ، فهو مظهر حب الحق لما هي على صورته ، ومرجعها حب الشيء لنفسه الموجب لمعرفتها الموجبة لمعرفة ربه ، إذ (معرفة الإنسان بنفسه ) الحاصلة من حبها ، ( مقدمة على معرفته بربه ) الموجبة لحبه ، ( فإن معرفته بربه نتيجة عن معرفته بنفسه ) ، والنتيجة مؤخرة عن المنتج ، فمعرفة النفس دليل على معرفة الرب المستلزمة لحبه ، والدال على الملزوم دال على اللازم ، فهي دلالة على حبه ؛
( ولذلك ) أي : ولإنتاج معرفة النفس معرفة الرب ، ( قال عليه السّلام :" من عرف نفسه ، فقد عرف ربه") .
ولم كانت هذه مقدمة واحدة لا تكفي في النتيجة ، ( فإن شئت قلت بمنع المعرفة ) ، أي : معرفة الرب والنفس ( في هذا الخبر ) ، وإن كان العوام يجزمون بالثبوت فيه ، وعلى هذا هو دليل ( العجز عن الوصول ) إلى معرفتهما ، فلا يعرف من الذات الإلهية سوى التنزيهات ، وهي أمور عدمية الإضافات أو بعض الصفات بوجه مناسبتها ، ولا يعرف من النفس الإنسانية سوى التجرد من المادة ، وهو من الأمور العدمية أو التدبير للبدن.
وهو بعض صفاته ( وإن شئت قلت بثبوت المعرفة ) ، أي : معرفتهما ، ولما كان المراد من الملازمة تعليق معرفة الرب بمعرفة النفس بحيث إذا عرف النفس عرف الرب ، وإذا لم يعرف النفس لم يعرف الرب ، لا الاستدلال بوجود الملزوم على وجود اللازم ، وبعدم اللازم على عدم الملزوم ، فإن ذلك يختص بأهل النظر ،
( فالأول ) وهو : منع معرفتهما ( أن تعرف أن نفسك لا تعرفها ، فلا تعرف ربك ) وإن كان لا دلالة لعدم الملزوم على عدم اللازم ، ( والثاني : أن تعرفها فتعرف ربك ) ، وإن لم يلزم من وجود السبب وجود المسبب ، إلا أن التعليق يفيد ذلك في عرف أهل العربية ، فالرب لا يعرف باعتبار استقراره في مقر عزه ، ويعرف باعتبار ظهوره في النفس ، والنفس لا تعرف بحسب حقيقتها ، وإنما يعرف بعض صفاتها ، وهذه المعرفة بالحق عن ظهوره في المظاهر تتفاوت بحسب تفاوت المظاهر كمالا ونقصا ، ونفس الإنسانية أكمل من سائر ما في العالم ، ونفوس الأنبياء عليهم السلام أكمل من نفوس العامة ، ونفس نبينا عليه السّلام أكمل من نفوس الأنبياء عليهم السّلام .
( فكان صلّى اللّه عليه وسلّم أوضح دليل على ربه ) يدل على رب الأرباب ، ونفوس سائر الأنبياء على أربابهم الكلية التي هي كالجزئيات لرب الأرباب ، وأجزاء العالم تدل على أرباب الجزئية لأربابهم ، (فإن كل جزء من العالم دليل على أصله الذي هو ربه ) من الأسماء الإلهية الجزئية التي تستند وجود تلك الأجزاء إليها ، وقد نمت تلك الدلالة عن حبه النساء من حيث إنهن أجزاؤه ، وكذا نفوس الأنبياء وسائر ما في العالم ، فاجتمعت فيه دلالات الكل ، فدل بالأصالة على رب الأرباب ، وبحبه للنساء وأجزاء العالم على الأرباب الجزئية ؛ ( فافهم ) .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( وإنّما حبّب إليه النّساء فحنّ إليهنّ لأنّه من باب حنين الكلّ إلى جزئه ، فأبان بذلك عن الأمر في نفسه من جانب الحقّ في قوله في هذه النّشأة الإنسانيّة العنصريّةوَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي[ الحجر : 29 ] ، ثمّ وصف نفسه بشدّة الشّوق إلى لقائه فقال للمشتاقين : « يا داود إنّي أشدّ شوقا إليهم » .
يعني : للمشتاقين إليه وهو لقاء خاصّ ، فإنّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال في حديث الدّجّال" إنّ أحدكم لن يرى ربّه حتّى يموت" . رواه الترمذي
؛ فلا بدّ من الشّوق لمن هذه صفته ، فشوق الحقّ لهؤلاء المقرّبين مع كونه يراهم فيحبّ أن يروه ويأبى المقام ذلك ، فأشبه قوله : "حَتَّى نَعْلَمَ" [محمد : 31 ] مع كونه عالما فهو سبحانه وتعالى يشتاق لهذه الصّفة الخاصّة الّتي لا وجود لها إلّا عند الموت ، فيبلّ بها شوقهم إليه كما قال تعالى في حديث التّردّد وهو من هذا الباب : « ما تردّدت في شيء أنا فاعله كتردّدي في قبض عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بدّ له من لقائي » . رواه البخاري
فبشّره بلقائه ، وما قال له ولا بدّ له من الموت لئلا يغمّه بذكر الموت ، ولمّا كان لا يلقى الحقّ إلّا بعد الموت كما قال عليه السّلام : « إنّ أحدكم لا يرى ربّه حتّى يموت » لذلك قال تعالى : « ولا بدّ له من لقائي » ؛ فاشتياق الحقّ لوجود هذه النّسبة .
يحنّ الحبيب إلى رؤيتي ..... وإني إليه أشدّ حنينا
وتهفو النّفوس ويأبى القض .... فأشكو الأنين ويشكو الأنين
افلمّا أبان أنّه نفخ فيه من روحه ، فما اشتاق إلّا لنفسه ) .
ثم استشعر سؤالا بأن أجزاء العالم لم تشارك النساء في جزئيته عليه السّلام ، فلما خصت النساء بالتحبب دون سائر أجزاء العالم ، فقال : ("وأنا حببت إليّ النساء " ) ؛ لأن الجزئية فيهن أظهر لمجانستهن إياه ، والمجانسة سبب الحب ، وانضمت إليه الجزئية ( فحن إليهن ) دون أجزاء العالم ( حنين الكل إلى جزئه ) المناسب له ، فشبه بذلك في حب ربه لمن خلقه على صورته المعنوية من الحياة والعلم ، والإرادة والقدرة ، والسمع والبصر والكلام فأبان أي :
صار صلّى اللّه عليه وسلّم ( بذلك ) ، أي : بهذا الحب ثبات (على الأمر ) ، أي : أمر الحب ( في نفسه ) الذي كان ( من جانب الحق ) لعباده الكمّل ، وهو المذكور ( في قوله ) الوارد في حق ( هذه النشأة الإنسانية العنصرية ) الشاملة على مرايا هذه الصفات ،( وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي) [ الحجر : 29]
، فأشار إلى حبه إياها بنفخ الروح المشرف بإضافته إليه ؛ لمناسبته إياه في التجرد وسائر الصفات الوجودية ، وإن كانت في غاية البعد عنه من حيث العنصرية .
( ثم ) أي : بعد الإشارة إلى حبه لها بهذا النفخ ، ( وصف نفسه بشدة الشوق إلى لقائه ، فقال ) فيما أول على داود عليه السّلام ؛ لبيان شوقه ( للمشتاقين ) من جملة الأبرار : « ( يا داود ) طال شوق الأبرار إلى لقائي ، ( "وإني أشد شوقا إليهم " ) ، ولكن لا يغني كل مشتاق إلى رؤيته ، فإنها من حظوظ النفس ، وإنم ( يعني للمشتاقين إليه ) ، أي : إلى ذاته بالغناء فيه والبقاء به ، فإن الحق وإن اشتاق إلى لقيا كل مشتاق ، لكن لا يوصف بشدة الشوق إلا بالنسبة إلى من اشتد شوقه إليه وهو المشتاق لذاته ، واللقاء وإن كان أعم من لقاء الرؤية ، ولقاء الفناء والبقاء ، فلقاء الفناء والبقاء ( هو لقاء خاص لهم ) ، وهو إنما يحصل بالموت حال الحياة كما أن لقاء الرؤية إنما يحصل بالموت الطبيعي .
( فإنه صلّى اللّه عليه وسلّم قال في حديث الدجال ) ؛ لبيان بطلان إلهيته بكونه يراه الأحياء بلا فناء عن ذواتهم وبقائهم به : ( " إن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت " ) ، إما الموت الطبيعي أو موت الفناء عن نفسه ، وهذا وإن فني عن نفسه ، ( فلا بدّ له من الشوق لمن هذا صفته ) ، وإذا كان لقاؤهم ببقائهم ،
( فشوق الحق لهؤلاء المقربين ) بالفناء والبقاء ( مع كونه يراهم ) مظاهر كاملة له أن يرى ذاته برؤيتهم له ، ( فيحب أن يروه ) ، وإن كان يرى ذاته بذاته ؛ ليحصل له في ذاته رؤية ، ولكن (يأبى المقام ) الإلهي ( ذلك ) أن يحدث فيه رؤية ، لكنه بالرؤية القديمة تحدث له نسبة عن رؤيتهم ، ( فأشبه قوله :حَتَّى نَعْلَمَ) بعلمهم الأشياء (مع كونه عالما ) بها بنفسه ، فالحق وإن رأى أكثر صفاته ظهرت فيهم على الكمال لم ير فيهم ظهور صفة بصره بحيث يبصرونه ؛ ليرى ذاته برؤيتهم بعد رؤيته بذاته .
( فهو ) أي : الحق ( يشتاق ) إلى لقائهم ( لهذه الصفة الخاصة ) ، وإن كان ظهورها يستلزم بطلان ظهور أكثر الصفات ؛ لأنها ( التي لا وجود لها ) لا عنه لموت المبطل لمظهرية أكثر الصفات إلا أنه يشتاق إليها ؛ لأن لها خصوصية ببعض المظاهر الكاملة في الغاية ، وإذا كانت هذه الصفة التي اشتاقوا إليها لا تحصل ( إلا بالموت ) شوقهم إلى الموت مع كراهتهم إياه ، لكنهم يتحملون تلك الكراهة لخصوصية هذه الصفة ( فيبل بها ) ، أي : بهذه الصفة ( شوقهم ) ؛ ليسهل عليهم بحمل الموت ، لأنهم إذا علمو أن للحق شوقا إلى هذه الصفة ازداد شوقهم ( إليه ، كما قال تعالى في حديث التردد ) ما يشير إلى [ . . . ] .
شوق المؤمنين بهذه الصفة ؛ ليهون عليهم محمل الموت من أجلها ، ( وهو ) أي : حديث التردد ( من هذا الباب ) ، أي : شوق الحق إلى لقاء المؤمن لهذه الصفة الخاصة ( ما ترددت ) ، أي : أخرت ( في فعل ) خير من خير وشر ( أنا فاعله كترددي في قبض ) نفس ( عبدي المؤمن ) حتى يرضى بقبضها بالتشويق إلى لقائي ؛ لأنه ( يكره الموت ) بسنية الموت بدون هذا الشوق ، ( وأنا أكره مساءته ) ، فأنا أكره له الموت ، ولكن ( لا بد له من لقائي ) لاشتياقه إليّ ، وأنه أشد شوقا إلى لقائه ، ولكن اللقاء لا يحصل إلا بالموت ، فلابدّ من الموت ، لكنه لم يصرح به ، واقتصر على ذكر اللقاء ، ( فبشره ) بمحض بشارة في اللفظ ، ( وما قال : لا بدّ له من الموت ) ، وإن تضمنته بشارة اللقاء ( لئلا يغمه بذكر الموت ) وهو إساءة وقد كرهها ، ولكنه صار في حكم المذكور ؛ لأنه ( لم كان لا يلقى الحق إلا بعد الموت ) بحسم القضاء الإلهي ، وإن أمكن عقلا لقاؤه بدونه ( كما قال عليه السّلام : « إن أحدكم لا يرى ربه حتى يموت » ) ، فكأنه ذكره مع الإشارة إلى أنه لم يذكره لما فيه من الإساءة .
( لذلك قال تعالى ) في مقام ذكر الموت : ( « ولا بدّ له من لقائي ») ، وإذا كان تردد الحق في الموت الطبيعي لهذه النسبة ، ( فاشتياق الحق ) فيما نحن فيه (لوجود هذه النسبة ) ، أي : هذه الصفة التي هي نسبة حادثة ، وإلا فل حدوث في صفته تعالى ، ولو كانت هذه النسبة للحق باعتبار ذاته كان الاشتياق إليه أشد من اشتياق العبد إلى لقاء ربه ؛ لأن نفس الشيء أحب إليه من كل ما عداه ، فكأنه تعالى يقول بلسان الحال : ( يحن ) ، أي : اشتياق
( الحبيب إلى رؤيتي ، وأنا إليه أشد حنينا ) ، ولكن لا يحصل المشتاق إليه إلا بالموت وهو مما ( تهفو ) ، أي : تضطرب له ( النفوس ) ، ولكن ( يأبى القضاء ) الإلهي حصول المشتاق إليه بدونه ، ( فأشكو الأنين ) من كراهة إساءته ، ( ويشكو الأنينا ) من الموت ، وإذ كان شدة اشتياق الحق إلى لقائهم لما فيه من رؤيته ذاته برؤيتهم بعد رؤيتها بنفسه لشدة زيادة ، والزيادة تنبغي أن تكون من جنس المزيد عليه ، فأصل شوقه أيضا إلى رؤية ذاته بصور المظاهر .
( فلما أبان أنه نفخ فيه من روحه ) المضاف إليه لاتصافه بصفاته من التجرد والحياة والعلم ، والإرادة والقدرة ، والسمع والبصر والكلام والتعلق ، وقد جعلنا فيه بالقوة ، ولا يخرج إلى الفعل إلا بهذا المظهر الجسماني ، ( فما اشتاق ) في أصل الاشتياق ( إلا إلى نفسه ) ؛ ليراها في المظهر الكامل الإنساني .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( ألا تراه خلقه على صورته لأنّه من روحه ؟ ولمّا كانت نشأته من هذه الأركان الأربعة المسمّاة في جسده أخلاطا ، حدث عن نفخه اشتعال بما في جسده من الرّطوبة ، فكان روح الإنسان نارا لأجل نشأته ، ولهذا ما كلّم اللّه موسى إلّا في صورة النّار وجعل حاجته فيها ، فلو كانت نشأته طبيعيّة لكان روحه نورا ، وكنّى عنه بالنّفخ يشير إلى أنّه من نفس الرّحمن ، فإنّه بهذا النّفس الّذي هو النّفخة ظهر عينه ، وباستعداد المنفوخ فيه كان الاشتعال نارا لا نورا ، فبطن نفس الحقّ فيم كان به الإنسان إنسانا ، ثمّ اشتقّ له شخصا على صورته سمّاه امرأة ، فظهرت بصورته فحنّ إليها حنين الشّيء إلى نفسه وحنّت إليه حنين الشّيء إلى وطنه ، فحبّب إليه النّساء ، فإنّ اللّه أحبّ من خلقه على صورته وأسجد له ملائكته النّوريّين على عظم قدرهم ومنزلتهم وعلوّ نشأتهم الطّبيعيّة ).
( ألا تراه خلقه على صورته ) التي ذكرناها ، وإنما كان على صورته ؛ ( لأنه ) أي :
الروح الإنساني إنما حصل ( من روحه ) ، أي : الروح الإلهي ، أي : معنى الإلهية من الذات والصفات المذكورة ، فيدبر هذا الروح الإنساني بدنه ، كما يدبر الروح الإلهي الأرواح والأجسام ، فهو روح الأرواح والأجسام جميع ، إلا أنه لا يشتغل فيما يدبره ، وهذا الروح الإنساني له اشتغال في البدن ؛ وذلك لأنه ( لما كانت نشأته ) ، أي : الإنسان باعتبار بدنه ( من هذه الأركان الأربعة ) التراب ، والماء ، والهواء ، والنار ( المسماة في جسده أخلاطا ) ، فالسواد تراب ، والبلغم والدم هواء ، والصفراء نار
( حدث عن نفخه ) ، أي : نفخ الإله فيه الروح ( اشتعال ) النار المكونة في مزاجه ( بما في جسده من الرطوبة ) ، إذ لا تقبل النار يابسا محضا كالتراب ، ول رطبا محضا كالماء ، بل القائل له الرطوبة مع اليبوسة ، ( فكان روح الإنسان ) مع كونه على صورة الحق في أصله ( نارا لأجل نشأته ) المشتملة بنفخه ؛ لصيرورتها بالرطوبة كالقبلة المبلولة بالدهن .
( ولهذا ) أي : ولصيرورة روح الإنسان نارا ( ما كلم اللّه موسى إلا في صورة النار ) ؛ لأنه عرف نفسه بصورة النار ، فلا يعرف ربه إلا بتلك الصورة ، وقد تقررت هذه الصورة فيه ، إذ قد ( جعل حاجته فيها ) ، والحاجة لا بدّ وأن تنطبع صورتها في النفس ، وإذا كانت نارية الروح الإنساني لأجل نشأته العنصرية ، ( فلو كانت نشأته طبيعية ) كنشأة العرش والكرسي ، ( لكان روحه نورا ) كالملائكة العلوية المدبرة لهما ، ( وكني عنه ) أي : عن جعل الروح النوري من كونه على صورة ربه نارا ( بالنفخ ) ، وهو عبارة عن إخراج الهواء من بطن النافخ إلى المنفوخ فيه ، ولا يتصور ذلك في حق اللّه تعالى ، فهو ( يشير إلى أن الروح من نفس الرحمن ) الذي به إخراجه ما في علمه إلى العين .
( فإنه بهذه النفس الذي هو النفخة ) في حق اللّه تعالى ( ظهر عينه ) من خفاء العلم إلى نور الوجود ، فهو بهذا الاعتبار نور ، ولكنه (باستعداد المنفوخ فيه ) من حيث اشتماله على النار مع الرطوبة ( كان الاشتعال نارا ) ، فتوهم بعضهم من ذلك أن الروح جسم لطيف سار في البدن ، خفيت نوريته ( لا نورا ) ، وإن كان من نفس الرحمن المقتضي كونه نورا ، وإليه نظر من قال بتجرده ، لكنه إذا صار نارا ( فبطن نفس الرحمن ) . ، وإن كان به الظهور ، ( فيما كان به الإنسان إنسانا ) وهو الروح المشتعل به بدنه ، وإلا فالبدن المجرد جماد ، فل يكون حيوانا فضلا عن الإنسان والروح المجرد ملك ، فالغير لناريته التي بها أخذ من قال بجسمانيته ، لكنه في الأصل على المتجرد واشتياق الحق إليه ؛ لذلك حتى إذا اشتد تجرده وكمل ، اشتد شوق الحق إليه .
( ثم ) أي : بعد ما خلقه على صورته واشتاق إليه ؛ لذلك أراد أن يخلق على صورة من خلقه على صورته شخصا آخر ، ويجعل من خلقه على صورته أولا مشتاقا إلى ذلك الشخص الآخر ؛ ليكون مظهرا لهذا الآخر ، وحينئذ ( اشتق له ) ، أي : لمن خلقه على صورته أولا ( شخصا على صورته ، فسماه امرأة ، فظهرت بصورته ) في الإنسانية وإن خالفته بالربوبية ، ( فحن ) المخلوق على صورة الحق أول ( إليها حنين الشيء إلى نفسه ) ، فكان مظهر الحن ، الحق ذاته في حبه لمن خلقه على صورته ، ولما ظهر حب الحق فيمن خلقه على صورته وهو الرجل ، ظهر حب المخلوق على صورته فيمن خلق على صورته ،
وهو المرأة وحينئذ ( حنت إليه حنين الشيء إلى وطنه ) ، إذ لم يخلق على صورته شيء دونها ، فرجعت إلى الأعلى ، فرجع الرجل إلى حب الحق بواسطة حبه إياها الموجب لحبها إياه ؛ ( فحبب إليه النساء ) على وجه المبالغة ،
( فإن اللّه أحب من خلقه على صورته ) ، وبالغ فيه حتى ( أسجد له ملائكته النوريين على عظيم قدرهم ) ، فإن نورانيتهم إلى نورانية أرواح الإنسان ، كنار عظيمة إلى السراج ( ومنزلتهم ) ؛ لأن نورهم أشبه بنور الحق ، إذ لم يصر بصورة النار ، ( وعلو نشأتهم الطبيعية ) بحيث لم يعارضها دنو النشأة الحيوانية والنباتية ، فإذا بالغ عليه السّلام في حب النساء مثل مبالغته تعالى في حب من خلقه على صورته .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( فمن هناك وقعت المناسبة ، والصّورة أعظم مناسبة وأجلّها وأكملها ؛ فإنّها زوج أي شفعت وجود الحقّ ، كما كانت المرأة شفعت بوجودها الرّجل فصيّرته زوجا ، فظهرت الثّلاثة : حقّ ورجل وامرأة ؛ فحنّ الرّجل إلى ربّه الّذي هو أصله حنين المرأة إليه ، فحبّب إليه ربّه النّساء كما أحبّ اللّه من هو على صورته ، فم وقع الحبّ إلّا لمن تكوّن عنه ، وقد كان حبه لمن تكوّن منه وهو الحقّ ؛ فلهذا قال : « حبّب » ولم يقل أحببت من نفسه لتعلّق حبّه بربّه الّذي هو على صورته حتّى في محبّته لامرأته ؛ فإنّه أحبّها بحبّ اللّه إيّاه تخلّقا إلهيّا .).
""أضاف المحقق :
كل من الحنين حب من ذوي الصورة إلى الصورة فيكون منشأ حبه هذا هو التخلف فلا يكون سند إلى نفسه ؛ فلذلك جاء بصفته حبب على الباء للمفعول ولم يسنده إلى نفسه .عبد الرحمن الجامي ""
( فمن هناك وقعت المناسبة ) بينه عليه السّلام ، وبين ربه عزّ وجل بظهور كمال صورة الحق فيه سيما من جملة مبالغته في حبه من خلقه على صورة ، ( والصورة أعظم مناسبة ) ؛ لأنها تجمع من وجوه المشاركة ما لا تجمعها غيرها ، ( وأجلها ) لجلالة كل شيء عنده ( وأكملها ) ؛ لإفادتها زيادة ظهور الشيء والظهور محبوب ، ( فإنه زوج ) لحقيقة الشيء المفرد حتى في حق اللّه تعالى ، ( أي : شفعت وجود الحق ) في ظهوره له ، إذ ظهر له في المظهر بعد ظهوره في ذاته ، فكان كمالا لظهوره بعد الكمال الأول له ، والكمال محبوب ( كما كانت المرأة ) محبوبة للرجل ؛ لأنها من ( شفعت بوجودها ) وجود ( الرجل ، فصيرته زوجا ) بعد انفراد صورته في الإنسانية مرآة ظهور الإنسانية بالصور المختلفة الحقيقية ، وعادت بهذه الشفعية فردية الحق في الظهور .
( فظهرت الثلاثة حق ورجل وامرأة ) ، والواحد أصل الشفع ، والأصل محبوب للمرأة ، إذ لم يكن لها محبوب دونها ، فرجع الرجل إلى حب الأصل ، ( فحن الرجل إلى ربه الذي هو أصله حنين المرأة إليه ) ، وكان ذلك من حبه إياها الجاعل محبوب لمحبوب محبوبا ، والمحبوب هنا الأصل من حيث هو أصل ،
( فحبب إليه ربه النساء ) ؛ ليكون ربه محبوبا له ( كما أحب اللّه من هو على صورته ) كحبه ، وإذا صار الحق محبوبا يحب الرجل امرأته ، ( فما وقع الحب ) ، أي : حب الرجل في الظاهر ( إلا لمن تكون عنه ) ، أي : عن الرجل وهو المرأة ، ( وقد كان ) في الباطن ( حبه لمن يكون ) الرجل منه ( وهو الحق ؛ فلهذا ) أي : ولكون حب المرأة حب الحق ( قال عليه السّلام : « حبب » ، ولم يقل : أحببت ) الموهم لكون حبه ( من نفسه ) ، فأزال ذلك الوهم بقوله : « حبب » ؛ ( فعلق حبه ) لامرأته ( بربه ) ، فإن إسناده إليه المفهوم من حذف الفاعل لتعينه ، يشعر برجوع هذا الحب إليه في الباطن من جهة المحبية التي هي راجعة إلى محبوبية الذات ؛ لأنه الذي هو على صورته في كل حال حتى في محبته لامرأته ، ( فإنه أحبها بحب اللّه إياه تخلقا إلهيّا ) ، ويرجع هذا الحب منه إلى حبه لذاته ، ثم إلى حبه لذات الحق من حيث إنه الأصل ؛ فافهم ، فإنه مزلة للقدم .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( ولمّا أحبّ الرّجل المرأة طلب الوصلة أي : غاية الوصلة الّتي تكون في المحبّة فلم يكن في صورة النّشأة العنصريّة أعظم وصلة من النّكاح ، ولهذا تعمّ الشّهوة أجزاءه كلّها ، ولذلك أمر بالاغتسال منه ، فعمّت الطّهارة كما عمّ الفناء فيها عند حصول الشّهوة ، فإنّ الحقّ غيور على عبده أن يعتقد أنّه يلتذّ بغيره ، فطهّره بالغسل ليرجع بالنّظر إليه فيمن فني فيه ، إذ لا يكون إلّا ذلك ، فإذا شاهد الرّجل الحقّ في المرأة كان شهودا في منفعل ، وإذا شاهده في نفسه من حيث ظهور المرأة عنه شاهده في فاعل ، وإذا شاهده في نفسه من غير استحضار صورة ما تكوّن عنه كان شهوده في منفعل عن الحقّ بلا واسطة ، فشهوده للحقّ في المرأة أتمّ وأكمل ، لأنّه يشاهد الحقّ من حيث هو فاعل منفعل ؛ ومن نفسه من حيث هو منفعل خاصّة.)
ثم إنه أشار إلى أن العبد إنما يصل إلى الحب الباطن الإلهي بعد استكمال الحب الظاهر بالوصلة ، لكن بعد التطهر عن التلذذ بالغير ، فقال : (ولم أحب الرجل المرأة ) في الظاهر ( بطلب الوصلة ) منها بقدر المحبة وهي محبوبة في الغاية ، فطلب الوصول إلى ( غاية الوصلة ) ، فإن الوصلة هي (التي تكون ) مطلوبة ( في المحبة ) بقدرها ، ( فلم تكن في صورة النشأة العنصرية ) احترز بذلك عن وصلة العبد بالحق ( أعظم وصلة من النكاح ) ، أي :
الوطء لجمعه بين الوصلة الصورة والمعنوية بغاية التلذذ من المحبوب ؛ (ولهذ ) أي : ولكون النكاح أعظم وجوه الوصلة بما فيه من غاية التلذذ ، (فعمت الشهوة أجزاءه كلها ) بحيث تلذذ الجميع ( أمر بالاغتسال ) ، أي : غسل جميع البدن الظاهر ( منه ) ، أي : من النكاح من حيث م حصل به التلوث بالتلذذ بالغير بغاية اللذة الموجبة ؛ لغفلة المتلذذ الذي هو حق التلذذ باللّه تعالى .
( فعمت الطهارة ) الظاهرة ؛ لتؤثر في تطهير الباطن على سبيل العموم ، ( كما عم الفناء فيها ) أي : في المرأة من حيث هي امرأة لا من حيث ظهور الحق فيها ؛ لأنه ( عند حصول الشهوة ) متحقق أن تلذذه كان بالغير من حيث هو غير فأمر بالاغتسال عنه دفعا لهذه الغيرية ،
( فإن الحق غيور ) يغار ( على عبده أن يعتقد أنه يلتذ بغيره ، فطهره ) في الظاهر ( بالغسل ) ؛ ليؤثر ذلك في باطنه لارتباط بينهما ؛ ( ليرجع ) عند هذه الطهارة الرافعة حجب الباطن ( بالنظر إليه ) ، أي : إلى الحق من حيث ظهوره ( فيمن فني ) به وهو المرأة ، ولا بد من هذا النظر عند رفع الحجب ، ( إذ لا يكون ) الظاهر في كل شيء ( إلا ذلك ) ، لكن لا يدركه المحجوب ، ووصلة النكاح وإن كانت حجابا كثيفا ، فعند التطهير يرتفع الحجاب بالكلية في حق الكامل .
( فإذا شاهد الرجل الحق في المرأة ) من غير وصلة النكاح ( كان شهوده في منفعل ) ؛ لأنه إنما يشاهد الحق فيها من حيث إنها وجدت بإيجاد الحق وبواسطة الرجل ، والحق يكون باعتبار الظهور منفصلا ، وإن امتنع ذلك من حيث استقراره في مقر عزه ،
( وإذا شاهده ) أي : الرجل الحق ( في نفسه ) لا من حيث وجوده من الحق ، بل ( من حيث ظهور المرأة عنه شاهد في فاعل ) ؛ لأنه وإن لم توجد المرأة ، فهو سبب وجودها ، والسبب له حكم الفاعل ، ( وإذا شاهده ) أي : الحق من نفسه لم يقل (في نفسه ) ؛ لأنه يشعر بالاستقرار ، واستقرار الحق في نفس الرأي موجب لفنائه ( من غير استحضار صورة ما تكون عنه ) وهي المرأة ، ( كان شهوده في منفعل ) من حيث وجوده من ( الحق ) ، لكن ( بلا واسطة ) مثله ، وشهوده في الفاعل وحده أو المنفعل وحده ناقص ، ( فشهوده للحق في ) وصلة ( المرأة ) بالنكاح بعد التطهير عما تلوث من التلذذ بالغير ( أتم وأكمل ؛ لأنه يشاهد الحق ) في هذه الوصلة ( من حيث هو فاعل منفعل ) ، إذ لا وصلة بدون فعل الرجل وانفعال المرأة ، وكيف لا يكون أكمل وهو يرى الحق في الفاعل عين رؤيته في المنفعل ؛ لأنه يراه من نفسه من حيث هو منفعل لانفعالها في الوجود عن الحق ، وهذه رؤية ( خاصة ) ، وهي كمال بعد التمام .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( فلهذا أحبّ صلّى اللّه عليه وسلّم النّساء لكمال شهود الحقّ فيهنّ ، إذ لا يشاهد الحقّ مجرّدا عن الموادّ أبدا ؛ فإنّ اللّه بالذّات غنيّ عن العالمين ، فإذا كان الأمر من هذا الوجه ممتنعا ، ولم تكن الشّهادة إلّا في مادّة ، فشهود الحقّ في النّساء أعظم الشّهود وأكمله ، وأعظم الوصلة النّكاح وهو نظير التّوجّه الإلهيّ على من خلقه على صورته ليخلفه فيرى فيه صورته بل نفسه فسوّاه وعدله ونفخ فيه من روحه الّذي هو نفسه ، فظاهره خلق وباطنه حقّ ) .
(ولهذ ) أي : ولتمام شهود الحق في هذه الوصلة مع الكمال المذكور ( أحب عليه السّلام النساء ) ، وإن كن من حيث هن حجبا على الحق والفناء فيهن موجب للغسل ، ( فكمال شهود الحق فيهن ) باعتبار هذه الوصلة عند التطهر ، وإن كان يتوهم أن رؤية الحق في الصورة التنزيهية أكمل ، ( إذ لا يشاهد الحق مجردا عن المواد ) ، بل إنما يرى في المادة الأسمائية أو الكونية ، لكن المادة الأسمائية لا تكون إلا فاعلة ، والمادة الكونية لا تكون إلا أحدهما ،
( فإن اللّه بالذات غني عن العالمين ) ، إذ يشاهد ذاته وكمالاتها بذاته في غاية الظهور ، وإنما يطلب ظهورها بصور الأسماء أو آثاره ، إذ لا مجال للحوادث في ذاته ، فكأنه بهذا الاعتبار محتاج إلى إظهار ذلك ، والفعل بدون الحاجة عبث يمنع صدوره عن الحكيم ، ( فإذا كان الأمر ) أي : أمر المشهود (من هذا الوجه ) أي : وجه المتجرد عن المواد ( ممتنعا ) ، وليس المراد الامتناع العقلي ؛ لأن الحق يرى ذاته بذاته ، بل ( لم يكن ) يحسب السنة الإلهية ( الشهادة ) لنا ( إلا في مادة ) من الصور الأسمائية أو الكونية .
( فشهود الحق في ) وصلة ( النساء أعظم الشهود و أكمله ) ؛ لجمعه بين شهود الذات وشهود حبه لذاته في حبه لمن خلقه على صورته ، وشهود محبوبية الحق لنفسه ولعبده ، والجملة لرؤيته فاعلية الحق ومنفعليته في أمر واحد وهو الرجل ، وكذا المرأة باعتبار تأثيرها في حب الرجل ، ( وأعظم الوصلة النكاح ) لما ذكرنا مع أنه يتضمن باعتبار طلب الولد به إرادة الحق ، وتكوينه للإنسان الكامل لظهور سره فيه ،
وإليه الإشارة بقوله :( وهي نظير التوجه ) الإرادي الذي استيلاء القدرة ( على من خلقه ) كاملا ؛ لكونه ( على صورته ) ، فتوجه إليه بهذه الإرادة للخليقة ( على صورته ، فيرى فيه ) نفسه ، أي : ذاته بكمال ظهورها ، ولما كان لا يتم الظهور إلا بالتسوية والاعتدال ، (فسواه ) أي : سوى مزاجه ، وبالغ في تسويته حتى ( عدله ) بحيث لا تميل بعض الأطراف ، ( ونفخ فيه من روحه ) الأعلى من أرواح سائر الحيوانات والنباتات ، فإنها من العناصر وروحه ليس كذلك ، فإنه ( الذي هو كأنه نفسه ) الرحماني وهو عين الحق ، وقد صار باطنه عندما يصور روحه بصورة النار عند اشتعال البدن به ، ( فظاهره خلق وباطنه ) الذي هو مبدأه ( حق ) .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( ولهذا وصفه بالتّدبير لهذا الهيكل ، فإنّه تعالى :يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّماءِ وهو العلوّ ،إِلَى الْأَرْضِ [ السجدة : 5 ] ، وهو أسفل السّافلين ، لأنّها أسفل الأركان كلّها ، وسمّاهنّ بالنّساء وهو جمع لا واحد له من لفظه ، ولذلك قال عليه السّلام : « حبّب إليّ من دنياكم ثلاث : النّساء » ، ولم يقل المرأة ، فراعى تأخّرهنّ في الوجود عنه ، فإنّ النّسأة هي التّأخير قال تعالى :إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ [ التوبة : 37 ] والبيع بنسيئة يقول بتأخير ، فلذلك ذكر النّساء ، فما أحبّهنّ إلّا بالمرتبة وأنّهنّ محلّ الانفعال ؛ فهنّ له كالطّبيعة للحقّ الّتي فتح فيها صور العالم بالتّوجّه الإرادي والأمر الإلهيّ الّذي هو نكاح في عالم الصّور العنصريّة ، وهمّة في عالم الأرواح النّوريّة ، وترتيب مقدّمات في المعاني للإنتاج ، وكلّ ذلك نكاح الفرديّة الأولى في كلّ وجه من هذه الوجوه ) .
( ولهذا ) أي : ولكون باطن الروح المدبر لهذا الهيكل الإنساني بالاتفاق ( وصفه الحق بالتدبير لهذا الهيكل ) ، فإنه تعالى قال :يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّماءِ إِلَى الْأَرْضِ[ السجدة :5 ].
، والمعنى المجازي إذا كان أهم من الحقيقي أولى ، فالمراد بالتدبير أعم من التدبير الظاهر والباطن ، والمراد من السماء ما ارتفع حسّا أو معنى ، وهو العلو فتدخل فيه الروح ، والمراد بقوله :إِلَى الْأَرْضِ أي : م انخفض حسّا أو معنى ، ( وهو أسفل السافلين ) ، فيدخل فيه الهيكل الإنساني ؛ وذلك ( لأنها ) أي : الأرض ( أسفل الأركان كلها ) ، وهي النار والهواء والماء والأرض ، وكذا الهيكل الإنساني أسفل المولدات ، وهي المعادن والنبات والحيوانات والإنسان ، لكن سفل الهيكل الإنساني من حيث التأخر في الرتبة ، وهذا المعنى في لفظ النساء أظهر ؛ وذلك لأنه عليه السّلام ( سماهن بالنساء ، وهو جمع ) بتأخر رتبته عن رتبة الواحد ، وإن كان ( لا واحد له من لفظه ) والتأخر أدنى من التقدم ؛ ( ولذلك قال عليه السّلام : « حبب إليّ من دنياكم ») ، فأشار إلى دنوهن « ثلاث » ، فقدم الثلاث ، ثم قال : "النساء " المشعر بالتأخر من جهة كونه جمعا ، ( ولم يقل : المرأة ) ، وإن كان المقصود المرائية .
( فراعى بتأخرهن في الوجود عنه ) ؛ ليظهر أثر الإرادة ، إذ لا أثر له في التقديم ، وكيف لا ولفظ النساء مشعر بذلك بحسب شبهة الاشتقاق من النسأة والنسيء والنسية ، ( فإن النسأة ) والنسيء والنسية ( هي التأخير ) قال تعالى :"إِنَّمَا النَّسِيءُ" [ التوبة : 37 ] هو مصدر كالشعير والحريق ، أي : تأخير الأشهر الحرم "زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ" [ التوبة : 37 ] بتحليل الحرام ، وتحريم الحلال ، قال : لعل العرف المتبع ( بنسيئة ) أي : ( بتأخير ) في إذن الثمن ، ( فلذلك ) أي : فلإشعار لفظ النساء بمعنى التأخير المشير إلى نفوذ القدرة بالإرادة ، وإلى الدخول تحت الأمر ( ذكر النساء ) في خبر الحب الذي يتشبه فيه بحب الحق للمراتب المنفعلة منه بظهور صور ذاته وصفاته وأسمائه ، ( فم أحبهن إلا بالمرتبة ) ، أي : باعتبار كونهن مراتب ظهوره عليه السّلام ، والظهور إنما يتم بانفعال المحل بصورة الشخص ،
وذلك يقضي أنه إنما أحبهن من حيث ( إنهن محل الانفعال ) ، إذ محل الانفعال هو المتوجه إليه بالإرادة ، وقد أحب الحق ظهوره في محل الانفعال الكلي وهو الطبيعة بهذه الإرادة ؛ لأنها تنتج في الصور المختلفة والنساء بالولادة كذلك ؛ (فهن له كالطبيعة للحق ) أحبها ؛ لأنها ( التي فتح فيه صور العالم ) التي هي صور ذاته وصفاته وأسمائه ( بالتوجه الإرادي ) كتوجه الناكح إلى طلب الولد.
ثم استشعر سؤالا بأن التشبه بالإله في هذه الوصلة التي أعظمها النكاح ، إنما يتم لو تصور النكاح في حقه عزّ وجل ؟
فأجاب بأن : النكاح الحقيقي وإن لم يتصور ، فالمجازي متصور فيه وهو كاف ، وهو أن يقول ( الأمر الإلهي ) الذي به طلب الإيجاد ( هو النكاح ) ؛ لأنه يجمع ( في عالم الصور العنصرية ) بين العناصر ، ولكن لا جمع للمختلفات في عالم الأرواح والمعادن ، فيقول الأمر الإلهي ( همته ) ، أي : قصده في ( عالم الأرواح النورية ) التي لا تركيب فيها لتجرده ، ( وترتيب المقدمات ) في عالم ( المعاني ) ، ولكن الهمة والترتيب إنما يكونان (للإنتاج ) ، أي :إنتاج الأرواح والمعاني ، والإنتاج في الحيوان يؤدي إلى النكاح ،
فصح أن يقال :( كل ذلك نكاح الفردية الأول ) ، وهي ذات واردة والنكاح ، إنما هو في الفاعل وقد حصل الاجتماع بين هذه الثلاثة ، فصح إطلاق لفظ النكاح بالمجاز ( في كل وجه من هذه الوجوه ) ، أي : إيجاد عالم الصور العنصرية ، والأرواح النورية ، والمعاني النظرية ،
وإذ كان في حب النساء هذه الأسرار ، وهن رؤية نكاح الفردية الأول ، وأنهن له كالطبيعة للحق في إيجاد صور العالم ، والتوجه الإرادي في إيجاد من يكون على صورته ، وحبه له ولذاته ، ورؤية الحق في الفاعل والمنفعل .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( فمن أحبّ النّساء على هذا الحدّ فهو حبّ إلهيّ ، ومن أحبّهنّ على جهة الشّهوة الطّبيعيّة خاصّة نقصه علم هذه الشّهوة ، فكان صورة بلا روح عنده ، وإن كانت تلك الصّورة في نفس الأمر ذات روح ولكنّها غير مشهودة ، لمن جاء امرأته أو أنثى حيث كانت لمجرّد الالتذاذ ولكن لا يدري لمن فجهل من نفسه ما يجهل الغير منه ما لم يسمّه هو بلسانه حتّى يعلم كما قال بعضهم :
صحّ عند النّاس أنّي عاشق ..... غير أن لم يعرفوا عشقي لمن
كذلك هذا أحبّ الالتذاذ فأحبّ المحلّ الّذي يكون فيه وهو المرأة ولكن غاب عنه روح المسألة ، فلو علمها لعلم بمن التذّ ومن التذّ ، وكان كامل ) .
( فمن أحب النساء على هذا الحد ، فهو حب إلهي ) ، أي : يخلق بحبه تعالى وراجع إلى حبه عزّ وجل ، ( ومن أحبهن على جهة الشهوة الطبيعية ) احتزر بذلك عن جهة كونها مظهر الحب الإلهي ( خاصة ) ، أشار بذلك إلى أن هذه الجهة لو انضمت إلى تلك لم [ . . . ] .
روح المسألة ، ولم ينقص علم الشهوة ( نقصه علم ) سبب إيجاده ( هذه الشهوة ) ، فإنها إنما خلقت ليصير مظهر حبه لمن أوجده على صورته ومظهر توجهه الإرادي إلى إيجاده ، والعلم بالشيء هو روح منه إلى العالم ، فإذا نقصه علم هذه الشهوة ، ( فكان ) حبه لأجلها ( صورة بلا روح ) حصل منه (عنده ) ، أي : عند هذا الحب ( وإن كانت تلك الصورة في نفس الأمر ذاتروح ) إذلا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ[ الروم : 30 ] ،
فلابدّ أن يوجد مع هذه الشهوة روحها وهي المعنى الذي خلقها اللّه لأجله من كونها مظهر لحبه وتوجهه الإرادي ، ( ولكنها ) أي : روح هذه الصورة ( غير مشهودة ) ، ولا تخلق بدون الشهود ( لمن جاء امرأته ) المنكوحة أو المملوكة ، وإن كان من شأنها أن يكون حبها تخلقا بالحب الإلهي ، ( أو أنثى ) لشبهه وإن لم تكن محبوبته حتى يتخلق فيها بالمذكور بخلاف من زنا أو لاط ، فإنه لا روح هناك أصلا ، وهنا وإن وجدت ، فهي كالعدم ( حيث كانت ) غير امرأته مما ليس من شأنها ذلك حيث كانت شهوته ( لمجرد الالتذاذ ) ، وإن كان هذا الالتذاذ مظهرا لالتذاذ الحق بحبه لذاته .
( ولكن لا يدري ) هذا الرجل ( لمن ) تحصل هذه اللذة أتحصل لنفسه من حيث هي نفسه فلا وجه لمظهريتها للذة الحق ، ولنفسه من حيث هي مظهر الحق ، فتكون لذاتها مظهر لذاته تعالى ، وهل يلتذ بالمرأة من حيث هي امرأة أو من حيث كونها على صورته أو صورة الحق ، فكأنه لا يدري من نفسه أنها ملتذة أصلا وأن المرأة ملتذة بها ، ( فجهل من نفسه ما يجهل الغير منه ) من لذته .
""أضافة المحقق :
الحاصل أن العارف لمحل الالتذاذ يظهر ذلك عند نفسه ، ويظهر للغير والجاهل به يخفى عند ذلك ويخفى للغير ، وإن كان الالتذاذ بنفسه ظاهرا له ولغيره . عبد الرحمن الجامي""
( م لم يسمه هو بلسانه حتى ) بدا من وجه آخر كرؤية أسبابها في حقه ، ولكنه يقع التلذذ في الواقع لمظهر الحق بمظهره وإن لم يشعر به هذا الرجل ، فصار ( كما قال بعضهم : صح عند الناس أني عاشق غير أن لم يعرفوا عشقي لمن ) ؛ لأنه ( كذلك ) الناس ( هذا الرجل أحب الالتذاذ ) بالشهوة من حيث هو الالتذاذ بها ، فصار محبوبا له بالذات ، ( فأحب ) بتبعيته ( المحل الذي يكون منه وهو المرأة ) بينه ؛ لئلا يتوهم أن المرأة نفسه فإنها أيضا محل حصول لهذه اللذة ، فالالتذاذ وإن كان مظهرا لالتذاذ الحق من حبه ذاته والمرأة وإن كانت مظهر لذاته ، يقال : ومعرفة ذلك روح مسألة حبها ، ( ولكن غاب عند روح المسألة ) ، إذ لم يكن له مقصودا مع أنه يحب كونه مقصودا بالذات وغيره مقصودا بالتبعية ، ( فلو علمها ) أي : روح المسألة ( لعلم بمن التذ ) ، وهو نفسه من حيث هو على صورة ربها ، ( ومن التذ ) وهي المرأة من حيث هي على صورة ربها ، ( فكان كاملا ) يرى الحق في كل شيء وأنه المحب والمحبوب .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( وكما نزلت المرأة عن درجة الرّجل بقوله :وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ [ البقرة : 288].
نزل المخلوق على الصّورة عن درجة من أنشأه على صورته مع كونه على صورته ، فبتلك الدّرجة الّتي تميّز بها عنه ، بها كان غنيّا عن العالمين وفاعل أوّلا ، فإنّ الصّورة فاعل ثان ، فما له الأوّليّة الّتي للحقّ . فتميّزت الأعيان بالمراتب : فأعطى كلّ ذي حقّ حقّه كلّ عارف ) .
ثم استشعر سؤالا بأنه كيف يفوته روح المسألة مع أن المحب والمحبوب في حقه صورة الحق في الواقع ؟
فأجاب بقوله : ( وكما نزلت المرأة عن درجة الرجل ) مع كونها مخلوقة على صورته علم ذلك ( بقوله تعالى :وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) [ البقرة : 228 ] ؛ لكونهم سبب وجودهن وأصله ( نزل المخلوق على الصورة ) ، أي : صورة الخالق ( عن درجة ) من النشأة على صورته ، إذ كونه منشأ يوجب له درجة رفيعة ، وكيف ل ينزل المخلوق على الصورة المعنوية عن درجة ( من أنشأه على صورته ) بنوع مناسبة ضعيفة مع عظم التفاوت بين الصورتين ، وقد حصل التنزل في صورة المرأة عن درجة الرجل ( مع كونها على صورته ) حسّا ، ومعني بمناسبة قوية مع قلة التفاوت بين الصورتين ، فدل ذلك على التفاوت بين محبة الحق ومحبة صورته ، فإذ قصدت الصورة من حيث هي صورة الحق بمحبة الحق بالذات ، فالصورة بالتبعية وإذا قصدت الصورة نفسها ، فليس هناك محبة الحق أصلا في قصده ،
وأشار إلى عظم التفاوت بين صورة الحق والمخلوق على صورته الموجبة للحق درجة عظيمة عليه بقوله : ( فتلك الدرجة التي تميز بها ) الحق (عنه ) ، أي : عن المخلوق على صورته ( بها ) ، أي : بتلك الدرجة الكائنة عن عظم التفاوت .
( كان ) الحق ( غنيّا عن العالمين ) ، وبها كان ( فاعلا أولا ) في كل فعل حتى في أفعالنا ، ( فإن الصورة فاعل ) كان كحركة صورة المرأة من حركة ذي الصورة ، ( فما له ) أي : الفاعل الثاني ( الأولوية التي للحق ) لا في فعله كما تقوله المعتزلة ، ولا في الذات والصفات والأسماء بالاتفاق ، وإذ وجب التمايز بين الحق والمخلوق على صورته بالدرجة ظهر ذلك فيما بين الأعيان كلها ، ( فتميزت الأعيان بالمراتب ) حتى تميزت أفراد نوع واحدتها ، ومعرفة هذ التمييز موجب لتمييز الحقوق ؛ ( فأعطى كل ذي حق حقه كل عارف ) ، فأعطى الحق حقه من المحبة فيراه محبوبا بالذات ، وأعطى الحق حقه هي المحبة فيراه محبوبا لأجل الحق ، وأكمل العلوم للّه تعالى وقد ظهر به في حبيبه محمد صلّى اللّه عليه وسلّم .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( فلهذا كان حبّ النّساء لمحمّد صلّى اللّه عليه وسلّم عن تحبّب إلهيّ وأنّ اللّه تعالى :"أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ" [ طه : 50 ] وهو عين حقّه ، فما أعطاه إلّا باستحقاق استحقّه بمسمّاه ؛ أي بذات ذلك المستحقّ ، وإنما قدّم النساء لأنّهنّ محلّ الانفعال ، كم تقدّمت الطبيعة على من وجد منها بالصّورة ، وليست الطّبيعة على الحقيقة إلّ النّفس الرّحمانيّ ، فإنّه فيه انفتحت صور العالم أعلاه وأسفله لسريان النّفخة في الجوهر الهيولانيّ في عالم الأجرام خاصّة، وأمّا سريانها لوجود الأرواح النّوريّة والأعراض فذلك سريان آخر).
( فلهذا كان حب النساء لمحمد صلّى اللّه عليه وسلّم عن تحبب إلهي ) ؛ لأنه لكمال معرفته رأى الحق محبّا ومحبوبا بالذات وغيره بالتبعية ، وإنما كان حب العارف عن تحبيب إلهي دون حب غيره ؛ لأنه صح ( أن اللّه تعالى :أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ) أيما كان خلقه عليه من استعداده ، وكيف لا يعطي كل شيء خلقه ( وهو عين حقه ) الثابت في علمه الأزلي ، المطلع على الاستحقاق الذي يوجب الجواد ( أعطاه ) بحسب السنة الإلهية ، فهو وإن أعطاه تفضلا باعتبار غنى ذاته عن الكل ، فما أعطاه باعتبار العلم والجود (ل باستحقاق ) ، وكيف لا يعطي ذلك الاستحقاق وقدست ( مسماه ) ، أي : باعتبار كونه محل تصرف اسم من أسماء الحق التي لا تغايره من كل وجه ، فكأنه أعطى ذاته ذلك ، ولكن الذات غنية عن العالمين ، فلا يظهر تصرف الأسماء إلا في ذوات الأشياء ؛ فلذلك قال ، ( أي : بذات ذلك المستحق ) الذي استحقه باعتبار كونه محل تصرف الأسماء الإلهية لا باعتبار كونه عينا ثابتة ، فإن ذلك إنما هو في العلم الأزلي وهي لا تقبل التصرف بذلك الاعتبار ؛ فافهم ، فإنه مزلة للقدم .
( وإنما قدم النساء ) مع اعتبار التأخر بالرتبة في حبهن في بعض الوجوه ؛ لأنهن في هذا الاعتبار يشبهن الطبيعة ؛ ( لأنهن محل الانفعال ) لطلب من هو على صورته وهو الولد ، فقدمهن ( كما تقدمت الطبيعة ) بالصورة النفسية ( على من وجد ) تشبيها من صور العالم ؛ وذلك لأنه ( ليست الطبيعة على الحقيقة ) ، وإن كان المتعارف أنها الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ( إلا ) صورة ( النفس الرحماني ) ؛ لذلك صارت مبتدأ الفعل والانفعال ، وهو أعم من المتعارف ؛ لشموله جميع الموجودات تأثيرا أو تأثرا ،
( فإنه ) أي : النفس الرحماني عند تصوره بصورة الطبيعة بسريان نفخته ( فتحت فيه صور العالم ) كصور الحروف في النفس الإنساني ( أعلاه ) الروحاني ، ( وأسفله ) الأجسام وأعراضها وقواها ، لكن انفتاح صور العالم فيه ( بسريان النفخة في الجوهر الهيولاني ) القابل لصور الأجرام كما تقوله الفلاسفة ، لكن لا تقول نقدمه خلافا لهم ( في ) صور ( عالم الأجرام خاصة ، وإنما سريانها ) أي : النفخة
( لوجود الأرواح النورية ) احترز به عن القوة النباتية والحيوانية (والأعراض ، فذلك سريان آخر ) غير السريان في الجوهر الهيولاني ، أما الأرواح النورية فلتجردها عن المادة ، وأما الأعراض فلأنها ليست بجواهر حتى تقوم صورها الجوهر الهيولاني .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( ثمّ إنّه صلّى اللّه عليه وسلّم غلّب في هذا الخبر التّأنيث على التّذكير لأنّه قصد التّهمّم بالنّساء ؛ فقال : « ثلاث » ، ولم يقل : "ثلاثة " بالهاء الّذي هو لعدد الذّكران ، إذ همّه فيها ، ذكر الطّيب وهو مذكّر ، وعادة العرب أن تغلّب التّذكير على التأنيث فتقول : « الفواطم وزيد خرجوا » ، ولا تقول خرجن ، فغلّبوا التّذكير وإن كان واحدا على التّأنيث وإن كنّ جماعة ؛ وهو عربيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فراعى المعنى الّذي قصد به في التّحبّب ما لم يكن يؤثر حبّه ، فعلّمه اللّه ما لم يكن يعلم وكان فضل اللّه عليه عظيما ، فغلّب التّأنيث على التّذكير بقوله : « ثلاث » بغير هاء فما أعلمه صلّى اللّه عليه وسلّم بالحقائق ، وما أشدّ رعايته للحقوق ).
( ثم إنه عليه السّلام غلب في هذا الخبر التأنيث على التذكير ) في العدد المفسر بهما ؛ ( لأنه قصد التهمم بالنساء ) كما ذكرنا من الوجوه ، وكأنه قصدهن بالذات بذلك العدد ، فقال :
" حبب إليّ من دنياكم ثلاث " . بحذف الهاء المختصة بعدد الإناث ، ( ولم يقل ثلاثة بالهاء الذي هو لعدد الذكران ) مع أنه مفسر بما يشتمل على المذكر ( إذ ) مفسره المذكور أن بعده ، ( وفيه ذكر الطيب وهو مذكر ) لفظا ومعنى ، ( وعادة العرب أن يغلب التذكير على التأنيث ) إلا لنكتة ، ( فتقول : الفواطم وزيد خرجوا ، ولا نقول : خرجن ) مع أنهن أكثر وأقدم ، ( فغلبوا التذكير ، وإن كان واحدا على التأنيث ، وإن كن جماعة ) مقدمة ، إلا أنه لم يعتبره الشيخ - رحمه اللّه - لعدم كونه مقدما من كل وجه فيما نحن فيه ، فهنا النساء والصلاة وإن كانتا أكثر من الطيب ، فعادة العرب تقتضي تغليب التذكير على التأنيث ( وهو صلّى اللّه عليه وسلّم عربي ) فل يترك عادتهم إلا لنكتة .
( فراعى صلّى اللّه عليه وسلّم المعنى الذي قصد به ) ، أي : قصده الحق أن يتحقق عليه السّلام به ( في التحبيب ) إليه ، أي : تحبيب الحق إليه ( ما لم يكن عليه السّلام ) بنفسه ( يؤثر حبه ) وهن النساء ، يعني أنه عزّ وجل لما حبب إليه النساء لما ذكرنا من الوجوه أتم نشأتهن ، فراعى حقهن حتى غلبهن على المذكور في العدد ، ولو كان ذلك عن نفسه لما تحقق بتلك المعاني ، ولم يكن له هذا الاهتمام الموجب لرعاية حقهن ، فلما كان هذا التحبيب الإلهي مقصودا من اللّه لتلك المعاني ، ولم يكن من نفسه عليه السّلام ، (فعلمه اللّه ) في رعاية حقهن ( ما لم يكن يعلم ) من عادة العرب ،( وَكانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً) [ النساء : 113 ] .
في إفاضة تلك المعاني عليه في حبه النساء ورعاية حقهن ؛ لأن التحبيب كان من اللّه تعالى بقصد هذه المعاني التي جعلت الأمر النفساني في العادة أجل من الروحاني كالصلاة ، ومن المشرك بين الروحاني والجسماني وهو الطيب ، ( فغلب التأنيث على التذكير ) ؛ للإشارة إلى غلبة حبهن على حب الطيب مع كماله بالاشتراك بين الروحاني والجسماني ( بقوله : « ثلاث » بغير هاء ) ، فكأنه قصد ذكر من دون غيرهن في المجمل من العدد الشامل عليهن وعلى غيرهن ، ( فما أعلمه بالحقائق ) ، إذ علم هذه الوجوه في حبهن وهي أكثر وأجل من التي في حب الطيب والصلاة مع جلالة شأنها ، ( وما أشد رعايته للحقوق ) إذ قدمهن وقصدهن في العدد الشامل عليهن وعلى غيرهن ؛ فافهم ، فإنه مزلة للقدم .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( ثمّ إنّه جعل الخاتمة نظيرة الأولى في التّأنيث وأدرج بينهما التّذكير ، فبدأ بالنّساء وختم بالصّلاة وكلتاهما تأنيث ، والطّيب بينهما كهو في وجوده ، فإنّ الرّجل مدرج بين ذات ظهر عنها وبين امرأة ظهرت عنه ، فهو بين مؤنّثين : تأنيث ذات ، وتأنيث حقيقيّ ، كذلك النّساء تأنيث حقيقيّ والصّلاة تأنيث غير حقيقيّ والطّيب مذكّر بينهما كآدم بين الذّات الموجود هو عنها وبين حواء الموجودة عنه ، وإن شئت قلت :
الصّفة فمؤنثة أيضا ، وإن شئت قلت : القدرة فمؤنّثة أيضا ، فكن على أيّ مذهب شئت ، فإنك لا تجد إلّا التّأنيث يتقدّم حتّى عند أصحاب العلّة الّذين جعلوا الحقّ علّة في وجود العالم والعلّة مؤنّثة ).
( ثم إنه صلّى اللّه عليه وسلّم جعل الخاتمة ) وهي الصلاة (نظير الأولي ) ، وهي النساء ؛ ليشعر بأن النهاية تشبه البداية ( في التأنيث ) ؛ ليشعر بأن مرجع الأسماء إلى الذات الإلهية ، ( وأدرج ) أي : وسط ( بينهما التذكير ) ؛ ليشعر بأن تردد الرجال إنما هو بين الذات والأسماء ، لكن لا يقصدون في الأسماء سوى الذات ،
( فبدأ بالنساء ) للاهتمام بهن من حيث كونهن مظهر الذات ، ( وختم بالصلاة ) ليشعر بأن طالب الذات لا يجدها إلا في لبسه الأسماء ، ولكن من حيث رجوعها إلى الذات بدليل اعتبار التأنيث فيها أيضا إذ ( كلتاهما تأنيث والطيب بينهما ) ؛ ليعلم أن الطيب إنما يكون لمن يدور بينهما ، فإنه كمال الرجال ، فالطيب بين التأنيث (كهو ) ، أي : الرجل ( في الوجود ) الذي هو أول كمالاته وآخرها [ تحت ] أن يشبه الأول .
( فإن الرجل في الوجود مدرج بين ذات ) إلهية ( ظهر عنها ) على صورتها ، ( وبين امرأة ظهرت ) تلك المرأة ( عنه ) على صورته ، ( فهو ) في حال الكمال أيضا ( بين مؤنثين ذات ) وأسماء من حب رجوعها إلى الذات ، لكن في وجوه الأول السابق مؤنث غير حقيقي ، والثاني مؤنث حقيقي ، وفي النهاية كلا المؤنثين غير حقيقيين ؛ لأن الكمال أزال عنهما الانفعال ، لكن الترتيب في الخبر على عكس وجود الرجل
كم أشار إليه بقوله :
( كذلك ) ، أي : مثل وجود الرجل من مؤنثين حقيقي وغير حقيقي الطيب ، إذ ( النساء تأنيث حقيقي ، والصلاة تأنيث غير حقيقي ، والطيب مذكر بينهما ) ، لكن المؤنث الأول في وجود الرجل غير حقيقي ، والثاني حقيقي ، والطيب بالعكس ؛ ليشعر بأن أول أمر الطيب الانفعال بتحصيل الأخلاق الطيبة حتى إذا كمل سار مترددا بين الذات والأسماء في الفعل بهما فيمن دونه ، فمرجعه إلى التأنيث من حيث هو عبد ، لكنه لما تصور بصورة الحق صار كأنه غير منفعل عند ظهور جهة الفاعلية فيه ، وكان عند وجوده الأول لا ينفعل عن الهوى أولا ، ثم صار منفعلا عنه ، ولما لم يظهر هذ التمثيل في كل رجل وامرأة ، وتردد في كون آدم من الذات أو من الصفة عند القائل بهما أو من العلة عند القائل به .
قال : ( كآدم ) مدرج ( بين الذات الموجود هو عنها ) إما باعتبار الروح فظاهر ، وإما باعتبار البدن ؛ فلأن تجمير طينته منسوب إليها ( وبين حواء الموجودة عنه ) ، وإن كان موجدها الذات أيضا ، لكن السبب يتنزل منزلة الموجد ، ( وإن شئت قلت ) : نظرا إلى استغناء الذات عن العالمين مدرج بين (الصفة ) الإلهية وبين حواء مؤنثة ، أي : ( فالصفة مؤنثة أيضا وإن شئت قلت ) : نظرا إلى أن في الصفات ما هو مذكور كالعلم ، والسمع والبصر والكلام بين (القدرة ) وحواء ( فمؤنثه أيضا ، فكن على أي مذهب شئت ، فإنك لا تجد ) في المبدأ ( إلا التأنيث ) مقدما على المذكر حتى ( عند أصحاب العلة ) ، وهم الفلاسفة ( الذين جعلوا الحق علة في وجود العالم ) ؛ لقولهم : بأنه موجب بالذات ، فجعلوا العالم قديما ؛ لامتناع تخلف المعلول عن علته ( والعلة مؤنثة ) هذا ما يتعلق بحب النساء من الحكمة .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( وأمّا حكمة الطّيب وجعله بعد النّساء فلما في النّساء من روائح التّكوين ، فإنّه أطيب الطّيب عناق الحبيب . كذا قالوا في المثل السائر ، ولمّا خلق عبد بالأصالة لم يرفع رأسه قطّ إلى السّيادة ، بل لم يزل ساجدا واقفا مع كونه منفعل حتّى كوّن اللّه عنه ما كوّن . فأعطاه رتبة الفاعليّة في عالم الأنفاس الّتي هي الأعراف الطّيّبة ، فحبّب إليه الطّيب : فلذلك جعله بعد النّساء ، فراعى الدّرجات الّتي للحقّ في قوله :رَفِيعُ الدَّرَجاتِ ذُو الْعَرْشِ[ غافر : 15 ] لاستوائه عليه باسمه الرّحمن ، فلا يبقى فيمن حوى عليه العرش من لا تصيبه الرّحمة الإلهيّة ؛ وهو قوله تعالى :وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ [الأعراف : 156 ] ، والعرش وسع كلّ شيء ، والمستوي الرّحمن فبحقيقته يكون سريان الرّحمة في العالم كما قد بيّناه في غير موضع من هذا الكتاب ومن الفتوح المكّي ).
(وأم حكمة الطيب وجعله بعد النساء فلما في النساء من روائح التكوين ) ، فإنهن ، وإن ظهرت فيهن الذات الإلهية ، فإنما ظهرت فيهن من حيث الانفعال المشار إليه في قوله :وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ[ الشورى : 25 ] ، وهو سابق في حق العبد على تخلقه بالأخلاق الإلهية التي هي الروائح الطيبة ، بل إنما تحصل بالانفعال ، وإنما كانت روائح طيبة إذ بها غاية التقرب من المحبوب بحيث يصير فاعلا بأسمائه كفعله ، فكأنه معانق له والمعانقة غاية الطيب ، ( فإنه من أطيب الطيب عناق الحبيب ) ، وهو وإن لم يكن كلام من يتمسك بقوله من الأنبياء والأولياء ؛ فهو مقبول في العامة فيصح التمسك به في باب الإشارات التي تكفي فيه الخطائيات إذ هم ( كذا قالوا في المثل السائر ) .
ثم استشعر سؤالا بأنه عليه السّلام كيف قدم جهة الانفعال فيما حبب إليه بعد النبوة التي لا تكون إلا بكمال التخلق ؟
فأجاب بقوله : ( ولما خلق صلّى اللّه عليه وسلّم عبدا ) ؛ لأن جهة العبودية فيه ( بالأصالة لم يرفع رأسه قط إلى السيادة ) التي يفعل بها بالأسماء الإلهية عند التحقيق بها بعد التخلق ، وإن بلغ من كمال التخلق ما بلغ ، بل من كمال التخلق م بلغ ، ( بل لم يزل ساجدا ) وهو أنه كان عند التخلق بالأسماء الإلهية ( واقفا مع كونه منفعلا ) عنها إلا فاعلا به (حتى كون اللّه عنه ما كون ) بأسمائه التي تخلق بها ، ( فأعطاه رتبة الفاعلية ) بتلك الأسماء ؛ ليتحقق بها بعد التخلق الذي هو انفعال عنها ، وذلك بأن جعله عند كمال التخلق بها ( في عالم الأنفاس ) الرحمانية ( التي هي الأعراف ) ، أي : الروائح ( الطيبة ) عن تلك الأسماء للنفخ في الموجودات .
وهي المشار إليها بقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : « ألا إن للّه في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا له » ، رواه الطبراني في الأوسط والكبير والسيوطي في الجامع الصغير والهيثمي في مجمع الزوائد
فانقسم هذا الطيب إلى طيب التخلق ، ( فحبب إليه الطيب ) عند كمال طيبه المعنوي الطالب لمناسبة الذي هو الطيب الحسي ، وكان الطيب الأول انفعاليّا وهذا فعليّا ؛ ( فلذلك جعله بعد النساء ) كأنه إذ ضل فيهن الطيب الانفعالي ، فكأنه لظهور الحق بأسمائه فيه ترتيب ،
( فراعى ) في ترتيب ما في هذا الخبر ( الدرجات التي للحق ) في ظهوره بالأسماء ، فإنه يظهر أولا بالانفعال وآخرا بالفعل ، وذلك عند استوائه على عرشه الذي هو قلب الكامل .
كم هو المشار إليه ( في قوله :رَفِيعُ الدَّرَجاتِ ذُو الْعَرْشِ) [ غافر : 15 ] ، فأعلى درجات ظهوره كونه ذا العرش ؛ ( لاستوائه عليه باسمه الرحمن ) الذي هو أعلى الأسماء الفاعلية اللاحقة باسم الذات ، في قوله تعالى :قُلِ ادْعُو اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ[ الإسراء: 110].
؛ ولذلك اختص به تعالى ، وذلك عموم رحمته ( فلا يبقي فيمن حوى العرش من لا تصيبه الرحمة الإلهية ).
( وهو ) أي : الدليل على ذلك ( قوله تعالى :وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ) [ الأعراف : 156].
، وكيف لا تسع رحمته كل شيء ( والعرش وسع كل شيء ) ؛ لإحاطته لكن العرش الحقيقي هو الحقيقة المحمدية ، ( والمستوي ) عليه أي : العرش المحمدي اسمه ( الرحمن ) ؛ لإحاطته بجميع المراتب حتى أنه وسع العرش الجسماني وما دونه ، فاستوى اسم الرحمن بالحقيقة عليه ويحسب الظاهر على العرش الجسماني ، ( فبحقيقته يكون سريان الرحمة في العالم ) الذي يدخل فيه العرش الجسماني وغيره ( كما قدمنا في غير موضع ) واحد ، بل في مواضع كثيرة (من هذا الكتاب ومن الفتوح المكي ) .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( وقد جعل الطّيب في هذا الالتحام النّكاحي في براءة عائشة فقال :الْخَبِيثاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثاتِ وَالطَّيِّباتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّباتِ أُولئِكَ مُبَرَّؤُنَ مِمَّا يَقُولُونَ[ النور : 26 ] ، فجعل روائحهم طيّبة وأقوالهم صادقة لأنّ القول نفس ، وهو عين الرّائحة فيخرج بالطّيّب والخبيث على حسب ما يظهر في صورة النّطق ، فمن حيث إنه إلهيّ بالأصالة كلّه طيّب ؛ فهو طيّب ؛ ومن حيث ما يحمد ويذمّ فهو طيّب وخبيث .
فقال في خبث الثّوم : هي شجرة أكره ريحها ، ولم يقل أكرهها ؛ فالعين لا تكره ، وإنّما يكره ما يظهر منها ، والكراهة لذلك إمّا عرفا أو بعدم ملائمة طبع أو غرض أو شرع ، أو نقص عن كمال مطلوب وما ثمّ غير ما ذكرناه ، ولمّ انقسم الأمر إلى خبيث وطيّب كما قرّرناه ، حبّب إليه الطّيّب دون الخبيث ووصف الملائكة بأنّها تتأذّى بالرّوائح الخبيثة لما في هذه النّشأة العنصريّة من التّعفين ؛ فإنّه مخلوق من صلصال من حمأ مسنون أي متغيّر الرّيح ، فتكرهه الملائكة بالذّات ، كما أنّ مزاج الجعل يتضرّر برائحة الورد وهي الرّوائح الطّيبة . فليس ريح الورد عند الجعل بريح طيبة . ومن كان على مثل هذا المزاج معنى وصورة أضرّ بالحقّ إذا سمعه وسرّ بالباطل : وهو قوله : وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْباطِلِ وَكَفَرُو بِاللَّهِ[ العنكبوت : 52 ] . )
ولذلك قال تعالى فيه :وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ [ الأنبياء : 107 ] في الاستواء العرشي أنه ( قد جعل الطيب تعالى في هذا الالتحام النكاحي ) فيما أنزل ( في براءة عائشة - رضي اللّه عنها ، فقال :الْخَبِيثاتُ) من الأزواج ( لِلْخَبِيثِينَ) من الرجال ،(وَالْخَبِيثُونَ ) من الرجال ( لِلْخَبِيثاتِ ) من الأزواج ،( وَالطَّيِّباتُ لِلطَّيِّبِينَ،وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّباتِ ) حصر كل قسم من النساء والرجال فيمن يناسبه في أمر النكاح الكامل الموجب للمودة والرحمة ، ثم قال :( أُولئِكَ )أي : الطيبون من الرجال والنساء( مُبَرَّؤُنَ )[ النور : 26 ] من خباثة أنفسهم يعرف ذلك
( مما يقولون ) ، أي : من أقوالهم المتزوجة بما في بواطنهم ، ( فجعل روائحهم ) الظاهرة في أقوالهم ( طيبة ) لطيب بواطنهم التي خرجت منها أنفاسهم الحامية لأسرارها وهي ( صادقة أقوالهم ؛ لأن القول نفس ) ، والنفس ريح ، والريح (هي عين الرائحة ) عند تجاوزها للمريح ، وبواطنهم مريحة ، ( فتخرج ) النفس من الباطن ( بالطيب ) من أثر المريح الباطن وهو الرائحة ، ( وبالخبيث على حسب ما ظهرت ) تلك النفس به عند المقاولة ( في صورة النطق ) ، ولكن إنما يشتم تلك الرائحة الكمّل الذين يَعْرِفُونَ كُلًّ بِسِيماهُمْ [ الأعراف : 46] ؛ فلذلك قال تعالى :" فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيماهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ " [ محمد : 30 ] .
وهذ النفس الإنساني مظهر النفس الرحماني المنزه عن الخباثة ، (فمن حيث ) هو ، أي : النفس الإنساني ( إلهي بالأصالة ) ، والنفس الإلهي (كله طيب ) ، فهو أي : النفس الإنساني باعتبار مظهريته له طيب ، ولكنه ( من حيث ما ) تأثر هذا النفس الإنساني من مخرجه بوصفه الذي ( يحمد ) تارة ( ويذم ) أخرى ، ( فهو ) بهذا الاعتبار ( طيب ) تارة ( وخبيث ) أخرى .
فالنفس الإنساني في هذا الأمر كسائر الموجودات ، فإنها من حيث أعيانها الثابتة في العلم الإلهي المنزه عن الخبائث كلها طيبة ، ومن حيث اتصافها بالعوارض عند ظهورها بصور الأشياء تنقسم إلى طيبة وخبيثة ، فاعتبر صلّى اللّه عليه وسلّم بعضها باعتبار تلك العوارض ؛
( فقال : « في خبث الثوم هي شجرة ) خبيثة " . ثم أشار إلى أن خبثها من عوارضها ، فقال : ( « أكره ريحها ») ، رواه مسلم وأحمد في المسند .
(ولم يقل أكرهها ) مع أنه وصفه بالخباثة ، والخبيث لا بدّ وأن يكره للإشارة إلى أن خباثتها ليست من ذاتها ، وإلا لكانت حين تثبت في العلم الأزلي خبيثة مع أنها منزه عن الخبائث ، ( فالعين ) من حيث ثبوتها في العلم الأزلي ( لا تكره ، وإنما يكره ما ظهر منها ) ، ومع تك ( الكراهة لذلك ) الظاهر ليس من حيث أنه تلك العين ، أو من حيث أنه الظاهر ، بل ( إما عرفا ) لكونه خلاف ما أطبق عليه الجمهور ( أو بعدم ملائمة طبع ، أو بعدم غرض ، أو ) بعدم موافقة ( شرع ، أو ) بوجود ( نقص عن كمال مطلوب ) ، وهذه كلها عوارض ذلك الظاهر ( وما ثمة ) ، أي : في المكروهات سبب الكراهة ( غير ما ذكرن ) ، فالأشياء وإن كانت طيبة بالأصالة ونظر الكامل إلى الأصل ؛
ولكن ( لما انقسم الأمر ) ، أي : أمر الموجودات بحسب هذه العبارات ( إلى خبيث وطيب كما قررناه ، حبب إليه الطيب ) ؛ لبقائه على صفة الأصل المحبوب ، فهو في (الخبيث ) المتغير عن الأصل ؛ لأنه بالتغير صار إلى ضد المحبوب ، وإنما لم يحب الخبيث ؛ لبقائه على أصل الفطرة ، والدليل عليه أنه ( وصف الملائكة ) الذين لا يتغيرون عن الفطرة ( بأنها تتأذي من الروائح الخبيثة ) ، وإن لم يكرهه بعض الإنسان بنشأتها لهذه التغييرات ( لما في هذه النشأة العنصرية من التعفين ؛ فإنه مخلوق منصَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ[ الحجر : 26 ] ،
أي : متغير الريح ) ، فهو يحبها بهذا العوارض ، لكن لا عارض في الملائكة (فتكرهه الملائكة بالذات ) ، فالشيء الواحد يختلف حاله طيب وخباثة بالنظر إلى المنتفعين به والمتضررين ،
( كما أن مزاج الجعل يتضرر برائحة الورد وهي )في العرف من ( الروائح الطيبة ) ، لكن لا يتضرر بالطيب أحد يكون عنده طيبا ، ( فليس ريح الورد عند الجعل بريح طيبة ) لغاية بعده عن الأصل بكثرة التغيرات ؛ ولذلك ( من كان على هذا المزاج ) الجعلي ( معنى ) بذهاب إنسانيته ( وصورة ) بدناءة عقله وغمته وتلطخه بالقاذورات آخرية ( الحق ، إذا سمعه وسر بالباطل ) لبعده عن الأصل وألفه للتغيرات الباطلة ، ( وهو )الذي أشار إليه ( قوله :وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْباطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ .)
قال الشيخ رضي الله عنه : ( ووصفهم بالخسران ؛ فقال :أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ [ العنكبوت : 52 ]الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ [ الأنعام : 12 ] ؛ فإنّه من لم يدرك الطّيّب من الخبيث فلا إدراك له ، فما حبّب إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم إلّا الطّيّب من كلّ شيء وما ثمّة إلّا هو ، وهل يتصوّر أن يكون في العالم مزاج لا يجد إلّا الطيّب من كلّ شيء ولا يعرف الخبيث أم لا ؟
قلنا : هذا لا يكون ؛ فإنّا ما وجدناه في الأصل الّذي ظهر العالم منه وهو الحقّ ، فوجدناه يكره ويحبّ ؛ وليس الخبيث إلّا ما يكره ولا الطّيب إلّ ما يحبّ ، والعالم على صورة الحقّ والإنسان على الصّورتين فلا يكون ثمّة مزاج ل يدرك إلّا الأمر الواحد من كلّ شيء ، بل ثمّة مزاج يدرك الطّيّب من الخبيث ، مع علمه بأنّه خبيث بالذّوق طيّب بغير الذّوق ، فيشغله إدراك الطّيّب منه عن الإحساس بخبثه ، هذا قد يكون .
وأمّا رفع الخبيث من العالم أي من الكون فإنّه لا يصحّ ، ورحمة اللّه في الخبيث والطّيب . والخبيث عند نفسه طيّب والطيّب عنده خبيث . فما ثمّة شيء طيّب إلّا وهو من وجه في حقّ مزاج ما خبيث : وكذلك بالعكس ) .
وأشار إلى سبب ذلك بما ( وصفهم بالخسران ) للأصل ، ( فقال :أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ) [ العنكبوت : 52 ] بطريق الحصر ، ثم بيّن أنه خسران الأصل الذي به إنسانيتهم ، فقال :( الَّذِينَ خَسِرُو أَنْفُسَهُمْ[ الأنعام : 12 ] ؛ لخسران إنسانيتهم بفوات الإدراك ، ( فإنه لم يدرك الطيب من الخبيث فلا إدراك له ) ، والحب فرع الإدراك ، وهو بقدر الإنسانية ، وهي بقدر البقاء على الفطرة ، ( فما حبب إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم إلا الطيب من كل شيء ) ؛ لكمال بقائه على الفطرة التي هي أنسب للأصل ، فيحب بهذه المناسبة ما بقي على الأصل ،
وإن كان ( ما ثمة ) أي : في الأصل ( إلا هو ) ، أي : الطيب باعتبار مظهرية الحق ، ونظر الكامل إنما يكون إلى الأصل ، لكنه مع ذلك إنما يحب ما لم يتغير عنه ، وينظر إلى التغيرات بمزاجه الذي يناسبه ، والكامل من المزاج ، وإن كان يدرك الأصل باعتبار رجوعه إلى الوحدة عند إنكار طبائع أجزائه ، لكن ( هل يتصور أن يكون في العالم مزاج لا ) يدرك ( إلا الطيب من كل شيء ) بحيث ( لا يعرف الخبيث أم لا ، قلنا : هذا ) وإن أمكن عقلا ( لا يكون ) موجود ، فإن غاية أمر المزاج في ترك الطبائع المختلفة ، والأخذ في الوحدة أن يتشبه بالأصل الذي وجد منه ، لكن ليس هذا في ذلك .
( فإن ما وجدناه في الأصل الذي ظهر منه العالم ) الذي من جملته المزاج ، ولما توهم من الأصل هاهنا الهيولى أو العناصر ، قال :وَهُوَ الْحَقُّ[ محمد : 2 ] ، بل وجدنا فيه ما يدل على إدراكه الخبيث والطيب ، (فوجدناه يكره ) شيئا ( ويحب ) شيئا آخر ، ( وليس الخبيث إلا ما يكره ، ول الطيب إلا ما يحب ، والعالم على صورة الحق ) ، فوجب في حقه التمييز بينهم كالأصل ( والإنسان على الصورتين ، فلا يكون ) فيه ما ليس منهما ، والمزاج من جملة ما في الإنسان ، فلا يكون ( ثمة ) أي : في الإنسان ( مزاج ل يدرك إلا الأمر الواحد ) وهو الطيب ( من كل شيء ) بحيث لا يعرف الخبيث أصلا ، (بل ) غاية ما في الباب أن يكون ( ثمة ) أي : في الإنسان ( مزاج يدرك ) الوصف ( الطيب من ) الشيء (الخبيث ) باعتبار بلوغ ذلك المزاج غاية الوحدة ، لكن ذلك إنما كان له من التعفن في طبائع العناصر التي حصل هذا المزاج من تركبها ، فيكون إدراكه للطيب والخبيث
( مع علمه بأنه خبيث ) ، كيف وقد أدرك خبثه ( بالذوق ) ، وم علم من أنه ( طيب ) فهو إنما علم ( بغير الذوق ) ، وهو النظر إلى الأصل والمعلوم بالذوق يغلب المعلوم بغير الذوق في أكثر الأحوال ، لكن قد يغلب في بعض الأشخاص النظر إلى الأصل ؛ ( فيشغله إدراك ) الوصف ( الطيب منه ) أي :
من الخبيث ( عن الإحساس بالخبيث ، هذا قد يكون ) على سبيل الندرة ، ويقرب منه ما روي : « أن عيسى عليه السّلام مرّ مع أصحابه بجيفة ، فقالوا : ما أنتن ريحها ! فقال : ما أحسن بياض أسنانها » ، رواه أبو نعيم في حلية الأولياء
ولكن يكون الخبيث محبوبا له لوجوده في العالم .
كم أشار إليه بقوله : ( وأما رفع الخبيث من العالم ) ، ولما توهم أن المراد غير الإنسان أزاله بقوله ، ( أي : من الكون ، فإنه لا يصح ) ، بل يجب إيجاده لطيبه بالنظر إلى نفسه ، وبالنظر إلى بعض الموجودات ؛ ولذلك يقول ( رحمة اللّه ) : الإيجادية ( في الخبيث والطيب ) لا كما تقول النبوية من أنه لا ينسب إليه الشر ، كيف ( والخبيث ) إنما يكون ممتنع الإيجاد ولو كان خبيثا في نفسه ، ولكن الخبيث ( عند نفسه طيب ) ، إذ لا يتضرر شيء بنفسه ، ولا يتأذى منه ولا يكرهه أصلا ، ولو امتنع إيجاده لخبثه عند الغير ، لامتنع إيجاد الطيب إذ ( الطيب عنده خبيث ) ، ولو اعتبر انتفاع الغير وتضرره في إيجاد الشيء وإعدامه ، لوجب إيجاد كل شيء وإعدامه معا ، (فم ثمة ) أي : في العالم ( شيء طيب إلا وهو من وجه في حق مزاج ما خبيث ) ، كالورد في الجعل ، والحق للكافر ، ( وكذلك بالعكس ) ؛ فافهم ، فإنه مزلة للقدم .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( وأمّا الثالث الّذي به كملت الفرديّة فالصّلاة ، فقال : « وجعلت قرّة عيني في الصّلاة » ؛ لأنّها مشاهدة ، وذلك لأنّها مناجاة بين اللّه وبين عبده كم قال :فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ،وهي عبادة مقسومة بين اللّه وبين عبده بنصفين : فنصفها للّه ونصفها للعبد كما ورد في الخبر الصّحيح عن اللّه تعالى أنّه قال : « قسمت الصّلاة بيني وبين عبدي نصفين : فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل ، يقول العبد :بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِيقول اللّه : ذكرني عبدي ، يقول العبد :الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ يقول اللّه : حمدني عبدي ، يقول العبد :الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ يقول اللّه : أثنى عليّ عبدي ، يقول العبد :مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ يقول اللّه : مجّدني عبدي ، فوّض إليّ عبدي . فهذا النّصف كلّه للّه تعالى خالص ، ثمّ يقول العبد :إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ يقول اللّه : هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل ، فأوقع الاشتراك في هذه الآية ، يقول العبد :اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَ الضَّالِّينَ[ الفاتحة : 71 ] يقول اللّه :"فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل". رواه أحمد في المسند ، وابن حبان.
فخلص هؤلاء لعبده كما خلص الأوّل له تعالى ، فعلم من هذا وجوب قراءة " الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ فمن لم يقرأها فما صلّى الصّلاة المقسومة بين اللّه وبين عبده ).
( وأما الثالث الذي كملت به الفردية ) ، أي : به تمام الإلهية ، فإنه بالأسماء لغنى الذات عن العالمين ، والصفات بالنظر إلى الذات عينها ، وإنما تتميز بالأسماء الجامعة بينهما ، ( فالصلاة ) الموجبة محبة الأسماء عن مشاهدة الحق بصوره .
)قال صلّى اللّه عليه وسلّم : « وجعلت قرة عيني في الصلاة ( ، وإنما كانت قرة عينه ؛ ( لأنها مشاهدة ) ، أي : مستلزمة لمشاهدة الحبيب الإلهي ، ( وذلك ) أي : استلزامها للمشاهدة ؛ ( لأنها مناجاة بين اللّه وبين عبده ) ، وهي ذكر وهو مستلزم للمجالسة بالحديث ، وهي مستلزمة للمشاهدة على ما يأتي بيانه ، وإنما كانت ذكرا لقوله تعالى :"وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي" [ طه : 14 ] ، وإنما كان الذكر مستلزما للمجالسة ؛ لاستلزامه ذكر العبد ذكر الحق ( كما قال :فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ) [ البقرة : 152 ] ، فلزم التشارك في الذكر ، وهو يستلزم التشارك في الصلاة ، ولذلك ( عبادة مقسومة بين اللّه وبين عبده ) ، ومن شأن الشريكين في أمر اجتماعهما عنده ، وليس هذا المحل المنقسم مما لا يلتفت إليه أحد الشريكين لقلة نصيبه ، بل هو منقسم ( بنصفين ) ، وهذا النصف وإن كان في القراءة وحدها ، فهي لما كانت أعظم مقاصدها وكانت كلها منقسمة .
( فنصفها للّه ونصفها للعبد كما ورد في الخبر الصحيح ، فعن اللّه تعالى أنه قال :
"قسمت الصلاة " ) أي : بتقسيم القراءة المتضمنة المعاني جميعه ( « بيني وبين عبدي
نصفين ) رواه مسلم وابن حبان.
، ولم أترك هذا القسم منها وإن كنت أترك شرك في عمل أشرك فيه معي غيري ، ( " فنصفها لي ونصفها لعبدي" ) ، ول أتغلب على العبد بأخذ نصفه كما هو شأن الجبابرة ، بل ( لعبدي ما سأل ) والسؤال بي ( يقول العبد:"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ" ،يقول اللّه : ذكرني عبدي ) بأخص أسماء ذاتي وصفاتي ، فكأنما جمع وجوه ذكري ، ( يقول العبد:"الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ"،يقول اللّه : حمدني عبدي ) بجميع محامد العالمين يجعل الحمد عليهم حمدا عليّ ؛ لأنهم إنما استحقو الحمد بتربيتي إياهم ، فهو حمدي مع الحمد الذي في ذاتي ،
فكأنم جمع وجوه محامدي ، ( يقول العبد:"الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ"،يقول اللّه : أثني عليّ عبدي ) بعموم الجود وخصوصه ، ( يقول العبد :"مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ"، يقول اللّه : مجدني عبدي ، فوضإليّ عبدي ) ، فلم يوجب عليه شيئا ، إذ جعلني مالكا فلا يملك على أحد شيئا فيوجبه ، بل الجود بمحض التفضيل منّي ؛ (فهذا النصف ) من القدر المتميز ( كله للّه خالص ) ، وإن كان ذكر فيه العالمون ؛ لأن المقصود ذكر يختص بالربوبية .
( ثم ) بعد الفراغ من خالص ما يتعلق بالربوبية الواجب تقديمه على المشترك والمختص للعبد ، ( يقول العبد :"إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ"،يقول اللّه : هذا بيني وبين عبدي ) من غير تميز ما يختص باللّه ، وما يختص بالعبد في اللفظ ، ( فأوقع الاشتراك في هذه الآية ) وإن كان المقصود منها بذلك العبد واستعانته ، فقد كان المقصود تخصيص الحق بالمعبودية والإعانة ، بدليل تقديمإِيَّاكَ، ( يقول العبد :اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ ( 6 ) صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ( 7 )، يقول اللّه : فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل » ) من هداية طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين درجتهم من طريقة أهل الغضب من الكفار والفساق ، ومن طريقة أهل الضلال عن موجبات القرب ،
( فخلص هؤلاء لعبده ) وإن ذكر فيه الرب ، ( كما خلص الأول له تعالى ) وإن ذكر فيه العالمون ، إذ لا عبرة بغير المقصود ( فعلم من هذا ) الخبر الجاعل قراءة الفاتحة كل الصلاة في القسمة
( وجوب قراءة :الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) لعله أشار إلى عدم وجوب البسملة كما هو مذهب مالك والشيخ منهم ، وإنما أوردرَبِّ الْعالَمِينَ ؛لئلا يتوهم قيام سورة الأنعام وغيرها مما ابتدأت بالحمد فيه مقامه ، كيف والمقصود من وضع الصلاة هذه القسمة ، ( فمن لم يقرأها ) في (الصلاة المقسومة بين اللّه وبين عبده ) ، فكأنما ضيع حق اللّه وحق نفسه ، فما حصلت له صلاة كاملة ولا ناقصة .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( ولمّا كانت مناجاة فهي ذكر ، ومن ذكر الحقّ فقد جالس الحقّ وجالسه الحقّ ؛ فإنّه صحّ في الخبر الإلهيّ أنّه تعالى قال : « أنا جليس من ذكرني » ) رواه ابن أبي شيبة في المصنف.
(ومن جالس من ذكره وهو ذو بصر حديد رأى جليسه ، فهذه مشاهدة ورؤية ؛ فإن لم يكن ذا بصر لم يره ، فمن هاهنا يعلم المصلّي رتبته هل يرى الحقّ هذه الرؤية في هذه الصّلاة، أم لا؟
فإن لم يره فليعبده بالإيمان كأنّه يراه فيخيّله في قبلته عند مناجاته ، ويلقي السّمع لما يرد به عليه من الحقّ ).
ثم رجع إلى بيان ما أجمل من مقدمات كونها مشاهدة ، فقال : (ولم كانت ) الصلاة ( مناجاة ) ، لما روي أنس عنه صلّى اللّه عليه وسلّم أنه قال : « إن أحدكم إذ قام إلى الصلاة ، فإنما يناجي ربه ، وإن ربه بينه وبين القبلة ، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ، ولكن عن يساره أو تحت قدمه ، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ، ثم رد بعضه على بعض ، فقال : أو يفعل هكذا » رواه البخاري ومسلم
( فهي ذكر ) إذ المناجاة مكالمة ، وقد قال تعالى :"وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي" [ طه : 14].
(ومن ذكر الحق فقد جالس الحق وجالسه الحق ، فإنه صح في الخبر الإلهي أنه قال : « أن جليس من ذكرني » ) ، والمراد ما يلازم المجالسة من الرؤية ، وذلك أن ( من جالس من ذكره وهو ذو بصر حديد رأى جليسه ) ، ولكن لا يمكن رؤية الحق بالبصر الظاهر في الدنيا ، ( فهذه ) الرؤية لذاكره ( مشاهدة ) قلبية ، ( ورؤية ) روحية إن كان لقلبه وروحه بصر ، ( فإن لم يكن ) الذاكر ( ذا بصر ) قلبي ولا روحي ( لم يره ) ، كما لا يبصر أعمي العين الظاهرة جليسه ، والمصلي ذاكر ، ( فمن هنا ) أي : من رؤية الذاكر البصير ، وعدم رؤية الذاكر الأعمى ( يعلم المصلي رتبته هل ) هي رتبة الذاكر البصير ، فهو ( يرى الحق هذه الرؤية ) القلبية أو الروحية ( في هذه الصلاة ) التي هي جامعة وجوه الذكر ، أو هي رتبة الذاكر الأعمال ، فهو لا يرى الحق هذه الرؤية .
(فإن لم يره هذه الرؤية فليعبده بالإيمان ) الموجب اعتقاد قربه كما يعتقد الجليس الأعمى قرب جليسه ، فتبلغ بذلك رتبة الإحسان ، فيصير ( كأنه يراه فتخيله في قبلته عند مناجاته ) كما ورد به الحديث المذكور آنفا ، ( ويلقي السمع ) في حالتي الرؤية والإحسان ( لما يرد عليه من الحق ) في معاني كلامه ، وفيما يأتي به من سائر الأفعال إذ يصير كأنه يسمع من اللّه تعالى على ما نقله الشيخ شهاب الدين السهروردي في الباب الثاني من « العوارف » عن الإمام جعفر الصادق : "أنه خرّ مغشيا عليه ، وهو في الصلاة ، فسئل عن ذلك ، فقال : ما زلت أردد الآية حتى سمعتها من المتكلم به " .
قال الشيخ رضي الله عنه : (فإن كان إماما لعالمه الخاصّ به وللملائكة المصلّين معه فإنّ كلّ مصلّ فهو إمام بلا شكّ ، فإنّ الملائكة تصلّي خلف العبد ؛ إذا صلّى وحده كما ورد في الخبر فقد حصل له رتبة الرّسول في الصّلاة ، وهي النّيابة عن اللّه ، وإذا قال : سمع اللّه لمن حمده ، فيخبر نفسه ومن خلفه بأنّ اللّه قد سمعه ، فتقول الملائكة والحاضرون : ربّنا ولك الحمد ؛ فإنّ اللّه قال على لسان عبده : سمع اللّه لمن حمده ، فانظر علوّ رتبة الصّلاة وإلى أين تنتهي بصاحبها ) رواه البخاري ومسلم .
(فمن لم يحصّل درجة الرّؤية في الصّلاة فما بلغ غايتها ولا كان له قرّة عين ، لأنّه لم ير من يناجيه ، فإن لم يسمع ما يرد من الحقّ عليه فيها فما هو ممّن ألقى السّمع ، ولا سمعه ، ومن لم يحضر فيها مع ربّه مع كونه لم يسمع ولم ير ، فليس بمصلّ أصلا ، ولا هوأَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ[ ق : 37 ] ) .
( فيخير نفسه ومن خلفه ) من الناس والملائكة ، ( فإن اللّه قد سمعه ) فيصدقه المخبر لهم ما سمعوا على لسانه من قول اللّه ، ( فيقول ) المخبر لهم وهم ( الملائكة ) ، وإنم تسرون ربنا لك الحمد كما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « إذا قال الإمام : سمع اللّه لمن حمده ، فقولوا : اللهم ( ربنا لك الحمد ) ، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » .
وإل فلا معنى لهذه الأخبار منه ، وهذا القول منهم عقيب قوله ، فتعين أن اللّه نزله منزلة الرسول الذي ينطق على لسانه ، كما أشار إليه بقوله : ( فإن اللّه قال على لسان عبده : سمع اللّه لمن حمده ) .
كما ورد في قصة شعيب عليه السّلام : أنه نطق اللّه تعالى على لسانه كما نقله محيى السنة في تفسير قوله تعالى :"وَقَضَيْن إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ" [ الإسراء : 4 ] من معالم التنزيل ، وإذا كان للمصلي رتبة رؤية الحق وسماع كلامه وإمامة الملائكة ، وقد يبلغ في ذلك رتبة الرسل ، ( فانظر علو رتبة الصلاة ، وإلى أين تنتهي بصاحبها ) من مراتب الرسل الذين ينطق على لسانهم الحق ، وذلك بمشاهدة الحق فيها ، وسماع كلامه منه فيها ، ( فمن لم تحصل له درجة الرؤية في الصلاة فم بلغ غايتها ) ، أي : المقصود منها ، ( ولا كان له ) فيها ( قرة عينه ) اللازمة لغايتها ؛ ( لأنه لم ير من يناجيه ) وهي غاية الصلاة .
( فإن لم يسمع ما يرد من الحق عليه فيها ) من جواب قراءته ، وبيان معانيها الخفية ، وأشار أنها اللطيفة وسائر ما يتعلق بالأذكار والأفعال ، (فم هو ممن ألقى السمع ) ، كما أنه ليس بصاحب الطيب الرائي ، ( ومن لم يحضر فيها مع ربه ) الذي يذكره كما هو شأن من يعبده بالإيمان ( مع كونه لم يسمع ولم ير ) ، أشار بذلك إلى أنه لا يطلب حضور الفاني في الحق والباقي به الرائي إياه ببصره ، والسامع منه بسمعه ، ( فليس بمصلّ أصلا ) عند اللّه ، وعند أصله في حكم الآخرة وإن كانت صلواته تمنع قتله ، وأفتى بصحته فقهاء الدنيا ،
(ول ) يقال : ( هو ممن ألقى السمع ) ، لكنه لم يسمع لعدم حضوره ؛ لأنا نقول لا يتصور إلقاء السمع من أحد إلا ( وهو شهيد ) ، وكيف لا يشرط الحضور في صحته .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( وما ثمّة عبادة تمنع من التّصرّف في غيرها ما دامت سوى الصّلاة ، وذكر اللّه فيها أكبر ما فيها لما تشتمل عليه من أقوال وأفعال ، وقد ذكرنا صفة الرّجل الكامل في الصّلاة في « الفتوحات المكيّة » كيف تكون لأنّ اللّه تعالى يقول :إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ[ العنكبوت : 45 ] ، لأنّه شرع للمصلّي أن لا يتصرّف في غير هذه العبادة ما دام فيها ويقال له : مصلّ ،وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ[ العنكبوت : 45 ] ، يعني فيها : أي الذّكر الّذي يكون من اللّه لعبده حين يجيبه في سؤاله . والثّناء عليه أكبر من ذكر العبد ربّه فيها ، لأنّ الكبرياء للّه تعالى ، ولذلك قال :وَاللَّهُ يَعْلَمُ ما تَصْنَعُونَ[ العنكبوت : 45 ] ، وقال :أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ[ ق : 37 ]فإلقاؤه السّمع هو لم يكون من ذكر اللّه إيّاه فيه ) .
( وما ثمة عبادة تمنع من التصرف في غيرها ما دامت ) باقية ( سوى الصلاة ) ، كما أن التصرف فيها شاغل عن الحضور فيها ، كيف والإخلال بالحضور إخلال مقصود الذكر ، ( وذكر اللّه فيها أكبر ما فيها لم يشتمل عليه من أقوال وأفعال ) لا تقصد بعينها لذكر اللّه فيها ، فإذا أخل بمقصود الذكر ، فقد أخل بأكبر ما فيها وللتكبر حكم الكل ، ( وقد ذكرنا صفة الرجل الكامل في الصلاة في « الفتوح المكية » كيف تكون ) في أقواله وأفعاله فيها مستحضرا لمعانيها ، منتظرا لما يرد عليه من الحق فيها ، والغفلة عنها من الفواحش المنافية للصلاة ؛ ( لأن اللّه تعالى يقول :إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ) [ العنكبوت : 45 ] ، وينعكس بعكس النقيض إلى أن كل ما لا ينهى عن الفحشاء والمنكر فليس بصلاة ، وإنما كانت الغفلة عنها من الفواحش ؛ ( لأنه شرع للمصلي ألا يتصرف في غير هذه العبادة ما دام فيها ) ؛ لأن التصرف في غيرها موجب للغفلة عنها ، وخلاف المشروع فاحشة ، وهذا التصرف وإن لم يكن فاحشة في سائر الأوقات في حق المصلي وغيره ، ولكنه فاحشة في حق المصلي ما دام ( يقال له : مصلّ ) ، وكيف لا يكون فاحشة في حقه ، وهو إعراض عن سماع ذكر اللّه إياه وقت قيامه بين يديه ؟ ! كما أشار إليه بقول :(" وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ") [ العنكبوت : 45 ] .
ولم توهم من إطلاقه أن اللّه تعالى ذاكر له في كل حين ، فيكون كل تصرف شغل عنه فاحشة ، لكن ليس كذلك بالاجتماع ، قال : ( يعني فيها ) ، بدليل أن ذكره تعالى مرتب على ذكر العبد في قوله :"فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ" [ البقرة : 152 ] ،
ولم توهم جواز كونه من إضافة المصدر إلى المفعول والاسم المقصود ، قال ( أي : الذكر الذي يكون مع اللّه لعبده ) ، وأشار إلى وجه تخصيصه بحال الصلاة بقوله : ( حين يجيبه في سؤاله ، والثناء عليه ) على ما يدل عليه حديث قسمة الصلاة ( أكبر من ذكر العبد ربه فيها ) ، فهو وإن كان ذاكرا معرض عما هو أكبر ، فكأنه معرض مطلقا ، واستدل على أن المراد إضافة المصدر إلى الفاعل بقوله : ( لأن الكبرياء للّه ) ، ولو كان ذكر اللّه أكبر ، لكان له الكبرياء وهو باطل ؛ (ولذلك ) أي : ولكبر هذا الذكر ذكر الحق المعرض بالوعيد الشديد ، والمقبل بالمدح ، إذ هم ( قال ) تعالى في حق المعرض :( "وَاللَّهُ يَعْلَمُ م تَصْنَعُونَ") [ العنكبوت : 45 ] .
( وقال ) في حق المقبل :( أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ[ ق : 37 ] ) ، فألحقه بصاحب القلب ، والآية وإن لم تنزل في حق المصلي خاصة ، فهو داخل فيها ، ( فإلقاؤه السمع هو لما يكون من ذكر اللّه إياه فيها ) وهو ثابت بالنص ، فلا يكون من جملة تخيلاته ؛ فافهم ، فإنه مزلة للقدم .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( ومن ذلك أنّ الوجود لمّا كان عن حركة معقولة نقلت العالم من العدم إلى الوجود عمّت الصّلاة جميع الحركات وهي ثلاث : حركة مستقيمة وهي حال قيام المصلّي ، وحركة أفقيّة وهي حال ركوع المصلّي ، وحركة منكوسة ؛ وهي حال سجوده فحركة الإنسان مستقيمة وحركة الحيوان أفقيّة وحركة النّبات منكوسة ؛ وليس للجماد حركة من ذاته : فإذا تحرّك حجر فإنّما يتحرّك بغيره).
( ومن ذلك ) أي : ومن علو رتبة الصلاة أنها اشتملت على أنواع الحركات الاختيارية ، والمشبهة بها مما تطلب بها الكمالات ، وتحترز عن النقائص ، وهي التي أخرجت العالم عن غاية النقص إلى غاية الكمال ، وذلك ( أن الوجود ) أي : وجود العالم ( لما كان عن حركة معقولة ) للعالم ( نقلب العالم ) والقدم الذي هو غاية النقص ، ( إلى الوجود ) الذي هو غاية الكمال ، ( عمت الصلاة ) التي تطلب بها الكمالات ، وتهرب بها عن النقائص ( جميع الحركات ) الاختيارية وما أشبهها في السير إلى الجهات المختلفة ، ( وهي ثلاثة : حركة مستقيمة ) يصير بها المتحرك كالخط المستقيم ، ( وهي حال قيام المصلي ، وحركة أفقية ) يتوجه بها المتحرك إلى الأفق الذي هو الدوائر المتوهمة بين النصف الظاهر من الفلك والنصف الباطن منه ، ( وهي حال ركوع المصلي ، وحركة منكوسة ) بجعل أعلى المتحرك أسفله وأسفله أعلاه ، ( وهي حالة سجوده ) ، فجمعت الصلاة هذه الحركات المتفرقة على المواليد التي هي منتهى كمالات العالم مما يتحرك بالاختبار أو بما يشبهه .
(فحركة الإنسان ) من القعود والوقوف إلى القيام ( مستقيمة ) بجعله كالخط المستقيم ، ( وحركة الحيوان أفقية ) إذ وجهه إلى الأفق فيها ، ( وحركة النبات ) في نشر عروقها التي بها قوامها ( منكوسة ) ولا عبر بسائر حركاته كسائر حركات الإنسان والحيوان ، وهذه الحركة النباتية نسبة الاختيارية في أخذ الجهات المختلفة ، ( وليس للجماد ) وإن كان من المواليد حركة ( من ذاته ) باختيار أو بما يشبهه ، وإلا لتحرك مع كونه في مركزه كالإنسان والحيوان والنبات ، ( فإذا تحرك ) حجر في مركزه بالزحزحة مثلا ، فإنما يتحرك ( بغيره ) فليس بها طالب للكمال لنفسه حتى يعتد بحركته ، فإذا جمعت الصلاة هذه الحركات الكمالية لما هي منتهى كمالات العالم مما يتحرك لطلب الكمال والهرب من النقائص ، كانت الصلاة كذلك بمجرد صور هذه الحركات ، فأين ما يقصد من معانيها ومعاني ما يتلى فيه .
قال الشيخ رضي الله عنه : (وأمّا قوله : « وجعلت قرّة عيني في الصّلاة » ، ولم ينسب الجعل إلى نفسه فإنّ تجلّي الحقّ للمصلّي إنّما هو راجع إليه تعالى لا إلى المصلّي ، فإنّه لو لم يذكر هذه الصّفة عن نفسه لأمره بالصّلاة على غير تجلّ منه له ، فلمّا كان منه ذلك بطريق الامتنان ، كانت المشاهدة بطريق الامتنان ؛ فقال : « وجعلت قرّة عيني في الصّلاة » ، وليست قرّة عينه إلّا مشاهدة المحبوب الّتي تقرّ بها عين المحبّ ، من الاستقرار فتستقرّ العين عند رؤيته فلا تنظر معه إلى شيء غيره في شيء وفي غير شيء ) .
ثم أشار إلى أن أعظم ما فيها قرة العين ، وهي من المواهب دون المكاسب ، فقال :
وأما قوله : « وجعلت قرة عيني في الصلاة » ، فنسب الجعل إلى اللّه تعالى ؛ ليشير إلى أن هذه القرة من جملة المواهب ، وإن كانت مسنده إلى عين العبد ، ولكن ( لم ينسب الجعل إلى نفسه ) التي لها التصرف في عينه ، إذ لا مدخل للكسب فيها ، وهي وإن كانت من الصلاة فهي متوقفة على التجلي ول فعل للمصلي فيه ، ( فإن تجلي الحق للمصلي ، إنما هو راجع إلى اللّه لا إلى المصلي ) وإن فرض جريان السنة بحصوله عند الصلاة ، والمشاهدة من لوازمه ، والقرة من لوازم المشاهدة ، وإذا لم يكن للعبد قدرة على الملزوم ، لم يكن له قدرة على اللازم ، علمنا أن له قدرة على القرة والمشاهدة من حيث أنهما من فعله ، لكنهم إذا كانا مقدورين كانا مورين ؛ لأنهما من جملة الكمالات سيما في الصلاة ، بل كان المقصود من الصلاة ولا يمكن الأمر بهما عند التجلي لحصولهما عنده ولا يؤمر بتحصيل الحاصل ، فلا يمكن الأمر بالصلاة عند التجلي ،
وإليه الإشارة بقوله :( فإنه ) أي : الحق ( لو لم يذكر هذه الصفة ) ، أي : إفادة القرة والمشاهدة ( عن نفسه ) ، بل جعلها من كسب نبيه عليه السّلام ( لأمره بالصلاة ) إذا كان ( على غير تجلّ منه ) ، لكنه مأمور بالصلاة عند التجلي وعدمه بالاتفاق ، فإنه لا يسقطها سوى زوال العقل مع أنهما يتوقفان على التجلي ، فيكون الأمر بهما أمرا بالتجلي الذي لا يقدر على تحصيله ، فلا يؤمر به حين عدم التجلي ؛ لعدم القدرة عليه ولا حين التجلي ؛ لأنه أمر بتحصيل الحاصل ، فعلم أن القرة والمشاهدة غير مقدورة للعبد ، فلا يؤمر بهما ، بل يمن بهما على العبد كالتجلي ،
وإليه الإشارة بقوله :( فلما كان منه ) ، أي : من الحق ( ذلك ) التجلي ( بطريق الامتنان ) ، إذ لا فعل للعبد فيه أصلا ( كانت المشاهدة ) من حيث لزومها له ( بطريق الامتنان ) ، وإن كانت من فعل العبد ، وكذا لازمها التي هي القرة .
( فقال : « وجعلت قرة عيني في الصلاة » ) ، وإذا كانت من المشاهدة في الصلاة ، فليس موجبها ( إلا مشاهدة المحبوب التي تقر بها عين المحب ) .
""أضاف المحقق :
القرة إما من المقر يعني البرد فتكون قرة عينه كناية عن المسرة ؛ فإن عين المسرور تبرد لقرار باطنه وعين المهموم تسخن لاضطراب باطنه ، وإما من القرار فيكون المراد بقرة العين ما تستقر عليه العين . عبد الرحمن الجامي ""
فإن القرة ( من الاستقرار ) ، واستقرار عين المحب برؤية المحبوب لانتهاء طلبها لمرئي آخر عند رؤيته ، ( فتستقر العين عند رؤيته ) عن طلب مرئي آخر ، بل يخاف أن يشارك رؤيته رؤية المحبوب ، ففوته التلذذ بالمحبوب بقدر ما انصرف عن رؤيته إلى الغير ، ( فلا ينظر معه إلى شيء غيره ) سواء رأى المحبوب ( في شيء وفي غير شيء ) ، وهي الرؤية في غير المظاهر كما في الآخرة ، فلا تشغله رؤية الشيء عند رؤية المحبوب فيه ، إذ لا يراه أصل .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( ولذلك نهي عن الالتفات في الصّلاة ، فإن الالتفات شيء يحتلسه الشّيطان من صلاة العبد فيحرمه مشاهدة محبوبه ، بل لو كان محبوب هذا الملتفت ، ما التفت في صلاته إلى غير قبلته بوجهه ، والإنسان يعلم حاله في نفسه هل هو بهذه المثابة في هذه العبادة الخاصّة أم لا ، فإنّ "الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ . وَلَوْ أَلْقى مَعاذِيرَهُ" [ القيامة:14-15 ].
فهو يعرف كذبه من صدقه في نفسه ، لأنّ الشّيء لا يجهل حاله ؛ فإنّ حاله له ذوقيّ ) .
( ولذلك ) أي : ولكون عين المحب لا ينظر عند رؤية المحبوب إلى شيء آخر ( نهى عن الالتفات ) الموجب لرؤية الغير ( في الصلاة ) التي فيها مشاهدة المحبوب ، كيف وهو مانع عن مشاهدة المحبوب ،
( فإن الالتفات شيء يختلسه ) ، أي : يختلس بسببه (الشيطان ) المشاهدة ( من صلاة العبد ، فيحرمه مشاهدة محبوبه ، بل ) يسلب عنه محبته ، إذ ( لو كان محبوب هذا المتلفت ) ( في صلاته ) الموجبة لمشاهدته ( إلى غير قبلته ) التي يشاهد فيها محبوبه على ما أشار إليه الحديث السابق ( بوجهه ) الذي به مشاهدته ، والمقصود من هذا النهي : النهي عن الالتفات إلى غير الحق سواء تخيله في جهة القبلة أم لا ، فيجب الانتهاء عنه ، فيجب على العبد صرف نفسه بالكلية إلى الحق بحيث لا يلتفت إلى غيره (في هذه العبادة الخاصة ) التي يضيع هو بالكلية بتضييعها عن تضييع التوجه الكلي إلى الحق فيها ( أم لا ، فإنالْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقى مَعاذِيرَهُ) [ القيامة : 14 ، 15 ] .
بأنه من الدقائق التي فاتته ، وأن حضور نفسه ليس من مقدوراته ، ( فهو يعرف كذبه من صدقه ) ، إذا كانا في نفسه ؛ ( لأن الشيء لا يجهل حاله ) ، وإن دقّ فإن ( حاله له ذوقي ) ، والذوقي في الضروري ، وإن صعب بيانه ، وهذه المشاهدة كانت من مجالسه المصلي مع الحق لاجتماعهما على الصلاة التي انقسمت بينهم .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( ثمّ إنّ مسمّى الصّلاة له قسمة أخرى ؛ فإنّه تعالى أمرنا أن نصلّي له وأخبرنا أنّه يصلّي علينا ؛ فالصّلاة منّا ومنه ، فإذا كان هو المصلّي فإنما يصلّي باسمه الآخر ، فيتأخّر عن وجود العبد : وهو عين الحقّ الّذي يخلقه العبد في قلبه ، بنظره الفكريّ أو بتقليده وهو الإله المعتقد ، ويتنوّع بحسب ما قام بذلك المحلّ من الاستعداد كما قال الجنيد حين سئل عن المعرفة باللّه والمعارف ؛ فقال : لون الماء لون إنائه ،
وهو جواب سادّ أخبر عن الأمر بما هو عليه ، فهذا هو اللّه الّذي يصلّي علينا ، وإذا صلّينا نحن كان لنا الاسم الآخر فكنّا فيه كما ذكرناه في حال من له هذا الاسم ، فنكون عنده بحسب حالنا ، فلا ينظر إلينا إلّا بصورة ما جئناه بها فإنّ المصلّي هو المتأخّر عن السّابق في الحلبة ، وقوله تعالى :"كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ"[ النور : 41 ] أي : رتبته في التّأخّر في عبادته ربّه ، وتسبيحه الّذي يعطيه من التّنزيه استعداده ، فما من شيء إلّا وهو يسبّح بحمد ربّه الحليم الغفور .)
""أضاف المحقق :
أي : المتنزل إلى رتبة من هو دونه ، وهذا التنزل هو ظهوره بصور الأشياء لإظهار كمالاته ؛ فهو ناظر إلى الحمد ، والغفور أي : الساتر هذا التنزل كما هو مقتضى التنزيه والتسبيح . عبد الرحمن الجامي . ""
( ثم إن مسمى الصلاة ) ، أي : مفهوم لفظها ( له قسمة أخرى ) باعتبار اشتراكها اللفظي بين المعنى القائم بنا ، والمعنى القائم بالحق ، ( فإنه تعالى أمرنا أن نصلي له ) بقوله :
"وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ "[ البقرة : 43 ] ( أخبرنا أنه يصلي علينا ) بقوله :"هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ"[ الأحزاب : 43 ] ،
( فالصلاة ) منها شيء هو الجامع للأذكار والأفعال المخصوصة ، ومنها شيء آخر هو سبب الإخراج من الظلمات إلى النور ، وليس عين الأفعال والأذكار إذ لا يتنافي عنه ، ولا يليق بجنابه ، فهو شيء من تجلياته على المصلي يصدق عليه اسم المصلي ببعض المعاني ، وقد وجدنا المصلي يطلق على الفرس المتأخر من السابق في الحلبة ، فيكون تجليه على المصلي منها بما يناسب هذا المعنى ،
( فإذا كان الحق هو المصلي ، فإنما يصلي باسمه الآخر ) ، وليس هذا الاسم الآخر هو الذي تجلى به على العبد فوجد العبد به ؛ لأنه سبب لإخراج العبد بعد وجوده من الظلمات إلى النور .
( فيتأخر عن وجود العبد ) ، وهذا المتجلي بالاسم الآخر في الصلاة ، المتأخر عن وجود العبد ( هو عين الحق ) الذي يتصوره العبد في قبلته ، والتصوير من فعل العبد ، فهو ( الذي يخلقه العبد في قلبه ) ، وكيف لا وهو يقيده ( بنظره الفكري ، أو بتقليده ) للمتكلمين القائلين بالتنزيه المحض مع أن كونه في قبلته ينافي ذلك ، وإنما هو بالظهور منه مع أنه غير مقيد بذلك الظهور ولا بتنزيه المتكلمين ، ( وهو ) أنه ( المعتقد ) الذي يعتقد تقيده بمعتقده يخرجه من الظلمات إلى النور بحسب اعتقاده .
ولم كان الاعتقاد بحسب استعداد المعتقد ، فهو ( يتنوع ) مع تنزهه في اعتقادات هؤلاء ( بحسب ما قام بذلك المحل ) ، أي : محل الاعتقاد ) من الاستعداد ) لتصوير تنزيهه ، فهذه الصور التنزيهية المتنوعة بحسب تنوع استعدادات محل الاعتقاد من المعتقدين
( كما قال الجنيد حين سئل عن المعرفة باللّه ، والعارف ، فقال : "لون الماء لون إنائه " ، فإنه لا لون للماء ، وإنما هو للإناء ، لكن يرى في الماء لون الإناء ) ، فكذا الحق منزه عما يقيده المعتقدون فيه وإن قالوا بالتنزيه ، لكن تتقيد صور اعتقاداتهم بحسب ما قام بمحلها من الاستعدادات .
( وهو جواب ساد ) قل من أجاب به ، ولكنه ( أخبر عن الأمر ) ، أي : أمر المعرفة ( بما هو عليه ) ، فإن الحق لا يتقيد بما يتصور العبد إلا في اعتقاده ، وإذا كان الفيض الإلهي في الإخراج من الظلمات إلى النور بحسب الصورة الاعتقادية للعبد ، ( فهذا هو اللّه الذي يصلي علينا ) ، فيفيض علينا بحسب صور اعتقاداتنا المختلفة ، وإن اتفقت في كونها تنزيهية ، لكنها تختلف كمالا ونقص ، وإذا كان تجلي الحق علينا بالاسم الآخر في الصلاة ، فالمعطي من حيث هو مصلّ مظهر هذا الاسم ، ( فإذا صلينا نحن كان لنا الاسم الآخر ) يظهر به في مرآة الحق عند مشاهدتنا إياه ، ( فكنا فيه ) ، أي : في الحق يعني في مرآته على صور اعتقاداتنا في اللّه ( كما ذكرناه في حال من له هذا الاسم ) المتجلي به فينا حال الصلاة ، أنه يكون بحسب استعدادات محل اعتقاداتنا ، ( فيكون عنده ) من غير حلول فيه كمال حلول له فينا عند ظهوره بمرآتنا ( بحسب حالنا ) من تجليه بهذا الاسم فينا ، وإذا كانت هذه صورتن في نفوسنا ، وفي مرآتن .
( فلا ينظر إلينا إلا بصورة ما جئناه بها ) ، ويكون فيضه بحسب هذه الصورة ، وإنما كان تجلي الحق على المصلي بالاسم الآخر ؛ لصدق معنى المتأخر على من صدق عليه اسم المصلي كصدق معنى العابد عليه ، ( فإن المصلي ) من فرس المسابقة ( هو المتأخر عن السابق في الحلبة ) أي : الميدان ،
وقد تقرر إطلاق اسم العابد على مع أن للعابد إنما يسمي مصليا ؛ لتأخر رتبة العبدية عن رتبة الربوبية ، فتعين أن يكون إطلاق اسم المصلي عليه باعتبار تجليه بالاسم الآخر ، وهو ظهوره للعبد بصورة اعتقاده ، وهو أي : الدليل على أن الصلاة بمعنى التأخر أنها قد جاءت في حق العباد بهذا المعنى ، فكيف لا يكون في حق اللّه تعالى بهذ المعنى ( قوله تعالى :كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ) [ النور : 41 ] .
فإنه من المعلوم أنه لا يصلي كل طير ودابة الصلاة التي هي ذات الأذكار والأفعال المخصوصة ، فلابد له من تأويل ، وأحسن التأويلات ما بين معنى العبادة اللازمة لصلاتنا ، وبين معنى التأخير المفهوم من الصلاة في الجملة اللازم للعبادة ، وهو الذي أشار إليه قوله :
( أي : رتبة في التأخير ) عن درجة ربه عرف تنزيهه عن رتبة نفسه ، وعرف أيضا ( تسبيحه الذي يعطيه من التنزيه ) الكلي الإلهي ( استعداده ) ، فإنه لا يصل أحد إلى كنه تنزيهه الكلي ، وإنما يصل إلى مقدار ما يتنزه في نفسه ، فالملائكة أكثر تنزيها من عامة البشر ، وهم أكثر من الدواب حتى ينتهي تنزيه بعضهم إلى أنه لا يكون عين ذاته لا غير "وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ" [ الإسراء : 44 ] في عدم مؤاخذته من لم ينزهه حتى تنزيهه ، كيف وقد تجلي عليهم بالاسم الغفور السائر كنه تنزيهه عليهم .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( ولذلك لا نفقه تسبيح العالم على التّفصيل واحدا واحدا ، وثمّة مرتبة يعود الضّمير على العبد المسبّح فيها في قوله :"وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ" [ الإسراء :44] ، أي : بحمد ذلك الشّيء ، فالضّمير الّذي في قوله "بِحَمْدِهِ" [ الإسراء : 44 ] ، يعود على الشّيء أي بالثّناء الّذي يكون عليه ،
كما قلنا في المعتقد : إنّه إنّما يثني على الإله الّذي في معتقده وربط به نفسه ، وم كان من عمله فهو راجع إليه ، فما أثنى إلّا على نفسه ، فإنّه من مدح الصّنعة فإنّما مدح الصّانع بلا شكّ ، فإنّ حسنها وعدم حسنها راجع إلى صانعها ، وإله المعتقد مصنوع للنّاظر فيه ، فهو صنعته فثناؤه على ما اعتقده ثناؤه على نفسه ) .
( ولذلك ) أي : ولكون تسبيح الكل بما يعطيه استعداده ، ولكل واحد من الموجودات غير المتناهية استعدادات خاصة تخالف استعداد كل واحد استعداد غيره بوجه من الوجوه ، ولا يمكن لنا الاطلاع على تفاصيلها ( لا نفقه تسبيح العالم ) ، وإن علمن إجمالا اتفاقهم في تنزيه الحق ( على التفصيل واحدا ) بعد ( واحد ) ، وهذا مبني على أن الضمير في قوله : "وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ " يعود إلى اللّه تعالى.
""أضاف المحقق :
هذ كله في التسبيح والحمد اللذين في مرتبة صلاة العبد ؛ فالمصلي والمسبح والحامد في هذه المرتبة هو العبد . عبد الرحمن الجامي ""
، (وثمة ) أي : في الواقع ( مرتبة ) كشفية ( يعود الضمير إلى العبد ) لمن نظر (فيه ) ، أي : في تلك المرتبة
( في قوله :" وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ" أي : بحمد ذلك الشيء ) ؛ لأنه أقرب المذكورين ، واللّه تعالى أبعدهما في ( الضمير الذي في قوله :بِحَمْدِهِ يعود على الشيء )، أي : وإن لم يقصد حمد نفسه ، بل حمده اللّه تعالى ( بالثناء الذي يكون عليه ) ؛ لأنه إنما يسبح بقدر استعداده ، فهو إنم يثني على من يتصور منزها بقدر استعداده ، فصار ثناؤه عليه ( كما قلنا في المعتقد ) المقيد معبوده ، بل أدى إليه نظره الفكري أو تقليده للمتكلمين ، ( أنه إنما يثني على الإله الذي في معتقده ) ، وكيف لا يكون ثناؤه عليه ، وقد زين نفسه به ، فزعم أنه خالق نفسه ، ( وربط به ) ( ما كان من عمله ، فهو ) أي : ثناؤه على اللّه (راجع إليه ) ، أي : إلى معتقده الذي بصورة من فعله هو صنعته .
( فما أثنى ) في ثنائه على اللّه ( إلا على نفسه ، فإنه من مدح الصنعة ) ، فإنه مدح الصانع بلا شك ؛ لأن مدح الصنعة ( إنما ) كان فعل (الصانع ) ورعايته ما ينبغي فيها ، فهو وإن كان قبيحا في سائر الاعتبارات كان ممدوحا باعتبار الصنعة ،
( فإن حسنها وعدم حسنها راجع إلى صانعها ) ، والمعتقد اسم الفاعل صانع لما يتصوره من الإله في قلبه ، إذ ( إله المعتقد مصنوع للناظر فيه ) بنظر الحقيقة ، وإن زعم المعتقد إن ذلك الإله في اعتقاده صانعه ، وفي المصنوع أثر صنعة الصانع التي يمدح الصانع من أجلها ، (فهو ) أي : إله المعتقد من حيث اشتماله على أثر صنعة الصانع المعتقد المصور له صنعة ، فثناؤه على ما اعتقده على أثر ( صنعته ) فيه ، وهو ثناء على صنعته والصنعة من الصانع ، فهو ( ثناؤه على نفسه ) .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( ولهذا يذمّ معتقد غيره ، ولو أنصف لم يكن له ذلك ، إلّا أنّ صاحب هذا المعبود الخاصّ جاهل بلا شكّ في ذلك لاعتراضه على غيره فيما اعتقده في اللّه ، إذ لو عرف ما قال الجنيد لون الماء لون إنائه لسلّم لكلّ ذي اعتقاد ما اعتقده ، وعرف اللّه في كلّ صورة وكلّ معتقد ، فهو ظان ليس بعالم ).
( ولهذا ) أي : ولكون إله المعتقد من صنعته ( يذم معتقد غيره ) كما يذم بعض الصناع صنعة غيره إذا لم ينصف ، ( ولو أنصف لم يكن له ذلك ) ؛ لأنهم في اعتقاد أصل التنزيه على السوية ، إلا أن الأشعري يزعم أنه إنما ينزه عن النقائص لو ثبتت له صفات زائدة من الحياة والعلم ، والإرادة والقدرة ، والسمع والبصر والكلام والمعتزلي يزعم أنه إنما ينزه عن الكثرة لو كانت الصفات عين الذات ، ولو اتصف العلماء أن كلا منهما مصيب من وجه مخطئ من وجه ، فهو منزه عن كثرة الصفات باعتبار استقراره في مقر غيره ، وله صفات باعتبار تعلقه بالعالم ،
( إلا أن صاحب هذا المعبود الخاص ) لا يتأتى له ذلك ، والإنصاف ؛ لأنه ( جاهل ) بالجهل المركب ، فزعم أنه عالم ( بلا شك في ذلك ) المعتقد ؛ ( لاعتراضه على غيره فيما اعتقده في اللّه ) .
ولو لم يكن جهله مركبا لم يعترض عليه ، بل قال مثل قول المحققين ،
وإليه الإشارة بقوله : ( إذ لو عرف ما قال الجنيد : " لون الماء لون إنائه " ، لسلم كل ذي اعتقاد ) من أهل التنزيه ، والجامع بين التنزيه والتشبيه باعتبار استقراره في مقر غيره ، وتعلقه بالعالم ( ما اعتقده ، وعرف اللّه ) ظاهر ( في كل صورة ) من صور العالم ، ولم ينكر على الصوفية القائلين بظهوره في العالم بصور المحدثات ، فإنه وإن لم يكن له صور في ذاته ، فلا يبعد أن يتصور عند ظهوره في حقائق الأشياء ، كما أنه لا لون لنور الشمس ، وهو يتلون بألوان الزجاجات إذا أشرق عليها فيما يحبها ، وإذا كان (كل معتقد ) من الأشاعرة والمعتزلة مصيبا من وجه ومخطئا من وجه ، فكل معتقد يقيده ، ( فهو ظانّ ) في الحق "وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً " [ النجم : 28 ] ( ليس بعالم ) .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( فلذلك قال : « أنا عند ظنّ عبدي بي » . رواه البخاري ومسلم
أي : لا أظهر له إلّا في صورة معتقده : فإن شاء أطلق وإن شاء قيّد ، فإلّه المعتقدات تأخذه الحدود وهو الإله الّذي وسعه قلب عبده ، فإنّ الإله المطلق لا يسعه شيء لأنّه عين الأشياء وعين نفسه ، والشّيء لا يقال فيه يسع نفسه ولا لا يسعها فافهم ،وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ) [ الأحزاب : 4] .
(ولذلك ) أي : ولكون كل معتقد ظانّا ( قال ) اللّه تعالى : ( « أن عند ظن عبدي بي » ) ، ولم يقل : عند علم عبدي بي ، ( أي : لا أظهر له ) في الدنيا والآخرة ( إلا في صورة معتقده ) ما دام اعتقاده باقيا على ما مر ، فإذا ظهر في صورة أخرى أنكره ، ( فإن شاء أطلق ) فلا يتقيد بتنزيه في كل موضع ولا بتشبيه في الكل ، فإن التنزيه المحض نقص ، والتشبيه المحض كفر ، ( وإن شاء قيد ) وأخطأ بالنقص أو بالكفر أو البدعة ، قال : ( المعتقدات ) م حد (الحدود ) المانعة من دخول معتقد الغير فيه ، فالمنزه يمنع من التشبيه في الظهور أيضا ، والمشبه يمنع من التنزيه والمبتدع يمنع من التنزيه عن النقائص بعدم الصفات ، واللّه تعالى ليس بمحدود .
ثم أشار إلى أن المتصور في الإله شيئا من الإفراد بالتنزيه أو التشبيه أو الجمع بينهم ، فإلهه أيضا محدود وإن بلغ حد الكشف بقوله ، (وهو ) أي : المحدود هو ( الإله الذي وسعه قلب عبده ) دون المطلق ، ( فإن الإله المطلق لا يسعه شيء ؛ لأنه ) باعتبار الظهور ( عين الأشياء ) التي من جملتها قلب هذا العبد ، وباعتبار البطون ( عين نفسه ) ، وليس وسعه القلب باعتبار بطونه ، إذ هو باعتبار التجلي له ، فتعين أن يكون باعتبار الظهور ، ولكنه ليس على الإطلاق في الظهور بحيث يشمل القلب ؛
لأن ( الشيء لا يقال ) أنه ( يسع نفسه ، ولا يسعها ) ذو فهم يعني قوله عزّ وجل : « وسعني قلب عبدي المؤمن » . ؛ فإنه إنما وسعه ما يتصوره ، وإن كان أقرب إلى مطابقة ما عليه الحق في نفسه بالنظر إلى متصرفه من دونه لا في نفس الأمر ،("وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ") [ الأحزاب : 4 ] .
والحمد للّه عدد كل حرف ملء السماوات والأرض ، وملء مالا يدرك له طرق على ما وفقني فيه للتوفيق بين ظاهر الشرع في كل أصل وفرع يظنه المسمى بالحقيقة ،
فأخرجته من ظلمات إنكار المنكرين عن سوء الفهم ، وإقرار من يعترف به مع ما فهم فيه من مخالفة الشرع ، إذ لم يكن له من التوفيق بينهم ، فكانت كلتا الفرقتين في درك مقاصده في ذلك ضلال الهاوية " تَصْلى ناراً حامِيَةً تُسْقى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ " [ الغاشية : 4 ، 5 ] .
إلى يوم الهداية الجامعة بين أسرار الحقيقة ، وأنوار الشريعة بعون اللّه تعالى "فِي جَنَّةٍ عالِيَةٍ " [ الحاقة : 22 ] .
ل تسمع فيها من مخالفة الشرع والعقل " لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً " [ الغاشية : 11 ] ، فقيل لأربابها : " كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِما أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخالِيَةِ " [ الحاقة : 24 ]
قُطُوفُه من فوائد الكتاب "دانِيَةٌ" [ الحاقة : 23 ] ،
ومن لطائف نكات العلم "عَيْنٌ جارِيَةٌ " [ الغاشية : 12 ] ،
ومن تمهيدات قواعده " سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ " [ الغاشية : 13 ] ،
ومن التقريبات إلى العقل بنقيضه من الكتاب والسنة ، أو قدماء الصوفية ، أو البراهين العقلية "وَأَكْوابٌ مَوْضُوعَةٌ " [ الغاشية : 14].
وقلع أى رفع الشبه ، وأوهام الكفر والبدعة والخشوع "وَنَمارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرابِيُّ مَبْثُوثَةٌ " [ الغاشية : 15 ، 16 ] ،
والحمد للّه الذي نجانا من القوم الظالمين ، وأحلنا برحمته في عباده المؤمنين ،
والحمد للّه الذي هدانا لهذا التحقيق ، وما كنا لنهتدي لهذا التدقيق لولا أن هدانا اللّه بانتهاء أنواع التوفيق ، وقد أضل كثيرا من الشارحين ، فجعلهم "فِي كُلِّ وادٍ يَهِيمُونَ" [ الشعراء : 225 ] ، وفي مواضع الإشارة بعضهم " فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ" [ البقرة : 15].
وصلّ اللّه على سيدنا ، بل سيد الرسل والأنبياء محمد ،
وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ، والملائكة المقربين ،
وأهل السماوات والأرضين من عباده المؤمنين .
.
FCtiRnbrThw
 |
 |
البحث في نص الكتاب
يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!