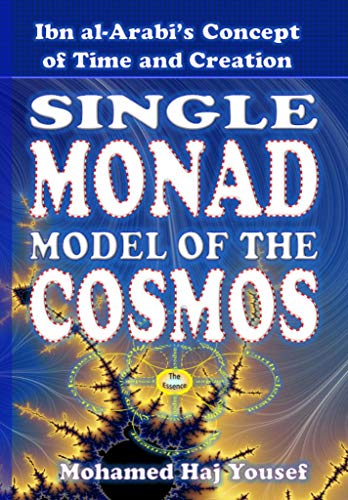كتاب خصوص النعم
في شرح فصوص الحكم
تأليف: الشيخ علاء الدين أحمد المهائمي
فص حكمة إحسانية في كلمة لقمانية
 |
 |
فص حكمة إحسانية في كلمة لقمانية
23 - فص حكمة إحسانية في كلمة لقمانية .كتاب خصوص النعم فى شرح فصوص الحكم علاء الدين أحمد المهائمي
كتاب خصوص النعم في شرح فصوص الحكم الشيخ علاء الدين أحمد المهائمي
الفصّ اللّقماني
قال الشيخ رضي الله عنه : (
إذا شاء الإله يريد رزقا ... له فالكون أجمعه غذاء
وإن شاء الإله يريد رزقا ... لنا فهو الغذاء كما يشاء
مشيئته إرادته فقولوا ... بها قد شاءها فهي المشاء
يريد زيادة ويريد نقصا ... وليس مشاءه إلّا المشاء
فهذا الفرق بينهما فحقّق ... ومن وجه فعينهما سواء
قال اللّه تعالى :وَلَقَدْ آتَيْنا لُقْمانَ الْحِكْمَةَ [ لقمان : 12 ] ،وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً [ البقرة : 269 ] ، فلقمان بالنّصّ ذو الخير الكثير بشهادة اللّه تعالى له بذلك ، والحكمة قد تكون متلفّظا بها وقد تكون مسكوتا عنها ، مثل قول لقمان لابنه :يا بُنَيَّ إِنَّها إِنْ تَكُ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّماواتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ [ لقمان : 6 ] ؛ فهذه حكمة منطوق بها ، وهي أن جعل اللّه هو الآتي بها ، وقرّر ذلك اللّه في كتابه ، ولم يردّ هذا القول على قائله ).
.
أي : ما يتزين به ، ويكمل العلم اليقيني المتعلق بالإحسان الذي هو رؤية ربه في كل شيء ، ورؤية الحق صور أسمائه وآثارها في الخلق ، وكل ذلك عن إحسان الحق بمشيئته لا بطريق الوجوب عليه ، ويتبع هذا الإحسان الإحسان الذي هو بمعنى فعل م ينبغي لما ينبغي ، فيحصل لصاحب الإنسان الأول لا محالة ،
وإن كان قد لا يحصل لصاحب هذا الإحسان الإحسان بالمعنى الأول ، وهو يفيد زيادة أنس أيضا ولتبعية الإحسان بالمعنى الثاني للإحسان بالمعنى الأول أورده الشيخ رحمه اللّه وإن كان فيه ما هو أساس الإحسان بالمعنى الأول ،
فظهر ذلك العلم بزينته وكماله في الحقيقة الجامعة المنسوبة إلى لقمان عليه السّلام ، إذ أوتي الحكمة المستلزمة لإيتاء الخير الكثير الذي لا يكمل إلا بالرؤيتين المذكورتين .
وقد أشار إليهما لقمان عليه السّلام في حكمته المنطوق بها والمسكوت عنها ، فنطق بم يدل على رؤيته وسكت عن رؤيتنا إياه بطريق التصريح ،
فأشاررحمه اللّه إلى وجه كونهما من الخير الكثير من حيث إنهما كمال غير واجب عليه بل حاصل بمشيئته ، فيكون إحسانا وتفضيلا ؛ ذلك لاستغنائه بكماله الذاتي عن طلب كمال آخر ، لكن من شأن الكامل
التفضل بالتكميل ، وهو إنما يكون بالمشيئة لكنها محل لوجوب اعتبار الوحدة في صفاته سيم التي قربت منه ، وكانت بلا اعتبار واسطة صفة أخرى بحسب التعقل ، وإن كان الكل مع في الوجود ؛ فلابدّ من أمر يفصلها في تعقلها بجزئيات الأكوان ، وهو الإرادة ؛
فقال رضي الله عنه : ( إذا شاء الإله يريد ) أي : يريد ( رزقا له ) ، أي : كمالا لأسمائه بإخراج ما فيها بالقوة من صورها وآثارها إلى الفعل ، وإن كانت غنية عنها بحسب تعلقها بالذات ،
فقال رضي الله عنه : ( فالكون ) أي : الوجود الجاذب ( أجمعه غذاء ) كمال لها وراء الكمال الذي له في ذواتها مع غناها به نفي هذا الكمال ، وإن بقاء الإله ( يريد رزقا لنا ) بتكميلنا ،
( فهو ) أي : ( الغذاء ) فرؤيته في كل شيء هو الكمال لنا ، لكن ليست رؤيته على ما هو عليه ، بل ( كما شاء ) على تفاوت استعداد الرائين من .
ثم أشار إلى سبب جمعه بين المشيئة والإرادة وإيقاع المشيئة عليها بقوله : ( مشيئته ) ، وهي الصفة المرجحة أحد طرفي المقدور ، فهي وإن كانت مجملة لوحدتها باعتبار تعلقها بالذات بلا اعتبار واسطة ؛ فهي ( إرادته ) المتصلة من حيث التعلق بجزئيات الأكوان ، وهذا التعلق للإرادة من المشيئة ، ( فقولوا : بها ) أي : المشيئة ( قد شاءها ) أي : شاء تعلق الإرادة ، فهي أي : الإرادة وإن كانت قديمة ، كأنها ( هي المشاء ) بفتح الميم مصدر ميمي أريد به اسم المفعول وإذا لم يؤنثه ، وإنما كانت إرادته تفصيلية ؛
لأنه ( يريد زيادة ) في بعض الأكوان ، ( ويريد نقصا ) في البعض الآخر ، ( وليس مشاؤه ) أي : متعلق مشيئة الحق من حيث وحدتها ( إلا المشاء ) أي : إلا الذي شاءه من الإرادة ، فإنها واحدة وإن كانت مفصلة التعلق ، ولا يمكن اعتبار ذلك فيما قرب من الحق لغلبة الوحدة هناك بخلاف ما كان له بالواسطة .
فقال رضي الله عنه : ( فهذا الفرق ) من الإجمال والتعلق والتفصيل فيه ( بينهما ) أي : بين المشيئة والإرادة ، ( فحقق ) أي : قل فيه بالتحقيق فلا يتوهم جواز التفصيل في تعلق الوصف الأقرب مما لحق ، ( ومن وجه ) أي : ومن حيث أن كلا منهما صفة ترجح أحد طرفي المقدور ، ( فعينهما ) أي :
حقيقتهم ( سواء ) ؛ ولذلك صح قولنا : مشيئته إرادته وصح ، فلا يجوز إطلاق كل منهما بدل الآخر ، وإذا كانت الكمالات بالمشيئة كان إيجادها والاطلاع عليها من الإحسان الذي هو الخير الكثير اللازم للحكمة بدليل أنه..
(قال اللّه تعالى :"وَلَقَدْ آتَيْنا لُقْمانَ الْحِكْمَةَ" [ لقمان : 12 ] ، وقال :"وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً" [ البقرة : 269].)
لأن الحكمة هي العلم بحقائق الأشياء وخواصها ، والعمل بمقتضاها ، وجميع الكمالات منوطة بها ، ( فلقمان بالنص ) الوارد في الموضعين ( ذو الخير الكثير بشهادة اللّه تعالى ) ، إذ ذلك نتيجة نصيه التي إحداها صغير الشكل الأول والثاني كبيره ، فهي وإن لم تكن مذكورة بالفعل ، فهي مفهومة قطعا من كلامه ، فصارت شهادة إلهية ، وهي أقوي من البرهان العقلي .
ثم أشار إلى أن من كمال حكمته أن جمع المقصود الكلي من نوعي الحكمة المنطوق بها ، والمسكوت عنها في ألفاظ يسيرة ناطقا بالمنطوق بها صريحا مشيرا إلى المسكوت عنه بإشارات لطيفة بقوله : ( والحكمة قد تكون ملفوظا بها ) إذ لا يتضرر بها أحد سمعها ، ( وقد تكون مسكوتا عنها ) لتضرر العامة بسماعها ، فيشار إليها بالإشارات اللطيفة للخاصة .
""أضاف الجامع :
مسكوت عنه للإمتناع أحياننا أو لصعوبه تجلي أنوار وظلال صورها وسريانها في أرواح وعقول الكثير من العامة . فالحقائق له مواقيتها المرقومة من القدم وهى تختلف من انسان للآخر حسب استعداده منذ "الست بربكم" فيجب تفهم مراعاتها للحكمة الإلهية في خلقه منذ ألست وحتى يبعثون .أه "".
فقال رضي الله عنه : ( مثل قول لقمان لابنه ) ؛ ليصير حاملا سر كماله ، فإن الولد ، وإن كان سر أبيه فلا تظهر هذه الأسرار فيه إلا بالولادة المعنوية دون الولادة الطبيعية ؛
فلذلك قال :( يا بُنَيَّ ) بالتصغير إشارة إلى أن ولادته لم تتم ( إِنَّها ) أي : القصة ، أبهم الضمير ليدل على علو شأن المذكور بعدها بحيث لا يصل إليه فهم كل أحد ول علمه ،( إِنْ تَكُ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ ) أشار بعمومها إلى عموم تعلق القدرة والعلم والظهور الإلهي بها ،( فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ ) التي هي عليها السماوات والأرض ،
فقال رضي الله عنه : ( أَوْ فِي السَّماواتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ ) أشار بعموم مكانها إلى عموم سلطنته وعلمه وظهوره فيها أيض (يَأْتِ بِهَا اللَّهُ )[ لقمان : 16 ] أشار بذلك إلى وحدة الفاعل في الكل.
فقال رضي الله عنه : ( فهذه ) الدلالة على وحدة الفاعل ( حكمة منطوق بها ) ، ثم بينها بقوله : ( وهي أن جعل اللّه هو الآتي بها ) ؛ لئلا يتوهم أن منها الدلالة على عموم العلم والقدرة ، إذ يعترف بذلك كل مؤمن من العامة مع أنهم ليسوا من أهل الحقائق ، فليسوا من أهل الحكمة بخلاف وحدة الفاعل ، إذ تنكرها المعتزلة ، ويختص بمعرفتها على الكمال أهل الحكمة الجامعون بين القدر والشرع ، ( وقرر ذلك اللّه ) إذ أورده ( في كتابه ) لصدقه في نفس الأمر مع عدم تضرر أحد بسماعه ، وأما ما يتوهم فيه من التخيير ، ونفي التكليف ، فليس بلازم له ، فإن هذا جهة الإيجاد ، وإنما التكليف من جهة الاكتساب ،
وهذ الإيجاد متوقف على اكتسابه بحسب السنة الإلهية ، إذ لا يفعله الحق قبل اختياره فل ينافي التكليف المنوط باختياره واختباره ، وإن كان عن إيجاد الحق الداعية فيه ، فلا يؤخذ الحق فيه إلا باقتضاء عينه أن يوجده فيه بحسب السنة أيضا ، وإنما قلن قرر في كتابه ؛ لأنه ( لم يرد هذا القول على قائله )، ولو كان مردودا عند اللّه لوجب رده ، ولو كان مما يتضرر إظهاره لم يحكه صريحا في كتابه الذي خاطب به كل أحد ، وأكثر ما أورد فيه من الأسرار بطريق الإيماء أو في الألفاظ المتشابهة مع منع العامة عن تعوضها تخصيص فهمها للراسخين .
قال الشيخ رضي الله عنه : (وأمّا الحكمة المسكوت عنها ، وقد علمت بقرينة الحال ، فكونه سكت عن المؤتى إليه بتلك الحبّة ، فما ذكره وما قال لابنه يأت بها اللّه إليك ، ولا إلى غيرك ، فأرسل الإتيان عاما ، وجعل المؤتى به في السّموات إن كان ، أو في الأرض تنبيه لينظر النّاظر في قوله :وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّماواتِ وَفِي الْأَرْضِ[ الأنعام : 3 ] ، فنبّه لقمان بما تكلّم به وبما سكت عنه أنّ الحقّ عين كلّ معلوم، لأنّ المعلوم أعمّ من الشّيء فهو أنكر النّكرات ) .
فقال رضي الله عنه : ( وأما الحكمة المسكوت عنها ) ، وهي الدلالة على توحيد وجود الكل بتضرر العامة سماعها بتوهم الإلهية ، وأن لهم ذلك مع دلالته على عدمهم في ذواتهم ، وإن وجودهم عند إشراق نور وجود الحق عليهم ، ومحل إشراق الشمس من المرآة لا تكون شمسا بالحقيقة مغنية للعالم كله ، وهو وإن سكت عنه (علمت بقرينة الحال) لكلامه مع كلام آخر له وللّه تعالى في موضع آخر.
فقال رضي الله عنه : (فكونه سكت عن المؤتى إليه بتلك الحبة ) مع أنه لا بدّ منه ( فما ذكره ) على وجه العموم ، إذ يكون ناطقا بما يجب السكوت عنه ،
( ولا قال لابنه : يأت بها اللّه إليك ، ولا ) قال : يأت بها اللّه ( إليّ غيرك ) ؛ لدلالته على الخصوص المنافي للمقصود .
فقال رضي الله عنه : ( فأرسل الإتيان ) أي : أطلقها عن التقييد بالمفعول الخاص ؛ ليكون ( عامّا ) ، ولكن لم يصرح بهذا العموم ، وإن صرح بعموم المؤتى به ومكانه ، إذ ( جعل المؤتى به ) كل مثقال حبة ( في السماوات إن كان أو في الأرض ) ، مع أن حذف المكان أيضا يدل على عمومه ، لكن حذفه يدل على أن المقصود هو نفس العموم ؛ لأنه إذا حذف صار الذهن طالبا له ، ومن عادته أنه إذا وجد مطلوبه سكت إلا أن يجد داعيا آخر إلى طلب ما وراؤه والتصريح به لا يدل على ذلك ،
فيمكن أن ينتقل الذهن منه إلى ما هو المقصود ، فصرح بعمومه (تنبيه ) للخواص على أن عموم المكان ليس بمقصود ؛ ( لينظر الناظر ) منهم عند سماع قوله :فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّماواتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ (في قوله تعالى : وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّماواتِ وَفِي الْأَرْضِ) [الأنعام :3 ].
ثم ينتقل من هنا أن عموم المؤتى إليه أيضا ليس مقصودا لذاته ، وإنما المقصود منه ظهور الحق فيه بحيث يصير هو الآتي والمؤتى به ومكانه والمؤتى إليه جميعا ، ( فنبه لقمان بما تكلم به ) من نسبة إتيان كل ذرة إلى الحق ، (وبم سكت عنه ) من كونه المؤتى إليه ، وقد تكلم بوجه دون وجه بكونه عين مكان المؤتى به ( أن الحق عين كل معلوم ) باعتبار أنه لا محقق فيه سوى ما أشرق عليه من نور وجوده صرح بعينية فاعليته ،
وسكت عن عينية وجوده تارة من كل وجه ، وتارة بوجه دون وجه ؛ لتصير قرينة على ما سكت فيه بالكلية ، وإنما قلنا : عين كل معلوم دون عين كل شيء ؛
لأن المحذوف لو أخذ خاصّا بلا قرينة كان ذلك ترجيحا بلا مرجح ، فما هو أعم من كل وجه أولى مما لا يكون فيه ذلك العموم ، فأخذ بالمعلوم ؛
فقال رضي الله عنه : ( لأن المعلوم ) أي : الذي من شأنه أن يعلم ( أعم من الشيء ) ؛ لأنه يختص بالمحقق في الواقع والمعلوم أعم منه ، ومن المعدوم الممكن والممتنع ، إذ وجودهما الذهني أيضا وإشراق نور الحق ، وإذا كان الحق باعتبار الظهور عين كل معلوم ، وهو أعم من الشيء والشيء أنكر الموجودات ،
فقال رضي الله عنه : ( فهو ) أي : الحق ( أنكر المنكرات ) من حيث الظهور ؛ فلذلك خفي مع غاية ظهوره من حيث الظهور فضلا عن حيث الذات ، وقد فهم ذلك في إشارة لقمان عليه السّلام ؛ فافهم ، فإنه مزلة للقدم .
""أضاف المحقق :
( فهو ) أي : الحق (أنكر المنكرات) من حيث الظهور أي : لا مفهوم أعم منه إذ هو شامل للموجودات العينية والموجودات العلمية من الممكنات والممتنعات .أهـ شرح الجامي ""
قال الشيخ رضي الله عنه : ( ثمّ تمّم الحكمة واستوفاها لتكون النّشأة كاملة فيها فقال :إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌفمن لطفه ولطافته أنّه في الشّيء المسمّى بكذا المحدود بكذا عين ذلك الشّيء ، حتّى لا يقال فيه إلّا ما يدلّ عليه اسمه بالتّواطؤ والاصطلاح ، فيقال : هذ سماء وأرض وصخرة وشجر وحيوان وملك ورزق وطعام ، والعين واحدة من كلّ شيء وفيه ، كما تقول الأشاعرة : إنّ العالم كلّه متماثل بالجوهر ؛ فهو جوهر واحد ، فهو عين قولنا : العين واحدة .
ثمّ قالت : ويختلف بالأعراض ، وهو قولنا ويختلف ويتكرّر بالصّور والنسب حتّى يتميّز ، فيقال : هذا ليس هذا من حيث صورته أو عرضه أو مزاجه كيف شئت فقل : وهذا عين هذا من حيث جوهره ، ولهذا يؤخذ عين الجوهر في حدّ كلّ صورة ومزاج ، فنقول نحن إنّه ليس سوى الحقّ ؛ ويظنّ المتكلّم أنّ مسمّى الجوهر ، وإن كان حقّا ، ما هو عين الحقّ الّذي يطلقه أهل الكشف والتّجلّي ، فهذا حكمة كونه لطيف ).
فقال رضي الله عنه : ( ثم ) أي : بعد ما نطق لقمان بالحكمة المنطوق بها ، وأشار إلى المسكوت عنها ( تمم الحكمة ) نوعيها بما يقرب إلى الأفهام كونه عين كل فاعل ، وعين كل معلوم مع تنزهه عن الحدوث والنقائص ، ( واستوفاها ) ببيان سبب ذلك ؛ ( لتكون النشأة ) أي : نشأة ابنه ومن يكون بعده ( كاملة فيها ) أي : في الحكمة علما وعملا ،
فقال رضي الله عنه : ( فقال :إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ ) من اللطافة واللطف ، ( فمن لطافته ) الموجبة لإشراقه في مظاهره كأنه فيها ، ولطفه الموجب لرحمته على الأعيان بالإشراق عليها تفضلا ( أنه ) مع تنزهه عن الحدوث والتحديد والحلول في الحوادث والمحدودات ، إشراق نور وجوده
( في الشيء المسمى بكذا ) من أسماء المحدثات الشخصية ( المحدودة بكذا عين ذلك الشيء ) ، إذ لا تحقق من الشيء في الواقع سوى ما أشرق فيه من نوره ،
كم قال الإمام الغزالي في الباب الثالث من كتاب « التلاوة » من « الإحياء » :
بل التوحيد الخالص ألا يرى في كل شيء إلا اللّه ، ولكن انتهت لطافته إلى حيث اختفى بظهوره فقال رضي الله عنه : ( حتى لا يقال فيه ) أي : في ذلك الشيء ( إلا ما يدل عليه اسمه بالتواطؤ ) أي : اتفاق أهل اللغة ( والاصطلاح ) بين طائفة ، ولا يسمى باسم اللّه أصلا سواء كان فيه علو وثبات وشدة وإحداث شيء ، كالآثار ، وحياة وسمع وبصر وعلم وتكميل وحفظ أم ل .
فقال رضي الله عنه : ( فيقال : هذا سماء ) في العالي ، ( وأرض ) في الثابت ، ( وصخرة ) في الشديد ، ( وشجر ) في المثمر ، ( وحيوان ) في الحي السميع البصير ، (وملك ) في العليم ، ( ورزق ) في المكمل ، ( وطعام ) في الحفيظ ، فلا يسمى شيء منها باللّه ولا سائر أسمائه ،
وإن صح بالكشف أن ( العين ) المحققة (واحدة من كل شيء ) ، إذ لا محقق ( فيه ) سوى وجوده ، وم سواه أمور اعتبارية ، وهي الظاهرة به ، إذ ظهورها أصل لظهور حقيقته مع أنها مستقرة في العلم الإلهي ما شمت رائحته من الوجود بذلك الاعتبار ، ولا ينكر على هذا ؛
فإنه فقال رضي الله عنه : ( كما تقول الأشاعرة ) من أهل السنة : ( أن العالم كله متماثل بالجوهر ) ، والمتماثلات متحدات بالنوع ، ( فهو ) أي : العالم على قولهم (جوهر واحد ) بالنوع ، وقد قلنا : العين الظاهرة في الكل واحدة بالنوع ، فإنها صور الوجود الحقيقي ، ( وهو ) أي : قولهم ( عين قولنا العين واحدة ) ، وإن اختلفا في الاسم ،
فقال رضي الله عنه : ( ثم قالت ) الأشاعرة : ( ويختلف ) الجوهر الواحد إلى موجودات متعددة ( بالأعراض ) المختلفة ، ( وهو قولن : وتختلف العين الواحدة ) بالصور والنسب ، وبالجملة ( تتكرر بالصور والنسب ) في هذا الظهور مع الوحدة الشخصية في الأصل ، ( حتى يتميز ) كل شيء عما عداه ، حتى الأصل عن الفرع والفرع بعضه عن بعض ،
فقال رضي الله عنه : ( فيقال : هذا ليس من حيث صورته ) الحسية أو النوعية أو الشخصية ، ( أو عرضه ) العام أو الخاص ، ( أو مزاجه كيف شئت ، فقل : ) فإنه لا خلاف في صحة جميع ذلك ، ولا ينافي هذا التعدد والتميز ما قلنا من وحدة العين ،
إذ يقال عندهم أيضا : ( هذا عين هذا من حيث جوهره ) ، وإن تعدد جوهرا بالشخص ، لكنهما اتخذا بالنوع ، وهو حقيقة واحدة تعددت بالصور والأعراض والأمزجة .
فقال رضي الله عنه : ( ولهذا ) أي : ولاتحاد الجوهر بالحقيقة ( تؤخذ عين الجوهر في حد كل صورة ومزاج ) ، فيقال : الملك جوهر مجرد ، والجسم جوهر قابل للقسمة في الأبعاد الثلاثة على زوايا قائمة ، وقد أخذنا الجسم في حد العناصر والجماد والنبات والحيوان ، فهو أخذ الجوهر في ذلك ، ( فنقول نحن : إنه ليس ) الجوهر المأخوذ في الحدود ( سوى ) الخلق باعتبار ظهور في الأشياء ؛ لأن المراد به الأصل الذي تقوم به الصور والأمزجة والأعراض ، ولا يحصل شيء منه للمعدوم ،
فهي لاحقة بالوجود الذي هو إشراق نور ( الحق ) فيه ، وهو الذي يسميه بالحق الظاهر في الكل ؛ لأنه الثابت أولا ، ويتبدل عليه ، ويلحق الصور والأحوال والنسب والأمزجة ، ( ويظن المتكلم ) من الأشاعرة وغيرهم ( أن مسمى الجوهر ، وإن كان حقّا ) بمعنى : أن الثابت في الواقع بحيث يتبدل عليه ما ذكرنا ويلحقه ( ما هو ) عندهم ( عين الحق الذي ) هو صورة الوجود الحقيقي ،
إذ يزعمون أن وجود كل شيء عرض عام له أو عين إعراضه ولواحقه المتبدلة ، ولا يقولون بأنه صورة ذلك الوجود الحقيقي ، فليس هو الذي ( يطلقه أهل الكشف والتجلي ) جمع بينهما ؛ لأن من الناس من يكاشف ببعض الأمور ، ولا يكاشف بتجلي الحق والتجلي بظهور الحق حاصل لكل أحد مع أنه لا كشف لأكثرهم ؛ ( فهذه ) النكتة ( حكمة كونه لطيفا ) لا ما تتوهمه العامة من أن المراد به أنه غير محسوس ، أو أن العالم بدقائق الأمور وأنه البر بعباده .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( ثمّ نعت فقال :خَبِيرٌ[ لقمان : 16 ] أي : عالم عن اختبار وهو قوله :وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ[ محمد : 31 ] ، وهذا هو علم الأذواق ، فجعل الحقّ نفسه مع علمه بما هو الأمر عليه مستفيدا علما ، ولا تقدر على إنكار ما نصّ الحقّ عليه في حقّ نفسه ؛ ففرّق تعالى ما بين علم الذّوق والعلم المطلق ، فعلم الذّوق مقيّد بالقوى ، وقد قال عن نفسه : إنّه عين قوى عبده في قوله : « كنت سمعه » ، وهو قوّة من قوى العبد ، « وبصره » وهو قوّة من قوى العبد ، « ولسانه » وهو عضو من أعضاء العبد ، « ورجله ويده » فما اقتصر في التّعريف على القوى فحسب حتّى ذكر الأعضاء : وليس العبد بغير هذه الأعضاء والقوى ؛ فعين مسمّى العبد هو الحقّ ، لا عين العبد هو السّيّد ، فإنّ النّسب متميّزة لذاتها ؛ وليس المنسوب إليه متميّزا ، فإنّه ليس ثمّة سوى عينه في جميع النّسب ، فهو عين واحدة ذات نسب وإضافات وصفات).
فقال رضي الله عنه : ( ثم ) أي : بعد ذكره اللطيف الدّال على سريان ما أشرق من نوره في الكل بحيث يصير الكل كأنه هو عقب اللطيف بما يدل على سبب لطفه ، والمقصود منه ،
( فقال :خَبِيرٌ[ الحج : 63] أي : عالم عن اختبار ) ، وهذا العلم بالاختبار وإن كان جاريا ، فهو في حقه تعالى ثابت باعتبار ظهوره في هذه المظاهر ، وكيف لا ( وهو ) ما دل عليه ( قوله : وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ[ محمد : 31 ] ) ، وكيف لا يكون هذا العلم مطلوبا للحق ، وإن كان علمه في الأزل كاملا ؟
فقال رضي الله عنه : (وهذا هو علم الأذواق ) والذوق بالمعلوم مطلوب للعالم منا ، فكذا للحق ، وإن لم يؤثر فيه شيء ، فلا شكّ أنه يؤثر في صور ظهوره ، وهو عالم بما يكون فيها ، فيكون بذلك كأنه عالم بالذوق ، ( فجعل الحق نفسه ) مع تنزيهه عن أن يكون محلا للحوادث باعتبار استقرارها في مقر غيرها ، مع علمه في الأزل (بم هو الأمر ) أي : أمر كل موجود ( عليه ) بطريق علم اليقين ( مستفيد علما ) ، فهو وإن لم يتجدد في حقه علم لا بطريق الذوق ، ولا بطريق آخر قلناه على ما يعلم من ذوق صور ظهور ومظاهرة ، فجعلناه علما ذوقيّا في حقه ؛
وذلك لأنه ..
فقال رضي الله عنه : ( لا يقدر على إنكار ما نص الحق عليه في حق نفسه ) فلابدّ من تأويله بهذا التأويل.
وقد أشار الحق إلى هذا التأويل في تسمية العلمين ( ففرق تعالى ما بين علم الذوق ) فسماه اختبارا وابتلاء ، وسمى نفسه باعتباره خبير (بالعلم المطلق ) وسماه علما ، وسمى نفسه عليما ، فالعلم المطلق لعدم توقفه على أمر حصل له بذاته ، والذوقي لتقييده توقف على حصول سببه ، وعلى صيرورة الحق كأنه ذلك السبب بظهوره فيه حتى كأنه عينه ،
فقال رضي الله عنه : ( فعلم الذوق مقيد بالقوى ) إذ لا بدّ له من ذائق ، وليس سوى القوى المدركة بالاستقراء والوجدان ، فظهر فيها ليصير كأنه ذائق بما تذوقه القوى ، بل في صاحبها كأنه عينه ، وهو الذائق في الأصح ، ( وقد قال تعالى عن نفسه ) فيما روي عنه صلّى اللّه عليه وسلّم من قوله : « ولا يزال العبد يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها ، ولسانه الذي ينطق به ".
فكأنه قال رضي الله عنه : ( أنه عين قوى عبده ) في قوله : كنت ( سمعه ) ويده ، وهو وإن صار مجلي الحق وحتى كأنه عينه ( قوة من قوى العبد ) ، فيجوز كونه محلا للحوادث ، فيحدث فيه علم ذوقي ، وهو إن لم يكن محلا للمسموع ، فلا شكّ أن البصر محل لانطباع صورة المرئي ،
وقد قال رضي الله عنه : ( وبصره ) ، وهو أيضا ( قوة من قوى العبد ) ، وهما إن لم يكونا ذائقين فلا شكّ في أن لسانه هو الذائق ،
وقد قال رضي الله عنه : ( لسانه ، وهو عضو من أعضاء العبد ) ، وإن قلنا : لا ذوق فيه أيضا بل في العبد ، فقد قال : ( ورجله ويده ، فما اقتصر في التعريف ) أي : ظهور الحق بصور الخلق ( على القوى فحسب ، حتى ) لو لم تكن القوى ذائقة لم يكن الحق ذائقا بذوق العبد ؛ لأنه تجلى في جميع قواه وأعضائه .
فقال رضي الله عنه : ( وليس العبد بغير هذه الأعضاء والقوى ) ، فسواء كانت الذائقة هي القوى والأعضاء ، أو العبد كان الحق كأنه ذائق بذوقها ، وإن لم يكن محلا للحوادث ؛ لأن الذائق في العبد إنما هو صورة الحق ، إذ قبل الوجود ل يمكن حصول شيء من هذه الأذواق ، ( فعين مسمى العبد ، وهو ) الوجود الظاهر في عينه ، إذ قبل ذلك ،
وإن شئت عينه ؛ فلا يسمى عبدا هو العبد باعتبار إشراق نوره فيه ، والعبد إنما يذوق م يذوق بهذا المسمى ، فينسب إلى ( الحق لا عين العبد ) أي : حقيقته هو ( السيد ) ، فلا ينسب إلى الحق من العلم ، وما ينتسب إلى العبد من التأثير
( متميز بذاته ) ، فلابدّ من اعتبار التمييز في هذه النسب ، ومع ذلك ينسب إلى الحق العلم الذوقي ، وإن ضمن التأثير ، إذ ( ليس المنسوب إليه ) هذا العلم والذوق ، وهو الوجود الظاهر في عينه ( متميزا ) بحيث يكون ( ثمة ) للحق صورة وللعبد صورة أخرى ، فإنه ليس ثمة في مسمى العبد ، وهو المنسوب إليه العلم ، وذوقه شرب منه أي : ( عين ) الحق الظاهر فيه ( في جميع النسب ) من العلم والذوق وغيرهم .
فقال رضي الله عنه : ( فهو ) أي : الحق ( عين واحدة ذات نسب ) له نسبة باعتبار وجوده ، ونسبة باعتبار ما ظهر فيه هو من العين الثابتة للعبد ، ( وإضافات ) تضاف إليه من حيث كونه صورة الحق أفعال العبد وتأثيراته ، ويضاف إليه من حيث كونه ظاهرا في عين العبد النقائص والانفصالات ، ( وصفات ) فله باعتبار استقراره في مقر عين صفات كاملة أزلية ، وباعتبار ظهوره في المظاهر صفات محدثة ناقصة ، فلما كان لهذا التتميم هذه الفوائد الجليلة .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( فمن تمام حكمة لقمان في تعليمه ابنه ما جاء به في هذه الآية من هذين الاسمين الإلهيّين ، لطيف خبير سمّى بهما اللّه تعالى ، فلو جعل ذلك في الكون وهو الوجود ؛ فقال : « كان » لكان أتمّ في الحكمة وأبلغ ، فحكى اللّه تعالى قول لقمان على المعنى كما قال لم يزد عليه شيئا ، وإن كان قوله :إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ[ لقمان : 16 ] من قول اللّه فلما علم اللّه تعالى من لقمان أنّه لو نطق متمّما لتمّم بهذا ، وأمّا قوله :إِنْ تَكُ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ [ لقمان : 16 ] لمن هي له غذاء ، وليس إلّا الذّرّة المذكورة في قوله تعالى : فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ[ الزلزلة : 7 8 ] .
فهي أصغر متغذّ والحبّة من الخردل أصغر غذاء ، ولو كان ثمّة أصغر لجاء به كما جاء بقوله تعالى :إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلً ما بَعُوضَةً [ البقرة : 26 ] ، ثمّ لمّا علم أنّه ثمّ ما هو أصغر من البعوضة قال : فَما فَوْقَه [ البقرة : 26 ] يعني في الصّغر ، وهذا قول اللّه والّتي في « الزّلزلة » قول اللّه أيضا ، فاعلم ذلك فنحن نعلم أنّ اللّه تعالى ما اقتصر على وزن الذّرّة وثمّ ما هو أصغر منها ، فإنّه جاء بذلك على المبالغة ، واللّه أعلم. )
فقال رضي الله عنه : (فمن تمام حكمة لقمان في تعليمه ) المحتاج إلى إقامة الأدلة ، ورفع الشبه والتقريب إلى الأفهام ، وبيان الأسرار ( لابنه ) ؛ لإرادة جعله حامل أسراره ( ما جاء به في هذه الآية من هذين الاسمين الإلهيين لطيف وخبير ) ، إذ (تسمى اللّه ) بهما في الكتب السماوية ، فكانا دليلين عقليين نقليين ، لكنهم باعتبار ظهوره في المظاهر ،
فلو جعل ذلك المذكور من نسبة الحق بالاسمين ( في الكون ) ، وهو وإن كان اسم لحصول الشيء على سبيل الحدوث ، فاسمه يجوز أن يكون أسماء للحق ، إذ هو الوجود الظاهر في المظاهر ، وهو من حيث أنه وجود صورة الحق ، والصورة تسمى باسم ذي الصورة ،
فقال : إن اللّه كان لطيفا خبيرا ( لكان أتم في الحكمة ) ؛ لدلالته بالمطابقة على المقصود على ما هو عليه ، ( وأبلغ ) في رفع الالتباس من توهم ذلك في الحق باعتبار استقراره في مقر غيره ، لكنه اعتمد على القرينة ، فأطلق في موضع التقييد .
فقال رضي الله عنه : ( فحكى اللّه قول لقمان ) بلغة أصله ( على المعنى ) ، كما قال : ( ولم يزد عليه شيئا ) ، إذ يتوهم كونه من قول لقمان مع أنه لم يقله ، فيكون كذبا هذا ( إن كان قوله :إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ[ الحج : 63 ] ) من قول لقمان ،
وإن كان قوله رضي الله عنه :( إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌمن قول اللّه ) تمم به حكمة لقمان تعليما لهذه الأمة أفضل من تعليمه ابنه وأكمل ، (فلم علم اللّه من لقمان أنه لو نطق متمما ) لحكمته ( لتمم بهذا ) ، فكأنه صار قائلا بذلك ، فلم يزد عليه أيضا ، فهذ ما في هذه الآية من الإشارة إلى الحكمة النظرية ،
( وأما ) ما فيها من الإشارة إلى الحكمة العملية ، فهي المذكورة ( بقوله : إِنْ تَكُ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ) من الهيئات الحاصلة من الأعمال والأخلاق ،فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ هي البدن الكثيف ،أَوْ فِي السَّماواتِهي الأرواح العالية ،أَوْ فِي الْأَرْضِ هي النفوس ،يَأْتِ بِهَا اللَّهُ [ لقمان :16 ].
فقال رضي الله عنه : (لمن هي له غذاء ) أي : هذه كمال له ، ( وليس ) من هي له غذاء (إل الذرة ) من الأعمال والأخلاق ، إذ الأكبر منهما يقتضي منه الأكبر ، فلا تكفي الحبة غذاء له المذكورة في قوله تعالى :فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ [ الزلزلة : 7 ، 8 ] ).
فشبه العمل والخلق بالذرة والهيئة الخاصة منهما بالحبة ؛ للإشعار بأن أدنى الأعمال والأخلاق الموجب أدنى الهيئات يأتي بها اللّه لصاحب ذلك العمل والخلق في أي ذرة أصغر تنفذ من الأعمال والأخلاق من حيث اقتضائها تلك الهيئة ، كاقتضاء المتغذي للغذاء ،
فقال رضي الله عنه : ( والحبة من الخردل أصغر ) إذا جيء بهم للدلالة على المبالغة في أن اللّه تعالى لا يظلم في أقل قليل من الأعمال والأخلاق وهيئتهما ، ودلّ هذا على أنه ليس في الأعمال والأخلاق أصغر من الذرة ، وهي النملة الصغيرة ، وليس في الهيئات أصغر من الحبة ، إذ ( لو كان ثمة أصغر ) منهم ( لجاء به ) في موضع المبالغة ، (كم جاء ) في تمثيل الدنيا بأحقر الأشياء ،
""أضاف المحقق :
المراد أنه لا أصغر منها مما يسمى باسم ويذكر به كما أشرنا إليه مطلقا ، وليس شيء مم يسمى باسم ويذكر به أصغر من الحبة والذرة بخلاف البعوضة ؛ فإن ما فوقها من الصغر هو النملة .أه شرح الجامي ""
فقال رضي الله عنه : ( بقوله :"إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا م بَعُوضَةً فَما فَوْقَها") [ البقرة : 26 ] ، ( ثم علم أن ثمة ) أي : فيما تمثلت به الدنيا ما هو ( أصغر من البعوضة ، قال : فما فوقها ) .
ولم توهم أن الفوقية من الكبر ، وهو محل المبالغة فسره بقوله أي : ( في الصغر ) ؛ فإنه فوق البعوضة في الحقارة ( فهذه المبالغة ) ، وإن لم تجب في قول لقمان ، فهي واجبة في ( قول اللّه تعالى في ) صورة ( الزلزلة ) ؛ وذلك لأن عادته المبالغة في موضعها ، إذ هذا أي :
قوله :"فَما فَوْقَها" ( قول اللّه ) ، والذرة ( التي في الزلزلة قول اللّه أيضا ) ، فلا يختلف قوله في المبالغة ، وتركها لقوله تعالى : "وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً" [ النساء : 82 ] .
أي : برهانه المبالغة في البعض دون البعض ، والمبالغة في موضعها من جملة المبالغة ، ( فنحن نعلم ) من رعايته المبالغة في موضعها ( أن اللّه ما اقتصر على وزن الذرة وثمة ) أي : فيما يشبه به العمل والخلق ( ما هو أصغر منها ) ، إذ لا يدخل تحت نية العبد ، فلا يكون له فيه كسب يفيد عنه فيه ، إذ لو دخل تحتها لم يكن في هذه الآية مبالغة ، لكن وقع الاتفاق على المبالغة فيها ، ( فقد جاء بذلك على سبيل المبالغة ) ، فإنهم اتفقوا على أن هذه الآية أجمع الآيات لدقائق الأعمال ( واللّه اعلم ) .
قال الشيخ رضي الله عنه : (وأمّا تصغيره اسم ابنه فتصغير رحمة ولهذا وصّاه بما فيه سعادته إذا عمل بذلك ، وأمّا حكمة وصيّته في نهيه إيّاه أنلا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ [ لقمان : 13 ] ، والمظلوم المقام حيث نعته بالانقسام ، وهو عين واحدة فإنّه لا يشرك معه إلّا عينه ، وهذ غاية الجهل ، وسبب ذلك أنّ الشّخص الّذي لا معرفة له بالأمر على ما هو عليه ول بحقيقة الشّيء إذا اختلفت عليه الصّور في العين الواحدة ، وهو لا يعرف أنّ ذلك الاختلاف في عين واحدة ، جعل الصّورة مشاركة للأخرى في ذلك المقام فجعل لكلّ صورة جزءا من ذلك المقام ، ومعلوم في الشّريك أنّ الأمر الّذي يخصّه ممّا وقعت فيه المشاركة ليس عين الآخر الّذي شاركه إذ هو للآخر ، فإذن ما ثمّة شريك على الحقيقة ، فإنّ كلّ واحد على حظّه ممّا قيل فيه إن بينهما مشاركة فيه ، وسبب ذلك ، الشّركة المشاعة ، وإن كانت مشاعة فإنّ التّصرّف من أحدهما يزيل الإشاعة ،قُلِ ادْعُو اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ[ الإسراء : 110 ] هذا روح المسألة ).
فقال رضي الله عنه : ( وأما تصغير ابنه ) في باب الحكمة العملية التي لم يأت فيها بما هو غاية الكمال في الأخلاق والأعمال ، وإنما بالغ في أن شيئا من الأعمال لا يضيع حياتها أصلا ، ( فتصغير رحمة ) ؛ لأن الصغر محل الرحمة ، فأشار إلى أنه وإن بلغ ما بلغ من الكمال في العلم ، فهو من جهة العمل صغير محل الرحمة ؛
لقوله عليه السّلام : " استقيموا ولن تحصوا " رواه ابن ماجة ؛
( لهذا أوصاه بما فيه سعادته ) كقوله تعالى :" يا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ في العبادة البدنية " وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ" في السياسة المدنية ،"وَاصْبِرْ عَلى ما أَصابَكَ" في المساعي الباطنية "إِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ" [ لقمان : 17 ] ، "وَل تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ " في حقوق الصحبة ،" وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً " في كسر النفس ،"إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ"[ لقمان : 18 ] ،
" وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ " في الأخذ بأوساط الأمور في الأخلاق ،" وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ" [ لقمان : 19 ] في كف الأذى عن الخلق إذا عمل بذلك ، فإن الحكمة العملية إنما تفيد السعادة بالعمل ، كما أن الحكمة النظرية تفيده بالاعتقاد الصحيح الجازم .
ثم أشار إلى ما هو أساس الحكمتين بحيث ينهدم بناؤهما بدون ذلك بقوله : ( وأما حكمة وصيته في نهيه إياه ) أي : ابنه عن الشرك ، إذ وصاه (أل تشرك باللّه ) كما قال تعالى :" وَإِذْ قالَ لُقْمانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ " [ لقمان : 13 ] ،
فهي الاحتراز عن الظلم العظيم ، فإن الشرك لظلم عظيم قائم بالاعتقاد الذي هو أصل الاعتقادات والأعمال بحيث لا يبقى شيء منها بدونه ، كمن أحسن طاعة سلطانه سنين ، ثم قصد قتله فلا يعدمه ما تقدم منه من طاعاته ، وكيف لا يعظم هذا الظلم ( والمظلوم المقام )
أي : ما به يقوم هذا المعتقد واعتقاده ، بل جميع الأكوان وهو اللّه سبحانه وتعالى ؛ لأن الشرك إما للصور بأنفسها وهو باطل ؛ لأن المراد المشاركة في الإلهية والصور ل تقوم بذواتها ،
فكيف يتصور لها الإلهية حتى تشارك فيها ، وبهذا بطل مشاركة الصورة للعين ، وإما بالعين التي في صورها وهو ظلم عظيم بالعين حيث وضعه في غير موضعه ، ( إذ نعته بالانقسام ) وهو يستلزم التركيب المحوج للأجزاء ، ( وهو عين واحدة ) ل تفتقر إلى شيء من الأجزاء ، ولا من غيرها في وجودها ، وتفتقر إليها الصور كله والتركيب ينافي ذلك ، وإذا كان المقام عين واحدة ، فلو فرض فيها الشركة ؛
فقال رضي الله عنه : ( فإنه لا يشرك معه إلا عينه ، وهذا غاية الجهل ) يحكم به هذا الاعتقاد ، وعلى خلاف ما عليه الأمر فهو غاية الظلم في حق أعظم الأمور الذي به قوام الكل وافتقارهم إليه في كل الأمور .
فقال رضي الله عنه : ( وسبب ذلك ) الجهل الموجب لهذا الظلم في الحكم المخل بقيومية من به قوام الكل ( أن الشخص الذي لا معرفة له بالأمر ) أي : بأمر الحق أنه الوجود المقوم لكل ما عداه من الموجودات ( ولا بحقيقة الأشياء ) ؛ لأنها لا وجود لها إلا من إشراق نور ذلك الوجود الحق
عليه ( إذا اختلف عليه ) أي : في نظره الصور الثابتة في العين الواحدة باعتبار إشراقها على أعيان الأشياء ، وهو لا يعرف ذلك الاختلاف ( للصور في عين واحدة ) ، إذ نظر أن لكل صورة عينا تخالف عين الصورة الأخرى مع المشاركة بين العينين ،
كم يقول العامة : إن الوجود المشترك بين الموجودات كلها (جعل الصورة مشاركة للأخرى في ذلك المقام ) الذي هو العين الواحدة المتشارك فيها باعتبار انقسامها إلى عينين تختص كل صورة بعين منهما ، لكن هذه الشركة على تقدير انتساب العين الواحدة إليهما تكون غير حقيقية ، فلا يصح اعتقادها ثابتة في الواقع على ذلك التقدير أيضا؛ وذلك لأنه (معلوم في) حق (الشريك) الواحد منها (أن الأمر الذي يخصه) أي : الذي هو حصة مختصة بذلك الشريك حال كونه قسم
(مم وقعت) أي : فرضت (فيه المشاركة) من العين الواحدة (ليس عين) الأمر (الآخر الذي شاركه) أي : فرض مشاركته ، (إذ هو) أي : الآخر (للآخر) أي : للشريك الآخر ، والمختص لشيء لا يكون عين المختص بالشيء الآخر .
فقال رضي الله عنه : ( فإذا ما ثمة ) أي : في الواقع على تقدير انقسام العين الواحدة شريك ( على الحقيقة ) ، إذ معنى الشركة أن تكون العين الواحدة لكل واحد من الشريكين ، وهاهنا ليس كذلك ( فإن كل واحد ) من الشريكين في العين الواحدة بعد قسمتها تكون ( على حظه ) المختص به ، وإن كان ( مما قيل فيه إن بينهما مشاركة فيه ) ، فالشركة متوهمة من هاهنا ، لكن إنما يتم هذا التوهم قبل القسمة ؛
وذلك لأن ( سبب ذلك ) الاشتراك ( الشركة ) المشاعة في ذلك المقام أولا ، ( وإن كانت ) أي : الشركة في العين الواحدة حال كونها ( مشاعة ) ، فل تكون تلك شركة في الإلهية إذ لا بدّ للإله من التصريف ، لكن حصوله من كليهم يستلزم التناقض ، ومن أحدهما تبطل إلهية الآخر ، فالأول : إما أن يتصرف بالكل أو بالجزء ، فيتعطل الجزء الآخر وهو باطل فيتعين الأول ، بل لا يمكن ( التصرف ) حينئذ ببعض الأجزاء أصلا ، فإن التصريف من أحدهما ( يزيل الإشاعة ) فلا تتصور الشركة في الإلهية لعبودتين ، بل إنه يكون لاسمين إلهيين يتصرف كل واحد منهما بكل تلك الغير ،
كم قال تعالى :( قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ [الإسراء: 110] هذا ) المذكور في إبطال الشركة ( روح المسألة ) ؛ فافهم واللّه الموفق والملهم .
ولم فرغ عن الحكمة الإحسانية التي هي رؤية العبد وبه ظاهرا في كل شيء ، ورؤية الرب صور أسمائه وآثارها فيه ، ومن تحقق بذلك بارّا ما يتصرف نيابة الحق في الخلق ، والتي هي فعل ما ينبغي لما ينبغي له ، إنما تحصل على العموم بالإمام الآمر بذلك عقبه بالحكمة الإمامية ؛ فقال : فص الحكمة الإمامية في الكلمة الهارونية
.
m8Koh6O4exM
 |
 |
البحث في نص الكتاب
يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!