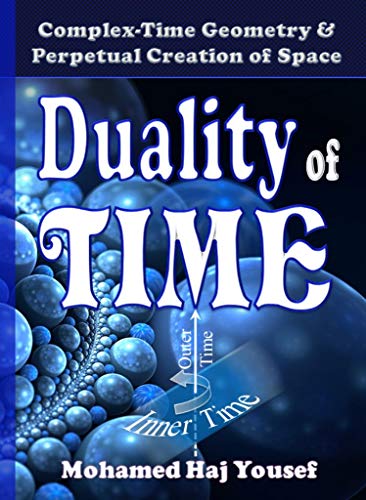كتاب خصوص النعم
في شرح فصوص الحكم
تأليف: الشيخ علاء الدين أحمد المهائمي
فص حكمة غيبية في كلمة أيوبية
 |
 |
فص حكمة غيبية في كلمة أيوبية
19 - فص حكمة غيبية في كلمة أيوبية .كتاب خصوص النعم فى شرح فصوص الحكم علاء الدين أحمد المهائمي
كتاب خصوص النعم في شرح فصوص الحكم الشيخ علاء الدين أحمد المهائمي
الفص الأيوبي
أي : ما يتزين به ويكمل العلم اليقيني المتعلق بالتجلي الغيبي ، ظهر ذلك العلم بزينته وكماله في الحقيقة الجامعة المنسوبة إلى أيوب عليه السّلام ، إذ ظهر له سر الحياة من الماء ، فاستفاد من الاغتسال فيه قوة تدبير النفس للبدن عن قوة الحياة حتى أصلحته وأزالت عنه مرضا غلبه مدة مديدة في أقل الأوقات ، وظهرت له الحياة المكمونة في أولاده الأموات ، وعبيده وضروعه وذروعه ، وسائر أمواله حتى علم بذلك حياة كل شيء ، ثم إنه كملها بما قويت النسبة بينه وبينهم ، حتى تم ظهورها فيهم بتدبير نفسه في أجسامهم بعد تدبيرها في جسمه .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( اعلم أنّ سرّ الحياة سرى في الماء فهو أصل العناصر والأركان ، ولذلك جعل اللّه من الماء كلّ شيء حيّ ، وما ثمّ شيء إلّا وهو حيّ ، فإنّه ما من شيء إلّا وهو يسبّح بحمد اللّه ، ولكن لا تفقه تسبيحه إلّا بكشف إلهيّ ، ولا يسبّح إلّا حيّ ، فكلّ شيء حيّ فكلّ شيء الماء أصله ، ألا ترى العرش كيف كان على الماء لأنّه منه تكوّن فطفا عليه فهو يحفظه من تحته ، كما أنّ الإنسان خلقه اللّه عبدا فتكبّر على ربّه وعلا عليه ، فهو سبحانه مع هذا يحفظه من تحته بالنّظر إلى علوّ هذا العبد الجاهل بنفسه ) .
( اعلم أنّ سرّ الحياة ) المعنى الفائض من صفة الحياة الأزلية فيضان نور الشمس منها على عالم الأجسام بواسطة الأرواح المدبرة لها ، ( سرى( أول ( في الماء ) قبل سائر العناصر والمواليد ؛ لكونه أعبد البسائط التي هي أصل المركبات ؛ لكونه ليس في كثافة في الأرض ، ولا في لطافة الهواء والنار بل بينهما ، وإذا سرى فيه سر الحياة دبره بالتكثيف تارة والتلطيف أخرى ، ( فهو أصل ) بقية ( العناصر ) ، فسرى فيه أصل الصفات الإلهية .
وهو ما جاء في التوراة : « إنّ اللّه خلق جوهرة ، فنظر إليها بنظر الهيبة فدابت وصارت ماء فتحرك ، فأوجبت حركته سخونته ، فتصاعد على وجهه زبد ، فتكون منه الأرض ، وارتفع منه بخار دخاني ، فتكون منه السماء ، وحصل فيه الهواء والنار بالتلطيف ، وبه أحدثا ليس من القدماء » .
( ولذلك جعل اللّه من الماء كل شيء حي ) أي : صورته ، وإن كان تركبه من العناصر الأربعة ، وأعطى فيه الغلبة لغيره كالتراب في الإنسان والنار في الجان ، ولا يختص هذا بالحيوانات والنباتات كما تتوهمه العامة ، إذ ( ما ثمة ) أي : في الواقع ( شيء إلا وهو حي ) ؛ لأن الحياة أول صفات الوجود ، فلا يفارق مظاهره ، وبها تدبيره للعالم ، ولا بدّ لكل شيء من مدبر ، فينبه بقاؤه وحفظه واستقراره في حيزه إن كان فيه وسيلة إليه إن خرج عنه ، بل هناك حياة وراء ذلك بها يسبحه ، فإنه ( وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ([ الإسراء : 44 ] كما ورد به النص .
وليس ذلك بلسان الحال فقط كما يظنه العوام ، إذ تفقهه الأكبر ، ) ولكن ) ورد النص في حقهم أنهم ( لا يفقهون تسبيحهم ) ، فلا بدّ ألا يفقه تسبيحه ( إلا بكشف إلهي ) يكشف عن عالم الملكوت الذي لا يفتر عن التسبيح الذي خلق الكل له ، فيكون تركه معصية ؛ ولذلك أردفه بقوله :إِنَّهُ كانَ حَلِيماً غَفُوراً[ فاطر : 41 ] أي : عمر غفل عن تسبيحه مع كمال حياته ، ولا يفتر عن تسبيحه من قصرت حياته ، ( ولا يسبح ) التسبيح الحقيقي ( إلا حي( ؛ لتوقفه على الشعور ، والمتوقف على الحياة فعلم أن كل شيء مسبح وكل مسبح حي ، ( فكل شيء حي ) وإن خفيت حياة البعض كالنبات والجمادات ، وعلم أيضا أن ( كل شيء ) حي ، وكل حي ( الماء أصله ) ، فكل شيء الماء أصله حتى الأركان العلوية التي اتفق الأكبر على أنها ليست عنصرية ، وقد صرح الشيخ - رحمه اللّه - بكون السماوات من دخان العناصر في الفص العيسوي .
( ألا ترى العرش كيف كان على الماء ؛ لأنه منه يكون ) ؛ وذلك لكونه مستوى اسمه الرحمن فيتعلق به التدبير الكلي العالم ، وهو بالحياة السارية أولا في الماء ، ( فطفا على ) الماء وإن صار أكثف منه لجملة سر الحياة على أقوى الوجوه بخلاف الأرض ؛ لأن سر الحياة فيها على أضعف الوجوه .
قال كعب : « خلق اللّه تعالى ياقوته خضراء ، ثم نظر إليها بالهيبة ، فصارت ماء ترتعد ، ثم خلق الريح فجعل الماء على متنها ، ثم وضع العرش على الماء » . رواه القرطيى في التفسير والبغوي في التفسير
""الحديث : (عن ابن عباس، رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لما أراد الله عز وجل أن يخلق الماء خلق من النور ياقوتة خضراء، غلظها كغلظة سبع سماوات وسبع أرضين وما فيهن وما بينهن، ثم دعاها، فلما أن سمعت كلام الله عز وجل ذابت الياقوتة فرقا حتى صارت ماء، فهو مرتعد من مخافة الله عز وجل إلى يوم القيامة، وكذلك إذا نظرت إليه راكدا أو جاريا يرتعد، وكذلك يرتعد في الآبار من مخافة الله إلى يوم القيامة، ثم خلق الريح فوضع الماء على الريح، ثم خلق العرش، فوضع العرش على الماء، فذلك في قوله تعالى: {وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا} [هود: 7] .....) رواه الأصبهاني في العظمة "".
ومعناه : أنه أشار بالياقوتة الخضراء إلى الحقيقة المثلثة والنشأة الكلية لمحمد صلّى اللّه عليه وسلّم ، إذ ليست في بياض المجردات ، ولا في سواد الماديات ، ونظر الهيبة هو خطاب الحق لها بما تفضضت عرقا ، فهو ذوياتها الموجب صيرورتها ماء ، وخلق اللّه الريح إشارة إلى تحملها سر الحياة الموجبة للتنفس ، ووضعه عليه جعله حاملا سر الحياة التي يتوقف عليها التدبير والتصرف .
وإلى ما ذكرنا أشار الشيخ رحمه اللّه في رسالته المسماة ب "عنقاء المغرب في معرفة ختم الأولياء وشمس المغرب " ؛ لأن محمدا عليه السّلام لما أبدعه اللّه سبحانه حقيقة مثلية ، ونشأة كلية حيث لا ابن ولا بنين .
وقال له : « أنا الملك ، وأنت الملك ، وأنا المدبر ، وأنت الفلك ، وسآتيك فيما يتكون عنك من مملكة عظمي ، وطامة كبرى ساسا مدبرا وناهيا ،
وأمرا عظيما على حد ما أعطيك ، وتكون فيهم كما أنا فيك ، فليس سواك كما ليس سواي ، فأنت صفاتي فيهم وأسمائي ، فخذ الحد وأنزل العهد ، وسأسألك بعد التنزيل عن اليقين والقطمير ، فتقصص لهذا الخطاب عرقا حيّا » ؛ فكان ذلك العرق الظاهر ، وهو الماء الذي نبأ به الحق سبحانه في صحيح الأنباء ، فقال :وَكانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ[ هود : 7 ] .
ثم قال : « فلما علم الحق تعالى إرادته ، وأجرى في إمضائها عادته نظر إلى ما أوجده في قلبه من مكنون الأنوار ، ورفع عنها ما اكتنفها من الأستار ، فتجلى له من جهة القلب والعين حتى كاثف النور من الجهتين، فخلق سبحانه من ذلك النور المنفهق عنه صلّى اللّه عليه وسلّم العرش".
هذا كلامه ومعناه على ما تلوح للخاطر الفاتر : أنه عزّ وجل أبدع لرسوله محمد صلّى اللّه عليه وسلّم حقيقة نورية روحية أولا ، ثم حقيقة مثلية جسمية ، وأشار إلى أن جميع حقائقه كلية شاملة لسائر الحقائق ، وأن الحقيقة المثلية قبل خلق المكان ؛ لأنه من عالم الأجسام ،
ثم قال له : إن الملائكة منحصرة فيه ، إذ لا إله غيره ، والتملكية منحصرة في حبيبه صلّى اللّه عليه وسلّم ، ومثل ذلك بالروح الفلكي مع الفلك المحيط بالكل ، والمراد بالسائس والمدبر القلب ، وبالأمر والناهي العقل .
ثم قال : « تعطيها إنها الروح على حد ما أعطيك من الفيض ، فإنه إنما يصل الفيض الإلهي بواسطة الروح والضمير"
في قوله : « فيهم » يعود إلى قوى القلب والعقل من المدركات والمحركات ،
وقوله : « فأنت صفاتي فيهم وأسمائي » أي : حامل أسرارهما ؛
فلذلك قال : « فخذ الحد » أي : فلا تدع الربوبية لنفسك ، و « أنزل العهد » أي : عهد العبودية المشار إليها بقوله :قالُوا بَلى ،
وقوله : « وكان ذلك العرق » ما أشاره إلى تكون عالم الأركان بعد عالم المثال ، والمراد بالعين : القوى المدركة ، وتكاثف النور من حيث تعلقه بالأجسام ، فازداد الماء المتكون فيه لكثافة أصله كثافة صار منها العرش ؛ فافهم ، فإنه مزلة للقدم .
وإذا كان طفو العرش من قوة الحياة ، وهي من الماء والحياة هي الحافظة المدبرة للجسم ، ( فهو ) أي : الماء ( يحفظه من تحته ) ولا عجب فيه ، فإن له مثالا أشار إليه بقوله :
( كما أن الإنسان خلقه اللّه عبدا ) من شأنه أسفل أبدا ، ( فتكبر ) عن غاية جهلة تنفسه ( على ربه ) الذي نار الكبر داؤه فبقيت ربوبيته ، (وعلا عليه ) ، فادعى الربوبية لنفسه ،
( فهو ) أي : اللّه ( سبحانه ) إشارة إلى تنزهه عن أن شارك في كبريائه وعلوه فضلا عن أن ينفيا عنه ويثبتا لغيره ( مع هذا ) التكبر والعلو منه عليه ( يحفظه من تحته ) ؛ فإنه له تعالى نسبة التحت أيض ( بالنظر إلى علو هذا العبد الجاهل بنفسه ) ، وهذه النسبة التحية ، وإن كان منشأها جهل هذا العبد ، فهي نسبة ثابتة باعتبار آخر تثبت معه نسبة الفرق له ، وإن نفاها هذا الجهل .
قال الشيخ رضي الله عنه : (وهو قوله عليه السّلام : « لو دليتم بحبل لهبط على اللّه » فأشار إلى نسبة التّحت إليه كما أنّ نسبة الفوق إليه في قوله :يَخافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ [ النحل : 50 ] ،وَهُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ[ الأنعام : 18 ] ، فله الفوق والتّحت ، ولهذا ما ظهرت الجهات السّتّ إلّا بالإنسان وهو على صورة الرّحمن ، ولا مطعم إلّا اللّه ، وقد قال في حقّ طائفة :وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقامُوا التَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ[ المائدة : 66 ] ، ثمّ نكّر وعمّم ؛ فقال :وَما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ [ المائدة : 66 ] ، فدخل في قوله :وَما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ[ المائدة : 66 ] ، كلّ حكم منزل على لسان رسول أو ملهم ،لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ[ المائدة : 66 ] ، وهو المطعم من الفوقيّة الّتي نسبت إليه ،وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ [ المائدة : 66 ] وهو المطعم من التّحتيّة الّتي نسبها إلى نفسه على لسان رسوله المترجم عنه صلّى اللّه عليه وسلّم ، ولو لم يكن العرش على الماء ما انحفظ وجوده ، فإنّه بالحياة ينحفظ وجود الحي ).
وهو أي : الدليل على ذلك ( قوله عليه السّلام : « لو دليتم بحبل لهبط على اللّه ») باعتبار ماله من نسبة التحت ،
( فأشار إلى أن نسبة التحت إليه ) ؛ لأن قوامه به ، ( كما أن نسبة الفرق إليه المذكورة في قوله :يَخافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ[ النحل : 50 ] ، وقوله :وَهُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ) [الأنعام : 18 ] .
وإذا ثبت ( له الفوق ) بالقرآن ( والتحت ) بالحديث قلة الفوق ، وإن نفاه الجاهل المتكبر المتعالي عليه والتحت ، وإن نفاه العامة وهما الجهتان الحقيقيتان المحتجبتان إلى المقوم لهما بالوجود بخلاف الجهات الست ، فإنها باعتبارته لتبدلها بتبدل أوضاع الإنسان .
""أضاف الجامع :
وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطً (126) سورة النساء
وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَمُحِيطٌ (47) سورة الأنفال
إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَمُحِيطٌ (92) سورة هود
أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍمُحِيطٌ (54) سورة فصلت
وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ (20) سورة البروج ""
( ولهذا ) أي : والاختصاص الحق بالجهتين الحقيقيتين المتحدد بهما محيط العالم ، ومركزه دون الجهات الست ( ما ظهرت الجهات الست إلا بالإنسان ) من حيث أن له عبد قيامه الذي هو الوضع الطبيعي له رأسا ورجلا ووجها وظهرا ويدين إحديهما أقوى من الأخرى ، غالبا يتعين بذلك ما تقرّب من كل واحد منهما ، ويتبدل بتبدل توجهاته ، ( وهو على صورة الرحمن ) المستوي على المحدد للجهات ، فنسب إليه الجهات لست بواسطته ، وإلا فالمحدد إنما حدد بالذات جهة الفوق ما يقرب من المحيط ، وجهة التحت ما هو غاية البعد منه ، وحفظ الحق يلحق بهاتين الجهتين لا غير ، والدليل عليه أنه ( لا مطعم إلا اللّه ) ، وهو من أسباب الحفظ ، ولا فرق بين هذا السبب وبين غيره .
( وقد قال في حق طائفة ) : لو كانوا كما قال فهم أكمل الطوائف ما يدل على انحصاره في الجهتين في حقهم ، فغيرهم أولى بألا يزيد لهم جهة أخرى ،وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقامُوا التَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ[ المائدة : 66 ] ، (ثم نكّر ) ولم يقصد به الأفراد بل ( عمّم ) ؛ حتى يدل على أنه لا جهة للإطعام سواهما أصلا ، ( فقال ) :وَما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ[ المائدة : 66 ] ،
( فدخل ) بطريق التصريح بعد دخوله في إقامة التوراة والإنجيل بطريق من الطرق ( في قوله :وَما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ) كل أمر حكيم أي : محكم مؤيد بموافقة الكتاب والسنة والأدلة العقلية غير متزلزل بوجه من الوجوه ، وفي بعض النسخ ( كل حكم منزل على لسان رسول ) في الظاهر ، ( أو ملهم ) في الباطن لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ ،ولا أكل في جهة ما لم يكن الموكل منسوبا إليها ، وهو واحد ؛
ولذلك يقول : هو المطعم من الجهة الفوقية ، وكيف لا وهي ( التي نسبت إليه ) في الكتاب ، ونفي الجهة عنه إنما بطريق تحيزه فيها ،وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ،( وهو المطعم من التحية التي نسبتها إلى نفسه ) ، وإن لم ينص عليها في كتابه ، بل يكفي في ذلك كونه ( على لسان رسوله المترجم عنه صلّى اللّه عليه وسلّم ) ، فلا يقول عنه ما لم يقل ، فليس سواها بمجرد قول الجاهل المذكور ، فلا يبعد موافقة قوله الحق على أنه ليس على الوجه الذي توهمه .
ولما انحصر الحفظ في هاتين الجهتين ، وحفظ كل حي بحياته وحياة العرش فائضة عن الماء ، ثبت أنه (لو لم يكن العرش على الماء ما انحفظ وجوده ) ، وإن كان وجود ما ليس على الماء ، ولو من الأشياء المخلوقة منه محفوظا بدون كونه على الماء ، إذ حياته التي بها استوى اسمه الرحمن عليه لتدبير العالم منوطة بالماء ، فإنها وإن كانت بالنفس المنطبعة فيه لكن لا بد لتعلقها به من اعتدال المزاج ، وليس ذلك إلا بهذا الماء الحامل له ، وإلا فليس فيه طبائع مختلفة فضلا عن حصول المزاج منها ، وإذا كانت حياته به فحفظه به ؛ ( فإنه بالحياة يحفظ وجود الحي ) وإن انحفظ بدونها وجود أجزائه ، واستدل عليه بالاستقراء والتمثيل .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( ألا ترى أنّ الحيّ إذا مات الموت العرفيّ تنحلّ أجزاء نظامه وتنعدم قواه عن ذلك النّظم الخاصّ ؟
قال تعالى لأيّوب :ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هذا مُغْتَسَلٌ بارِدٌ[ ص : 42 ] يعني ماء بارد ؛ وشراب لما كان عليه من إفراط حرارة الألم فسكّنه اللّه ببرد الماء ، ولهذا كان الطّبّ النّقص من الزّائد ، والزّيادة في النّاقص ، والمقصود طلب الاعتدال ، ولا سبيل إليه إلّا أنّه يقاربه ،
وإنّما قلنا : ولا سبيل إليه ، أعني الاعتدال من أجل أنّ الحقائق والشّهود تعطي التّكوين مع الأنفاس على الدّوام ، ولا يكون التّكوين إلّا عن ميل يسمّى في الطبيعة انحرافا أو تعفينا ، وفي حقّ الحقّ إرادة وهي ميل إلى المراد الخاصّ دون غيره .
والاعتدال يؤذن بالسّواء في الجميع وهذا ليس بواقع فلهذا منعنا من حكم الاعتدال ، وقد ورد في العلم الإلهيّ النّبويّ اتّصاف الحقّ بالرّضا والغضب ، وبالصّفات والرّضا مزيل للغضب ، والغضب مزيل للرّضا عن المرضيّ عنه والاعتدال أن يتساوى الرّضا والغضب ؛ فما غضب الغاضب على من غضب عليه وهو عنه راض ، فقد اتّصف بأحد الحكمين في حقّه وهو ميل ، وما رضي الحقّ عمّن رضي عنه وهو غاضب عليه ؛ فقد اتّصف بأحد الحكمين في حقّه وهو ميل ).
فقال رضي الله عنه : ( ألا ترى أن الحي إذا مات الموت العرفي ) ، فيدبه للإشعار ببقاء نوع حياة في أجزائه بل في جملته بلا بنية سيما في روحه (تنحل أجزاء نظامه ) الجسمانية العنصرية ، فتصير إلى أحيازها ، وتنفك بعضها عن بعض بعد امتزاجها ، ( وتنعدم قواه عن ذلك النظم الخاص ) بأجزاء جسمه ، وإن كانت باقية منتظمة بروحه وقلبه بوجه ونظام آخر ، حتى يدرك بذلك اللذة وآلام الواقع له في عالم البرج .
ولما فرغ عن بيان هذه المقدمات أعني : سريان سر الحياة في الماء ، وأفادته الحياة لما حمله على أكمل الوجوه ، وحفظه من تحته شرع في المقصود منها في حق أيوب عليه السّلام ؛ ( فقال : قال اللّه تعالى :ارْكُضْ بِرِجْلِكَ) [ ص : 42 ] .
أي : اضرب برجلك الأرض ؛ ليحصل لك من الجهة السفلية المناسبة لجسمك تدبيره بما ينبع منها من الماء الحامل سر الحياة ، مع دفع وجوه الأذيّات من الظاهر والباطن ، فضربها فنبعت عين ، فقيل :هذا مُغْتَسَلٌ.
ولما توهم من سكانته عليه السّلام أنه ذو دواء يغسل العلة غير أنها إذا لم يعتد جعله ذو المثل هذه العلة بينه بقوله : ( يعني ماء ) ، ثم بيّن وجه كونه دواء ، وإن كان على خلاف العادة بأنهبارِدٌ ،فصار دافع ( لما كان ) أيوب عليه السّلام ( عليه إفراط حرارة الألم ) ، وهذه الحرارة المفرطة ، وإن لم تجر العادة بزوالها ببرودة الماء ، ولكن جعل اللّه ذلك أنه في حقّه ، ( فسكنه اللّه ببرد الماء ) ، وهو سبحانه وتعالى ، وإن كان قادرا على الأشياء بلا واسطة ، فلا بدّ لرفع أحد الضدين من الضد الآخر ، فكان برد الماء ضدّا لإفراط حرارة الألم .
قال رضي الله عنه : ( ولهذا ) أي : ولأجل أن أحد الضدين لا يندفع إلا بالضد الآخر ، (كان الطّبّ ) فعل أمرين جميعا معا أو على الترتيب ( النّقص من ) الخلط (الزائد ) المتصف بأحد الضدين ، ( والزيادة في ) الخلط ( الناقص ) المتصف بالضد الآخر ، وإذا استويا دفع كل واحد سورة الآخر إلى أن يستوي المزاج الموجب كمال الحياة الموجبة حفظ النظام وكمال الأفعال ؛ ولذلك كان المطلوب من هذا النقص والزيادة طلب الاعتدال ، فلا يكتفي بأي مقدار حصل من الزيادة والنقصان بل لا بدّ من ( طلب الاعتدال ) ،
وإن كان ( لا سبيل إليه ) على الوجه الحقيقي ( إلا ) أنه أي : المطلوب حصول ( ما تقاربه ) ، فيكون له حكم الاعتدال واسمه .
قال رضي الله عنه : ( وإنما قلنا : لا سبيل إليه أعني : الاعتدال ) بينه ؛ لئلا يتوهم عوده على طلبه مع أن الطلب ليس بمحال ، وإنما هو حصول المطلوب من هذا الوجه ( من أجل أن الحقائق ) أي : علم الحقائق ودلائلها والشهود إنما ذكره ؛ لأنه ربما يمنع تلك الدلائل ( تعطي التكوين ) أي : تبدل كل شيء من حال إلى حال ( مع ) مقادير ( الأنفاس على الدوام ) ؛ لدوام غلبة من حركات الأفلاك التي لا تسكن أصلا ، ( ولا يكون التكوين ) ؛ لكونه حركة في الكيف أو الكلم ( إلا عن مثل في ) المكون الفاعل ، والمكون القابل وهو ( الطبيعة ) القابلة لتلك الأحوال المتبدلة يسمى ذلك الميل في الطبيعة ( انحرافا ) إن قرب من الاعتدال ، ( أو تعفينا ) إن بعد منه ، ( وفي حق الحق إرادة ) ؛ لأن اسم الميل يوهم عدم العدل ؛ ولكن لما كانت صفة توجب تخصص أحد المقدورين : (هي ميل إلى المراد الخاص دون غيره ) مع استواء نسبتهما إلى قدرته ، وحينئذ لا يكون فيها اعتدال إذ ( الاعتدال يؤذن بالسّواء ) أي : استواء الأمرين (في الجميع ) أي :
في جميع الصور والتي فيها الاعتدال سواء كان في حق الحق والخلق جميعا ، وإن كان في حق الحق يوجد الاعتدال في قدرته ، لكن لا حكم لها بدون الإرادة ، وكيف لا يكون في إرادة الحق ميل .
قال رضي الله عنه : ( وقد ورد في العلم الإلهي ) ، ولما توهم أن العلم المنسوب إلى الفلاسفة بينه بقوله ( النبوي اتصاف الحق بالرضا والغضب ، وبالصفات ) المتقابلة التي لا تخص الأشياء بظهور بعضها دون بعض إلا بالميل لامتناع اجتماعها ؛ وذلك لأن ( الرضا مزيل للغضب ) في حق المرضي عنه ، ( والغضب مزيل للرضا ) عن المغضوب عليه ، بل ( عن المرضي عنه ) لبعض الأسماء ، فإن الضال مرضي للاسم المضل ،
لكن الاسم القهار المنتقم مزيل تحكم هذا الرضا ، وإذ زال حكم أحدهما بالآخر بالكلية ، فليس فيه اعتدال إذ ( الاعتدال بتساوي الرضا والغضب ) " في نسخة : « يتساوى الرّضا والغضب » "
ولو على سبيل التقريب ، كاستواء حكم الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة في المزاج ، وليس هنا كذلك .
قال رضي الله عنه : ( فما غضب الغاضب على من غضب عليه وهو عنه راض ) حتى يتصور الاجتماع بينهما فيتفرع عليه الاعتدال ، ( فقد اتصف ) الغاضب ( بأحد الحكمين ) فقط (في حقه ) ، وإن كان متصفا بهما في الجملة ،
قال رضي الله عنه : ( وهو ) أي : اتصافه في حق أحدهما بصفة ، وفي حق الآخر بأخرى مع أنه متصف بهما في الجملة ( ميل ) ، سيما باعتبارات لا تعطيه حكم الرضا الذي لبعض أسمائه بالنسبة إلى المغضوب عليه ، ( وما رضي الحق عنهم ، وهو غاضب عليه ) ،
وإن كان لبعض الأسماء كالمضل الغضب عليه ، وكذا للاسم القهار والمنتقم إذا كان غاضبا مغفورا له ، ( فقد اتصف بأحد الحكمين في حقّه ) مع أنه قد يتصف بالحكمين معا في حق العصاة ، ( وهو ميل ) ، فلا اعتدال في ذلك ، وتسمية الحق عدلا ليس باعتبار الاستواء ، بل باعتبار كون ما فعل بهم جزاء وفاق .
قال الشيخ رضي الله عنه : (وإنّما قلنا هذا من أجل من يرى أنّ أهل النّار لا يزال غضب اللّه عليهم دائما أبدا في زعمه فما لهم حكم الرّضا من اللّه فصحّ المقصود ، فإن كان كما قلنا مآل أهل النّار إلى إزالة الآلام وإن سكنوا النّار ، فذلك رضا فزال الغضب لزوال الآلام ، إذ عين الألم عين الغضب إن فهمت ، فمن غضب فقد تأذّى ، فلا يسعى في انتقام المغضوب عليه بإيلامه إلّا ليجد الغاضب الرّاحة بذلك ، فينتقل الألم الّذي كان عنده إلى المغضوب عليه .
والحقّ إذا أفردته عن العالم يتعالى علوا كبيرا عن هذه الصّفة على هذا الحدّ ، وإذا كان الحقّ هويّة العالم ، فما ظهرت الأحكام كلّها إلّا منه وفيه ، وهو قوله تعالى : وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ حقيقة وكشفا فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ [ هود : 123 ] حجابا وسترا ، فليس في الإمكان أبدع من هذا العالم لأنّه على صورة الرّحمن ، أوجده اللّه أي : ظهر وجوده تعالى بظهور العالم كما ظهر الإنسان بوجود الصّورة الطّبيعيّة ، فنحن صورته الظّاهرة وهويّته تعالى روح هذه الصّورة المدبّرة لها .
فما كان التّدبير إلّا فيه كما لم يكن إلّا منه ؛هُوَ الْأَوَّلُ بالمعنى وَالْآخِرُ بالصّورة ، وهو الظَّاهِرُ بتغيّر الأحكام والأحوال الْباطِنُ بالتّدبير ، والله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [ الحديد : 3 ] فهو على كلّ شيء شهيد ، ليعلم عن شهود لا عن فكر ، فكذلك علم الأذواق لا عن فكر ، وهو العلم الصّحيح ، وما عداه فحدس وتخمين ليس بعلم أصلا ).
قال رضي الله عنه : ( وإنما قلنا هذا ) أي : كون الغضب مزيلا لحكم الرض ( من أجل من يرى أن أهل النار ) من الكفار ( لا يزال غضب اللّه عليهم دائما ) ، ولو حال نضج جلودهم قبل حصول البدل بأن يكون حصول البدل قبل تمام النضج أو يتم النضج ، ولكن يكون لهم عذاب عقلي أو خيالي أو بالنار في بواطنهم ، ولا ينضج ( أبدا ) ولو بعد استيفاء الحقوق غير الكفر ، ( فما لهم حكم الرضا من اللّه ) وهو إزالة الآلام عنهم ، وإن كان راضيا بكونهم معذبين أو باعتبار بعض أسمائه كالمضل والمذل ، ( فصح المقصود ) من بيان الميل وإلا كانا مجتمعين ، ولو بلا اعتدال فلا يكون ميلا كليّ .
قال رضي الله عنه : ( فإن كان كما قلنا مآل أهل النار ) عند نضج الجلود قبل حصول البدل بعد استيفاء الحقوق غير الكفر ( إلى إزالة الآلام ) الحسية والعقلية والخيالية ،
قال رضي الله عنه : ( وإن سكنوا النار ) فتألموا بصورتها بما علموا أنها المحرقة لهم المؤلمة عند حصول البدل عن قريب ؛ ( لذلك رضي ) ، وإن قل زمانه بحيث لا يعتد به ، فلا يسمى الحق بذلك راضيا عنهم ، ولكن هذا الحكم نقيض حكم الغضب ، والحكم لا يتخلف عن التسبب ، ( فزال الغضب ) حينئذ وإن كان يعود في حقهم عن قريب ؛ لأنه لم يبق في حقهم إرادة الانتقام في ذلك الوقت ( لزوال الآلام ) التي بها الانتقام ،
ومراد الحق واقع لا محالة ، ولا معنى لغضب الحق سوى إرادة الانتقام ، إذ هو بالمعنى الحقيقي محال في حقّ الحق ، ( إذ عين الألم ) المحال في حق اللّه تعالى ( عين الغضب ) بالمعنى الحقيقي ( إن فهمت ) حقيقة الغضب ، وهو غليان دم القلب وخروجه إلى سائر البدن .
قال رضي الله عنه : ( فمن غضب ، فقد تأذى ) بما ذكرنا ، وهو ألم ، ( فلا يسعى في انتقام المغضوب عليه بإيلامه إلا لنجد الغاضب الراحة عن ذلك ) الألم بذلك الانتقام ، إذ يرجع به الذم إلى مكانه ، ويسكن غليانه .
قال رضي الله عنه : ( فينتقل الألم الذي كان عنده إلى المغضوب عليه ) أي : يزول عن الغاضب ألم ، ويحصل بدله في المغضوب عليه ، وإن تخالفا بالشخص والنوع والسبب ، وهذا المعنى لا يتصور في حق الحق أصلا ، إذ ( الحق إذا أفردته عن العالم ) أي : عن ظهوره في العالم ، وإيجاده له ، وتدبيره وتصرفه فيه .
قال رضي الله عنه : ( يتعالى علوّا كبيرا عن هذه الصفة ) أي : صفة الغضب إذ لا يتصور في شأنه الذم ولا غليانه ولا تأمله ، وإنما هو بمعنى إرادة الانتقام بخلاف ما إذا اعتبر ظهوره فيه ، فإنه تلحقه هذه الصفات المحدثة "(على هذا الحد.)"، وإليه الإشارة بقوله :
قال رضي الله عنه : ( وإذا كان الحق ) بإشراق نور وجوده على حقائق العالم ( هوية العالم ) أي : كونه ، ( فأظهرت الأحكام ) كالغضب بالمعنى الحقيقي والانتقام واللطف والإنعام ( إلا ) فيه أي : في صور ظهوره .
( ومنه ) أي : من ظهوره بصفة القهر والحلال أو اللطف والجمال أو غير ذلك ، وهو أي : دليل ظهور الأحكام ( فيه ) ، ومنه قوله :(وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ [هود : 123] حقيقة وكشفا)،
وإن رجع بعضه إلى غيره حجابا وسترا ، فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ عبادة وتوكلا يرجعان إليك حجابا وسترا ، وهما من أفعاله في صور ظهوره في مرآتك ؛ فهو الموجد لهما ،
وإن كان لك كسبهما تكون صورته التي هي مجليهما منطبعة في مرآتك حديث فيها بنظره إليها ، وإن لم يكن صورة في ذاته ؛ ولذلك لا يسمى عابدا متوكلا إذ لا يتصف بهما في ذاته ،
بل في ظهوره بصورة ليست له في ذاته ، وهي لك حجابا وسترا ، وإذا كان الكل راجعا إلى الحق بكونهم صور أسمائه ، وكون أحكامهم ظاهرة فيه ومنه ، ولا كمال وراء كماله ،
قال رضي الله عنه : ( فليس في الإمكان أبدع ) أي : أكمل ( من هذا العالم ) ، وإن كان مشتملا على النقائض والشرور ؛ ( لأنه على صورة الرحمن ) ، وهو الاسم المفيض للوجود العام الشامل على سائر الأسماء المفيضة إذ ( وجده اللّه ) بإشراق نوره على أعيانه ، وهو نور واحد قبل كل عين منه ما يسعها ولا نقصان ، ولا شر في إشراقه ، وإنما هما من أعيان العالم ، ولا يمكن تبديلهما لامتناع قلب الحقائق ؛
ولكون إيجاده على صور أسماء الحق صح فيه أن يقال : ( أي : ظهر وجوده تعالى بظهور العالم ) ؛ لأن الوجود العام الشامل على صور الأسماء صورة وجود الحق الشامل على أسمائه صارت في المرايا محسوسة بعد ما كانت في ذاته معقولة .
وهذا الظهور للحق بهذه الصورة مع تنزهه عنه ( كما ظهر الإنسان ) ، أي : روحه مع تنزيهه عن الصورة المحسوسة في ذاته ( بوجود الصورة الطبيعية ) لبدنه ظهر فيها بالتدبير ، وسائر ما فيه من المعاني تصورت فيه بالصور المحسوسة كالسمع والبصر وغير ذلك ، وإذا كان العالم للحق بمنزلة الصورة الطبيعية لنا ، ( ونحن ) من العالم فنحن ( صورته الظاهرة ) أي : صور ظهوره في الظاهر ، وإن لم يكن له صورة في ذاته ، ولا في ظهوره في ذاته (وهويته ) أي : ذاته ( روح هذه الصورة ) إذ هي ( المدبرة لها ) تدبير أرواحنا لأبداننا ، وإذا كان هو المدبر ومحل التدبير محل ظهوره ، ( فما كان التدبير إلا فيه ) من حيث ظهوره بالصور ( كما لم يكن ) التدبير من حيث المبدأ إل ( منه ) ، فالكل بطريق المعنى فيه ، وقد تصور ذلك المعنى في ظهوره في المظاهر .
قال رضي الله عنه : ( فهو ) أي : الحق تعالى هُوَ الْأَوَّل ُأي : المبدئ كل صورة (بالمعنى ) الذي ظهر به ، ( وَالْآخِرُ بالصورة ) المرتبة على ذلك المعنى الذي صار صورة محسوسة بعد كونه معنى معقولا ، ( وهو ) الظَّاهِرُ لا بالصورة ، وإن قلنا أنه ظهر وجوده تعالى بظهور العالم ، فإن ظهوره به ليس من حيث كونه صورة إذ لا صورة له تعالى ،
بل من حيث دلالته عليه وهو ( بتغير الأحكام والأحوال ) ؛ لأن التغيير فيها يدل على أنها ليست من ذوات الأشياء بل مبدأ آخر هو كالروح لها ؛
ولذلك قلنا : هو( الْباطِنُ بالتدبير ) نعم ظهر ما فيه من المعنى بالصور بطريق التمثيل ، لكنه غير الظهور الحقيقي المطلوب بالدلالة ، فلا يحمل ما في القرآن عليه مع أنه لا يحمل للآخر سواه ، فلو حمل عليه الظاهر تكرر .
وإذا عرفت هذا فخذه فيما نحن فيه ، فالحق هو الأول القائم به معنى الحياة السارية في الماء والآخر بصورة الماء ، والظاهر بما فيه من التغيير العلة وغسلها ، والباطن بتدبير الصحة ، وكيف لا يكون باطنا بالتدبير ، والله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [ الحديد : 3 ] ،
فيعلم عواقب الأمور ، فيعلم بما ينتظم بها تلك العواقب ، وكيف لا يعلم كل شيء ، وإنما تصور به ليشاهد وجوه تجلياته ؟
فهوعَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ، فأوجه كل شيء ( ليعلم ) تجلياته ( عن شهود ) بصري ( لا عن فكر ) أي : لا عن علم الحاصل بالفكر في الأمور المغيبة من حيث غيبه المعلوم عن البصر ، وإذا كان مطلوب الحق الشهود دون الاكتفاء بعلمه مع كمال علمه في ذاته ، فهو كمال بعد كمال ؛
قال رضي الله عنه : ( فكذلك علم الأذواق ) إنما يكمل إذا كان عن شهود ( لا عن فكر ) مع غيبة العلوم ، فهو مطلب الكمّل ، كيف ( وهو العلم الصحيح وما عداه ) سواء حصل المقدمات النظرية أو بالنقل ،
( فحدس ) إن لم يتزلزل بأدنى شبهة ، ( وتخمين ) إن تزلزل به ( ليس بعلم أصلا ) ، وإن كان الحدس شبه الضروريات بل منها لكن فيه خفاء يوجب التردد بالتسكيك ، فأيوب عليه السّلام وإن علم ذلك بالفكر أشهده الحق ذلك في نفسه ؛ فافهم .
قال الشيخ رضي الله عنه : (ثمّ كان لأيّوب عليه السّلام ذلك الماء شرابا لإزالة ألم العطش الّذي هو من النّصب والعذاب الّذي مسّه به الشّيطان ، أي : البعد عن الحقائق أن يدركها على ما هي عليه ، فيكون بإدراكها في محلّ القرب ، فكلّ مشهود قريب من العين ولو كان بعيدا بالمسافة ، فإنّ البصر يتّصل به من حيث شهوده ولولا ذلك لم يشهده أو يتّصل المشهود بالبصر ، كيف كان ؟ فهو قرب بين البصر و المبصر ، ولهذا كنّى أيّوب عليه السّلام في المسّ ، فأضافه إلى الشّيطان مع قرب المسّ ؛ فقال : البعيد منّي قريب لحكمة فيّ ، وقد علمت أنّ القرب والبعد أمران إضافيان ، فهما نسبتان لا وجود لهما في العين مع ثبوت أحكامها في القريب والبعيد ).
ثم أشار إلى أن من فوائد ذلك الماء من حيث جهله سر الحياة كشف الحقائق ، كما أن من فوائده إزالة العلل عن البدن ؛
فقال رضي الله عنه : ( ثم كان لأيوب عليه السّلام ) بطريق المعجزة ( ذلك الماء شرابا ) كما ورد به القرآن ، وإنما ورد دفعا لشكوى الألم ، والشراب إنما يدفع ألم العطش ، ويكفي لدفعه كل ماء ولاصق فيه على الخلائق حتى يشتكي من أجله إلى الخالق ، فهو ( لإزالة ألم العطش ) إلى الاطلاع على الحقائق ، وله ألا يندفع إلا بدفع اللّه تعالى ، فيحتاج فيه إلى الشكوى عنده ؛ وذلك لأنه الذي ( هو من النصب ) أي : الشدة ؛ وذلك لشدة شوقه إلى ذلك ، ( والعذاب ) من التحيز في ذلك ، وهذا النصب والعذاب هو ( الذي مسه به الشيطان ) ؛ لأنه الذي ليس عليه الحقائق حتى تحيز ، واشتد شوقه إلى الاطلاع عليها ، فهو الحجاب عنها كما ورد في الخبر : « لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم ، لنظروا في ملكوت السماوات والأرض » . رواه أحمد وابن أبي شيبة .
فهو بوسوسته يشوق إلى تحصيلها ، ويمنع عن الوصول إلى ما اشتاقوا إليه ، فيشتد عليه الأمر ، ويتعذب به لبعده عن المحبوب بحجابه مع قربه في نفس الأمر وإلى هذا يشير لفظ الشيطان من حيث اشتقاقه من الشطن ، وهو البعد .
فلذلك فسره بقوله : ( أي : البعد عن الحقائق ) لا في الواقع لدوام قربها منه ، بل عن ( أن يدركها على ما هي عليه ) مع أنه مستشعر بها فيشتاق إليها ، فأزال اللّه عزّ وجل شكواه بالكشف عنها ، ( فيكون بإدراكها في محل القرب ) عنها ؛ ليزول عنه النصب والعذاب عن البعد عنها ، وكيف لا يكون بالكشف في حالة القرب ، وهو موجب للشهود ، وهو موجب لقرب البعيد في نفس الأمر ، فكيف لا يوجب قرب القريب في نفس الأمر ، وإنما عرض فيه من الحجاب إذ صار به لا يصل إليه كالبعد .
قال رضي الله عنه : ( فكل مشهود قريب من العين ) ، أي : القوة الباصرة ، ( ولو كان بعيدا ) من الشخص الرائي ( بالمسافة ، فإن ) البعيد بين الرائي والمرئي لا ينافي القرب بين الرؤية والمرئي ،
فإن ( البصر متصل به ) أي : بالمشهود لا من حيث غرضه له ، بل هو من عوارض الرأي ( من حيث شهوده ) الموجب لاتصال الشعاع منه بالمشهود ،
( ولولا ذلك لم يشهده ) على قول من يراه باتصال الشعاع ، ( أو يتصل المشهود بالبصر ) على قول من يراه بانطباع صورة المرئي في الباصرة .
ثم قال رضي الله عنه : ( كيف كان ) أي : سواء كان المشهود باتصال الشعاع والانطباع أو غيرها ، ( فهو ) أي : المشهود ( قرب بين البصر والمبصر ) مع بعد المسافة فكيف مع قربها .
( ولهذا ) أي : ولكون الحقائق قريبة في نفس الأمر بعيدة بالحجاب ( كنّي أيوب ) عن بعدها بالحجاب ( في ) لفظ ( المس ) لا من حيث دلالته على الالتصاق بل من حيث إسناده إلى الشيطان .
ثم قال رضي الله عنه : ( فأضافه ) أي : أسنده ( إلى الشيطان ) المشعر من استقامة بالبعد مع أنه سبب الحجاب ( مع قرب المس ) من حيث دلالته على الالتصاق ؛ ليدل على قربها في الواقع بطريق الإشارة حين بعدها بالحجاب ؛ ليدل ذلك على موجب الثبوت إليها مع الامتناع عن الوصول إليها .
ثم قال رضي الله عنه : ( فقال : ) أي : وكأنه قال في سكانته ( البعيد مني ) من الحقائق بسبب الحجاب بعد الشيطان عنك ، وهو الموجب لهذا الحجاب ( قريب ) مني في الواقع قرب المس ( لحكمة فيّ ).
"" أضاف المحقق : حاصله أنه عليه السّلام كان يشكو من بعده عن إدراك الحقائق عما هي عليه بواسطة حجابية بعينه المانعة له عن إدراكها ، ولما ذكر أن للبعد وقربه من أيوب حكما وأثرا فيه كان محال أن يقال : القرب والبعد أمران اعتباريان لا وجود لهما في الخارج ؛ فكيف يكون لهما حكم وأثر في الموجودات الخارجية ؟. شرح الجامي "" .
فإن الحقائق حاكمة في كل شيء سواء علمها أو احتجب عنها ، فهي من حيث القرب موجبة للشوق إليها ، ومن حيث البعد مانعة من الوصول إليها ، فقد أصابه من ذلك نصيب وعذاب فرفع ذلك بالماء من حيث تضمنه سر الحياة المترتب عليها العلم بحسبها ؛
فإن الجهل موت معنوي فصار شرابا مزيلا لعطش طلبه إياها ، وهذا لا ينافي شكايته الألم الظاهر إذ لا يدرك مع استراحة الباطن إذا اجتمع ألم الظاهر مع ألم الباطن تأكد كل واحد بالآخر .
ثم استشعر سؤالا بأنه كيف يجتمع القرب والبعد في الحقائق بالنسبة إليه ، وهما متقابلان ؟
فأجاب عنه بقوله : ( وقد علمت ) أي : في علم الحكمة والكلام (إذ القرب والبعد أمران إضافيان ) ؛ لأن قرب أحد الأمرين من الآخر وبعده لا يتصور بدون قرب الآخر وبعده ؛ والإضافة نسبة بين الشيئين معدومة في الخارج.
قال رضي الله عنه : (فهما نسبتان لا وجود لهما في العين ) أي : الخارج فليستا من المتقابلين الذين لا بدّ وأن يكون أحدهما موجود ( مع ثبوت أحكامها في القريب والبعيد ) أي : أحكام البعد في البعيدين ، وأحكام القرب في القريبين بالتقابل ، إنما هو بين أحكامها ، وتختلف الأحكام باختلاف الجهات ، فيكفي لتقابلها تقابل الجهات .
قال الشيخ رضي الله عنه : (واعلم أنّ سرّ اللّه في أيّوب الّذي جعله عبرة لنا وكتابا مسطورا حاليّا تقرؤه هذه الأمّة المحمّديّة لتعلم ما فيه فتلحق بصاحبه تشريفا لها ، فأثنى اللّه عليه - أعني : على أيّوب - بالصّبر مع دعائه في رفع الضّرّ عنه ؛ فعلمنا أنّ العبد إذا دعا اللّه في كشف الضّرّ عنه لا يقدح في صبره، وأنّه صابر، وأنّه نعم العبد كما قال تعالى :إِنَّهُ أَوَّابٌ [ ص : 17 ] ،
أي : رجّاع إلى اللّه لا إلى الأسباب ، والحقّ يفعل عند ذلك بالسبب ؛ لأنّ العبد يستند إليه ، إذ الأسباب المزيلة لأمر ما كثيرة والمسبّب واحد العين ، فرجوع العبد إلى الواحد العين المزيل بالسّبب ذلك الألم أولى من الرّجوع إلى سبب خاصّ ربّما لا يوافق علم اللّه فيه ،
فيقول : إنّ اللّه لم يستجب لي وهو ما دعاه ، وإنّما جنح إلى سبب خاصّ لم يقتضه الزّمان ولا الوقت ، فعمل أيّوب بحكمة اللّه تعالى إذ كان نبيّا ، لمّا علم أنّ الصّبر هو حبس النّفس عن الشّكوى عند طائفة وليس ذلك بحدّ الصّبر عندنا ، وإنّما حدّه حبس النّفس عن الشّكوى لغير اللّه لا إلى اللّه ، فحجب الطائفة نظرهم في أنّ الشّاكي يقدح بالشّكوى في الرّضا بالقضاء ، وليس كذلك ، فإنّ الرّضا بالقضاء لا تقدح فيه الشّكوى إلى اللّه ولا إلى غيره ، وإنّما تقدح في الرّضا بالمقضيّ ونحن ما خوطبنا بالرّضا بالمقضيّ والضّرّ هو المقضيّ ما هو عين القضاء ).
ثم أشار إلى تقريب الحق إياه بما أعطاه من الصبر مع الأوب إليه حتى أثنى بذلك عليه ، فقال : ( واعلم أنّ سرّ اللّه في أيّوب ) أي : المعنى القائم باللّه الظاهر في أيوب هو الصبر مع الشكوى المتضمنة للأوب إليه ؛ فإن اللّه تعالى يصبر على العصاة ويرزقهم ويعافيهم ، ومع ذلك شكا عنهم
؛ فيقول : « يؤذيني ابن آدم يسب الدهر ، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار ، ويقول : كذبني ابن آدم ، ولم يكن له ذلك ، وشتمني ابن آدم ، ولم يكن له ذلك ، أما تكذيبه إياي ، فقوله : لن يعيدنيكما بدأني ، وليس أول الخلق ، فأهون عليّ ما أعدته ، وأما شتمه إياي ، فيقول :اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً [ الكهف : 4 ] ، وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ، ولم يكن لي كفوا أحد ، ويقول :إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ [ لأحزاب :57 ] . رواه البخاري ومسلم
( الذي جعله ) غيره ( لنا نعبر ) عنه إلى أنفسنا ، فيفعل مثل فعله ؛ لينال مثل ما ناله من نعم العبد أو إلى اللّه ، فينظر إلى صبره مع شكواه ( وكتابا مسطورا ) ؛ لئلا تقع الغفلة عنه ( حاكيّا ) عن نبي من الأنبياء ما نال به الرتبة العالية بعد النبوة ( بقراءة هذه الأمة المحمدية )التي "علماؤها كأنبياء بني إسرائيل " ذكره المناوي في فيض القدير والعجلوني في كشف الخفاء.( ليعلم ما فيه ) من الأسرار العظيمة في الجمع بين الصبر والشكوى إلى اللّه تعالى ، ودعائه في إزالة الضر من معرفة المقصود من الابتلاء ، وهو الأوب إلى اللّه تعالى ، وإظهار العجز عن مقاومة قهره ، ورفع ما يشبه الأذى عن جنابه ، وهو الغضب بالتضرع والافتقار من العبد .
( فيلحق بصاحبه ) أي : صاحب ذلك السر وهو أيوب عليه السّلام في هذا المعنى ، وإن لم يكن لها تحصيل مثل مرتبته سريعا لها بما هو ( شرف ) بعض الأنبياء ، فتكمل بذلك ولا يتهم ، وإذا كان في أيوب هذا السر الإلهي ، (فأثنى اللّه عليه ) بقوله :إِنَّا وَجَدْناهُ صابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ [ ص : 44 ] ،
وبيّن الضمير بقوله : « ( أعني على أيوب ) ؛ لئلا يتوهم عوده إلى السر أو الكتاب ( بالصبر ) لا وحده لاشتراكه بينه وبين كثير من الناس ، بل ( مع دعائه في رفع الضر عنه ) بقوله :أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ [ الأنبياء : 83 ] ، إذ صار جامعا بين الضر والدعاء الذي هو مخ العبادة ، إذ تحقق عليه السّلام به بالعبودية والافتقار . رواه الترمذي والحكيم الترمذي في نوادر الأصول .
(فعلمنا أن العبد إذا دعا اللّه في كشف الضر عنه لا يقدح في صبره ) . ذكره الجرجاني في التعريفات.
إذ لا منافاة بينهما لما سيذكر في حد الصبر كيف ، ( وأنه صابر ) بالنص الإلهي ، ومع ذلك ( أنه ) بالدعاء نِعْمَ الْعَبْدُ بالنصّ أيضا ، وكيف لا وهو يصير بذلك أوابا ؟
( كما قال :إِنَّهُ أَوَّابٌ) [ ص : 30 ] ، فجعله نعم العبد بكونه أوابا مع صبره بل هو المقصود من الصبر ، إذ لو تجرد كصبر المشركين على آلهتهم ، وصبر المتمردين على أسباب معاصيهم لم يكن مستحقا للمدح والثواب بل للذم والعقاب ،
( أي : راجع إلى اللّه تعالى ) أورده بصيغة المبالغة ؛ لأنه في معنى تكرر الرجوع إليه ؛ لأنه لما خص رجوعه إليه ( لا إلى الأسباب ) ، فكان رجوعه إليه مكان كل رجوع له إلى كل سبب .
( والحق ) وإن كان ( يفعل ) رفع الضر عنه ( عند ذلك ) الرجوع إليه ( بالسبب ) ، فليس ذلك رجوع العبد إلى السبب ؛ ( لأن العبد إنما يسند ) حاجته ( إليه ) أي : إلى اللّه ، وإن كان من حيث هو مسبب الأسباب ، فليس رجوعه إليها من حيث ما فيها من الكثرة بل إلى وحدة الحق ،
( إذ الأسباب المزيلة لأمر ما ) أي : سواء سهل أو صعب كبيرة ؛ لئلا يضطر الإنسان عند فقدان سبب معين ، فيعجز عن دفعه بالكلية ، فوسع اللّه تعالى في الأسباب لا حتى يرجعوا إليها ؛ بل ليفعل بأنه شاء لجريان سنته أن يفعل بالسبب غالبا ، (والمسبب واحد العين ) وإن ظهر في كثرة الأسباب ، فيسهل الرجوع إليه ويحصل المقصود بجمع الهم فيه ، ولو رجع إلى الأسباب الكثيرة ،
فإن رجع إلى جميعها ربما أضر به دون بعض ، فربما لا يفيده كما قال :،
قال رضي الله عنه :(فرجوع العبد إلى الواحد العين ) مع ما فيه من التحقق في العبودية ونفي الشركة ، وإن كان رجوعا إلى (المزيل ) ما لبست ذلك الألم ، فإن النظر إلى الإزالة .
قال رضي الله عنه :( والسبب ) والألم ليس تفرقه لنظر الوحدة في حق الكمّل ، ومع (ذلك ) أولى من الرجوع إلى سبب خاص ، وإن نظر فيه إلى اللّه وحده ؛ لأنه (ربما لا يوافق ) ذلك ، أي :
كونه سببا لرفع ذلك الألم بعينه ( علم اللّه فيه ) أي : في حق ذلك الألم ، أو في ذلك الشخص ، أو في ذلك الوقت وإن كان سببا لنوع آخر ، أو شخص آخر ووقت آخر ،
فيقول : الراجع إلى اللّه من حيث ظهوره ( في سبب خاص ) بدعاء ربه وطلبه الشفاء فيه ( إن اللّه لم يستجب له ، وهو ما دعا ) لا من حيث هو هو ، ولا من حيث هو مسبب الأسباب ، ( وإنما جنح إلى سبب خاص ) وإن كان في زعمه أنه جنح إلى اللّه كما زعم بعض عبدة الأصنام أنه إنما يعبد اللّه فيه ، ولكنه لم يعبده من حيث هو هو ، ولا من حيث هو الظاهر في الكل ، بل خص بعض ظهوراته القاصرة للعبادة ورأى كماله فيها ،
وهو عين القصور في رؤيته ، ومع ذلك ( لم يقتنصه الزمان ) الجامع ( للأوقات ) ، إذ لم يكن مزيلا لنوع علته ، وإن كان مزيلا لنوع آخر من جنسها ولا الوقت الخاص لممانعة طبيعة الفصل أو الشخص أو البلد ، وإذا كان المقصود من الابتلاء الرجوع إلى اللّه تعالى بالشكوى إليه ، والدعاء في رفع البلاء والصبر بترك الشكوى إلى الغير والرجوع إلى الأسباب ، ( فعمل أيوب بحكمة اللّه ) في الابتلاء وهي الأمور المذكورة لا الصبر بترك الشكوى مطلقا وحده ،
قال رضي الله عنه :( إذ كان نبيّا ) فتم اطلاعه على الحكم فوق اطلاع من دونهم من الأولياء الذين يرى أكثرهم أن المقصود منه الصبر بترك الشكوى مطلقا وحده ، فشكا إلى اللّه تعالى ودعاه في رفع ما ابتلاه به ( لما علم أن الصبر الذي هو حبس النفس عن الشكوى ) مطلقا ليس بمقصود منه ، وإن كان مقصود ( عند الطائفة ) المخصوصة من الأولياء ، وهم جمهور هم كأنهم - بل الطائفة - بل المقصود الأصلي هو الرجوع إلى اللّه ؛ فإن انضم إليه الصبر بترك الشكوى إلى غير اللّه ، فهو مزيد في رتبة الكمال موجب للبناء على الصبر لا من حيث هو صبر ، بل من حيث هو صبر الالتفات إلى الغير .
ولذلك نقول : ( ليس ذلك ) الذي ذكروه في حدّ الصبر ( بحد للصبر عندنا ) جماعة المحققين ؛ لخروج صبر من شكا إلى اللّه تعالى مع أن اللّه تعالى سماه صابرا ، ( وإنما حده حبس النفس عن الشكوى لغير اللّه ) ؛ لتضمنها نوعا من الشرك ( لا إلى اللّه ) ، كقول أيوب عليه السّلام :إِنَّما أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ [ يوسف : 86 ] ، مع قوله :فَصَبْرٌ جَمِيلٌ[ يوسف : 18 ] ، كيف وقد اتفق الكل على استحباب الدعاء في دفع البلاء مع وجوب الصبر فيه ، فلو أخلت الشكوى بالصبر لتنافى اجتماعهما مع استحالة الدعاء ؛ للتنافي بين واجب ومستحب ، وإذا كان هذا حدّ الصبر عند تمام الكشف النبوي ، ولم يتم للطائفة المذكورة .
قال رضي الله عنه :( فحجبت الطائفة نظرهم في أن الشاكي ) ، ولو إلى اللّه ( يقدح بالشكوى في الرضا بالقضاء ) مع أنه واجب ، فترك ما يقدح فيه واجب ، ( وليس كذلك ؛ فإن الرّضا بالقضاء لا تقدح فيه الشكوى إلى اللّه ، ولا إلى غيره ، وإنما تقدح فيه ) لو شكا عن نفس القضاء ، فليس منع الشكوى إلى الغير لقدحه (في الرضا ) ، بل لما فيه من الشرك الخفي ، وإنما تقدح الشكوى عن البلاء في الرضا بالقضاء الذي هو البلاء والضر ، ( ونحن ما خوطبنا بالرضا بالمقضي ) ، وإلا لوجب الرضاء بالكفر الذي هو مقضي عندنا مع أن الرضاء بالكفر كفر ،
قال رضي الله عنه :(والضر هو المقضي ما هو عين القضاء ) ولا مما يتوقف عليه القضاء لسبقه ، والسابق لا يتوقف على اللاحق ، ولا مما يستلزم الرضا بالقضاء الرضا به ، فإنه يجوز أن يرضى بفعل الشخص ولا يرضى بمفعوله ، كمن يرضى بجماع ولده بالزنا لظهور رجوليته ، ولا يرضى به من حيث هو زنا والرضاء بفعل المحبوب لا يستلزم الرضاء بمفعوله إذا قصد به أن يتدلل له المحب ويعجز عنده ويدعوه في رفعه .
قال الشيخ رضي الله عنه : (وعلم أيّوب عليه السّلام أنّ في حبس النّفس عن الشّكوى في دفع الضرّ إلى اللّه مقاومة القهر الإلهيّ ، وهو جهل بالشّخص إذ ابتلاه اللّه بما تتألّم منه نفسه ، فلا يدعو اللّه في إزالة ذلك الأمر المؤلم ، بل ينبغي له عند المحقّق أن يتضرّع ، ويسأل اللّه في إزالة ذلك عنه، فإنّ ذلك إزالة عن جناب اللّه عند العارف وصاحب الكشف ، فإنّ اللّه تعالى قد وصف نفسه بأنّه يؤذي ؛ فقال :إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ [ الأحزاب : 57 ].
وأيّ أذى أعظم من أن يبتليك ببلاء عند غفلتك عنه أو عن مقام إلهيّ لا تعلمه لترجع إليه بالشّكوى فيرفعه، فيصحّ الافتقار الّذي هو حقيقتك، فيرتفع عن الحقّ الأذى بسؤالك إيّاه في رفعه عنك ، إذ أنت صورته الظّاهرة ، كما جاع بعض العارفين فبكى فقال له في ذلك من لا ذوق له في هذا الفنّ معاتبا له ، فقال العارف : « إنّما جوّعني لأبكي » ، يقول : إنّما ابتلاني بالضّرّ لأسأله في رفعه عنّي ، وذلك لا يقدح في كوني صابرا ؛ فعلمنا أنّ الصّبر إنّما هو حبس النّفس عن الشّكوى لغير اللّه ).
وإليه الإشارة بقوله رضي الله عنه : ( وعلم أيّوب عليه السّلام أنّ في حبس النّفس عن الشّكوى في دفع الضرّ إلى اللّه مقاومة القهر الإلهيّ ) ، ( وهو )وإن كان صابرا لا تشترط فيه الشكوى إلى اللّه ، كما لا يشترط فيه تركه (جهل ) لازم ( بالشخص ) المبتلى بمقصود الابتلاء ( إذا ابتلاه بما تتألم منه نفسه ) ؛ ليتضرع ، ويبتهل إلى اللّه بالدعاء ، وإظهار العجز له ، والافتقار إليه ، فإذا جهل هذا المقصود ، ( فلا يدعو إلى اللّه في إزالة ذلك الأمر المؤلم ) ، فيفوته مقصود الابتلاء وفائدة الدعاء ، ويتحصل من هذا الصبر مقاومة القهر الإلهي ، ويتضرر بها فوق ضرر ترك الصبر ، ( بل ) ثم نكتة أخرى ألطف مما ذكرنا هي أنه ( ينبغي له عند المحقق أن يتضرع ) إظهارا للعجز ، ( ونسأل اللّه في إزالة ذلك ) الألم ( عنه ، فإن ذلك ) التضرع والسؤال من حيث كونه موجبا للرضاء عنه ( إزالة ) لموجب الغضب عليه الذي كان سببا لابتلائه بمقتضى قوله تعالى :وَما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ[ الشورى : 30 ] .
والغضب أذى في حق الغاضب منا ، فهو يشبه الأذى في حق اللّه تعالى ، فكأنه يزيل بذلك التضرع والسؤال نفس الأذى ( عن جناب اللّه عند العارف وصاحب الكشف ) ، وإن استبعده العامة ، ولكن قد صحّ ذلك الكشف بالنص الإلهي ، ( فإن اللّه قد وصف نفسه ) في كتابه ( بأنه يؤذى ؛ فقال :إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) [ الأحزاب : 57 ] ،
قال رضي الله عنه :( وأي أذى أعظم ) في حق اللّه من أن تؤذيه أنت بإخلال ما قصده في ابتلائك ، وهو أنه ( يبتليك ببلاء عند غفلتك عنه بالكلية أو عن مقام إلهي ) يقتضي أمر الشيء ، أو النهي عن شيء ، وإن كنت ( لا تعلمه ) بعينه ، فابتلاؤه إياك ( لترجع إليه ) تداركا لتلك الغفلة الموجبة للغضب عليك ( بالشكوى ) ، والدعاء ، والتضرع ، وغير ذلك مما يوجب الرضا عنك ؛ ( فيرفعه ) عنك ، فيرتفع عنه إرادة الانتقام الذي هو الغضب في حقه ، وهو الأذى في حق الغاضب كيف ؟ !
وإنما كان ابتلاؤه إياك عند غفلتك ؛ لإخلالك ( بافتقارك ) إليه ( الذي هوحقيقتك )
، فإذا رجعت إليه بالشكوى ، ( فيصح الافتقار الذي هو حقيقتك ) ، ومقصود الحق في كل شيء تحقيق مقتضى حقيقته ، فإذا لم يتحقق غضب عليه ، فترك الشكوى موجب لترك الافتقار الموجب للغضب الإلهي ، وإن شكوت إليه حصلت مقصوده ، (فيرتفع عن الحق ) الغضب الذي هو ( الأذى بسؤالك إياه ) أي : الحق
قال رضي الله عنه :( في رفعه ) أي : الأذى ( عنك ) لا عنه ؛ لأنه يستلزم ارتفاعه عنك ارتفاعه عنه ، (إذ أنت صورته الظاهرة ) التي إنما لحقه الأذى بالنظر إليها لما رأى فيها من القصور ومطلوبه الظهور بالكمال ، فإذا ارتفع عنها لحصول الكمال لها ارتفع عن الحق .
واستدل على أن هذا الافتقار والتصريح مقصود الحق بقول بعض العارفين ، فقال :
قال رضي الله عنه :(كما جاع بعض العارفين ، فبكى ؛ فقال له في ذلك : من لا ذوق له في هذا الفن معاتبا له ) بترك الصبر على الجوع مع كونه عارفا ، ( فقال العارف : « إنما جوعني لأبكي ) .
ولما أوهم ظاهره أن المقصود نفس البكاء ، وليس كذلك ، بل إنما هو التصريح بالبكاء ، والانتقال به إلى اللّه تعالى بينه بقوله : يقول : (إنما ابتلاني بالضر لأسأله ) بالتصريح والبكاء ( في رفعه عني ) ؛ لأنه إذا ارتفع عني ارتفع موجب الغضب منه ، وهو أذى ، ولما كان هذا جوابا لعنى به بترك الصبر ،
فكأنه قال رضي الله عنه : : ( وذلك لا يقدح في كوني صابرا ) ؛ لأن غايته الشكوى إلى اللّه ، وإنما تقدح فيه الشكوى إلى الغير ، ( فعلمنا ) من النص الإلهي على كون أيوب عليه السّلام صابرا مع شكواه إلى اللّه ، ومن قول هذا العارف ، ومن قول المقصود من الابتلاء التصريح والدعاء : ( أن الصبر ) كما بينا حده إنما ( هو حبس النفس عن الشكوى لغير اللّه ) لما فيه من الرجوع إلى غيره .
قال الشيخ رضي الله عنه : (وأعني بالغير وجها خاصّا من وجوه اللّه ، وقد عيّن الحق وجها خاصّا من وجوه اللّه وهو المسمّى وجه الهويّة فتدعوه من ذلك الوجه في رفع الضّرّ عنه لا من الوجوه الأخر المسمّاة أسبابا ، وليست إلّا هو من حيث تفصيل الأمر في نفسه ، فالعارف لا يحجبه سؤاله هويّة الحقّ في رفع الضّرّ عنه عن أن تكون جميع الأسباب عينه من حيثيّة خاصّة ، وهذا لا يلزم طريقته إلّا الأدباء من عباد اللّه الأمناء على أسرار اللّه ؛ فإنّ للّه أمناء لا يعرفهم إلّا اللّه ؛ ويعرف بعضهم بعضا ، وقد نصحناك ؛ فاعمل وإيّاه سبحانه فاسأل ) .
ثم استشعر سؤالا بأن الغير منتف عند أهل التوحيد ، فكيف يتصور عندهم الشكوى إلى الغير ؟
فقال : ( وأعني بالغير وجها خاصّا ) ، وهو ظهوره في المظاهر المحدثة ، فإنها باعتبار محالها غيره وإن كانت ( من وجوه ) تجلي ( اللّه ) التي عينيتها بذلك الاعتبار عند أهل التوحيد ، فلا منافاة بين عينيتها وغيرتها ، فلما كانت فيها العينية والغيرية لم تكن وجوها معينة للعبادة والتصريح والدعاء ؛
ولذلك ( قد عين الحق ) للعبادة والدعاء والتصريح ( وجها خاصّا ) هو تجليه في ذاته ، وهو وإن كان من ( وجوه اللّه ) ، فليس كسائر الوجوه التي فيها الغيرية ، كيف ( وهو المسمى وجه الهوية ) إذ هو هو من كل وجه فلا غيرته فيها أصلا ، ( فدعوه من ذلك الوجه ) ؛ لأنه عينه الحق لذلك فلا وجه للغيرية فيه ، وكيف لا يدعوه من ذلك الوجه وهو الذي لحقه الأذى بالنهج المذكور ؟
فكأنك تدعوه ( في رفع الضر عنه لا من الوجوه الأخرى ) التي هي باعتبار الظهور في المظاهر ، وإن كانت رافعة للضر عنك لكونه ( المسماة أسبابا ) لرفع الضر ، وإن كانت تلك الوجوه ( ليست إلا هو ) أي : الوجه المسمى وجه الهوية ل ( من حيث ) هي في الظاهر ، بل من حيث ( تفصيل الأمر ) أي : أمر التجلي ( في نفسه ) ، فإنه لما تجلى في نفسه ظهرت له الأعيان الثابتة للأشياء وتفصل فيها هذا التجلي الذي له في نفسه .
ولذلك ترى العارف يستعمل الأشياء مع أنه لا يسأل إلا من الوجه الذي عينه الحق له ، فإن ( العارف لا يحجبه سؤال هوية الحق ) الذي عينه الحق للسؤال ( في رفع الضر عنه عن أن تكون جميع الأسباب عينه ) ، فيستعملها مع ذلك من حيث هي عينه ، إذ لا رجوع إلى الغير أصلا ، وهي وإن كانت غيرت من حيث ظهورها في المظاهر المحدثة ؛ فهي عينه ( من حيثية ) حاجته هي كونها تفصيل تجليه في ذاته ، والتفصيل عين المجمل .
قال رضي الله عنه :( وهذا ) أي : سؤال الهوية مع استعمال الأسباب من حيث عينيته (لا يلزم طريقته إلا الأدباء من عباد اللّه ) الذين ينزهون عن الحدوث ولا يرون له غير ( الأمناء على أسرار اللّه ) ، فلا يفشون سر ظهوره في الأسباب على العامة ؛ لئلا يتوهموا تأثيرها بالاستقلال ولا بعد في ذلك ، ( فإن للّه أمناء لا يعرفهم إلا اللّه ) ؛ لأنهم إنما يعرفون بتلك الأسرار المودعة عندهم وهم لا يفشونها إلى العامة فلا تعرفهم العامة ،
ولكن ( يعرف بعضهم بعضا ) إما لإفشائهم تلك الأسرار إليهم ، وإما لأنهم يكاشفون بأنهم كوشفوا بذلك ، ( وقد نصحناك ) بالشكوى في الضر ، وبالدعاء من الوجه المسمى وجه الهوية لا من سائر الوجوه ، وتحفظ الأمانة حتى لا تفشى الأسرار إلى غير أهلها ، ( فاعمل وإياه سبحانه ، فسأل ) لا الأسباب ، ولو باعتبار ظهور الحق فيه .
ولما فرغ عن الحكمة الغيبية التي كمالها إشراق نور الحياة ، التي هي أول الصفات على الماء ، الذي هو أول الأركان شرع في الحكمة الجلالية ، التي هي إشراق نور أول الأسماء ، وهو اسم الذات الذي لا اسم قبله ؛
فقال : فص الحكمة الجلالية في الكلمة اليحيوية
فقال : فص الحكمة الجلالية في الكلمة اليحيوية
.
zSlDyuoR4HI
 |
 |
البحث في نص الكتاب
يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!