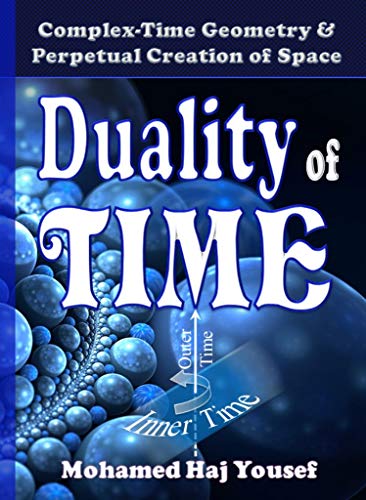كتاب خصوص النعم
في شرح فصوص الحكم
تأليف: الشيخ علاء الدين أحمد المهائمي
فص حكمة رحمانية في كلمة سليمانية
 |
 |
فص حكمة رحمانية في كلمة سليمانية
16 - فص حكمة رحمانية في كلمة سليمانية .كتاب خصوص النعم فى شرح فصوص الحكم علاء الدين أحمد المهائمي
كتاب خصوص النعم في شرح فصوص الحكم الشيخ علاء الدين أحمد المهائمي
الفصّ السليماني
قال الشيخ رضي الله عنه : (إِنَّهُ[ النمل : 30 ] ، يعني الكتاب مِنْ سُلَيْمانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ [ النمل : 30 ] ، أي : مضمونه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ [ النمل : 30 ] ، فأخذ بعض النّاس في تقديم اسم سليمان على اسم اللّه ولم يكن كذلك ، وتكلّموا في ذلك بما لا ينبغي ممّا لا يليق بمعرفة سليمان بربّه ، وكيف يليق ما قالوه وبلقيس تقول فيه :إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتابٌ كَرِيمٌ [ النمل : 29 ] أي : مكرّم عليها وإنّما حملهم على ذلك ربّما تمزيق كسرى كتاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ؛ وما مزّقه حتّى قرأه كلّه وعرف مضمونه ؛ فكذلك كانت تفعل بلقيس لو لم توفّق لما وفّقت له فلم يكن يحمي الكتاب عن الإحراق لحرمة صاحبه تقديم اسمه عليه السّلام على اسم اللّه تعالى ولا تأخيره ) .
أي : ما يتزين به ، ويكمل العلم اليقيني المتعلق بعموم الرحمة الإلهية التي هي الرحمانية المتضمنة للرحيمية ، ظهر ذلك العلم بزينته وكماله في الحقيقة الجامعة المنسوبة إلى سليمان عليه السّلام ، إذ خصه اللّه بالملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده ، فجمع له بين النبوة والولاية ، وتسخير الجن والإنس والطير والريح والماء ، ومعرفة جميع الأشياء حتى منطق الطير ، والتصرف في الكل بمناسبته إياهم .
فظهر بالرحمتين اللتين رحم بهما أولا ، ثم تصرف بهما وبالأسماء الداخلة تحتهما ثانيا ، فيما كتب إلى بلقيس معرفا لها فضله بحيث لا ترى نسبته لما أوتيت إلى ما أوتي مطمعا لها في حصول نصيب منهما لها عند انقيادها له ومتابعتها إياه ، حتى تنقاد له سريعا فكان ذكرهما لها كرما في حقه .
فلذلك وصفت كتابه بالكرم ، ثم بينت ذلك بأنه من المشهور بالكرم سليمان ، وهو عين الكرم لافتتاحه بالرحمتين مع إطماعها في النصيب منهما ، فقالت :إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتابٌ كَرِيمٌ [ النمل : 29 ] ، ( إنه يعني الكتاب ) فسر الضمير ؛ لئلا يتوهم أن للشأن ، فيكون مفتح كتاب سليمان ، فيكون عليه السّلام قدم اسمه على اسم اللّه تعالى وهو جهل ، وإنما هو من قول بلقيس ؛ ولذلك أورد لفظته يعني بتاء التأنيث ( من سليمان ، وإنه أي : مضمونه ) فسره ؛ لئلا يعود إلى البيان أو الكتاب .
فيتوهم أنه تم بقوله :بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ [ النمل : 30 ] ؛ لأنها خبران ، وليس كذلك بل هو مفتتحه وتتمته :أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ[ النمل : 31 ] ، وإن يفسر به فكأنه عليه السّلام يقول : إذا كنت صاحب الرحمة العامة بما أوتيت من الملك الجامع والرحمة الخاصة بما أوتيت من النبوة والولاية ، فلي العلو في الأمور الدنيوية والدينية ،"أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ"[ النمل : 31 ] ، من جهة الملك ،"وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ" [ النمل : 31 ]
من جهة الدين ، يحصل لكم نصيب من هاتين الفضيلتين بمتابعتكم إياي وانقيادكم لي ، وإلا فاتكم أمر الدارين ،ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِينُ[ الزمر : 15 ] .
فلما وقع قولها أنه من سليمان بعد ذكر الكتاب ، توهم بعض الناس أنه حكاية مضمونة ، ( فأخذ بعض الناس ) يطعن على الكتاب ( في تقديم اسم سليمان على اسم اللّه ) وهو جهل صرف ،
( ولم يكن ) كتابه ( كذلك ) أي : مقدما فيه اسم سليمان على اسم اللّه ، وإنما وقع ذلك في كلام بلقيس ؛ لجريان العادة بذكر الكاتب قبل تفصيل مضمون الكتاب ، ( وتكلموا في ذلك ) الأخذ ( بما لا ينبغي لهم ) أن يتوهموا في حق سليمان عليه السّلام ؛ لأنه ( مما لا يليق بمعرفة سليمان عليه السّلام بربه ) ، إذ عرفوا أنه قد أحل بأسراره ما لم تحط به أكثر الأنبياء عليهم السّلام فضلا عن غيرهم حتى سخر له العالم دونهم .
( وكيف يليق ) به ( ما قالوه ) من تقديم اسم سليمان على اسم اللّه ، وهو سفه يعرفه أهل البلاهة ، ( وبلقيس ) مع كمال عقلها وفطانتها بحيث مدحها اللّه تعالى على ذلك ( تقول فيه :إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتابٌ كَرِيمٌ[ النمل : 29 ] ) ، وليس ذلك إلا لتفضيل كلامه عليها ( أي :
تكرم عليها ) ؛ لانتمائه في الإحاطة بوجوه البلاغة والحسن بحيث تنهز له عقول العقلاء ، وتعقد دون الوصول إلى إدراك ما فيه فضلا عن مجاوبته ومعارضته ، فكيف يتصور أن يكون فيه تقديم اسمه على اسم ربه .
( وإنما حملهم ) أي : القائلين بكونه من جملة الكتاب ( على ذلك ) أي : تقديم سليمان اسمه على اسم اللّه ( ربما ) هذه الشبهة الواهية التي لا يتشبث بمثلها آحاد العقلاء فضلا عن كبار الأنبياء عليهم السّلام ( تمزيق كسرى كتاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ) ، وزعموا أنه إنما مزقه ؛ لأنه عليه السّلام ما قدم اسمه فيه.
فلم يقع في قلبه له ولا هيبة ، وتفطن سليمان عليه السّلام لهذه النكتة ، فقدم اسمه على اسم اللّه إظهارا لهيبته وعظمته ، فانقادت له وما مزقت كتابه ، وهذا غلط في المقيس والمقيس عليه ونفس القياس .
وذلك لأنه ( ما مزقه ) كسرى لعدم تقديمه عليه السّلام اسمه ، وإلا لمزقه أول ما رآه قبل استكمال قراءته وفهم مضمونه ، ولكن لم يفعل (حتى قرأه كله وعرف مضمونه ) ، بل إنما مزقه لعدم انقياده له فيما تضمنه الكتاب .
ومن لا ينقاد لأحد فهو سواء قدم اسمه أو لم يقدم لا ينقاد له أصلا ، ( فكذلك كانت تفعل بلقيس ) بكتاب سليمان كانت تمزقه بعد قراءته وفهم مضمونه ، ( لو لم توفق لما وفقت له ) من الإيمان ، ( فلم تكن تحمي الكتاب عن الإحراق لحرمة صاحبه ) الحاصلة في قلبها عن ( تقديم اسمه ) لدلالته على تجبره وعظمته .
أو عن تأخيره لدلالته على كمال رعايته حق ربه الدال على كمال عقله وفطانته ، وهو من أسباب تربية المهابة تقديم اسمه ( على اسم اللّه ولا تأخيره ) عنه ، ولا وجه آخر لهذا التقديم أصلا ، فلا ينبغي لأحد أن يتوهمه أصلا ، بل يجب أن يعتقد أن مفتتح بيان سليمان هو قوله : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ [ النمل : 30 ] .
قال الشيخ رضي الله عنه : (فأتى سليمان بالرّحمتين : رحمة الامتنان ورحمة الوجوب اللّتان هما الرّحمن الرّحيم ، فامتنّ بالرّحمن وأوجب بالرّحيم ، وهذا الوجوب من الامتنان ، فدخل الرّحيم في الرّحمن دخول تضمّن ، فإنّه كتب على نفسه الرّحمة سبحانه ليكون ذلك للعبد بما ذكره الحقّ من الأعمال الّتي يأتي بها هذا العبد ، حقّا على اللّه أوجبه له على نفسه يستحقّ بها هذه الرّحمة أعني رحمة الوجوب ، ومن كان من العبيد بهذه المثابة فإنّه يعلم من هو العامل منه ، والعمل منقسم على ثمانية أعضاء من الإنسان ).
""إضافة المحقق :الرحمة الامتنانية : هي السابقة ، سميت بذلك لأن اللّه تعالى امتن بها على الخلائق قبل استحقاقها ، لأنها سابقة على ما يصدر منهم من الأفعال التي توجب لهم استحقاقا ، والرحمة الامتنانية الخاصة : يعني بها رحمة اللّه تعالى لعبده ، حيث وفقه للقيام بما يوجب له من الأفعال استحقاق الثواب عليها ( لطائف الإعلام ص 161 ) .""
( فأتى سليمان بالرحمتين ) في كتابه لتجليهما عليه ؛ ليطمع من تابعه في نصيب منهم ( رحمة الامتنان ) لا في مقابلة عمل ( ورحمة الوجوب ) في مقابلته بحسب الوعد الإلهي مع أنه لا يجب عليه شيء .
( اللتين هما الرحمن الرحيم ) أي : مفهوم هذين الاسمين لا بطريق الترادف ، وإلا كان تكرارا بلا فائدة ، بل لا بدّ من التباين مع التواصل ( فامتن بالرحمن ) الدال بكثرة حروفه على كثرة أفراد مدلوله ، وهي الرحمة العامة التي لا تتصور أن تكون جميع أفرادها في مقابلة العمل ، سيما وقد دخلت فيه رحمة الإيجاد السابق على العمل .
( وأوجب بالرحيم ) الدال بقلة حروفه على قلة أفراد مدلوله ، وهي أفراد خاصة لا بد لها من تخصيص وهو العمل ، ( وهذا الوجوب ) ليس ما يقوله المعتزلة أنه يجب على اللّه تعالى إثابة المطيع والانتقام للعاصي بل هو(من الامتنان ) .
فإن الإثابة فضل كما أن الانتقام عدل ، ولكنه في حكم الواجب بوعده الصادق ، ( فدخل الرحيم في الرحمن دخول تضمن ) ، وإن كان شأن العام أن يدخل تحت مفهوم اللفظ الدال على الخاص بطريق التضمن ، وذلك باعتبار أن خصوصيته ليست أمرا زائدا على الامتنان كما تقوله المعتزلة ،
فهو داخل دخول أفراد الخاص تحت العام ، وهو مشبه دلالة التضمن من حيث أنه بعض ما صدق عليه العام ، كما أن المدلول التضمني بعض المفهوم الخطابي .
وكيف تجب هذه الرحمة على اللّه ولا موجب سواه ولا يوجب أخذ شيئا على نفسه ما لم يكن فيه جر نفع أو دفع الضر عنه ما لم يتعلق به شيء منهما ، بل غاية ما فيه أنه تعالى وعد المطيعين الإثابة فإنه :" كَتَبَ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ "[ الأنعام : 12 ] .
( سبحانه ) أن يكتب عليه أحد سواه ومن أن يصل إليه نفع أو ضر ، وإنما كتبه ؛ ( ليكون ذلك ) المكتوب (للعبد ) لا بحيث يذم الرب لو لم يفعل به ذلك لولا وعده السابق .
فهو إنما يكون له ( بما ذكره الحق ) ، وخبره صدق ، ووعده حق لا محالة ، وكيف يجب على اللّه ذلك الثواب الأبدي بحيث يذم بتركه ( من الأعمال التي يأتي بها هذا العبد ) ، وقد سبق عليه إنعامات من الحق يستحق الشكر عليها ، وهي لا تفي بشكره ، وإن وفت كفت لما مضى ، ولا يستوجب جزاء فضلا عن الأبدي الشامل على وجوه الإنعام والإكرام.
بل غايته أن يكون ( حقّا ) ثابتا ( على اللّه ) ؛ لأنه ( أوجبه له ) بوعده إذا أتى على وجه الاكتساب على بقية يستحق بها هذه الرحمة مفعول يستحق ، وبينها بقوله : ( أعني رحمة الوجوب ) ؛ لئلا يتوهم أنها رحمة الامتنان العامة ؛ لأنه نفى الوجوب عنها على وجه المبالغة .
وكيف تكون واجبة على اللّه الوجوب الحقيقي مع أنه إنما يستحقها إذا أتى بها على وجه يعتد به من الاعتقاد الصحيح والأركان والشرائط والآداب .
ومن جملة ما يجب أن يعتقد فيها أنه ليس يعامل بها على الحقيقة ، فكيف يجب له ثواب على اللّه بما ليس من عمله ، بل هو من أعمال الحق .
وإليه الإشارة بقوله : ( ومن كان من العبيد بهذه المثابة ) أي : بحيث يستحق على أعماله هذه الرحمة الوجوبية ، ( فإنه يعلم ) لإيمانه بالقدر ( من هو العامل فيه ) بالإيجاد ، وهل الأثر لقدرة الموجد أو المكتسب ، وكيف لا يكون الحق عاملا بالحقيقة فيه .
( والعمل ) المستند إلى العبد ( ينقسم على ثمانية أعضاء من الإنسان ) اليد والرجل والفم واللسان والأذن والعين والبطن والفرج .
قال الشيخ رضي الله عنه : (وقد أخبر الحقّ أنّه تعالى هويّة كلّ عضو منها ، فلم يكن العامل غير الحقّ ، والصّورة للعبد ، والهويّة مندرجة فيه ، أي في اسمه لا غير ، لأنّه تعالى عين ما ظهر وسمّي خلقا وبه كان الاسم الظّاهر والآخر للعبد ؛ وبكونه لم يكن ثمّ كان ، وبتوقّف ظهوره عليه وصدور العمل منه كان الاسم الباطن والأوّل ، فإذا رأيت الخلق رأيت الأوّل والآخر والظّاهر والباطن ، وهذه معرفة لا يغيب عنها سليمان عليه السّلام ، بل هي من الملك الّذي لا ينبغي لأحد من بعده ، يعني الظّهور به في عالم الشّهادة ، فقد أوتي محمّد صلّى اللّه عليه وسلّم ما أوتيه سليمان ، وما ظهر به ؛ فمكنه اللّه تعالى تمكين قهر من العفريت الّذي جاءه باللّيل ليفتك به فهمّ بأخذه وربطه بسارية من سواري المسجد حتّى يصبح فتلعب به ولدان المدينة ، فذكر دعوة سليمان فردّه اللّه خاسئا ، فلم يظهر عليه السّلام بما أقدر عليه وظهر بذلك سليمان ، ثمّ قوله :مُلْكاً[ النساء : 54 ] ، فلم يعمّ ، فعلمنا أنّه يريد ملكا ما ، ورأيناه قد شورك في كلّ جزء من الملك الّذي أعطاه اللّه ، فعلمنا أنّه ما اختصّ إلّا بالمجموع من ذلك ، وبحديث العفريت ، أنّه ما اختصّ إلّا بالظّهور ، وقد يختصّ بالمجموع والظّهور ) .
(وقد أخبر ) الحق بقوله عزّ وجل : « كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها ، ولسانه الذي يتكلم به » .
( أنه هوية كل عضو منها ) أي : ما به تحقق وجودها مثل تحقق الصورة المنطبعة في المرآة بالشخص المحاذي لها ، ولا شكّ أنه لا تتحرك تلك الصورة إلا بحركة الشخص ، ( فلم يكن العامل ) في هذه الأعضاء التي كالمرايا ( غير الحق ) الذي هو كالشخص المحاذي لها .
ولكن ( الصورة ) فيما نحن فيه (للعبد ) فقط ؛ لتنزه الحق عن الصورة في ذاته ، وإنما ظهرت له الصورة في المرآة ، ولم تجر العادة بنسبة هذه الصورة إلى الحق بخلاف صورة الشخص منا في المرآة .
فإنها تنسب إليه ( والهوية ) أي : تحقق هذه الصورة العاملة في مرايا الأعضاء الثمانية ( مندرجة فيه ) أي : في الحق ، أي : ( في اسمه ) ، فسمعه مندرج في سمعه ، وبصره في بصره ، وبطشه ومشيه في قدرته ( لا غير ) أي : لا في ذاته لامتناع تجزئته وانقسامه إلى الانفراد ، وكونه محلا للحوادث .
وبالجملة فالحق بجميع وجوهه مندرج في الأسماء الكلية للحق ، فإن أسماءه تعالى وإن كثرت فكلياتها الشاملة على جميعها منحصرة في هذه الأربع : الأول والآخر والظاهر والباطن ، وقد تحققت في الخلق .
( لأنه تعالى عين ما ظهر ) من الصور الوجودية في مرايا الخلق عينية الشخص لصورته في المرآة ، وإن ( سمي خلقا ) إذ لا لفرق بينهما لا يخل بهذه العينية ، فإن الشخص ثابت في الخارج وصورة المرآة متجلية ، ( وبه ) أي : وبظهور الحق في مرآة الخلق بعد بطونه عنها ، وإن كان معا باعتبار آخر.
( كان الاسم الظاهر والآخر ) من أسماء الحق ( للعبد ) ، إذ ظهوره تابع لظهوره وبطونه تابع لبطونه ، بل مندرجات في ظهوره وبطونه تعالى ، ( وبكونه ) أي : العبد ( لم يكن ) وهو اختفاء في ظلمة العدم ، ( ثم كان ) وهو موجب لسبق الاختفاء.
وأيضا ( بتوقف ظهوره ) أي : ظهور العبد ( عليه ) أي : على ظهور الحق في مظهره ، وهذا التوقف يوجب للعبد بطونا ، وكون بطونه سابقا على ظهوره ، إذ لا معنى للتوقف المذكور سواه ، ويتوقف ( صدور العمل منه ) على علمه ، وهو أن يوجده ويقدره عليه وهو باطن سابق على العمل الظاهر ، ( كان الاسم الباطن والأول ) من أسماء الحق للعبد بطريق التبعية والاندراج المذكورين .
( فإذا رأيت الخلق ) ذواتهم أو صفاتهم أو أفعالهم ( رأيت ) الحق بأسمائه الكلية الشاملة على جميع جزئياته ( الأول والآخر والظاهر والباطن ) في كل واحد منه ( وهذه ) أي :
معرفة أولية كل شيء وآخريته وظاهريته وباطنيته مندرجة في هذه الأسماء الإلهية الشاملة سائر أسمائه ، ( معرفة لا يغيب عنها سليمان ) في جميع أحواله ، فكان يرى الحق بكليته في كل شيء مع الخصوصيات التي له باعتبار تفاصيل الأشياء من حيث اندراجها في كليته ؛ فلذلك كان مجلي الرحمانية المتضمنة للرحيمية ، ( بل هو ) أي : دوام هذه المعرفة له .
( من الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده ) ، إذ به ناسب الحق والخلق مناسبة كلية مندرجة فيها المناسبات الخاصة للأشياء من غير اختلال فيها بالغيبة عنها الموجبة للحجاب عن الحق والخلق بمقدار ما غاب عنه من هذه المعرفة ، فكان يتصرف في الكل بالتصرف الكلي مندرجة فيها الجزئيات .
ولما أوهم ذلك فضيلة على نبينا صلّى اللّه عليه وسلّم ، أزال ذلك بقوله : ( يعني الظهور به في عالم الشهادة ) ؛ لأنه لم يكن لمحمد صلّى اللّه عليه وسلّم في الدنيا ولا أنه لا يظهر به في عالم الغيب أبد ( فقد أوتي محمد صلّى اللّه عليه وسلّم ) في عالم الشهادة( ما أوتيه سليمان عليه السّلام ) من هذا الملك الذي به تصرفه في الجن والإنس والطير والوحش ، (وما ظهر به ) في عالم الشهادة ، وسيظهر به يوم القيامة ، فيجعل من آمن به من أهل الجنة ومن كفر به من أهل النار .
والدليل على أنه صلّى اللّه عليه وسلّم أوتيه ما روي عن أبي هريرة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أنه قال : « أن عفريتا من الجن تغلب عليّ البارحة ؛ ليقطع عليّ صلاتي ، فأمكنني اللّه منه ، فأخذته فأردت أن أربطه بسارية من سواري المسجد ، حتى ينظر إليه كلكم ، فذكرت دعوة أخي سليمانقالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ[ ص : 35 ] ، فرددته خاسئا » رواه ابن حبان والبيهقي.
( فمكنه اللّه تمكين قهر ) ، وهو غاية التصرف ( من العفريت الذي جاءه بالليل ) خصّ مجيئه بالليل ؛ لأنه أهول ( ليفتك به ) ، وفي نسخة :
" ليضل به " ، والتمكين من مثل هذا العفريت الذي يقصد مثل هذا النبي تمكين من كل عفريت ( فهم بأخذه وربطه ) ، وهذا لا ينافي ما سبق من أخذه ؛ لتعلق هذا بالمجموع من الأخذ والربط ( بسارية من سواري المسجد ) خصه لإفادته غاية الشهرة ؛ لأن المسجد من شأنه أن يدخله كل أحد بخلاف البيت (حتى يصبح فتلعب به ولدان المدينة ) .
وهذا غاية القهران يصير من يقصد أشد الناس بالفتك ملعبا لصبيان البلد قويهم وضعيفهم ، وإن يصير من يعتاد الاختفاء عن نظر أهل العلم والفضل عاجزا عن الاختفاء عن الصبيان ، ( فذكر دعوة سليمان ) ، وهي قوله : "وَهَبْ لِي مُلْكاً لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي" [ ص : 35 ] ، فرده صلّى اللّه عليه وسلّم خاسئا ، فلم يظهر عليه السّلام بما أقدر عليه من قهره وربطه وجعله ملعبا للصبيان ، وظهر بذلك سليمان ، فاستعملهم إجمالا ساقه من الغوص في البحر ، ومن بناء البلدان وغير ذلك ، وقتل بعضهم وحبس بعضهم في نحو قمقمة .
ثم إنه عليه السّلام لو ظهر به لم يكن فعله منافيا لمقتضى دعوة سليمان ، ولكن لم يظهر به ؛ لأنه وإن كان في معنى التصرف الكلي إلا أنه في صورة الجزئي ، فلم ير الظهور به لائقا بكماله ، إذ ( قوله ملكا ) نكرة في سياق الأبيات ( فلم يعم ) كل فرد ونوع من الملك .
( فعلمنا أنه يريد ) بهذه الدعوة ( ملكا ما ) أي : نوعا أو فردا خاصّا منه ، ولكن ليس المراد أي نوع وفرد ؛ لأنّا ( رأيناه قد شورك في كل جزء ) جزء أي : فرد فرد ، ونوع نوع ؛ لأنه جزء من مجموع الأفراد والأنواع ( من الملك الذي أعطاه اللّه ) .
ولا شكّ أنه استجابة لهذا الدعاء لا زائد على ما دعاه ، وهو مجموع أنواعه وأفراده ، ( فعلمنا أنه ما اختص إلا بالمجموع من ذلك ) الملك الكلي الشامل على الملك المجموع ، والذي هو جزء منه والمجموع أيضا ليس من خواصه على الإطلاق ، إذ علمن ( تحديث العفريت ) الذي التمكين منه تمكين كلي ( أنه ما اختص إلا بالظهور بالمجموع ) .
وإنما حصل الظهور ببعض أجزائه ، وإن شاركه في الكل لمحمد صلّى اللّه عليه وسلّم ؛ ولذلك يقول :
( قد يختص ) غيره بالمجموع من غير ظهور به كنبيّنا صلّى اللّه عليه وسلّم والظهور من غير جمع كسائر الملوك ، وبعض من يسمع تسخيره للجن ، وبعض الشيوخ المسخرين للطيور والوحوش ، ولكن لا يفهم هذا من القرآن والحس إنما علم به الظهور من غير جمع .
قال الشيخ رضي الله عنه : (ولو لم يقل صلّى اللّه عليه وسلّم في حديث العفريت : « فأمكنني اللّه منه » . لقلنا : إنّه لمّا هم بأخذه ذكّره اللّه دعوة سليمان ليعلم أنّه لا يقدره اللّه على أخذه ، فردّه اللّه خاسئا ، فلمّا قال فأمكنني اللّه منه علمنا أنّ اللّه تعالى قد وهبه التّصرّف فيه ، ثمّ إنّ اللّه ذكّره فتذكّر دعوة سليمان فتأدّب معه ، فعلمنا من هذا أنّ الّذي لا ينبغي لأحد من الخلق بعد سليمان الظّهور بذلك في العموم ، وليس غرضنا من هذه المسألة إلّا الكلام والتّنبيه على الرّحمتين اللّتين ذكرهما سليمان في الاسمين اللّذين تفسيرهما بلسان العرب الرّحمن الرّحيم ، فقيّد رحمة الوجوب وأطلق رحمة الامتنان في قوله :وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ [الأعراف : 156 ] حتّى الأسماء الإلهيّة ، أعني حقائق النّسب ، فأمتنّ عليها بنا ، فنحن نتيجة رحمة الامتنان بالأسماء الإلهيّة والنّسب الرّبانيّة ) .
فلذلك قال : ( ولو لم يقل صلّى اللّه عليه وسلّم في حديث العفريت : « فأمكنني اللّه منه » ؛ لقلنا أنه صلّى اللّه عليه وسلّم لما هم يأخذه لربطه ذكره اللّه دعوة سليمان ؛ ليعلم أنه لا يقدره اللّه على أخذه ) ، وإن كان هذا الأخذ جزء من المجموع إلا أنه قد حصل له الجزء الآخر ، فلو حصل هذا معه لحصل له المجموع ، ولا يدل على هذا كونه مردودا خاسئا ، إذ نقول على ذلك التقدير لم يجعل اللّه له سلطانا عليه ، كما لم يجعله على عباده المصطفين.
(فرده اللّه خاسئا ، فلما قال : "فأمكنني اللّه منه » ) ؛ لئلا يكون عدم تسلط الشيطان مثل عدم تسلطه صلّى اللّه عليه وسلّم فيتكافآن ، ويلزم تفضيل سليمان عليه السّلام عليه ( علمنا أن اللّه قد وهبه التصرف فيه ) تكميلا لملكه الذي هو من جملة فضائله وكمالاته .
( ثم إن اللّه ذكره ) دعوة سليمان ، فتذكر دعوة سليمان ، فعلم أنه لو ظهر به لكان رادّا لدعوة سليمان وأمكنه ردّا لدعوة ، لكن فيه إساءة الأدب ( معه ، فتأدب ) سليمان عليه السّلام معه ، ( فعلمنا من هذا ) التقرير أن : مراد سليمان عليه السّلام بالملك ( الذي لا ينبغي لأحد من الخلق ) احترز به عن ملك الحق ، فإنه أشمل من ملك سليمان بكل حال من الأزل إلى الأبد ، ( بعد سليمان الظهور بذلك في العموم ) ، إذ علمنا من الحديث أن المراد من الاختصاص الظهور ، ومن الحس الاختصاص بالمجموع .
ثم أشار - رحمه اللّه - إلى أنه ليس غرضه بيان ما اختص به سليمان عليه السّلام من هذا الملك ، ولا بيان فضيلة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في أنه أوتي مثل ما أوتي سليمان عليه السّلام ؛ فقال : ( وليس غرضنا في هذه المسألة ) أي : بيان الملك المخصوص بسليمان عليه السّلام (إلا الكلام والتنبيه ) أوردهما ؛ ليشعر بأنه بين بعضه بالكلام الطويل الذيل الشامل على البراهين ، وتارة اكتفى بالتنبيه .
( على الرحمتين اللتين ذكرهما سليمان ) كيف يرتبطان بملكه حتى جعلهما مفتتح مكتوبه المتعلق بأمر المملكة التي كان يتصرف فيها بالأسماء الإلهية ، وعقبهما قوله :أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ[ النمل : 31 ] .
فذكرهما ( في ) ضمن (الاسمين اللذين ) هما المعينان القائمان بالذات الإلهية ، وكان ( تفسيرهما بلسان العرب : الرحمن الرحيم ) ، فكتب هذين اللفظين في مكتوبه إليها لكونها عربية ، ويحتمل أنه كتب الاسمين الدالين عليهما بلسانه إليها وهي عربية ؛ ليعلم اطلاعها على سائر اللغات ، ويحتمل ألا تكون هي عربية ، فكتب إليها باللسان الذي تعرفه هي .
( فقيد ) سليمان ( رحمة الوجوب )بجعله إياها صفة للّه بعد اتصافه بالرحمن ؛ لأن مفهوما مفهوم الرحمة مع زيادة اعتبار وجوبه .
""أضاف المحقق :- عن رحمة الوجوب : يعني أن العبد من حيث إنه يجب عليه إتيان أوامر مولاه ، فلا تجب الرحمة على المولى في مقابلة شيء ، فإذا قدر المولى وأوجب على نفسه لعبده شيئا في مقابلة عمله يستحق العبد بذلك الشيء بسبب عمله ، فوصول ذلك الشيء للعبد من المولى في مقابلة عمله امتنان وعطاء محض ، ولذا قالو : الجنة فضل إلهي فلا يستحقها العبد إلا بفضل اللّه ؛ فكان وجوب الرحمة من وجوب الامتنان . شرح القاشاني ""
( وأطلق رحمة الامتنان ) بجعلها صفة للّه الجامع لأسمائه لعمومها ( في قوله : وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ )[ الأعراف : 156 ] .
ومن جملتها الأسماء الإلهية فتضمن كل شيء ( حتى الأسماء الإلهية ) لا من حيث هي أسماؤه ، بل من حيث هي حقائق بها انتساب الموجودات إلى الحق .
وإليه الإشارة بقوله : ( أعني حقائق النسب ) ، فلما تعلقت الرحمة الامتنانية بأسمائه تعالى باعتبار انتسابها إلين ( فامتن عليها بنا ) يجعلنا ظهور آثارها الكائنة فيها ، إذ كانت بالقوة وهو كالكرب لها ، ( فنحن نتيجة رحمة الامتنان بالأسماء الإلهية والنسب الربانية ) ؛ لأن الأسماء الإلهية قديمة والنسب عدمية ، فلا يكون شيء منها قابلا للتأثير ، فكانت امتنانية مطلقة على العالم والأسماء الإلهية لا في مقابلة علم ولا عمل .
قال الشيخ رضي الله عنه : (ثمّ أوجبها على نفسه بظهورنا لنا وأعلمنا أنّه هويّتنا لنعلم أنّه ما أوجبها على نفسه إلّا لنفسه ، فما خرجت الرّحمة عنه ، فعلى من امتنّ وما ثمّ إلّا هو ؟ إلّا أنّه لا بدّ من حكم لسان التّفضيل لما ظهر من تفاضل الخلق في العلوم ؛ حتّى يقال : إنّ هذا أعلم من هذا مع أحديّة العين ، ومعناه معنى نقص تعلّق الإرادة عن تعلّق العلم ، فهذه مفاضلة في الصّفات الإلهيّة ؛ وكمال تعلّق الإرادة وفضلها وزيادتها على تعلّق القدرة ، وكذلك السّمع الإلهيّ والبصر وجميع الأسماء الإلهيّة على درجات في تفاضل بعضها على بعض ، كذلك تفاضل ما ظهر في الخلق من أن يقال : هذا أعلم من هذا مع أحديّة العين ).
ثم أشار إلى وجه تقيد الرحمة الوجوبية ، بقوله : ( ثم ) أي : بعد أن رحم العالم والأسماء الإلهية بالرحمة الامتنانية ( أوجبها على نفسه ، فظهورها لنا ) عند كمال التزكية والتصفية بالعلم والعمل ، ( وأعلمنا أنه هويتنا ) ؛ لأن عند هذه التصفية والتزكية يكمل ظهوره فينا بحيث نصبر كأننا هو ، فنعرفه معرفة كاملة بمعرفة أنفسنا ؛ ( لنعلم أنه ما أؤجبها على نفسه إلا لنفسه ) أي : لظهورها بكمالاتها فينا بعد ظهورها بها في ذاتها ، كما امتن بالامتنانية على أسمائها التي ليست غير نفسه .
( فما خرجت الرحمة ) الامتنانية والوجوبية ( عنه ) إلى من هو غيره من كل وجه ، فالوجوبية اختصت بصورة كاملة ، والامتنانية عمت آثار الأسماء وصورها الكاملة والقاصرة جميعا ، ( فعلى من امتن ) بالرحمة الامتنانية عندما رحم بها الآثار .
( وما ثم ) أي : في الواقع ( إلا هو ) ، فإن الآثار إنما تحققت بتصورها بصورة النور الوجودي عند إشراقه عليها ، وهو المتحقق في الكل وما سواه أمر اعتباري فيه ، فإذا لم يكن المرحوم من الآثار غيره من كل وجه ، فالراحم من صوره الكاملة أبعد من الغيرية وأقرب إلى العينية.
أي : التصور بصورته الكاملة ؛ فلذلك جعل سليمان عليه السّلام بتعلق ملكه هذين الاسمين ، ورتب عليه قوله :أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ[ النمل : 31] .
ولكن امتناع تحقق غيره يقتضي ألا يقع التفاضل في الموجودات ، فلا يكون بعضها مالكا متصرفا عاليا والبعض بخلاف ذلك ، ( إلا أنه لا بدّ من حكم لسان التفصيل ) بحيث يكون البعض مالكا متصرفا عاليا ، والبعض مملوكا متصرفا فيه سافل .
( ولما ظهر من تفاضل الخلق في العلوم ) ، والفاضل منها أقرب إلى الحق المالك المتصرف العالي ، فهو متصف بصفته بخلاف البعيد عنه ، ولا شكّ في ظهور ذلك ، ( حتى يقال : إن هذا أعلم من هذا مع أحدية العين ) الإنسانية التي هي المظهر أو الصفة العلمية التي هي الظاهر ، فهذا التفاضل ليس باعتبار أحدية العين لا في المظهر ولا في الظاهر ، بل باعتبار الصفات اللاحقة بها إما في الخلق الظاهر ، وإما في الحق ، فليس لنقص بعض صفاتها وكمال البعض الآخر .
فإن محال في الصفات القديمة إذ النقص من سمات الحادث ، ولكن ( معناه ) في صفاته تعالى ( معنى نقص تعلق الإرادة عن تعلق العلم ) ، فإن العلم متعلق بالواجب والممتنع والممكن موجودا أو معدوما ، والإرادة إنما تتعلق بالممكن ؛ لتخصيصه بالوجود أو العدم المتجدد أو المستمر ؛ (فهذه مفاضلة في الصفات الإلهية ) مع كونها ليست غير الذات باتفاق .
( وكمال ) عطف على نقص ( تعلق الإرادة ) بالنسبة إلى تعلق القدرة ؛ لتوقف تعلق القدرة على تعلق الإرادة ، ( وفضلها ) على تعلق القدرة ؛ لأن تعلق القدرة الإرادة في الأزل ، وتعلق القدرة عند الإيجاد المقدور ، ( وزيادتها على تعلق القدرة ) ؛ لأن الإرادة تتعلق بالعدم المستمر ليبقى الممكن فيه ، ولا تتعلق القدرة به لعدم كونه أثر .
( وكذلك ) أي : مثل هذه الصفات في نسبة التفاضل ( السمع الإلهي والبصر ) ؛ لتعلق الأول بالأصوات والحروف ، وما يدل عليه بها من التمايز ، وتعلق الثاني بالمبصرات من الألوان والأضواء والمقادير والأشكال والحركات والسكون .
( وجميع الأسماء الإلهية على درجات في تفاضل بعضها على بعض ) ، فالحياة متقدمة على العلم بدرجة ، وعلى الإرادة بدرجتين ، وعلى القدرة بثلاث درجات ، وعلى السمع والبصر من جزئيات العلم .
( كذلك ) أي : مثل التفاضل في الصفات الإلهية بعضها بالنسبة إلى بعض ( تفاضل ما ظهر في الخلق ) من كل صفة ( من أن يقال : هذا أعلم من هذا مع أحدية العين ) أي : عين العلم الظاهر فيهما ، وعين الإنسانية التي هي المظهر .
قال الشيخ رضي الله عنه : (وكما أن كلّ اسم إلهيّ إذا قدّمته سمّيته بجميع الأسماء ونعتّه بها ، كذلك فيما ظهر من الخلق فيه أهليّة كلّ ما فوضل به ، فكلّ جزء من العالم مجموع العالم ، أي هو قابل لحقائق متفرّقات العالم كلّه ؛ فلا يقدح قولنا إنّ زيدا دون عمرو في العلم أن تكون هويّة الحقّ عين زيد وعمرو ، ويكون في عمرو أكمل وأعلم منه في زيد ، كما تفاضلت الأسماء الإلهيّة وليست غير الحقّ ) .
ثم أشار إلى رؤية الكمّل كمال ظهور الحق في كل شيء ، إما بالفعل أو بالقوة مع رؤية أوليته وآخريته وظاهريته وباطنيته في الكل ؛ لأن المظاهر ، وإن كان بعضها قاصرا بالفعل فهو كامل بالقوة ، فقال : ( وكما أن كل اسم إلهي إذا قدمته سميته بجميع الأسماء ) ،
كما تقول الحي هو القيوم ، والرحمن هو الرحيم ( ونعته بها ) ، كما تقول : هو الحي القيوم ، وهو الرحمن الرحيم مع أن حقيقته الاسمية ، إنما تقتضي التسمية به لا كونه مسمى ، وتقتضي كونه نعتا لا منعوت ( كذلك ) أي : كما وقع في الأسماء خلاف مقتضى حقائقها وقع .
( فيما ظهر من الخلق فيه ) أي : في ظهور الحق من التفاضل ( أهلية كل ما فوضل به ) هذا الظهور بالنظر إلى الظهور في مظهر آخر ، فإن الظهور من حيث هو ظهور قابل للفاضلية ، وإن لم تكن حقيقة المظهر قابلة لظهور أكمل من الحاصل لها يجوز أن ينضم إلى هذه الحقيقة القابلة للمفضول الحقيقة القابلة للفاضل ، وذلك أن ( كل جزء من العالم مجموع العالم).
ولما أوهم ذلك أنه مجموع بالفعل أزال ذلك بقوله : ( أي : قابل ) الحقيقة ( لحقائق متفرقات العالم ) أي : فيه قوة اجتماعها إذ لا تزدحم الحقائق في محل واحد ( كله ) فيه إشارة إلى أن التقابل بين الحقيقتين لا يمنع من اجتماعهما بالجملة ؛ فلذلك يجتمعان في الذهن ، وإذا كان كل جزء من العالم مجموع أجزائه بالقوة ؛ ( فلا يقدح قولنا أن زيدا دون عمرو في العلم في أن تكون هوية الحق ) أي : ظهور نور وجوده ( عين زيد وعمرو ) .
فإن زيدا مثل عمرو بالقوة ، ( فيكون ) ظهور الحق في زيد بالقوة مثله ( في عمرو ) ، ولكنه يكون في عمرو بالفعل ( كما تفاضلت الأسماء الإلهية ) ، وهي متساوية من حيث إنها ليست غير الحق ؛ فلذلك يصح أن يتقدم كل اسم ، فيتسمى بالأسماء الباقية وينعت به .
قال الشيخ رضي الله عنه : (فهو تعالى من حيث هو عالم أعمّ في التّعلّق من حيث ما هو مريد وقادر ، وهو هو ليس غيره ؛ فلا تعلمه يا وليّي هنا وتجهله هنا وتثبته هنا وتنفيه هنا ، إلّا أن أثبّته بالوجه الّذي أثبت نفسه ، ونفيته عن كذا بالوجه الّذي نفى نفسه كالآية الجامعة للنّفي والإثبات في حقّه ، حين قال :لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ،فنفىوَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ[ الشورى : 11 ]فأثبت بصفة تعمّ كلّ سامع بصير من حيوان ، وما ثمّ إلّا حيوان إلّا أنّه بطن في الدّنيا عن إدراك بعض النّاس ، وظهر في الآخرة لكلّ النّاس ، فإنّها الدّار الحيوان .
وكذلك الدّنيا إلّا أنّ حياتها مستورة عن بعض العباد ليظهر الاختصاص والمفاضلة بين عباد اللّه بما يدركونه من حقائق العالم ، فمن عمّ إدراكه كان الحقّ فيه أظهر في الحكم ممّن ليس له ذلك العموم ، فلا تحجب بالتّفاضل وتقول لا يصحّ كلام من يقول إنّ الخلق هويّة الحقّ بعد ما أريتك التّفاضل في الأسماء الإلهيّة الّتي لا تشكّ أنت أنّها هي الحقّ ومدلولها المسمّى بها وليس إلّا اللّه تعالى ، ثمّ إنّه كيف يقدّم سليمان اسمه على اسم اللّه كما زعموا وهو من جملة من أوجدته الرّحمة ، فلابدّ أن يتقدّم الرّحمن الرّحيم ليصحّ استناد المرحوم ، هذا عكس الحقائق : تقديم من يستحقّ التّأخير وتأخير من يستحقّ التّقديم في الموضع الذي يستحقّه ) .
قال رضي الله عنه : ( فهو تعالى من حيث هو عالم أعم في التعلق من حيث ما هو مريد وقادر ) ، والحال أن كل اسم من هذه الأسماء ( هو ليس غيره ) ، فيصح أن يتعلق كل اسم بما تعلق به الآخر من حيث يتسمى به أو ينعت به ، وهذا التعلق وإن لم يظهر له بالفعل فهو له بالقوة ، وإذا كان ظهوره في الكل بالتساوي بالقوة مع التفاضل بالفعل.
( فلا تعلمه يا وليّ هاهنا ) أي : فيما ظهر فيه على الكمال بالفعل ، ( وتجهله هاهنا ) أي : فيما لم يظهر فيه على الكمال بالفعل لكمال ظهوره فيه بالقوة ، فسبحه عند رؤية كل شيء ولا تقتصر على التسبيح في رؤية المظاهر الكاملة بالفعل ، كما قال :فَسُبْحانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ[ الروم : 17 ] .
( وتنفيه هاهنا ) أي : فيما لم يظهر فيه بالفعل على الكمال ( وتثبته هاهنا ) أي : فيما ظهر فيه بالفعل على الكمال ، فإنه من فعل عبدة الأصنام جعلوا بعض المظاهر الكاملة في زعمهم مستحقة للعبادة ( إلا أن أثبته ) في كذا أي : الأمور المتصفة بالصفات المعينة من الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام (بالوجه الذي أثبت نفسه ) بالظهور فيه .
( ونفيته عن كذا بالوجه الذي نفي نفسه ) ، وهو المستلزم لحدوثه كالحلول والاتحاد ، فتجمع بين إثباته ونفيه في هذه المظاهر ( كالآية الجامعة للنفي والإثبات ) .
أي : لنفي التشبيه وإثباته ( في حقه ، حين قال :لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ[ الشورى : 11 ] ، فنفي ) التشبيه باعتبار استقراره في مقر غيره ، والظهور بالإلهية في المظاهر( وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ )[ الشورى : 11 ] .
(فأثبت ) التشبيه باعتبار ظهوره في المظاهر ( بصفة ) هي السمع والبصر ( تعم كل سامع وبصير من حيوان ) ، وإن استبعد ظهوره في مثل : الكلب والخنزير ، فلا نقص في إشراق الشمس عليهم .
ثم أشار إلى ظهوره بجميع الصفات في جميع المظاهر، وإن كان في بعضها بالقوة فهو بمنزلة الفعل عند الكمّل، فقال : ( وما ثم ) أي : في الواقع ( إلا حيوان ) ، وإن كان بعض الأشياء لا يسمى به ، بل يسمى بالنبات والجماد .
ولذلك قال صلّى اللّه عليه وسلّم : « لا يسمع صوت المؤذن حجر ، ولا شجر ، ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة » .
وقال تعالى :وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ[ الإسراء : 44 ] ، ( إلا أنه ) أي : كونه حيوان متصفا بالسمع والبصر ( بطن في الدنيا عن إدراك بعض الناس ) ؛ لقصور إدراكهم عن الأمور الكائنة بالقوة ، ( وظهر في الآخرة لكل الناس ) حتى تشهد لهم أو عليهم الأرض أو جدران أهل البيت بعملهم .
كما قال تعالى :" يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها . بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحى لَها " [ الزلزلة : 4 ، 5 ] ، ( فإنها الدار الحيوان ) تغلب فيها الأرواح حتى التي كانت فيها بالقوة على الأشباح ؛ فلذلك يكون لهم قوة المشي على الصراط الذي هو أرق من الشعر وأحد من السيف .
( وكذلك الدنيا ) في الحيوانية ؛ لأن ما في الآخرة نتيجة ما في الدنيا ، فلابد أن يوجد فيها بالقوة أو الفعل ، كالنتيجة في المقدمتين (إلا أن حياتها ) أي : حياة الدنيا لبعض الأشياء ( مستورة عن بعض العباد ) الذين لا يدركون كل ما يكون بالقوة ؛ ( ليظهر الاختصاص ) أي : اختصاص غيرهم بهذا الإدراك ؛ لقربهم من الحق حتى رأوه ظاهرا في الكل على الكمال بالقوة (والمفاضلة بين عباد اللّه ) ، وإن كمل ظهور الحق في الكل بالقوة ، لكن لا بد من المفاضلة في الظهور الفعلي .
فتختص الكمّل بذلك ( بما يدركونه من حقائق العالم ) ، فيعلمون روحانية كل شيء متصفة بالسمع والبصر وغيره من صفات الحق في كل شيء ، ( فمن عم إدراكه ) من العباد ( كان الحق فيه أظهر ) بالفعل ، فيقوم مقامه ( في الحكم ) كسليمان عليه السّلام وسائر الكمّل ، (فمن ليس له ذلك العموم ) ، فإنه تنقص رتبته بمقدار ما نقص إدراكه ، وإذا كان للحق تفاضل في الظهور بالفعل مع التساوي في الظهور بالقوة .
( فلا تحجب بالتفاضل ) الفعلي في ظهور الحق عن ظهوره ، فتنكره بالكلية ( وتقول لا يصح كلام من يقول إن الخلق هوية الحق ) أي : ظهوره إذ لا كمال له فيما يتفاوت فيه وهو المطلوب في زعمكم ، فتقول : ليس المطلوب في كل مظهر جزئي الكمال بالفعل من كل وجه ، بل يكفي الكمال فيه بالقوة ( بعد ما رؤيتك التفاضل في الأسماء الإلهية ) .
""إضافة المحقق : وتسمى أمهات الأسماء ، وأئمة الأسماء ، والأئمة السبعة ، والحقائق السبعة الكلية ، والأسماء الكلية الأصلية وهي سبعة هي : الحي ، والعالم ، والمريد ، والقائل ، والقادر ، والجواد ، والمقسط ( لطائف الإعلام ص 26 ) .""
بالفعل في تعلقها مع أنها ( التي لا تشك أنت أنها هي الحق ) كيف ، ( ومدلولها المسمى بها ) أي : بدلالة المطابقة أو التضمن (ليس إلا اللّه ) ، ولكنها إذا كانت جميع الأسماء بالقوة اكتفى بذلك الكمال هناك ، فكيف لا يكتفي هاهنا ، بل هو واجب ؛ ليتميز هذا الكمال عن كماله الذي له في ذاته ، إذ هو بالفعل من كل وجه فافهم ، فإنه مزلة للقدم .
( ثم ) أي : بعد ما عرفت اعتبار التفاضل بالفعل في نظر الكمال فيما بين المظاهر الخلقية بعضها بالنظر إلى بعض ، فكيف لا يقع اعتبار التفاضل فيما بين أسماء الحق وبين الخلائق ( أنه كيف يقدم سليمان اسمه على اسم اللّه كما زعموا ) ، فإنه وإن صار أكمل المظاهر بالفعل ، وصار ثابتا عن الحق ، فرتبته نازلة عن رتبة الرحمة النازلة عن رتبة الإلهية كيف ( وهو من جملة من أوجدته الرحمة ).
أي : التي هي المدلول التضمني للرحمن الرحيم ، ( فلابدّ أن يتقدم ) في الواقع ( الرحمن الرحيم ) على سليمان المرحوم ؛ ( ليصح إسناد المرحوم ) المعلول إلى علته الرحمن الرحيم ، فيجب تأخر اسم سليمان في الذكر عن الرحمن الرحيم المتأخرين عن اسم اللّه ، فلو قدم اسمه عليهما كان خطأ ،
وإليه الإشارة بقوله :( هذا ) أي : تقديم سليمان اسمه على هذه الأسماء الإلهية ، ( عكس الحقائق ) أي : عكس مقتضاه (تقديم من يستحق التأخير ) ، وهو المعلول ( وتأخير من يستحق التقديم ) ، وهو العلة ( في الموضع الذي يستحقه ) ؛ لإشعاره بالعلية والمعلولية ، فهو وإن حسن في موضع باعتبار آخر ، ولا يحسن في مثل هذا الموضع أصلا ؛ لأنه أشعر بأنه مرحوم بهما أولا ، وراحم بتجليهما والتحقق بهما ثاني .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( ومن حكمة بلقيس وعلوّ علمها كونها لم تذكر من ألقى إليها الكتاب ؛ وما عملت ذلك إلّا لتعلم أصحابها أنّ لها اتّصالا إلى أمور لا يعلمون طريقها ، وهذا من التّدبير الإلهيّ في الملك ، لأنّه إذا جهل طريق الإخبار الواصل للملك خاف أهل الدّولة على أنفسهم في تصرّفاتهم ، فلا يتصرّفون إلّا في أمر إذا وصل إلى سلطانهم عنهم يأمنون غائلة ذلك التّصرّف ، فلو تعيّن لهم على يدي من تصل الأخبار إلى ملكهم لصانعوه وأعطوا له الرّشا حتّى يفعلوا ما يريدون ، ولا يصل ذلك إلى ملكهم ، فكان قولها :أُلْقِيَ إِلَيَّ[ النمل : 29 ] ولم تسمّ من ألقاه سياسة منها أورثت الحذر منها في أهل مملكتها وخواصّ مدبّريها وبهذا استحقّت التّقدّم عليهم ) .
ثم أشار إلى بقية ما يتعلق بالآية مع الإشارة إلى كمال عقل بلقيس ؛ ليتم بذلك تمسكه على منع تقديم سليمان اسمه على اسم اللّه في الكتاب ، بقوله : إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتابٌ كَرِيمٌ [ النمل : 29 ] ؛ وليشير بذلك إلى ما أثر فيها كتابه من إعطاء نصيب من الرحمتين في تدبير المملكة .
فقال : ( ومن حكمة بلقيس ) أي : علمها الذي استحكمت به أمر المملكة ، ( وعلو علمها ) على العلوم أكبر ولاة الأمر ( كونها لم تذكر من ألقي إليها الكتاب ) ، وهو الطير مع أنه أمر عجيب ، وفيه تعظيم شأن من أرسله بعموم تصرفه في أجناس العالم وأنواعه مع أن المشورة تتعلق ببيان حاله ، ( وما علمت ذلك ) للاختصار.
إذ لا يبالي به مع هذه الفوائد ، ولا بجهلها بالملقي ، إذ ثبت في الأخبار أن الطير لما ألقي الكتاب على صدرها وهي نائمة حك عليه برجله ، حتى تنبهت فعلمت به ، فما عملت ذلك ( إلا ليعلم أصحابها أن لها اتصالا إلى أمور ) من مملكتها ومملكة غيره ( لا يعلمون طريقها ) الذي تسلكه لتحصلها وتصل به أخبارها إليه .
( وهذا ) إن لم يكن له فائدة متوقعة في المستقبل ، فهو في الحال شبيه بالآلة ، إذ هو( من التدبير الإلهي في الملك ).
لأن انتظام أمور أكثر الخلائق في جهلهم بما يفعله إلا له بهم ، فكيف إذا كانت له مع ذلك فائدة متوقعة في المستقبل ، ( فإن إذا جهل طريق الإخبار الواصل للملك ) من مملكته أو مملكة غيره ( خاف أهل الدولة على أنفسهم في تصرفاتهم ) .
فإنها المتعلقة بالمملكة أو بخاصة أنفسهم من وصول أخبار ظلمهم وإفسادهم فيها من حيث لا يشعرون ، فإذا خافوا .
(فلا يتصرفون إلا في أمر إذا وصل ذلك الأمر إلى سلطانهم خبر عنهم يؤمنون غائلة ذلك التصرف ) ؛ لسلامته عن الظلم والإفساد ، وهم إنما يخافون هذا الخوف الموجب لصلاح تصرفاتهم كلها عن عدم تعين طريق الإخبار الواصل إلى ملكهم ، ( فلو تعين لهم ) طريق الإخبار ، وعلموا ( على يدي من يصل الإخبار إلى ملكهم ، لصانعوه ) بأنواع المودة .
( وأعظموا له الرّشا ) ليخفي عليهم مظالمهم ومفاسدهم ، وينهي عنهم ما يريد ملكهم رضا عنهم وتقريبا لهم .
( حتى يفعلوا ما يريدون ) من أنواع الظلم والفساد ، كما نرى من أهل زماننا ، ( ولا يصل ذلك إلى ملكهم ) ؛ لأنه عين للإيصال طريقا وعرفه الناس ، وهو لا توصل إليه الأمور على ما هي عليه إذ لا يصل إليه شيء حينئذ ، فإن أوصله غيره أجمعوا على تكذيبه بواسطته ؛ فإن تم كلامه عنده ، فربما لا يوصل إلا بعد مدة لا يمكن تداركهم إلا بصعوبة ( فكان قولها إني ألقي إليّ ) بصيغة المبني للمفعول .
( ولم تسم من ألقاه ) مع كونه طيرا من غير مملكتها ، ولا يمكن معه مصانعتهم ، وإعظام رشا له لو أوصله أخبارهم إليها مع أنه لا يمكنه ذلك ( سياسة فيها ) أي : تدبيرا في مملكتها ( أورثت الحذر منها في أهل مملكتها ) أي : عامة من يسكنها ، ( وخواص مدبريها ) وهم العمال المتصرفون في مملكتها من معرفتهم وصول أمور إلى ملكهم بطريق لا يعلمونه ، ففيه سد مسالك الفساد بالكلية ؛ لأن إخفاء هذا الطريق في غاية الصعوبة يحتاج إلى علم عظيم ، وتدبير حكيم ، ( وبهذا ) أي :
باختصاصها بزيادة العلم والسياسة ( استحقت التقديم ) برتبة السلطنة ( عليهم ) مع كونهم رجالا من شأنهم التقديم للسلطنة ، وغيرها من الأمور العظام .
قال الشيخ رضي الله عنه : (وأمّا فضل العالم من الصّنف الإنسانيّ على العالم من الجنّ بأسرار التّصريف وخواصّ الأشياء ، فمعلوم بالقدر الزّمانيّ : فإنّ رجوع الطّرف إلى النّاظر به أسرع من قيام القائم من مجلسه ؛ لأنّ حركة البصر في الإدراك إلى ما يدركه أسرع من حركة الجسم فيما يتحرّك منه ، فإنّ الزّمان الّذي يتحرّك فيه البصر عين الزّمان الّذي يتعلّق بمبصره مع بعد المسافة بين النّاظر والمنظور ، فإنّ زمان فتح البصر زمان تعلّقه بفلك الكواكب الثّابتة وزمان رجوع طرفه إليه عين زمان عدم إدراكه ، والقيام من مقام الإنسان ليس كذلك ، أي ليس له هذه السّرعة ، فكان آصف بن برخيا أتمّ في العمل من الجنّ ، فكان عين قول آصف بن برخيا عين الفعل في الزّمن الواحد ، فرأى في ذلك الزّمان بعينه سليمان عليه السّلام عرش بلقيس مستقرّا عنده لئلا يتخيّل أنّه أدركه وهو في مكانه من غير انتقال ، ولم يكن عندنا باتّحاد الزّمان انتقال ، وإنّما كان إعدام وإيجاد من حيث لا يشعر بذلك إلّا من عرفه ، وهو قوله تعالى :" بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ " [ ق : 15 ] .
ولا يمضي عليهم وقت لا يرون فيه ما هم راءون له ، وإذا كان هذا كما ذكرناه ، فكان زمان عدمه أعني عدم العرش من مكانه عين وجوده عند سليمان من تجديد الخلق مع الأنفاس ، ولا علم لأحد بهذا القدر بل الإنسان لا يشعر به من نفسه أنّه في كلّ نفس لا يكون ثمّ يكون ، ولا تقّل « ثمّ » تقتضي المهلة ، فليس ذلك بصحيح ، وإنّما « ثمّ » تقتضي تقدّم الرّتبة العلّيّة عند العرب في مواضع مخصوصة كقول الشّاعر :
كهزّ الرّديني . . . ثمّ اضطرب
وزمان الهزّ عين زمان اضطراب المهزوز بلا شكّ ، وقد جاء بثمّ ولا مهلة ، كذلك تجديد الخلق مع الأنفاس : زمان العدم زمان وجود المثل كتجديد الأعراض في دليل الأشاعرة ).
""أضافة المحقق : كهزّ الرّديني جزء بيت من المتقارب ، وهو لأبي داود الآيادي في « الأنور ومحاسن الأشعار » للشماطي ص ( 231 ) ، و « التشبيهات » لابن أبي عون ص ( 52 ) ، يروى البيت بتمامه : كهزّ الرّدينيّ بين الأكفّ جرى في الأنابيب ثم اضطرب"".
.
ولما فرغ عن بيان تعلق الرحمتين بالكاتب ، وهو سليمان عليه السّلام ، والمكتوب إليها ، وهي بلقيس أشار إلى تعلقها ببعض أصحاب سليمان عليه السّلام في الإتيان بعرشها عنده من جملة هذه القصة ، مع بيان فضله عن أصحابه من الجن في ذلك .
فقال : ( وأما فضل العالم من الصّنف الإنساني ) ، وهو آصف بن برخيا وزير سليمان عليه السّلام المشار إليه بقوله عزّ وجل قال :الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ[ النمل : 40 ] .
وفي قوله : من الصنف الإنساني إشارة إلى كمال مناسبته لسليمان بحيث صار من صنف الكمّل من الإنسان حتى اطلع على اللوح المحفوظ ، فعلم ما فيه من أسرار التصريف ( على العالم من الجن ) المشار إليه بقوله عزّ وجل : قالعِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ[ النمل : 39 ] .
وكان عالما بخواص الأشياء ( بأسرار التصريف ) ، وهو الإيجاد والإعدام ( وخواص الأشياء ) التي بها التأثير فيها ، والأول يتعلق بالأول والثاني بالثاني ، ( فمعلوم بالقدر الزماني ) ، فإن الفعل الواحد بالشخص إذا حصل من فاعل في زمان أقصر .
ومن آخر في زمان أطول يدل على مزية الأول فيه ، وهذه المزية تدل على فضل علمه به ، فكيف إذا حصل الفعل المفتقر إلى مدة مديدة من واحد في زمان واحد ، ومن آخر في زمانين فصاعدا ، فإنه يدل على أن الأول ما حصله عن تحريك ، وإنما حصله من اطلاعه على أسرار التصريف .
وعلى أن الثاني حصله عن تحريك في غاية السرعة عن اطلاعه على خواص الأشياء ، فعلم بذلك فضل علم آصف القائل : ( "أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ"[ النمل : 40 ] ) على فضل علم العفريت القائل :"أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقامِكَ" [ النمل : 39 ] .
( فإن رجوع الطرف )""المحقق : أي الإتيان في كلامه موقت بارتداد الطرف ورجوعه ""
المفهوم من قبل أن يرتد إليك طرفك من المنظور ( إلى الناظر به أسرع من قيام القائم من مجلسه ) المفهوم من قوله قبل أن تقوم من مقامك ؛ ( لأن حركة البصر ) بخروج الشعاع منه ( في ) طريق الإدراك ، وأصل ( إلى ما يدركه ) من صور المبصرات ( أسرع من حركة الجسم فيما يتحرك منه ) إلى أي : مقصد كان وإن قرب غاية القرب .
إذ لا بدّ له من ثلاثة أزمنة زمان كونه في المبدأ ، وزمان كونه في الوسط ، وزمان انتهائه إلى المقصد ، فإن رجع احتاج إلى ثلاثة أزمنة أخرى زمان سكونه في المنتهى الأول ، وزمان تحركه في الوسط ، وزمان وصوله إلى المنتهى الثاني الذي هو المبدأ في الحركة الأولى ، بخلاف حركة البصر إلى صور المبصرات ورجوعه إلى الباصر .
( فإن الزمان الذي يتحرك فيه البصر ) لخروج الشعاع منه ( عين الزمان الذي ) يصل إلى مقصده ، وهو كونه ( يتعلق بمبصره مع بعد المسافة بين الناظر والمنظور ) بحيث لو تحرك فيها الجسم لطالت المدة جدّا ، ( فإن زمان فتح البصر ) الموجب لتحركه إلى المبصرات ، هو بعينه ( زمان ) وصوله إلى المبصرات البعيدة جدّا ، فإنه زمان ( تعلقه بفلك الكواكب الثابتة ) ، وبعد ما بينهما مدة ثمانية آلاف سنة بحركة الأجسام العنصرية كما بين الأرض ، وفلك القمر مدة خمسمائة عام ، وكذا ما بين كل فلكين ، وتحت كل فلك ( وزمان رجوع طرفه إليه ) ؛ لانطباع المرئي في بصره ( عين زمان إدراكه ) أي : وصول شعاعه إلى المبصر ، وهذا الرجوع أيضا يحتاج في حركة الجسم العنصري إلى ثمانية آلاف سنة أخرى في البصر بتحرك هذه الحركة خروجا ورجوعا في زمان واحد مسافة لو تحرك فيها الجسم العنصري ، لافتقر إلى مدة ستة عشر ألف سنة .
وفي كلام الشيخ - رحمه اللّه - إشارة إلى الجمع بين مذهبي الشعاع والانطباع ، فدلّ هذا على أن الفعل الحاصل في مدة ارتداد الطرف أسرع منه في مدة قيام الشخص من مقامه ؛ وذلك لأن :
( القيام من مقام الإنسان ليس كذلك ) أي : ليست هذه الحركة كحركة البصر ، إذ ( ليس له هذه السرعة ) ؛ لافتقاده إلى زمانين فصاعدا ؛ لأن زمان ابتدائه غير زمان حصوله على الكمال ، فإذا كان فعل آصف يفتقر إلى زمان واحد ، وقول الجن إلى زمانين ،
( فكان آصف بن برخيا أتم في العمل من قول الجن ) ؛ لأنه حصل في أقصر مدة عن كمال علمه بأسرار التصريف ، ولو حصله الجن لم يتأت منه في تلك المدة ؛ لأن علمه كان بخواص الأشياء ولا بدّ من استجماعها .
( فكان عين قول آصف بن برخيا ) : أنا آتيك به ( عين الفعل ) إتيان عرش بلقيس ، إذ حصل بمجرد قصده من غير تحريك ( في الزمن الواحد ) ، كما يحصل المعلول مع العلة في زمانها ، وإن كان لها التقدم في الرتبة ، فصدق في إتيانه قبل ارتداد طرف سليمان عليه السّلام ( عرش بلقيس ) ، لا في مكانه الأول ولا منتقلا منه ، بل ( مستقرّا عنده ) ، أي : في مكان قريب .
وإنما قال تعالى في كتابه :"فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ"[ النمل : 40 ] .
ولم يكتف بقوله :"فَلَمَّا رَآهُ"[ النمل : 40 ] ، ولا بقوله :"مُسْتَقِرًّا"[ النمل : 40 ] ، .
( لئلا يتخيل )( أنه أدركه ، وهو في مكانه) الأول ( من غير انتقال ) له أصلا فضلا عن الانتقال إلى مكان سليمان عليه السّلام ، كيف ( ولم يكن عندنا باتحاد الزمان ) أي : مع اتحاده ( انتقال ) الجسم من مكان إلى آخر ؛ لافتقاره إلى تعدد الأزمنة ، وإن أمكن ذلك في انتقال البصر ورجوعه ، فكان يتخيل أنه رآه في مكانه الأول ، وآصف إنما أتى به في منظر سليمان عليه السّلام لا في مكانه .
ولما استقر عنده من غير انتقال علم أنه ( إنما كان ) لعرش بلقيس إعدام من مكانه الأول ، وإيجاد في مكان سليمان ( من حيث لا يشعر ) أحد بذلك ، فتوهموا الانتقال مع اتحاد الزمان ، وهو محال ( إلا من عرفه ) أي : وقوع الإعدام والإيجاد في جميع أجزاء العالم في كل نفس نفس ، ( وهو ) ما دلّ عليه ( قوله تعالى :"بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيد"[ ق : 15 ]) .
في كل جزء من أجزاء العالم ؛ لأن الأصل في الممكنات العدم من ذواتها ، والوجود من إشراق نور ربها عليها ، فهي تعود في كل نفس إلى أصلها والحق يمدها بالوجود في ذلك النفس بعينه ، وكيف لا يكونون في هذا اللبس ، وهم يعتقدون أنه لا يجمع وجود شيء وعدمه في زمان واحد ، وإن المعدوم غير مرئي مع أنه ( لا يمضي عليهم وقت لا يرون فيه ما هم راءون له ) ، فيتوهموا أنه لو حصل الشيء مما يرونه مستمرا الإعدام والإيجاد ، لكان غير مرئي وقت عدمه ومرئيّا وقت وجوده ، ولم يكن يرى مستمرا .
ولا يعلمون أنه يمكن اجتماع الوجود والعدم في الشيء الواحد باعتبارين اعتبار نفسه واعتبار غيره ، وإن المعدوم إنما لا يرى لو لم يكن له وجه من الوجود الخارجي أصلا ، وألا يرى من جهة وجوده .
( وإن كان هذا المذكور ) من وقوع الإعدام والإيجاد لأجزاء العالم في كل وقت ، وامتناع الانتقال على الأركان مع اتحاد الزمان .
( كما ذكرناه ، فكان زمان عدمه أعني : عدم العرش ) بينه ؛ لئلا يتوهم عوده إلى العالم ( من مكانه عين ) زمان (وجوده عند سليمان ) ، وإن كان ( من تجديد الخلق مع الأنفاس ) ، وقد جرت العادة فيه بالإيجاد في مكانه الأول ، فليس ذلك من لوازمه ، فإنه من قبيل إعادة المعدوم ، ولا يجب أن يعاد بجميع عوارضه حتى يعاد مع كونه في مكانه وزمانه ، بل تكفي الإعادة بذاته وعوارضه المشخصة .
وهذا مع كونه معقولا من حيث إن الأصل في الأشياء العدم ، وهو لا يفارق أصله بحال ، وإن الوجود له من غيره فهو إنما يستمر بإمداده ؛ ولذا قال المحققون : البقاء يحتاج إلى فاعل كالابتداء ، ومنصوصا في الكتاب الإلهي ( لا علم لأحد بهذا القدر ) في أجسام العالم .
وإن قال بعضهم به في الأعراض ، ولم يقل به أحد في عرش بلقيس ، وقالوا فيه بالانتقال مع اتحاد الزمان أو تبطئ به الأرض أو بالظفرة ، ( بل الإنسان لا يشعر به من نفسه أنه في كل ) مقدار ( نفس ) من الزمان ( لا يكون ) لوجوب عوده إلى أصله العدم ، ( ثم يكون ) بمدد ربه ، فكيف يشعرون في عرش بلقيس .
ثم استشعر سؤالا بأن لفظه ، ثم يشعر بتعدد الزمان ، وهذا يناقض ما تقدم من كون الإعدام والإيجاد في زمن واحد ، فقال : ( ولا تقل ثم ) في قولنا ، ثم يكون ( تقتضي المهلة ) المستلزمة تأخير زمان المعطوف عن زمان المعطوف عليه ، وهذا التأخير يستلزم تعددهما ؛ ( فليس ذلك ) الاقتضاء (بصحيح ) على الإطلاق ، ( وإنما ) الصحيح أن ( ثم ) تقتضي تقدم المعطوف على المعطوف عليه نوع تقدم إما بالزمان أو بالذات أو بالشرف أو غير ذلك .
فإنها ( تقتضي تقدم الرتبة العليّة ) للمعطوف عليه به ( عند العرب ) ، وإن لم يكن لهم اطلاع على أنواع التقديم ( في مواضع مخصوصة ) من غير أن يكون لتلك الرتبة تقدم زماني ، فلا يصح إطلاق اقتضاء ، ثم التقدم الزماني للمعطوف عليه مع صحة نقيضه ، ( كقول الشاعر : كهزّ الرّديني ) سيف منسوب إلى ردينة ، والهز التحريك ، ( ثم اضطرب وزمان الهزعين زمان اضطراب المهزوز بلا شك ) ضرورة امتناع تخلف الأثر عن التأثير .
( وقد جاء ) هذا الشاعر من العرب (بثم ولا مهلة ) في قوله : ثم اضطرب ، فهو إنما جاء بها تقدم الهز بالرتبة العلية ، فإنها متقدمة على المعلول بالرتبة لا بالزمان .
( كذلك ) أي : كما أن زمان الهز زمان اضطراب المهزوز مع علو رتبة الهز على رتبة الاضطراب ، ( تجديد الخلق مع الأنفاس ) لأجزاء العالم والإنسان المفهوم من قولنا لا يكون ، ثم يكون ( زمان العدم ) المشار إليه بقولنا لا يكون ( زمان وجود المثل ) المشار إليه بقولنا ، ثم تكون مع علو رتبة العدم لكونه الأصل في الممكن ، وكيف يمنع هذا التجديد في زمان واحد في أجسام العالم وأعراضه .
والمراد بالمثل المعتاد لاشتباهه بالمثل إلا أن المثلين شخصان متغايران ، وهذا شخص واحد تخلل العدم بين وجوديه كما يتخلل المرض بين صحتيه ، وهو ( كتجديد الأعراض فقط في دليل الأشاعرة ) .
فليس هذا من البدعة ، وإن اختص انتظام بالقول به ، واستدل الأشعري بأن العرض لو بقي لامتنع زواله ؛ لأنه إما بنفسه ، فيلزم أن يصير مستحيلا بعد ما كان ممكنا ، وهو قلب الحقائق المحال أو بموجب وجودي ، كطريان ضد ، وهو محال ؛ لأن طريانه مشروط بزوال الأول ، فلو كان زوال الأول لطريان الثاني لزم الدور أو بموجب عدمي كزوال شرط ، فإن كان عرضا لزم الدور والتسلسل ، وإن كان جوهرا .
فإن زال بالعرض لزم الدور ، وإلا لزم التسلسل أو بفاعل مختار ، وإلا زالت إعدام ؛ فلا يكون أثرا ، وهذا الدليل بعينه دليل النظام ؛ فإن أجبت عنه بطل مذهب الأشعري أيضا ، فيقال للسّنّي : إما أن تعترف بصحة مذهب النظام أو ببطلان مذهبك أو بالفرق ، ولم يظهر على أن تهول جميع ما في العالم كالأعراض لصورة الوجود الحقيقي الإلهي باعتبار ظهوره في حقائق العالم ، فحكمها حكم ما تسميه الأشاعرة بالأعراض بلا فرق .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( فإنّ مسألة حصول عرش بلقيس من أشكل المسائل إلّا من عرف ما ذكرناه آنفا في قصّته ، فلم يكن لآصف من الفضل في ذلك إلّا حصول التّجديد في مجلس سليمان عليه السّلام ، فما قطع العرش مسافة ، ولا زويت له أرض ولا خرقها لمن فهم ما ذكرناه ، وكان ذلك على يدي بعض أصحاب سليمان ليكون أعظم لسليمان في نفوس الحاضرين من بلقيس وأصحابها ، وسبب ذلك كون سليمان هبة اللّه تعالى لداود عليه السّلام من قوله تعالى :"وَوَهَبْنا لِداوُدَ سُلَيْمانَ "[ ص : 30 ] .
والهبة عطاء الواهب بطريق الإنعام لا بطريق الجزاء الوفاق أو الاستحقاق ، فهو النّعمة السّابغة والحجّة البالغة والضّربة الدّامغة ، وأمّا علمه فقوله تعالى :"فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ" [ الأنبياء : 79 ] ، مع نقيض الحكم "وَكُلًّا آتَيْنا حُكْماً وَعِلْماً"[ الأنبياء : 79 ] .
إذ كان هو الحاكم بلا واسطة ، فكان سليمان ترجمان حقّ في مقعد صدق ، كما أنّ المجتهد المصيب لحكم اللّه الّذي يحكم به اللّه في المسألة أو تولّاها بنفسه أو بما يوحى به لرسوله له أجران ، والمخطئ لهذا الحكم له أجر مع كونه علما وحكما ، فأعطيت هذه الأمّة المحمّديّة رتبة سليمان عليه السّلام في الحكم ، ورتبة داود عليه السّلام ، فما أفضلها من أمّة).
وإنما أطنبنا هذا الإطناب ( في مسألة حصول عرش بلقيس ) عند سليمان عليه السّلام في زمان انعدامه عن مكانه لغاية إشكالها ، فإن مسألة حصول عرش بلقيس في رؤية سليمان مستقرّا عنده ( من أشكل المسائل ) ؛ لأنه إن قيل فيها بالانتقال لزم تصور حركة الجسم من مكان إلى آخر في زمان واحد مع اقتضائه بالضرورة ثلاثة أزمنة في أقرب الأمكنة .
وإن قلنا بالتحديد لزم أن يكون زمان العدم عين زمان الوجود ، وهما متحدان معا مع أنه اعتراف بمذهب النظام .
وإن قلنا : إنه مع اتحاد الزمان لزم اجتماع الوجود والعدم في شيء واحد في زمان واحد ، والتزم بعضهم فيه القول بالحركة في زمن واحد ، وبعضهم عدل إلى القول بطيء المسافة ، وبعضهم إلى القول بالظفرة .
لكن الكل محال على ما يأتي ( إلا عند من عرف ما ذكرناه في قصته ) من أنه تحديد في زمان واحد محمقين مختلفين من غير انتقال ؛ فلذلك رآه مستقرّا غير مستقبل ، وإذا كان التجديد ( حاصلا لأجزاء العالم كله ما لآصف من الفضل في ذلك ) التحديد من حيث هو تحديد ، فإنه يحصل بدون قصده أبدا .
فلا فضل له ( إلا حصول التجديد في مجلس سليمان ) ، فإنه كان يقصده على خرق العادة بخرقها بالتحديد في المكان الأول إن كان ساكنا ، أو المكان المنتقل إليه إن كان متحركا إما مع السكون في مكانه الأول ، فلم يكن التحديد في مكان آخر عادة ، وإذا كان كذلك ، ( فما قطع مسافة العرش ) بعيدة في زمان واحد حتى يشكل بالحركة الممتدة في زمان واحد ، ( ولا زويت الأرض ) إلا لزوي دارها مع عرشها .
( ولا خرقها ) أي : حصلت له الظفرة التي يقول بها النظام ، لكنه إنما يقال ( لمن فهم ما ذكرناه ) من تحديده في زمان واحد في مكان آخر مع اجتماع الوجود والعدم عليه باعتبارين ، ومن استحالة بقية الاحتمالات بما ذكرن .
ثم أشار إلى سر ظهوره ( على يدي بعض أصحابه ) مع أن ظهور الخوارق على يديه أولى ، فقال : ( وكان ذلك ) أي : حصول عرش بلقيس مستقرا عند سليمان في زمان عدمه عن مكانه ( على يدي بعض أصحاب سليمان ؛ ليكون أعظم ) وقعا ( لسليمان عليه السّلام في نفوس الحاضرين من بلقيس وأصحابها ) ، بأنه إذا كان لبعض أصحابه هذه الرتبة العظيمة في إظهار الخوارق ، فأين رتبته في ذلك ، فيتأكد بذلك أمر نبوته مع أنه يدل على أنه إنما حصل له بتركه متابعته لسليمان ، فلو تبعناه ربما حصل لنا مثل هذه الرتبة .
( وسبب ذلك ) أي : اختصاص سليمان لظهور مثل هذه الخوارق على يدي بعض أصحابه دون أكثر الأنبياء عليهم السّلام ( كون سليمان عليه السّلام هبة اللّه لداود ) ، فيكون كمالا لنبوته ، وثبوت النبوة بظهور الخوارق على يدي النبي ، فكمالها يكون بظهورها على يدي بعض أصحابه عن متابعته وتكميله إياه (من قوله تعالى :وَوَهَبْنا لِداوُدَ سُلَيْمانَ) [ ص : 30 ] ، والهبة الإلهية للشخص لا بدّ وأن تفيده كمالا فوق الكمال المستحق له من ذاته أو من أعماله ، سيما إذا انتسبت إلى نون التعظيم ؛ وذلك لأن ( الهبة ) الإلهية (إعطاء الواهب ) من أسمائه تعالى ( بطريق الإنعام ) الذي ليس في مقابلة شيء ولا أداء حق .
ولذلك قال : ( لا بطريق الجزاء الوفاق )؛ فإنه في مقابلة العمل ( والاستحقاق ) ، فإنه من أداء الحق إلى مستحقه ،.
""إضافة المحقق : أي : الجزاء الموافق للأعمال وجزاء الاستحقاق بحسب العمل ، يعني أن وجود سليمان هبة اللّه لداود والفعل الذي حصل على يد بعض أصحابه في بلقيس ، سليمان هبة اللّه لسليمان لذلك لم يظهر على يدي نفسه ، إذا لو ظهر لتوهم أن ذلك مقابلة عمله لا بطريق الإنعام . ( شرح القاشاني ص 239 ) .""
فلا يسمى هبة ( فهو ) أي : هذا العطاء ( النعمة السابغة ) فوق الجزاء الوفاق وأداء قدر الاستحقاق ، فيكون أكمل النعم ، ولا أكمل فيها مما يكمل النبوة ، وتكميلها إما بتكميل علمها أو بتكميل المعجزات ؛ ولذلك يقول : هي الحكمة السالفة المكملة لعلم النبوة ، وفي نسخة : ( الحجة البالغة ) ، والمراد الأدلة العلمية المنتهية في الآية إلى المطالب ، ( والضربة الدامغة ) المكملة للمعجزات ، فإن ظهور الكرامات على يدي أصحاب النبي من الحجج المانعة للخصوم ؛ لتسكينهم تسكين الضربة الدامغة لا يقدرون على التحرك ، فالضربة الدامغة في حق سليمان عليه السّلام ما ذكرناه من ظهور هذه الكرامة من بعض أصحابه ، وأما الحكمة البالغة ؛ فقد أشار إليها بقوله : ( وأما علمه ) أي : المكمل لنبوته ، ) فقوله تعالى :”فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ”[ الأنبياء : 79 ] ( .
ففضل علمه على علم داود ( مع نقيض الحكم ) الذي هو متعلق علم داود ، والاعتقاد المتعلق بأحد النقيضين إذا كان علما كان الآخر جهلا غالبا ، فكان فضل هذا العلم على علم داود فضل العلم على الجهل ، إلا أنه ليس بجهل.
لأن معلومه وإن كان نقيض الحكم الصواب ، حكم مؤتى له من عند اللّه إذ كان يجب عليه العمل به ؛ لحصوله من العلم المؤتى له من اللّه تعالى بسبب اجتهاده بحيث يجب عليه أن يعتقده ويفتي به ؛ وذلك لأن ( كلا أتاه اللّه حكما وعلما ) بحيث أوجب على كل واحد منهما أن يعمل بما أوتي ويعتقد ويفتي به.
( فكان علم داود ) أي : اعتقاده مع تعلقه بنقيض الصواب ( علما مؤتى ) حصل له باجتهاده الخطأ ، لكن لم يؤته بالاجتهاد والنظر ، بل ( أتاه اللّه ) بإفاضة النتيجة بعد النظر والاجتهاد ، ولكنه أخطأ بمخالفة علم اللّه تعالى في المسألة .
( وعلم سليمان علم اللّه في المسألة ) بحيث ( إذا كان ) اللّه ( هو الحاكم بلا واسطة ) من حكام الخلق يحكم بحكم سليمان لا بحكم داود ، وإن أوجب عليه أن يعمل بما يراه من الخطأ ويعتقده ويفتي به وجعله علما مؤتى له ، ( فكان سليمان ترجمان حق ) بين علمه وحكمه ( في مقعد صدق ) ، أي : نائبا منابه في هذا الأمر دون داود ، وإن كان منصوصا عليه بالخلافة ، فكان مكملا خلافته ونبوته ، ولا يبعد أن تكون الاعتقادات المتعلقات بالنقيضين علمين ، فإن له نظيرا عندنا أشار إليه بقول : ( كما أن المجتهد المصيب لحكم اللّه ) .
ولما كان المخطئ أيضا حاكما بحكم اللّه ( الذي أوجب عليه العمل والفتوى ) به فسره بقوله : ( الذي يحكم اللّه به في المسألة أو لو تولاها ) أي : الحكومة ( بنفسه ، أو ) تولى التنصيص عليها ( بما يوحي به لرسوله له أجران ) مع إنما يعتقد الحكم المؤتي به من اللّه عن اجتهاده وعمله ، وأفتى به كالمخطئ إلا أن له مع أجر الاجتهاد المفيد له حكما وعلما أجر الإصابة لحكم اللّه ، ) والمخطئ لهذا الحكم ) المعين الذي تعينه في علم اللّه لو تولى الحكم بنفسه أو أوحى به إلى رسوله ، وإن كان مثل المصيب في الاجتهاد ، ووجود الفتوى والعمل به له أجر واحد هو أجر الاجتهاد فقط.
( مع كونه ) أي : كون خطئه في الاجتهاد ( علما ) يجب عليه اعتقاده والفتوى به ، ( وحكما ) يجب عليه العمل به ، فصح أن النقيضين حكمان إلهيان إذا صدرا عن الاجتهاد ، وإن الاعتقاد المتعلق بهما علم قطعي ، وإذا صح تشبيه سليمان وداود بمجتهدي هذه الأمة في الإصابة والخط .
( فأعطيت هذه الأمة المحمدية رتبة سليمان في الحكم ) إذا أصابوا ، ( ورتبة داود ) إذا أخطئوا ، ( فما أفضلها من أمة ) إذا كانوا في الخطأ على رتبة بعض الأنبياء الخلفاء ، بحيث يلحق خطؤهم بحكم اللّه في وجوب العمل والتسوي به في الجملة .
قال الشيخ رضي الله عنه : (ولمّا رأت بلقيس عرشها مع علمها ببعد المسافة واستحالة انتقاله في تلك المدّة عندها "قالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ" [ النمل : 42 ] وصدقت بما ذكرناه من تجديد الخلق بالأمثال ، وهو هو ، وصدق الأمر ، كما أنّك في زمان التّجديد عين ما أنت في الزّمن الماضي ، ثمّ إنّه كمال علم سليمان التّنبيه الّذي ذكره في الصّرح "قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ" [ النمل : 44 ] ، وكان صرحا أملس لا أمت فيه من زجاج ؛"فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً"[ النمل : 44 ] ، أي : ماء "وَكَشَفَتْ عَنْ ساقَيْها"[ النمل : 44 ] ، حتّى لا يصيب الماء ثوبها ، فنبّهها بذلك على أن عرشها الّذي رأته من هذا القبيل ، وهذا غاية الإنصاف ، فإنّه أعلمها بذلك إصابتها في قوله :"كَأَنَّهُ هُوَ"[ النمل : 42 ] ، فقالت عند ذلك :" قالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمانَ " أي : إسلام سليمان "لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ"[ النمل : 44 ] ، فما انقادت لسليمان ، وإنّما انقادت للّه ربّ العالمين ، وسليمان من العالمين ، فما تقيّدت في انقيادها كما لا تتقيّد الرّسل في اعتقادها في اللّه ، بخلاف فرعون فإنّه قال :"رَبِّ مُوسى وَهارُونَ" [ الأعراف : 122 ] ، وإن كان يلحق بهذا الانقياد البلقيسي من وجة ، لكن لا يقوى قوّته فكانت أفقه من فرعون في الانقياد للّه ) .
ثم أشار إلى ظهور هذا العلم في بلقيس عند إسلامها، وسببه مثل ظهور الخوارق في آصف ، وهو أتم لها من الخوارق إذ المقصود منها تقويته لا غير .
فقال : ( ولما رأت بلقيس عرشها ) عند سليمان ( مع علمها ببعد المسافة ) بين هذا المكان والمكان الأول ، ( واستحالة انتقاله في تلك المدة عندها ) ، وإن أمكن بتعدد الأزمنة في الجملة ، ولم تعلم انتفاءه ( قالت "كَأَنَّهُ هُوَ" [ النمل : 42 ].
أي : مثله ( وصدقت ) في أنه مثله ، وإن كان عينه في الواقع الأعراض أو الأركان لشبه المعاد بالمثل ، حتى أنه لا يتميز عنه عندنا ، وإن تميز في الواقع ( بتعدد الشخص في المثل ) دون المعاد ، ( وهو ) أي : المرئي عند سليمان ( هو ) عرش بلقيس الذي كان في مكانها.
ولذلك ( صدق الأمر ) في قوله : " أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِها قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ" [ النمل : 38 ] ، فإنه أمر في صورة الخبر ؛ ليعتقد المأمور أن في امتثاله تصديقه ، وفي تركه تكذيبه فيبادر إلى الامتثال لإيثاره تصديقه وينفر عن تكذيبه ، وهذا الصدق باعتبار المعنى الحقيقي .
( كما أنك في زمان التجديد عين ما أنت في الزمان الماضي ) ؛ لاتحاد الشخص في صورة الاتحاد ، ولا بدّ من تعدده في المثل ، ( ثم إنه من كمال علم سليمان ) الذي به اطلاعه على أنه لو صدقها في هذا القول باعتبار المعنى المجازي ، واعترفت بذلك مع كونه قائلا بخلافها بالمعنى الحقيقي كان ذلك سبب كمالها في الإسلام بأن تعرف ميله إلى ترجيح الصدق بأي وجه أمكن.
وكذا اطلاعه على ( تنبيه ) صدقها في الاشتباه بالأمر المشتبه الآخر ، ( الذي ذكره ) بلسان الحال (في) وضع (الصرح) مشابها للماء تنبيها على أن الاشتباه فيه مثل الاشتباه في العرش .
( فقيل لها : ادخلي الصرح ) ، وسبب الاشتباه أنه ( كان صرحا أملس ) مستوية أجزاء سطحه غاية الاستواء ( لا أمت فيه ) أي : لا ارتفاع لبعض أجزائه على بعض وكان صاف ؛ لأنه ( من زجاج ) ، فاشتبه الماء الساكن عند عدم الريح وغيرها من تحركاته ،("فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً " [ النمل :44] ).
أي : ماء ،(" وَكَشَفَتْ عَنْ ساقَيْها "[ النمل : 44 ] ، حتى لا يصيب الماء ثوبها ) بحسب حسبانها ، فهو وإن قصد بذلك ظهور ما على ساقيها من الشعر الذي أخبرته به الجن ، لما قيل إنها كانت بنت جنية ، فتظهر أسرارهم إليه .
( فنبهها ) أيض ( بذلك ) أي : بوضع الصرح على الهيئة المذكورة ؛ ليشتبه باللجة ( على أن عرشها الذي رأته ) ، وقالت فيه :" كَأَنَّهُ هُوَ" [ النمل : 42 ] .
( من هذا القبيل ) أي : اشتباه المعاد بالأمثال ، ( وهذا غاية الإنصاف ) من سليمان إذ صدقها على الوجه المجازي فيما يحكم بخلافه على الوجه الحقيقي ، ( فإنه أعلمها بذلك إصابتها في قولها كأنه هو ) في الجملة ، وإن خالفته في قوله :" أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِها " [ النمل : 38 ] ، (فقالت عند ذلك ) من رؤية الإنصاف على خلاف ما يقوله ، مع ترجيح جانب ما قاله ؛ لكونه المعنى الحقيقي ترجيحا للصدق بأي وجه كان ،" رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي " [ النمل : 44 ] بتأخير الإيمان بمن له تلك المعجزات ، وهذا العلم الكامل ، وهذا الإنصاف بعد عبادتي للشمس من دونك .
( وأسلمت مع سليمان أي : إسلام سليمان ) بحيث أكون معه في إسلامه ( للّه رب العالمين ) لا لسليمان ، إذ الإسلام له باعتبار كونه مظهرا جامعا إلهيّا شبه عبادة الشمس ،
( فما انقادت لسليمان ) وإن آمنت بنبوته .
( وإنما انقادت ) في الإيمان بنبوته ( لرب العالمين ) ، فإنه الظاهر فيه بكماله الذي أفادته النبوة ( وسليمان من ) غير اعتبار هذا الظاهر فيه من ( العالمين ) ، فلا يجب الإيمان به إلا باعتبار هذا الظهور ، ومع ذلك ( فما تقيدت في انقيادها ) بالرب الظاهر فيه من حيث هو ربه ، ولا باعتبار ظهوره فقط ، بل أخذت في ذلك رتبة المعية .
فما تقيدت ( كما لا تتقيد ) الرسل الذين من جملتهم سليمان الذي هي معه ( في اعتقادها في اللّه ) بأربابهم المخصوصة ، ولا بظهوره فيهم أو في محل معين آخر .
( بخلاف فرعون ، فإنه ) تقيد في إيمانه برب بني إسرائيل ، إذ ( قال : ) آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل ، وإن كان الذي آمنت به بنو إسرائيل ( رب موسى وهارون ) ، فكأنه قال : آمنت برب موسى وهارون ، والظاهر فيهما المقيد لهما النبوة الرب الجامع ، وما تقيدا في الإيمان بالرب الخاص ، بل كان إيمانهما بالرب الجامع ، لكنه تقيد في الظاهر بالرب الخاص ببني إسرائيل .
ففارق ( الانقياد البلقيسي وإن كان يلحق بهذا ) أي : بكون إيمان بني إسرائيل الذي قيد فرعون إيمانه بربهم الذي آمنوا به الرب الجامع ؛ لكونه رب موسى وهارون من حيث أفادهما النبوة وآمنا به الانقياد البلقيسي لرب العالمين من وجه ، وهو كون الرب الجامع هو المقصود بالانقياد الفرعوني ، ( ولكن لا يقوى قوته ) ؛ لأنه إنما يصل إلى هذا المقصود بوسائط ومقدمات بخلاف بلقيس ؛ لوصولها إلى هذا المقصود بلا واسطة ، فكانت مع كونها امرأة من شأنها قلة التفقه ( أفقه من فرعون ) ، وإن كان مطلعا على دقائق كثيرة كما ستعرف في الفص الموسوي ( في الانقياد للّه ) أي : للاسم الجامع مع التصريح بجمعيته بقوله : " لرب العالمين " ، وفرعون إنما انقاد في الظاهر لرب بني إسرائيل .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( وكان فرعون تحت حكم الوقت حيث قال :" إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرائِيلَ " [ يونس : 90 ] » فخصّص ، وإنّما خصص لما رأى السّحرة قالوا في إيمانهم باللّه :" رَبِّ مُوسى وَهارُونَ" [ الشعراء : 48 ] .
فكان إسلام بلقيس إسلام سليمان إذ قالت : " مَعَ سلَيْمانَ" فتبعته ، فما يمرّ بشيء من العقائد إلّا مرّت به معتقدة ذلك ، كما نحن على الصّراط المستقيم الّذي الرّبّ تعالى عليه لكون نواصينا في يده ، ويستحيل مفارقتنا إيّاه ، فنحن معه بالتضمين وهو معنا بالتّصريح ، فإنّه قال :" وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ " [ الحديد : 4 ] ، ونحن معه بكونه آخذا بنواصينا ، فهو اللّه تعالى مع نفسه حيثما مشى بنا من صراطه ، فما أحد من العالم إلّا على صراط مستقيم وهو صراط الرّبّ تعالى ، وكذلك علمت بلقيس من سليمان؛ فقالت :"لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ " [ النمل : 44 ] وما خصّصت عالما من عالم).
ثم أشار إلى وجه تخصيص فرعون رب بني إسرائيل للإيمان به ؛ فقال : ( وكان فرعون تحت حكم الوقت ) أي : حكم الرب الذي له السلطنة في الوقت ، وهو الاسم الخاص ببني إسرائيل ، ( حيث قال :آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرائِيلَ )، فقيد إيمانه بالذي آمنت به بنو إسرائيل من أسماء اللّه تعالى لما رأى السلطنة له في إنجائهم من الغرق .
( فخصص ) هذا الرب ، وإن كانوا مطلقين لما كان إيمانهم برب موسى وهارون ، وهما لا يتقيدان في الإيمان باسم دون اسم لما في التخصيص من الكفر بالأسماء الباقية .
وهو في معنى الكفر باللّه بالكلية ، ولكنه ( إنما خصص لما ) توهم أن هذا التخصيص في معنى التعميم لما ( رأى السحرة قالوا في إيمانهم باللّه ) الجامع على قولهم :" آمَنَّا بِرَبِّ الْعالَمِينَ . ("رَبِّ مُوسى وَهارُونَ ") [ الشعراء : 48 ، 47 ] ، وسمع من موسى وأصحابه فوزهم ، فظن أنه في معنى التعميم ، ولكنهم إنما أتوا به بعد التصريح بالتعميم وبالجملة ، فقد قصر إسلام فرعون عن إسلام بلقيس .
( فكان إسلام بلقيس إسلام سليمان ) في علو الرتبة ( إذ قالت مع سليمان ) ، وإن لم يكن لإيمانها هذه الرتبة بذاتها أمكن أن تكون له هذه الرتبة بالتبعية ، كعبد الوزير يمكنه أن يدخل بتبعية الوزير المواضع المخصوصة للسلطان ما لا يمكنه أن يدخلها لو انفرد ( فتبعته ) ، فما يمر سليمان ( بشيء من العقائد ) المفصلة ( إلا مرت به ) مجملة لكونها ( معتقدة ذلك ) أي : اعتقاد سليمان ، وإن لم يتفصل لها ذلك الاعتقاد ، فتحصل لها تلك الاعتقادات بالتضمين ، كما يحصل لسليمان بالتصريح ، فهذا الفرق بينهما مستمر كالفرق بيننا وبين ربنا في المرور على صراطه ، بل في كوننا معه .
كما أشار إليه بقوله : ( كما كنا نحن ) أي : جملة الناس ( على الصراط المستقيم الذي الرب تعالى عليه ) في أفعاله بنا ، فإنها مستقيمة له ؛ فهي مستقيمة لنا باعتبار تبعيتنا له ، وإن كانت غير مستقيمة لنا باعتبار ما يكتسب منها من الصفات الذميمة أو كانت قبيحة.
وإنما تبعناه ( لكون نواصينا في يده ) ، وإنما لم تكن هذه الجهة جهة الاكتساب لنا ؛ لأنها ضرورية لا اختيار لنا فيها ، والكسب إنما يتعلق بالاختيار ؛ وذلك لأنه ( يستحيل مفارقتنا إياه ) ، وإذا كانت استقامتنا في الأفعال القبيحة بتبعيته .
( فنحن معه ) على الصراط المستقيم لا قدرة لنا من دونه ، والقدرة المكتسبة غير مؤثرة في حصول الفعل نفسه بل في صفاته .
فلذلك صرح بكونه معنا ، ولم يصرح بكوننا معه ، فإنه قال في بيان كونه معناوَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ ،فصرح وقال في بيان كوننا معه :" مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِناصِيَتِها إِنَّ رَبِّي عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ " [ هود : 56 ] .
فلم يصرح بل أفهم ( بالتضمين ) أنه نحن معه بكونه آخذ بناصيتها ، وإذا صح أن كوننا بالتضمين لتبعيتنا إياه ، فلا يكون الحق تابعا لنا في اكتسابنا ؛ فهو تعالى مع نفسه حيث ما مشى بنا في أفعالنا من صراط مستقيم أو غير مستقيم بالنسبة إلينا ؛ فإنه مستقيم بالنسبة إليه لا يلحقه بتبعيتنا إياه القبائح التي تلحقن .
وإذا كان له المشي على جميع صراطنا ، وهو على صراط مستقيم دائما ، فما بقي أحد من العالم إلا على صراط مستقيم ، وإن لم يستقم بوجه آخر عقلا أو عرفا أو شرعا ؛ فإن الوجود خير كله ، وإنما جهة الشرفية نسبة عدم الغير أو عدم كماله إليه ، ولكن جهة الخيرية مخصوصة بمفيض الوجود .
ولذلك يقول : هو من جهة الاستقامة ، إنما هو صراط الرب تبارك وتعالى لا صراطنا ، إذ ليس منا إفاضة الوجود الذي هو الخير ، بل إنما يكون منا إفادة الصفات بمظاهرنا ، وهي منشئة الاكتساب الذي يقسم الصراط إلى المستقيم وغيره .
ويقسم الأفعال إلى الحسن والقبيح ، وكما علمنا هذه الدقائق كذا علمت بلقيس من سليمان أنه مع اللّه على جميع صراطه على ما هو ربه عليه من جهة الاستقامة .
حيث ثابت له فقالت للّه رب العالمين ، فتجمع صراط العالم في الوصول إلى ربها وما خصصت عالما من عالم ليحصل لها الوصول إلى ربها من جميع الوجوه من غير قصد أن تكتسب شيئا من الاكتسابات القبيحة أو الحسنة حتى يحتاج إلى تمييز بعضها عن بعض ، بل قصدت جهة الجذب الذي أقله يوازي عمل الثقلين ، فهذا من سريان علمه إليها كسريان الكرامة إلى آصف ؛ فافهم ، فإنه مزلة للقدم .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( وأمّا التّسخير الّذي اختصّ به سليمان ، وفضّل به على غيره وجعله اللّه له من الملك الّذي لا ينبغي لأحد من بعده ؛ فهو كونه عن أمره ، فقال : " فَسَخَّرْنا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ " [ ص : 36 ] ، فما هو من كونه تسخيرا ، فإنّ اللّه يقول في حقّنا كلّنا من غير تخصيص :" وَسَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ " [ الجاثية : 13 ] .
وقد ذكر تسخير الرّياح والنّجوم وغير ذلك ، ولكن لا عن أمرنا بل عن أمر اللّه ، فما اختصّ سليمان إن عقلت إلّا بالأمر من غير جمعيّة ولا همّة .
بل بمجرّد الأمر ، وإنّما قلنا ذلك لأنا نعرف أنّ أجرام العالم تنفعل لهمم النّفوس إذا أقيمت في مقام الجمعيّة ، وقد عاينّا ذلك في هذا الطّريق ، فكان من سليمان مجرّد التّلفّظ بالأمر لمن أراد تسخيره من غير همّة ولا جمعيّة ).
ثم أشار - رحمه اللّه - إلى أثر الرحمتين سيما الرحمة في حق سليمان عليه السّلام بقوله : ( وأما التسخير ) أي : تسخير الريح والماء والشياطين والطيور والدواب ( الذي اختص به سليمان ) من بين أفراد الإنسان ، ولم يكن ذلك كتسخير أرباب العزائم لبعضها ، بل فضل به غيره من الأنبياء الأولياء .
وذلك لأنه جعل اللّه له من الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده ، إما لعدم بلوغه إلى كماله أو لعدم ظهوره بذلك ؛ فهو كونه حاصلا له عن مجرد أمره بلا همة ولا عزيمة بخلاف من بعده من الأولياء وأهل العزائم ، بل من أمر اللّه تعالى وحده .
فقال :" فَسَخَّرْنا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ " [ ص : 36 ] ، يدل على أن اختصاصه به من حيث كونه من أمره ؛ لأنه تعالى قيده بذلك ، فما هو أي : اختصاص التسخيرية من كونه تسخيرا أعم من أن يكون بأمره أو بالهمة أو العزيمة أو بأمر اللّه .
وإن قيل : إنه لم يدل على نفي اختصاصه بالوجه العام به ، فلابدّ من نفيه لدلالة نص آخر عليه ، فإن اللّه تعالى يقول في حقّنا كلنا من غير تخصيص بالكمّل منا أو بأهل العزائم حتى يقال : إنه اختصاص إضافي ، أي : بالإضافة إلى العامة غير أهل العزائم .
"وَسَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ " [ الجاثية : 13 ] ، أي : من أمره ، وقد ذكر في مواضع أخر من كتابه تسخير الرياح حيث قال :"وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ " [ إبراهيم : 32 ] ، وقال :" وَالسَّحابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ "[ البقرة :164 ] ،
ولا شكّ أن تسخيرهما تسخير الرياح والنجوم .
حيث قال : " وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّراتٍ بِأَمْرِهِ " [ الأعراف: 54 ] ، وقال :" وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دائِبَيْنِ " [ إبراهيم : 33 ] ، وغير ذلك حيث قال :" أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّراتٍ فِي جَوِّ السَّماءِ ما يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ " [ النحل : 79 ] .
وقال في الدواب : " الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ " [ الزخرف : 13 ] ، وقال كذلك : " سَخَّرْناها لَكُمْ " [ الحج : 36 ] .
وقد ذكرنا تسخير العفريت لنبيّنا عليه السّلام ، ولكن لا عن أمرنا بل عن أمر اللّه بلا واسطة ، فلم نقر بفضيلة ظهوره فينا بالأمرية في هذه الأمور ، وإن كان لنا فضيلة كوننا مسخرا لهم ، وفاز بها سليمان فما اختص سليمان بشيء لأمثلة التسخير .
إن نقلت ولم تقتصر على ما اشتهر إلا بالأمر ، أي : إلا بكون التسخير عن أمرية لا باعتبار كونه أمر أعم من أن يكون بجمعية وهمة ، أو دونهما بل من غير جمعية ولا همة ، فإنهما وإن اختصا بمن له نوع كمال بالنسبة إذ يرجع بالجمعية إلى اللّه ، وبالهمة إلى قدرته وإرادته ، فليس ذلك أخص خصوصية إلى من لا يحتاج إليهما بل يكون له التسخير بمجرد الأمثلة ؛ لكمال تشبهه باللّه تعالى إذ يصدر منه كل شيء بمجرد أمره من غير جمعية ولا همة .
وإنما قلنا ذلك أي :اختصاصه بكون التسخير من مجرد أمره ، وإن لم يدل عليه النقل ؛ لأنّا نعرف أن أجرام العالم كالرياح ، والمياه ، والشياطين ، والدواب ، والطيور ، وقيد بها ؛ لأن الأرواح لا يتأثر بعضها عن بعض إلا باعتبار أجرامها تنفعل .
أي : تقبل الأثر لهمم النفوس إذا قمت في مقام الجمعية ، أي : بقيت فيها مدة لا تشتغل بغير ما يهمها ، فيتم عشقها معها الموجب لتأثيره .
وقد عاينا ذلك في أهل هذا الطريق إذ تيسر لهم هذه الجمعية دون غيرهم ؛ لتفرق هممهم لتعلقها بالأمور المتفرقة ، فلا يتم تأثير همتها فيها لاشتغالها بغيرها ، فلا يجتمع في ذلك الموضع اجتماع قوي المثل الموجب لقوته ، لكنه قصور في التشبيه باللّه الذي لا يشغله شأن عن شأن ، فكان التسخير من سليمان بمجرد التلفظ بالأمر .
كمعنى قول : كن القائم بذات الحق لمن أراد تسخيره من غير همة ولا جمعية ؛ لأنه لا يشغله شأن عن شأن ؛ لظهور الحق باسميه الرحمن الرحيم فيه .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( واعلم أيّدنا اللّه ، وإيّاك بروح منه أن مثل هذا العطاء إذا حصل للعبد أيّ عبد كان ؛ فإنّه لا ينقصه ذلك من ملك آخرته ، ولا يحسب عليه ، مع كون سليمان عليه السّلام طلبه من ربّه تعالى ، فيقتضي ذوق الطّريق أن يكون قد عجّل له ما ادّخر لغيره ، ويحاسب به إذا أراده في الآخرة ، فقال اللّه له :"هذا عَطاؤُنا"[ ص : 39 ].
ولم يقل لك : ولا لغيرك "فَامْنُنْ" [ ص : 39] ، أي : أعط ،"أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ "[ ص : 39 ] ، فعلمنا من ذوق الطّريق أنّ سؤاله ذلك كان عن أمر ربّه ، والطّلب إذا وقع عن الأمر الإلهي كان الطّالب له الأجر التّامّ على طلبه ، والباري تعالى إن شاء قضى حاجته فيما طلب منه ، وإن شاء أمسك ، فإنّ العبد قد وفّى ما أوجب اللّه عليه من امتثال أمره فيما سأل ربّه فيه ؛ فلو سأل ذلك من نفسه عن غير أمر ربّه له بذلك لحاسبه به )
.
ثم استشعر سؤالا بأنه كيف يكون هذا التسخير أثر الاسمين المذكورين مع أنه مضر في الآخرة تنقص منزلته بما أوتي في الدنيا ؛ لقوله تعالى :"أَذْهَبْتُمْ طَيِّباتِكُمْ فِي حَياتِكُمُ الدُّنْيا"[ الأحقاف : 20 ] ، ويحاسب به عليه .
فرفع ذلك بقوله : ( واعلم أيدنا اللّه وإياك بروح منه ) فيه إشارة إلى أن من غلبت روحانيته لا تضر الأمور الدنيوية في آخرته أن مثل هذا العطاء ، وإن كان من شأنه الحساب ، ونقص الدرجة في الآخرة في حق القاصرين ، فهو من حيث هو عطاء إذا حصل للعبد ، أي : عبد كان ، أي : نبيّا كسليمان أو غيره ، فإنه لا ينقصه ذلك من ملك آخرته ، ولا يحسب عليه في جزائه حتى ينقص من جزائه بقدره ما لم يكن ذلك عن هواه ، فلا ينقص في حق سليمان ، ولا هو يحاسب عليه مع كون سليمان طلبه من ربه بقوله :"وَهَبْ لِي مُلْكاً لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي "[ ص : 35 ] .
ويوهم هذا الطلب كونه عن هواه فيقتضي ذوق الطريق ، وفي نسخة : " ذوق التحقيق " بناء على هذا الوهم أن يكون سليمان قد عجل له في الدنيا سؤاله ما ادخر لغيره في الآخرة ، وهو يوجب نقص ذلك من آخرته إذ يحاسب به في جزائه إذا أراده في الآخرة ، فلا يقرر في شأنه هذا الوهم ، وهو ينافي كون ملكه أثر هذين الاسمين .
أي : الرحمن الرحيم ، فرفع اللّه عزّ وجل هذا الوهم في حقّه ، فقال اللّه له :هذا عَطاؤُنابنسبة العطاء إلى حضرة التعظيم ، وهي حضرة الاسم الجامع للأسماء المعطية ، وهو الرحمن ، ولم يقل ما ينافي جمعيته لك ولا لغيرك ، ثم قال :فَامْنُنْأي : أعط أو امسك إشارة إلى جمعية نيابته عن اللّه في العطاء والمنع .
""المحقق : فما نسب إلى العبد إلا الإعطاء أو الإمساك بما لا يحاسب عليه . ""
ثم صرّح بإزالة الوهم ، فقال :بِغَيْرِ حِسابٍ ،فدل على أنه لا يحاسب به في الآخرة ، ولا ينقص ذلك من ملك آخرته ، وذوق الطريق ماء يقتضي ذلك إذا كان حصوله من الشيء الذي منشأه هوى السائل لا ما يكون منشأه أمر ربه ، فعلمنا من ذوق الطريق ، وإن لم نجد عليه نصّا من الكتاب والسنة أن سؤاله صلّى اللّه عليه وسلّم ذلك كان عن أمر ربه .
وذلك لأن الطلب إذا وقع لا عن هوى الطالب ، بل عن الأمر الإلهي كان الطالب له الأجر التام في الآخرة من غير أن ينقص حصول مطلوبه في الدنيا شيئا منه في الآخرة على طلبه ، لما فيه من امتثال ربه المقيد لوجوبه أو ندبيته ، ولا هو يجوز أن يكون أجره ما يحصل له من مطلوبه في الدنيا إذ البارئ تعالى إن شاء قضى حاجته فيما طلب منه ، وإن شاء أمسك ، والأجر ليس موكولا إلى المشيئة بل محروم الحصول .
وإذا لم يكن هذا المعجل أجره على امتثال أمر ربه في سؤاله كان أجره مدخرا في الآخرة ، فيحصل له بتمامه هناك ، فإن العبد قد وفي ما أوجب اللّه عليه من امتثال أمر ربه فيما سأل ، وإن وافق هواه ، لكن لم يكن منشأ سؤاله ذلك بل أمر ربه ، فهذه التوفية من العبد في امتثال الأمر توجب التوفية من الرب في إعطاء الأجر التام في الآخرة والحساب ، والنقص بمقداره في الآخرة ينافي هذه التوفية منه تعالى .
بل لو كان السؤال عن أمر ربه مع هواه جميعا لم يحاسب به ، ولم ينقص في حقه ، كما يشير إليه قوله : « فلو سأل ذلك من هوى نفسه من غير أمر ربه له بذلك لم يحاسبه به » .
""المحقق : في نسخة « فلو سأل ذلك من نفسه عن غير أمر ربّه له بذلك لحاسبه به "".
فنقصه في آخرته كما قال في حقّ أهل الهوى :" أَذْهَبْتُمْ طَيِّباتِكُمْ فِي حَياتِكُمُ الدُّنْيا" [ الأحقاف : 20 ] .
قال الشيخ رضي الله عنه : ( وهذا سار في جميع ما يسأل فيه اللّه كما قال لنبيّه محمّد صلى اللّه عليه وسلّم :"وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً "[ طه : 114 ] فامتثل أمر ربّه فكان يطلب الزّيادة من العلم حتّى كان إذا سيق له لبن يتأوّله بالعلم كما تأوّل رؤياه لمّا رأى في النّوم أنّه أتي إليه بقدح لبن فشربه وأعطى فضله عمر بن الخطّاب ، " قالوا : فما أوّلته ؟ قال : العلم ، وكذلك لمّا أسري به أتاه الملك بإناء فيه لبن وإناء فيه خمر فشرب اللّبن ، فقال له الملك : أصبت الفطرة أصاب اللّه بك أمّتك" « رواه مسلم وابن خزيمة » ، فاللّبن متى ظهر فهو صورة العلم ، فهو العلم تمثّل في صورة اللّبن كجبريل تمثّل في صورة بشر سويّ لمريم ) .
( وهذا ) أي : عدم محاسبة الحق فيما حصل بالسؤال عن الأمر الإلهي ( سار ) ، أي : عام ( في جميع ما يسأل اللّه فيه ) سواء كان المسؤول فيه عين ما أمر به الحق أو مناسب له نوع مناسبة ؛ لأنه امتثال الأمر من كل وجه بخلاف الاقتصار على الامتثال في عين ما أمر به دون ما يناسبه مع أنه في معناه ، فإنه امتثال من وجه دون وجه ، ( كما قال لنفسه صلّى اللّه عليه وسلّم « 2 » :" وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً"[ طه : 114 ] ) .
""المحقق : في نسخة : « لنبيه محمد صلّى اللّه عليه وسلّم . ""
( فامتثل أمر ربه ) بطلب عين المأمور وما يناسبه ؛ ( ولذلك كان يطلب الزيادة من العلم ) في الصور المتعارفة له أي : المسائل العلمية ، وفي صورة اللبن.
""المحقق : في نسخة : " فكان" ""
(حتى كان إذا سيق له لبن ) في يقظته ( يتأوّله ) علما ؛ ليكون بهذا التأويل طالبا لحصوله له ، فإن تأويل الرؤيا سبب حصول تأويله ، وتركه سبب ضياعه ، وتأويل الصور الحسية في معنى ذلك عند الكمّل ، فكان عليه السّلام يتناول اللبن المسوق إليه ( بالعلم ) ، ( كما تأوّل رؤياه ) بالعلم ، ( فلما رأى في النوم أنه أتي بقدح لبن ، فشربه وأعطى فضله عمر بن الخطاب ، قالوا : « فما أولته » قال : العلم ) .
وذلك لأن العلم قوام الروح في النهاية ، كما أن اللبن قوام البدن في البداية والنهاية هي الرجوع إلى البداية ، فالنهاية في العلم ظهور جميع ما في الروح بالقوة في فطرته إلى الفعل .
ثم أشار إلى دليل عدم اختصاصه بالمنام بقوله : ( وكذلك لما أسري به أتاه الملك ) ، أي : جبريل ، وفي لفظ « الملك » إشارة إلى أن لكلّ صورة معنى في عالم الملكوت هو تأويله ( بإناء فيه لبن ) تأويله العلم الكامل الفطري ، ( وإناء فيه خمر ) تأويله الحيرة والسكر ، ( فشرب اللبن ) ؛ ليكمل علمه الفطري ، ( فقال له الملك : « أصبت الفطرة » ) التي كان عليها الروح عند تجردها عن البدن ، وهو سبب كمال علمه ( « أصاب اللّه بك أمتك » ) .
أي : جعلها اللّه مصيبة للفطرة بسبب شربك اللبن لسراية ما فيك إليهم بالمناسبة التي بينك وبينهم ؛ ( فاللبن متى ظهر ) في عالم الملكوت أو الملك في يقظة أو منام ( فهو صورة العلم ) ، فمن رأى لبنا ( فهو العلم ) من جملة عالم المعاني "تمثل في صورة اللبن" حسية أو خيالية ، (كجبريل ) من جملة عالم الأرواح ( تمثل في صورة بشر سوي ) خيالية ظهر بها لمريم ، فالصور الحسية كالخيالية .
قال الشيخ رضي الله عنه : (ولمّا قال عليه السّلام : " النّاس نيام فإذا ماتوا انتبهو ".رواه البيهقي.
نبّه على أنّه كلّ ما يراه الإنسان في حياته الدّنيا إنّما هو بمنزلة الرّؤيا للنّائم خيال فلابدّ من تأويله إنّما الكون خيال ... وهو حقّ في الحقيقة
والّذي يفهم هذ ... حاز أسرار الطّريقة
فكان صلّى اللّه عليه وسلّم إذا قدّم له لبن قال : « اللّهمّ بارك لنا فيه وزدنا منه » . رواه الهيثمي.
لأنّه كان يراه صورة العلم ، وقد أمر بطلب الزّيادة من العلم ؛ وإذا قدّم له غير اللّبن قال : « اللّهمّ بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه » . رواه النسائي
؛ فمن أعطاه اللّه ما أعطاه بسؤال عن أمر إلهي فإنّ اللّه لا يحاسبه به في الدّار الآخرة ، ومن أعطاه اللّه ما أعطاه بسؤال عن غير أمر إلهيّ فالأمر فيه إلى اللّه ، إن شاء حاسبه به ، وإن شاء لم يحاسبه .
وأرجو من اللّه في العلم خاصّة أنّه لا يحاسبه به ، فإنّ أمره لنبيّه بطلب الزّيادة من العلم عين أمره لأمّته ، فإنّ اللّه يقول :لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ[ الأحزاب : 21 ] ، وأيّ أسوة أعظم من هذا التّأسّي لمن عقل عن اللّه تعالى ، ولو نبّهنا على المقام السّليمانيّ على تمامه لرأيت أمرا يهولك الاطلاع عليه ، فإنّ أكثر علماء هذه الطّريقة جهلوا حالة سليمان عليه السّلام ومكانته وليس الأمر كما زعموا ) .
وإليه الإشارة بقوله : ( ولما قال عليه السّلام : « الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا به » ، نبّه على أنه كل ما يراه الإنسان في حياته الدني ) سواء كان في اليقظة أو المنام ، وأوّله فحقق تأويله بعد اليقظة ، ( إنما هو بمنزلة الرؤيا للنائم ) حتى أن تأويله الواقع في الدنيا من قبيل ما يرى في المنام ؛ لأنه ( خياله ) ، وإن عدّ من المحسوسات الظاهرة ، ( فلابدّ من تأويله ) حتى أن تأويله يحتاج إلى تأويل آخر في الآخرة ، وكيف لا .
وقد قالوا : ( إنما الكون ) أي : الوجود الحادث ( خيال ) ؛ لأنه صورة الوجود الحقيقي الظاهرة في مرايا الخلائق ، ( وهو ) أي : الكون باعتبار تحققه ( حق في الحقيقة ) ، إذ لا تحقق له في نفسه ، وإنما هو من جهة إشراق نور ربه عليه ، ( بل من يفهم هذا حاز أسرار الطريقة ) أي : معانيها الدقيقة كالفناء ، والبقاء ، والجمع ، والفرق ، وعلم كيفية السير في المقامات ، وإذا كانت جميع الموجودات صورا خيالية راجعة إلى الحق ، فأي عجب في رجوع بعض الصور إلى بعض المعاني التي في الحق مما ظهر بها في هذه الموجودات إذا عرفت هذا ، فقد ظهر الحق بصفة القيومية في اللبن ، فصار قوام الأبدان وقيوميته للأرواح بالعلم ، فلما كان اللبن مظهر القيومية وأصلها في الأرواح كان صورة العلم .
" ( فكان صلّى اللّه عليه وسلّم إذا قدم له لبن ) في اليقظة ( قال : « اللهم بارك لنا فيه )أي : أعطنا ما هو بركته ، وهو كونه مظهرا لقيوميتك ، فنصير مقومين للأشباح والأرواح جميع " .
ثم قال : « ( وزدنا منه ) أي : من هذا اللبن الذي من جهة العلم ؛ ( لأنه كان يراه صورة العلم ، ومرجع الصورة إلى ما هي صورته ، ( وقد أمر بطلب الزيادة من العلم ) » ، وكان طلبها بقوله : « وزدنا منه » ، وإلا فطلبه الزيادة من اللبن من حيث هو لبن قليل الجدوى لا يليق به صلّى اللّه عليه وسلّم ، ( وإذا قدم له غير اللبن ) مما لا يناسب العلم بوجه من الوجوه .
( قال ) : « ( اللهم بارك لنا فيه ) بظهور ما فيه من أسمائك ليتحقق به (وأطعمنا خيرا منه ) » ؛ ليطلع على ما فوق تلك الأسماء ، فإن العلم فوق الإرادة وهي فوق القدرة ، فاللبن وإن لم يكن عين ما أمر به عليه السّلام بطلبه ، لم ير الحساب على طلب المزيد منه ؛ لأنه كان مناسبا لما أمر بطلب الزيادة منه ، فكيف يحاسب في طلب ما أمر به بعينه .
( فمن أعطاه اللّه ) كنبينا وسليمان عليه السّلام ( ما أعطاه بسؤال عن أمر إلهي ) سواء كان في عين ما أمر به أو فيما يناسبه ، ( فإن اللّه لا يحاسبه به في الدار الآخرة ) ، وإن عجل له ذلك في الدنيا ووافق هواه ، أو لم يكن سؤاله عن محض الهوى بل عن أمر اللّه وحده ، أو صح هواه ، (ومن أعطاه اللّه ما أعطاه بسؤال ) ( من غير أمر إلهي ) لا فيه ، ولا في مناسبته ، فإنه واف بذلك في سؤاله للحق وتحقق بعبوديته فيه.
( فالأمر فيه إلى اللّه ) ( إن شاء حاسبه به ) ؛ لأنه وسط الحق في طلب غيره ، ( وإن شاء لم يحاسبه ) ؛ نظرا إلى أنه امتثل في الجملة قوله :ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ[ غافر : 60 ] .
( وأرجو من اللّه في العلم خاصة ) إذا طلبه أحدنا من غير أمر خاص في حقه ( أنه لا يحاسب به ) ، ( فإن أمره لنبيه عليه السّلام ) بطلب الزيادة من العلم عين ( أمره لأمته ) ، وإن لم يكن مفهوم ذلك الأمر لكن يفهم ذلك من أمرهم باقتدائه ، فإن اللّه يقول :" لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ "[ الأحزاب : 21 ] ، إذ هو أمر في صورة الخبر .
( وأي أسوة أعظم من هذا التأسي ) ؛ فإنه تأسي في الأمر الذي تتعلق به جميع العبادات التي أمروا بالاقتداء فيها ، ولكن إنما يقال هذ ( لمن عقل عن اللّه تعالى ) ، إذ ربما يقول غيره طلب العلم من قبيل توسيط الحق ، وليس كذلك فإن المقصود منه معرفة الحق بما يمكن معرفته به من المعاني الظاهرة له في الخلائق ، وهذا تنبيه على بعض ما اختص به سليمان عليه السّلام .
( ولو نبّهنا على المقام السليماني على تمامه ، لرأيت أمرا يهولك الاطلاع عليه ) لغاية ذمته ، حتى خفي على أكبر علماء هذه الطريقة ، (فإن أكثر علماء هذه الطريقة جهلوا حالة سليمان عليه السّلام ومكانته ) ، فزعموا أنه كان كأكبر الملوك .
( وليس الأمر كما زعموا ) إذ كان ملكه من مكملات الأمور الأخروية من غير أن يفوته فيها شيء شبيه .
ولما فرغ من الحكمة الرحمانية التي فيها إفاضة الوجود العام والصفات العامة ، شرع في الحكمة الوجودية التي منها فيض كمالاته من النبوة والولاية والجلاء ، وسائر الهيئات الخاصة ؛ فقال : عن فص الحكمة الوجودية في الكلمة الداودية
.
jZaiezXmH-A
 |
 |
البحث في نص الكتاب
يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!