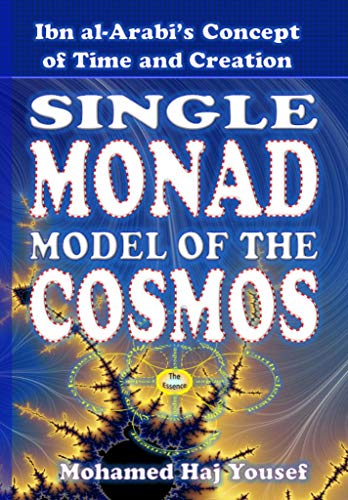تعليقات أبو العلا عفيفي
على فصوص الحكم
تأليف: د. أبو العلا عفيفي
فص حكمة قلبية في كلمة شعيبية
[نسخة أخرى فيها المتن مع التعليقات والمقدمات]
 |
 |
فص حكمة قلبية في كلمة شعيبية
12 - فص حكمة قلبية في كلمة شعيبية .كتاب فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي مع تعليقات د.أبو العلا عفيفي
تعليقات د.أبو العلا عفيفي على كتاب فصوص الحكم للشيخ الأكبر ابن العربي الطائي الحاتمي
12 - فص حكمة قلبية في كلمة شعيبية
(1) القلب.
(1) القلب عند ابن العربي كما هو عند سائر الصوفية الأداة التي تحصل بها المعرفة باللَّه وبالأسرار الإلهية: بل بكل ما ينطوي تحت عنوان العلم الباطن: فهو أداة إدراك وذوق لا مركز حب وعاطفة.
أما مركز الحب عندهم فهو الروح، وإن كانوا ينسبون الحب إلى القلب أحياناً.
وهنالك طريق ثالث للاتصال الروحي عندهم وهو «السر» الذي هو مركز التأمل في اللَّه.
وليس غريباً أن يعدّ الصوفية القلب مركزاً للإدراك لا للعاطفة فإنهم نحوا في ذلك منحى القرآن الذي صور القلب هذا التصوير فجعله محلًا للإيمان ومركزاً للفهم والتدبر الصحيحين.
يقول: «أَ فَل يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها؟» (س محمد- 22).
«أُولئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ» (س المجادلة- 21) «فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغاءَ تَاوِيلِهِ» (س آل عمران- 6) وما شاكل ذلك.
وليس المراد بالقلب تلك المضغة الصنوبرية الجاثمة في الجانب الأيسر من الصدر- وإن كانت متصلة به اتصالًا ما، لا يعرف كنهه.
بل هو القوة الخفية التي تدرك الحقائق الإلهية إدراكاً واضحاً جلياً لا يخالطه شك.
وإذا أشرق فيه نور الإيمان وصفا من غشاوات البدن وشهواته انعكس عليه العلم الإلهي: أو على حد تعبير ابن العربي: انكشف ما فيه من العلم الإلهي فشاهد فيه صاحبه صفحة الوجود: بل شاهد فيه الحق ذاته.
وهذا في نظره معنى الحديث القدسي الذي يقول اللَّه تعالى فيه: «ما وسعني أرضي وا سمائي و لكن وسعني قلب عبدي المؤمن».
ولكن قلب أي عبد مؤمن؟
يقول ابن العربي هو قلب العارف الذي يدور مع الحق أينما دار، ويشاهده في كل تجلّ من تجلياته.
هو القلب الذي لا يشاهد سوى الحق.
ولكن القلب محجوب عادة عن الحق مشغول عنه بما سواه، تتنازعه عوامل العقل والشهوة.
ولذا كان مجال نضال دائم بين جنود الحق وجنود الشيطان، يطلب كلٌ الظفر به لنفسه. وتتلخص حياة السالك في الطريق الصوفي في تدبير الوسائل التي يقهر بها شيطان النفس ويظفر بالحق.
وللقلب بابان تدخل المعرفة الإلهية من أحدهما، وتدخل الأوهام إليه من الآخر. وهذا عالَمٌ وذلك عالم آخر كما يقول جلال الدين الرومي. فغاية الصوفي تخليص القلب من أثر الأوهام بطرد كل خاطر يتصل بما سوى اللَّه.
وقد أنكر الصوفية على العقل القدرة على فهم الألوهية وأسرارها قائلين إن العقل مقيد بمنطقهِ في دائرة الأمور المحدودة المتناهية. أما الحق فلا حد له ولا نهاية.
ومن ناحية أخرى يرى العقل الأمور على أكثر من وجه، ويرى الشي ء الواحد ونقيضه، ويدافع عن كل منهما بحجج متكافئة في القوة والإقناع.
ومن ناحية أخرى يرى العقل الأمور على أكثر من وجه، ويرى الشي ء الواحد ونقيضه، ويدافع عن كل منهما بحجج متكافئة في القوة والإقناع.
ثم هو فوق ذلك يسدل على الحقائق ستاراً كثيفاً من الألفاظ، بل لقد يعني بالألفاظ التي هي رموز الحقائق ويغفل عن الحقائق نفسها.
وقد أفنى الفلاسفة أعمارهم في الاشتغال بألفاظ جوفاء لا طائل تحتها. أما الصوفية فينظرون إلى الحقائق ذاتها ثم يمسكون عن الحديث عنها أو لا يجدون من الألفاظ ما يستطيعون به التعبير عما يشاهدونه.
(2) اعلم إن القلب- أعني قلب العارف- هو من رحمة اللَّه، وهو أوسع منها، فإنه وسع الحق جلّ جلاله».
(2) موضوع الكلام هنا هو قلب العارف لا القلب الإنساني إطلاقاً، و العارف هو المولى أو الإنسان الكامل الذي تحققت فيه كل صفات الوجود فكان مظهراً تاماً و كوناً جامعاً لها.
والقلب من رحمة اللَّه لأنه شيء من الأشياء التي وسعتها الرحمة الإلهية في قوله تعالى: «وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ ءٍ»، أي هو شيء من الأشياء التي منحها اللَّه الوجود نعمة منه وفضلًا، إذ جرينا على تفسير الرحمة الإلهية في هذا الكتاب بمعنى إسباغ اللَّه الوجود على الأشياء.
ورحمة اللَّه التي وسعت كل شي ء في الوجود أي في الوجود المخلوق أو في عالم الوجود الإضافي- لا تسع الحق تعالى لأن وجوده لا يوصف بأنه ممنوح أو معطى، بل هو له من ذاته وواجب له لذاته.
ولكن قلب العارف يسع الحق بدليل قوله تعالى: «ما وسعني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن». ولهذ كان القلب أوسع من الرحمة.
بأي معنى إذن وعلى أي وجه وسع قلب العارف الحقَّ جل جلاله؟ هذه مسألة ظهر فيها اختلاف بين الصوفية لاختلاف مشاربهم ومذاهبهم. أما أهل السنة منهم فيذهبون إلى أن قلب المؤمن الصادق في إيمانه لا يتسع لشي ء من الأشياء مع الحق لأنه مشغول به عمن سواه. فهو لا يفكر إلا في الحق ولا يرى شيئاً سوى الحق ولا يخطر به خاطر إلا كان متصلًا بالحق. فني عن نفسه وعن كل ما سوى الحق وبقي بالحق وحده.
وهذا رأي عامة الناس وطريقتهم في فهم احتواء القلب للحق.
وأم الخاصة والمقصود بهم دائماً صوفية وحدة الوجود فيفهمون احتواء قلب العارف على الحق بأحد الوجهين الآتيين:
الأول: أن قلب العارف يشاهد الحق في كل مجلى و يراه في كل شي ء و يعبده في كل صورة من صور المعتقدات. فهو هيولي الاعتقاد كلها كما أشار إليه من قبل. فهو يحتوي الحق بمعنى أنه مجتمع صور الاعتقادات في الحق. و المراد بالحق هن «الحق المخلوق في الاعتقاد» لا الحق من حيث هو في ذاته. و في هذا المعنى قال ابن العربي:
عقد الخلائق في الإله عقائدا ..... وأنا شهدت جميع م اعتقدوه
الثاني: أن العارف هو الإنسان الكامل الذي جمع كل صفات الوجود في نفسه فكان بذلك صورة كاملة للحق. و لما كان قلب العارف بمثابة المرآة التي ينعكس عليها وجوده الذي هو صورة مصغرة من وجود الحق، شاهد الحق في مرآة قلبه و هذا معنى احتواء قلبه عليه. و لا يحتوي قلب إنسان آخر- بل و لا قلب موجود آخر- الحق بهذ المعنى لأنه لا ينعكس على مرايا قلوبهم إلا صور ناقصة للحق ينتزعونها من صور وجودهم الخاصة.
(3) «و رحمته لا تسعه. هذا لسان العموم من باب الإشارة، فإن الحق راحم ليس بمرحوم فل حكم للرحمة فيه».
(3) المسألة هنا: هل الرحمة تسع الحق كما تسع الخلق: و هل لها حكم في الحق؟
يقول إن لغة العموم- و هي لغة أهل الظاهر تثبت أن الرحمة لا تسع الحق لأنه راحم غير مرحوم: اي منْح الوجود للأشياء- و هو المراد بالرحمة- من فعل الحق، أما الحق فلا يوصف بأنه مرحوم بهذ المعنى. هذا إذا نظرنا إلى الحق في ذاته، أما إذا نظرنا إليه من حيث تجليه في صور الممكنات و ظهوره بها فللرحمة حكم فيه أيضاً، فإن الوجود يفيض على هذه الممكنات فتظهر بالصور التي هي عليها، و هذا هو الرحمة بعينها. هذه هي لغة أهل الخصوص التي شرع بعد ذلك في شرحها.
و لم يزد في هذا الشرح على ما ذكره سالفاً و كرره مراراً من انتشار النفس الرحماني على صور الموجودات و ظهور الحق بمظاهرها: و انتهى من كل هذا إلى أن الرحمة الإلهية قد وسعت الحق أيضاً، بل هي أوسع من القلب أو مساوية له في السعة.
راجع ما ذكر عن المعنى الخاص للرحمة في الفص الأول و الفص السادس عشر و ما ذكر عن العطايا و المنح في الفص الثاني.
(4) «فالألوهية تطلب المألوه و الربوبية تطلب المربوب».
(4) هذا بيان لسبب وجود العالم و ظهوره بالصورة التي هو عليها. و ذلك أن الأسماء الإلهية التي هي عين مسمى الحق تطلب ما تعطيه للوجود من الحقائق أي تطلب مظهراً خارجياً تحقِّق و تظهر فيه كمالاتها. وليس ذلك المظهر إلا العالم.
فلا بدّ إذن من هذ الظهور و لا بدّ من وجود العالم، و إلا لم يكن للأسماء الإلهية معنى. و الطلب هنا- في قوله: «طالبة ما تعطيه من الحقائق» إشارة إلى ضرورة عقلية هي ضرورة وجود أحد المتضايفين إذا وجد الآخر. فالأسماء الإلهية تطلب- أي تطلب عقلًا ما يحقق معانيه و هذه هي متضايفاتها: فإنه لا معنى لوصف الحق بأنه عالم إلا إذا وجد المعلوم، و ل معنى لوصفه بالألوهية إلا إذا وجد المألوه، و لا بالربوبية إلا إذا وجد المربوب و هكذا.
و في الأسماء الإلهية طائفتان متمايزتان مختلفتان: إحداهما الأسماء التي يتصف بها الحق من حيث كونه إلهاً- أي معبوداً- و من هذه تتكوّن الألوهية.
و الأخرى الأسماء التي يتصف بها الحق من حيث كونه مدبِّراً للوجود و متصرفاً فيه: و منها تتكون الربوبية. فمن حيث ألوهية الحق يُعْبَد و يُخَاف و يقدّس و يسبّح بحمده و يدعَى و يُتَضرّع إليه إلى غير ذلك من الأفعال التي يقوم بها المألوهون إزاء إلههم. و من حيث كونه رباً يرزق الخلق و يدبّر الكون و يجيب المضطر إذا دعاه، و غير ذلك مما يقوم به الرب نحو المربوبين. فالألوهية إذن تطلب المألوهين، و الربوبية تطلب المربوبين، و لا وجود لإحداهما- بل و لا تقدير لوجود إحداهما إلا بوجود أو تقدير وجود م يضايفها. و قد صرح ابن العربي بهذا المعنى في موضع آخر من الفصوص بقوله: «فنحن بمألوهيتنا قد جعلناه إلهاً».
هذا كلام يقضي به منطق العقل و منطق أي مذهب من مذاهب الدين، و لكن ما معناه و ما قيمته في مذهب ابن العربي و هو يقول بوحدة الوجود: أي بوحدة الإله و المألوه و الرب و المربوب؟ ل يزال إله ابن العربي يُعْبَد و يقدّس
و يسبّح بحمده: و لكن بمعان خاصة وضعها لهذه الألفاظ، و قد سبق شرح بعضها. و هو معبود و مقدّس و مسبّح بحمده من حيث إنه «الكل»، و الذي يعبده و يقدسه و يسبح بحمده هي أفراد الموجودات أو صورها. فالألوهية و المألوهية، و إن لم يكن لهما المعنى الديني الخاص الذي نعرفه، ليسا خلواً من معنى فلسفي له قيمته و خطره في مذهبه. على أنه قد يُشْرِب ذلك المعنى الفلسفي أحياناً روحاً دينية عالية و يبث فيه عاطفة دينية قوية لا تقلّ في قوتها و لا في حرارتها عن عاطفة أي رجل ديني. فالعبد- مع أنه وجه من وجوه الحق و مجلى من مجاليه- لم يزل مفتقراً إلى الحق الذي هو أصله- مستمداً وجوده من وجوده، لا قيمة و لا وجود له في ذاته. و أي افتقار أعظم من افتقار الصورة- و هي في ذاته عدم محض- إلى من يقومها و يوجدها؟
فشأن ابن العربي في هذ الصدد شأن «اسبنورا»: لم يخْفُتْ في قلبه صوت العاطفة الدينية، و إن قضى عقله على كل معنى من المعاني التي تحملها ألفاظ الدين- أعني دين المذاهب و النحل و هو الدين بمعناه الضيق. أما دينه فهو الدين العالمي الواسع الذي وجد أصوله و مبرراته في رحبة وحدة الوجود.
على أن الألوهية و الربوبية من جهة أخرى مفتقرتان إلى المألوهين و المربوبين، و لا بد من ذلك لكي ينعكس كل من المتضايفين على الآخر تمام الانعكاس و يتكافآ وجوداً و عدماً. فإذا قلن إن الحق غني عن العالمين، كان المراد بذلك الذات الإلهية التي لا نسبة لها مطلقاً إلى الوجود من حيث هي، لا الحق الذي هو إله و رب.
(5) «فلما تعارض الأمر بحكم النسب ورد في الخبر ما وصف الحق به نفسه من الشفقة على عباده».
(5) لا تعارض و لا تناقض في الذات الإلهية من حيث ما هي عليه في نفسها، و لكن التعارض و التناقض حاصلان فيها من حيث الأسماء الإلهية و الصفات التي هي نسب و إضافات بين الذات الواحدة و مظاهرها الكونية الكثيرة.
و المظاهر الكونية متعارضة متناقضة فلا بد من وقوع التعارض و التناقض في نِسَبِها إلى الذات. فالحق موصوف بصفات متضادة كالأول و الآخر و الظاهر و الباطن و الجميل و الجليل، و هو- في مذهب ابن العربي- موصوف أيضاً بصفات المحدثات لأنه هو الظاهر في صورها الكثيرة المتباينة.
ففي هذه الحضرة فقط و في هذا المقام وحده، و هو مقام الكثرة (لا مقام الوحدة الذي هو حضرة الذات) وصف الحق نفسه بالشفقة على عباده و برحمته إياهم، فإن شفقته و رحمته يتجليان في منح الوجود للكثرة الوجودية التي هي العالم. و لهذا قال: «فلما تعارض الأمر بحكم النسب»: أي فلما وقعت المعارضة في الذات الإلهية من أجل نسبها إلى الكثرة الوجودية، خلق اللَّه العالم. و خلق العالم هو عين شفقته به.
(6) «فلا يزال «هو» له دائماً أبداً».
(6) ذكر في الفقرة السابقة أن للحق تجليين: تجلي غيب و تجلي شهادة. فتجليه في الغيب هو تجليه لذاته في ذاته في الصور المعقولة لأعيان الممكنات و هذه هي حضرة الأسماء و الفيض الأقدس الذي شرحناه في الفص الأول.
و تجليه في الشهادة هو ظهوره في صور أعيان الممكنات في العالم الخارجي، و هو الفيض المقدّس المشار إليه هنالك.
فالتجليان هما هذان الفيضان أو الحضرتان المتقابلتان و هما أيضاً المرموز إليهما بالاسمين الإلهيين: الأول و الآخر أو الباطن و الظاهر: عالم الغيب و عالم الشهادة.
و لما كان الضمير «هو» يشير إلى المفرد التائب كان رمزاً على عالم الغيب، و وجب إطلاقه على الحق في تجليه الأول وحده، و لهذا قال: «فلا يزال «هو» له (أي للحق) دائماً أبداً. و لا يطلق «هو» على عالم الشهادة لأنه كثرة مظهرية لا ذات واحدة، كما أنه لا يقال على أي موجود من الموجودات إنه هو الحق. و لهذا كفَّر ابن العربي النصارى في قولهم: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ» * لأنهم قصدوا أنه عيسى ابن مريم دون غيره.
و في تجلي الغيب يحصل الاستعداد الذي يكون عليه قلب العارف. و قد ذهب جمهور الصوفية إلى أن الحق يتجلى لقلب كل عبد بحسب استعداد ذلك القلب، و لكن ابن العربي يخالفهم في هذا الرأي و يذهب إلى أن قلب العارف يتلون في كل لحظة بلون الصورة التي يتجلى له الحق فيها، فهو هيولي الصورة أو الاعتقاد كما أشرنا.
و لهذا قال: «فإن العبد- و يقصد به العارف خاصة- يظهر للحق: و المراد يظهر قلبه للحق: على قدر الصورة التي يتجلى له فيها الحق». و قد شرح هذا المعنى من قبل في قوله: «فإن القلب من العارف أو الإنسان الكامل بمنزلة محل فص الخاتم من الخاتم لا يفضل: بل يكون على قدره و شكله».
فكأن المسألة إذن ليست مسألة استعداد للقلب يحصل تجلي الحق بمقتضاه، فيراه القلب على هذا النحو أو ذلك و يدركه في هذه الصورة أو تلك، بل المسألة مسألة مرآة تنعكس عليها صور جميع الموجودات فيدركها قلب العارف على أنها صور للحق و يتشكل بشكلها و يتلون بلونها و يضيق و يتسع بضيقها و سعتها، لأن القلب من هذه الصور كفصّ الخاتم من الخاتم.
على أن هذا لا يمنعنا من أن نسمي قدرة القلب على قبول جميع صور التجلي الإلهي استعداداً أيضاً و أن قلب العارف قد قدّر له ذلك في عالم الغيب كما قدر لغيره ألا يدرك من صور التجلي إل صورة واحدة.
و لكن الأولى أن نقول إن تفسير الصوفية لتجلي الحق في قلب العبد تفسير صوفي، و تفسير ابن العربي تفسير فلسفي متأثر بمذهبه في وحدة الوجود.
(7) «فلا يشهد القلب و لا العين أبداً إلا صورة معتقده في الحق».
(7) بعد أن شرح معنى احتواء قلب العارف للحق ومشاهدته له، أراد أن يفسر ذلك «الحق» المشهود، فقال إنه صورة معتقد العارف.
فالعارف يشهد جميع صور المعتقدات لأنه لا يتقيد بصورة دون أخرى، و إن شئت فقل أنه يشهد الحق المخلوق في المعتقدات في هذه الصورة، بينما يشهده غيره في صورة خاصة و لا يراه إلا فيها. وهؤلاء هم أصحاب الاعتقادات الخاصة.
وفي هذه العبارة اعتراف صريح من ابن العربي بأن «الحق» في ذاته ليس مشهوداً لأحد في هذه الدنيا، وإنكار صريح على الصوفية الذين يدّعون أنهم يشاهدون «الحق» في حال وجدهم وفنائهم.
فليس الحق في نظره مشهوداً لأحد من حيث ذاته المقدسة المنزهة عن جميع النسب والإضافات وكل ما يتصل بالوجود الخارجي.
وليس الحق مشهوداً لأحد من حيث إنه ذات موصوفة بالصفات والأسماء، إلا عن طريق المجالي والمظاهر الوجودية التي يتألف منها العالم.
ولكن «الحق» مشهود في كل قلب- وفي قلب العارف بوجه خاص في صور معتقدات صاحب هذا القلب.
فإن عبَّرنا عن هذه المسألة بلغة التجليات كما يعبر عنها هو أحياناً، نقول إن تجلي الحق في ذاته غير مشهود لأحد، و كذلك تجليه في الحضرة العلمية في أسمائه و صفاته، و لكنه مشهود في تجليه في صور الإله المخلوق في المعتقدات.
(8) «فالأمر لا يتناهى من الطرفين».
(8) المعرفة الحقيقية بالحق هو أنك لا تقيده في صورة خاصة فتقر به و تنكر ما عداها، بل تطلقه إطلاقاً في جميع الصور الوجودية على السواء- أو في جميع صور الاعتقادات على السواء و صور الوجود لا تتناهى فمعرفتك بالحق لا تتناهى.
و لذلك قال: «و كذلك العلم باللَّه ما له غاية في العارف يقف عندها. و كيف يقف العلم باللَّه عند غاية، و العلم به مستمد من العلم بمظاهر الوجود المتغيرة المتبدلة في كل آن من الآنات، و الخلق الجديد « يشير الشيخ ابن العربي في مثل هذا المقام إلى قوله تعالى: «بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ» (قرآن س 50 آية 14) و يشرح الخلق الجديد بهذا المعنى. وقد عالج هذه المسألة في الفص السادس عشر.
الذي هو تحول الحق في الصور هو قانون الوجود؟
والمراد بالطرفين اللذين لا نهاية لهما هو «العلم بالحق» والحق نفسه من حيث ما هو معلوم. و لا نهائية المعلوم تفضي حتماً إلى لا نهائية العلم.
(9) «و ما يعرف ما قلنا سوى عبد له همَّه»
(9) أي لا يعرف حقيقة الوجود و أنه واحد على الرغم من كثرته، و عامٌّ على الرغم من تخصصه، و نور كله على الرغم من وجود الظلمة فيه، إلا عبد وهبه اللَّه تلك القوة الخفية الغامضة التي يسميها الصوفية بالهمة.
و قد سبق أن شرحنا ناحية هامة من نواحي هذه القوة في التعليق الثامن على الفص السادس، و هي وظيفة همة العارف في الخلق و تسخير الأشياء. أما هنا فيشير ابن العربي إلى ناحية أخرى في الهمة، و هي وظيفتها كأداة لتحصيل المعرفة بالأمور التي يعجز العقل عن إدراكها. فهي من هذا الوجه مرادفة للذوق الصوفي.
و معنى الهمة توجه القلب و قصده بجميع قواه الروحانية إلى فعل أمر من الأمور أو كشف حقيقة من الحقائق:
فهي عند الصوفية وسيلة من وسائل التصرف و طريق من طرق المعرفة في آن واحد. فهي القوة التي تنفعل لها أجرام العالم إذا أقيمت النفوس في مقام الجمعية (الفص السادس عشر)،
و هي القوة التي تخترق الحجب الكثيفة التي يسد لها العقل على الحقائق و تدرك كنه هذه الحقائق ذوقاً.
و حقيقة الحقائق كلها عند ابن العربي هي وحدة الوجود. فالقلب وحده- عن طريق هذه القوة هو الذي يدرك الحقيقة الوجودية في وحدتها. أما العقل فمقضيّ عليه بالعجز و القصور في هذا الميدان، لأنه لا يستطيع التحرر أبداً من عبوديته لمنهجه و هو منهج تحليل «الكل» إلى أجزائه.
(10) «إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْرى لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِيدٌ»، (قرآن س 50 آية 36) إلى قوله فإن الرسل لا يتبرأون من أتباعهم الذي اتبعوهم».
(10) فسر هذه الآية تفسيراً باطنياً خاصاً- كعادته- أخرجها به عن معناها و بنى عليه نظرية معتقدة في معرفة العباد بالحق و مدى صحة هذه المعرفة في حالة كل منهم.
قسم طالبي المعرفة بالحق ثلاثة أقسام:
الأول أصحاب القلوب وهم الكاملون من الصوفية.
والثانيأصحاب العقول وهم الفلاسفة والمتكلمون.
و الثالثالمؤمنون الذين يأخذون علمهم بالتقليد من أنبيائهم.
أم أصحاب القلوب فيعرفون الحق بالشهود و الذوق، و يرونه في كل مجلى و يقرون به في كل صورة.
فهم يدورون مع الحق أينم دار، و يشاهدون وجهه (ذاته) في كل مشهد.
ألم يقل الحق في كتابه: «فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ»؟ (قرآن س 2 آية 115).
و أما أصحاب العقول من الفلاسفة و المتكلمين فهم أهل الاعتقادات الخاصة الذين حصرو الحق في صور خاصة- و الحق يأبَى الحصر.
و هؤلاء هم الذين «يكفر بعضهم ببعض و يلعن بعضهم بعضاً» من أجل ما وهموا أن الحق في هذا المعتقَد أو ذاك أو في هذه الصورة العقلية أو تلك. و ليس لهؤلاء القوم شهود للحق في قلوبهم، و إن كانت له صور معقولة مجردة في عقولهم.
و أما المقلدون الذين قلدوا الأنبياء و الرسل فيما أخبروا به عن الحق- و هم المشار إليهم بقوله: «أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ» فلهم في الحق أيضاً اعتقادات خاصة و صور معينة.
ولكنهم أصحاب شهود بدليل قوله: «وَهُوَ شَهِيدٌ» لأنهم يشاهدون الحق بنوع ما في صلواتهم و أدعيتهم و يمثلونه بين أيديهم اتباعاً لأمر النبي صلى اللَّه عليه و سلم في قوله: «أعبد اللَّه كأنك تراه»: أي تصوره على نحو ما في قبلتك و أنت تعبده حتى لكأنك تراه.
و ليس هذا شهود قلب كشهود العارفين من الصوفية و إنما هو شهود خيال.
(11) «وَ بَدا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ - في هويته- ما لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ».
(11) أشار فيما سبق إلى الحديث القائل إن اللَّه يتجلى لعباده يوم القيامة في صورة فينكرونه و يستعيذون منه، و في صورة أخرى فيعرفونه و يسجدون له، و قال:
إن هذه الصور ليست سوى صور الاعتقاد التي يعرف فيها أصحابها الحق أو ينكرونه. و يشرح هنا معنى قوله تعالى «وَ بَدا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ ما لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ» بنفس المعنى: أي أن الحق تعالى يظهر لعباده يوم القيامة بصور لم يكونوا يتوقعونها و لا خطرت لهم ببال. و هذه الصور هي صور الاعتقاد المتعلق بحكم من أحكام اللَّه أو بهويَّة اللَّه ذاتها. فالمعتزلي مثلًا يعتقد أن العاصي إذا مات على غير توبة عاقبه اللَّه، فإذا رأى يوم القيامة أن من مات كذلك رحمه اللَّه و عفا عنه للعناية الإلهية السابقة في حقه، انكشف له خلاف معتقده. و هذا معنى تجلي الحق له يوم القيامة بصورة لم يكن يحتسبها.
أما في هوية الحق، فإن بعض العباد يعتقد أنه كذا و كذا ثم يتجلى الحق لهم في صورة هوية أخرى تخالف معتقدهم فيبدو لهم من اللَّه ما لم يكونوا يحتسبون.
و الأمر الخطير في المسألة أن ابن العربي يفسر يوم القيامة و كل ما يتصل به من أمور الآخرة تفسيراً جديداً يتمشى مع مذهبه في وحدة الوجود و لا يمت إلى المعاني الإسلامية بصلة. فيوم القيامة هو يوم يقظة الروح الانسانية، أو يوم عودة النفس الجزئية إلى النفس الكلية: أو هو الوقت الذي تتحقق فيه النفس الجزئية من وحدتها الذاتية بـ «الكل».
وعند هذه العودة- أو عند هذا التحقق تنمحي صور الاعتقادات الخاصة و يشاهَدُ الحق في كل شي ء و في صورة كل معتقد. فإذا ظهر الحق و وقع الشهود من العبد: أي إذا ارتفعت حجب المعتقدات الجزئية، ارتفعت كذلك الحواجز و الفوارق بين الحق و العبد- بين الواحد و الكثير- و استيقظت النفس من سباتها العميق فوجدت أنها هي هو:
وشاهدت الحق بعد رفع الغطاء ببصر لا يعتريه كلال، وحق فيها قول الحق:
«لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ» (قرآن س 50 آية 22).
(12) «و من أعجب الأمور أنه في الترقي دائماً و لا يشعر بذلك للطافة الحجاب و رقته و تشابه الصور».
(12) الضمير في أنه يعود على الإنسان، و لكن الأمر ليس قاصراً على الإنسان، بل شاملً للوجود كله: إذ كل شي ء في ترق دائم من حيث إنه في خلق متجدد في كل آن، و الخلق الجديد إظهار للحق فيما لا يتناهى من صور الممكنات التي يتحقق فيها وجوده.
فإذا نظرنا إلى الخلق من ناحية الحق، قلنا إن الحق «ينزل» إلى أعيان الممكنات ويتجلى فيها، وإذا نظرنا إليه من ناحية الممكنات نفسها وإظهارها للحق، قلنا إنه «تصعد» أو «ترقى» إليه. ولا تزال الممكنات في هذا النوع من الترقي نحو الحق لأن الحق لا يزال يتجلى لها في مختلف صورها.
فإذا نظرنا إلى الخلق من ناحية الحق، قلنا إن الحق «ينزل» إلى أعيان الممكنات ويتجلى فيها، وإذا نظرنا إليه من ناحية الممكنات نفسها وإظهارها للحق، قلنا إنه «تصعد» أو «ترقى» إليه. ولا تزال الممكنات في هذا النوع من الترقي نحو الحق لأن الحق لا يزال يتجلى لها في مختلف صورها.
وهو بتجليه لها أو فيه يظهر وجوده ويتحقق، وهي بقبولها ذلك التجلي يتحقق وجودها فيه.
فالترقي المذكور إذن هو التجلي الإلهي في الصور، وهو فيض الوجود الدائم من الحق إلى الخلق، سواء في هذه الدار أو في الدار الآخرة- لا بداية له ولا نهاية:
هو الفيض المقدس الذي أشرنا إليه سابقاً.
ولكنه فيض يختلف اختلافاً جوهرياً عن الفيض الذي يتحدث عنه أفلوطين، لأن الفيوضات الأفلوطينية وإن كانت ترجع إلى أصل واحد، ليست هي هذا الواحد ولا مظهراً من مظاهره كما أنها لا تلحقه أبداً ولا ترد إليه بحال.
والتجليات عند ابن العربي هي الحق نفسه مهما اختلفت صورها.
أما ما ذكرناه من هذه الدار والدار الآخرة فليس لهما معنى عنده إلا حال ظهور الموجودات في صورة ما وحال اختفاء هذه الصورة.
فالدار الآخرة موجودة في هذا العالم، بل موجودة في كل آن بالنسبة إلى كل موجود. هي جزء من ذلك الزمان الأزلي الذي تظهر فيه صور الموجودات وتختفي على الدوام.
(13) «لكن عثرت عليه الأشاعرة في بعض الموجودات وهي الأعراض، وعثرت عليه الحسبانية في العالم كله».
(13) بعد أن فسر «الخلق» بأنه محض ظهور الحق في صور أعيان الممكنات على نحو يتجدد في كل آن منذ الأزل، وبعد أن قرر أن هذا هو الخلق الجديد الذي ذكره القرآن، أشار إلى أقرب مذاهب مفكري الإسلام من مذهبه.
فقال إن الأشاعرة أدركوا جزءاً من هذه الحقيقة في نظريتهم في تجدد الأعراض، وأدركها الحسبانية في نظريتهم في طبيعة العالم كله.
قال الأشاعرة إن العالم مؤلف من جوهر و أعراض، و إن الأعراض في تغير و تبدل مستمرين بحيث لا يبقى واحد في جوهر آنين، و نسبوا كل صور الموجودات و كثرتها و تعددها إلى اختلاف الأعراض المتجددة على الجوهر الواحد.
ولا شك عندي أن هذه النظرية الذرية التي قالوا بها وإن كانت بعيدة كل البعد عن فكرة وحدة الوجود، لأن الأشاعرة يثبتون وجود إله خالق إلى جانب الجواهر والأعراض كان لها أكبر الأثر في الإيحاء بفكرة وحدة الوجود التي قال بها ابن العربي.
لأنه لمّا أحلّ «الحق» محل جوهر الأشاعرة استقامت له نظريته وأصبحت نظرية واحدية بعد أن كانت ثنائية، وأصبح الوجود منحصراً في الجوهر الواحد (الذات في اصطلاحه) والأعراض التي تختلف عليه (الصور الوجودية في مذهبه): وسقطت من نظرية الأشاعرة فكرة الخلق بالمعنى الصحيح، وأصبح ظهور الصور في الذات الواحدة أمراً تلقائياً ضرورياً.
وأقوى وجوه الشبه بين نظرية الأشاعرة ونظريته هو أن الأشاعرة ردوا الكثرة الوجودية في العالم إلى جوهر واحد مؤلف من ذرات أو جواهر فردة لا نهاية لعددها، وقالوا إن هذه الذرات لا يمكن معرفتها ولا وصفها إلا عن طريق ما يعرض لها من الأعراض التي تتغير وتتبدل في كل آن. فإذا اجتمعت على نحو ما أو افترقت ولحقها هذا العرض أو ذاك، ظهرت بصورة من صور الوجود سرعان ما تخلعها وتلبس صورة أخرى غيرها.
هكذا تظهر الموجودات وتتبين لنا صفاتها التي يسمونها بالأعراض.
و لكن الأشاعرة يختلفون عن ابن العربي في أنهم يرون أن مجرد التغيير في العالم العالم دليل قاطع على حدوثه و إمكانه و افتقاره إلى محدث يحدثه و يحدث فيه ذلك التغير.
و لكن ابن العربي اعتبر الحدوث و الافتقار قاصرين على الصور، و لم ير داعياً لفرض خالق أو محدث للذوات.
و من مواضع الشبه أيضاً بين نظريتهم و نظريته مسألة تجدد الأعراض الذي سماه هو بالخلق الجديد كما أسلفنا.
أما الحسبانية (بكسر الحاء أو ضمها) فهم فرقة من السوفسطائيين زعمت أن كل شي ء في العالم، جوهراً كان أو عرضاً، متغير متبدل، وأن الدوام والاستقرار لا يحملان على شي ء ما، وإذن ل يمكن أن يكونا صفتين تتميز بهما الحقيقة.
بل الحقيقة ليس لها وجود إلا فيما تدركه الآن، وهي حقيقة بالإضافة إليك.
وكلمة حسبانية مشتقة من «حَسِبَ» بمعنى طن أو اعتقد.
فالحقيقة حقيقة في حسبان هذا الشخص أو ذاك لا في ذاتها.
و كلا الفريقين الأشاعرة و الحسبانية مخطئ في نظر ابن العربي: و لو أنهما لَمَسَا جانباً من الحق: فالأشاعرة لم يدركوا العالم على حقيقته: أي لم يدركوا أن العالم جملة من الأعراض و الظواهر يقوِّمها جوهر واحد هو الذات الإلهية، بل افترضوا وجود جوهر أو جواهر إلى جانب هذه الذات حيث لا وجود لهذه الجواهر. أما الحسبانية فلم يدركوا أن وراء هذه الظواهر المدركة بالحس، المتغيرة على الدوام، جوهراً غير محسوس لا يتغير و لا يقبل الانقسام في ذاته، فقصروا الحقيقة على ما هو متغير و محسوس: مع أن الأمور المتغيرة ليست إلا صوراً و لا يمكن أن توجد أو تتصور موجودة إلا في ذلك الجوهر غير المحسوس الذي يقومها.
(14) «كالتحيز في حد الجوهر القائم بنفسه الذاتي وقبوله للأعراض حد له ذاتي».
(14) يشير إلى أن تعريف الأشاعرة للأشياء يدل على فساد نظريتهم لأنهم يعرفون
الجسم مثلًا بأنه المتحيز القابل للأبعاد الثلاثة: والتحيز والقبول فصلان وعرضان ذاتيان في نظر الأشاعرة لأنهما صفتان أساسيتان داخلتان في ماهية الجسم.
والعرض الذاتي عندهم هو كل ما كان جزءاً من ماهية المعرف كالنطق في تعريف الإنسان والحساسية في تعريف الحيوان والتحيز في تعريف الجسم.
وإذا كانت الحدود بالذاتيات، والذاتيات عندهم أعراض، والأعراض متغيرة لا تبقى زمانين كما يقولون، إذن يخرج من الأشياء التي لا تقوم بنفسها وهي الأعراض ما يقوم بنفسه وهو الجوهر المحدود: إذ الجوهر المحدود عين ماهيته في الخارج غيرها في الذهن ويبقى زمانين وأزمنة كثيرة مع أنهم قالوا إنه لا يبقى زمانين. وهذا باطل.
وقد جاء بطلان مذهبهم من أنهم عرَّفوا الأشياء بأنها مجموعة أعراض وأن هذه الأعراض هي عين جواهر الأشياء ولم يفرضوا وجود جوهر واحد يقوِّم هذه الأعراض جميعه
CuWsGPSyVJg
 |
 |
البحث في نص الكتاب
يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!